بين الأسر والاستعراض: بن غفير وسياسة الإذلال الإسرائيلية
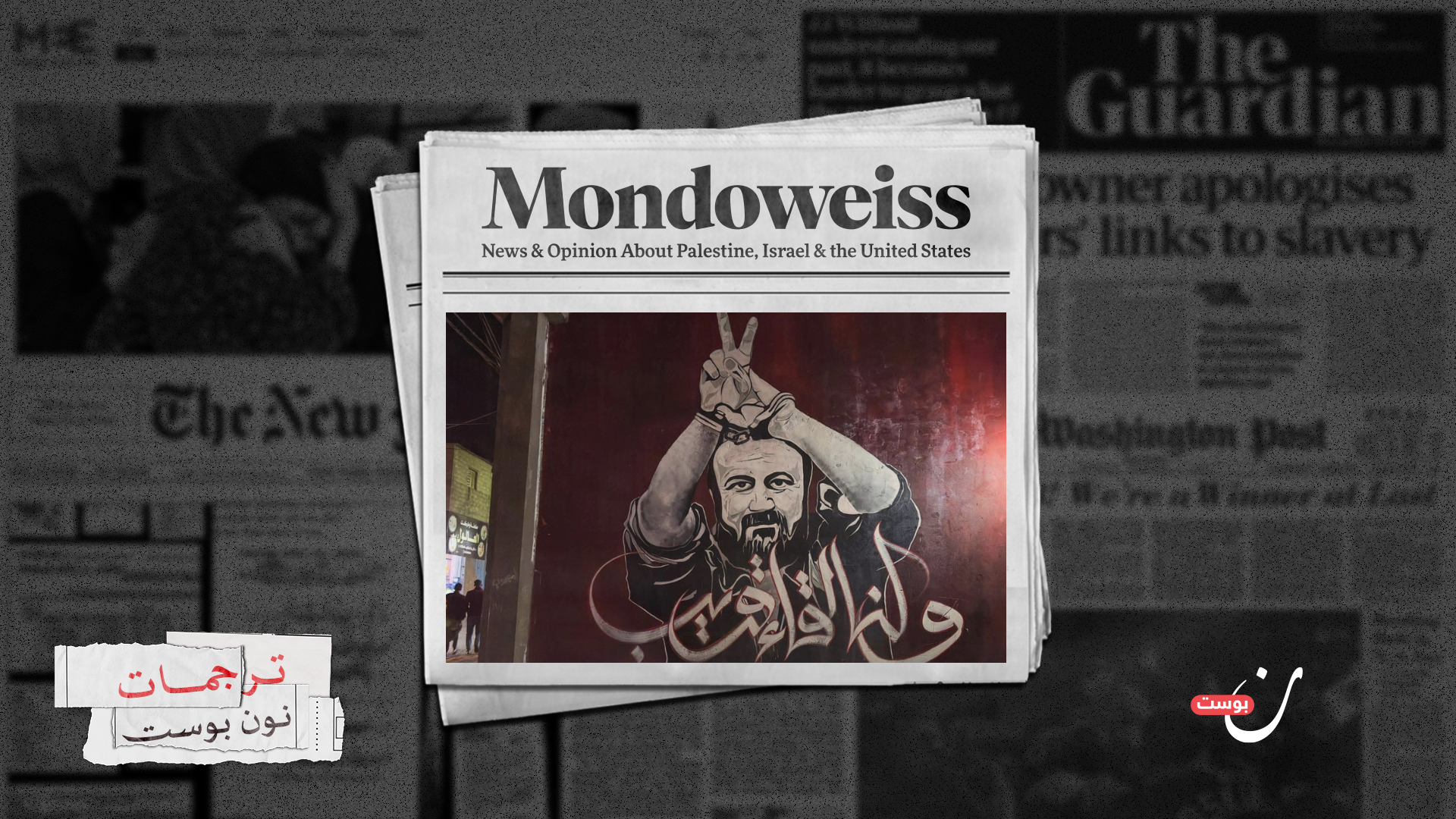
ترجمة وتحرير: نون بوست
كشفت محاولة إيتمار بن غفير المسرحية لإذلال مروان البرغوثي مدى هشاشة النظام السياسي الفلسطيني، لكنها عرّت في الوقت نفسه المخاوف والقلق العميق الذي يُغذّي حاجة إسرائيل لإخضاع الفلسطينيين علنًا.
في محاولته لإذلال مروان البرغوثي أخرج بن غفير بدقة مشهدًا سياسيًا معدًّا مسبقًا. فبدخوله السجن محاطًا بالكاميرات، واجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي زعيم حركة فتح الأسير داخل زنزانته ملوّحًا بتهديد صريح مفاده أن من يؤذي إسرائيل سيتم “محوه”. وقد بُثّ المشهد لاحقًا على حسابات بن غفير في وسائل التواصل الاجتماعي. بدا البرغوثي نحيلًا لكن ثابتًا كرمز وأسير في آنٍ واحد ليُحوّل حضوره ممر السجن إلى مسرح تُستعاد فيه الأساطير الوطنية والخصومات أمام جمهور خارج الجدران.
جاء هذا اللقاء في إطار مسرح أوسع من الإذلال على مدار السنتين الماضيتين: رجال يُجردون من ملابسهم ويُساقون نحو الاعتقال، وغزاويون جائعون يُغرّر بهم للفخاخ القاتلة قرب مواقع المساعدات، وجنود عند الحواجز يمارسون سلطة إبقاء الفلسطينيين في الانتظار، ومستوطِنون يشنّون حملات اعتداء جماعي على الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية، وأسرى فلسطينيون يتعرّضون للضرب والاغتصاب.
كان الهدف من زيارة بن غفير الاستفادة من رأس المال الرمزي للمواجهة، أي تعزيز شخصيته السياسية عبر طقس علني من الإهانة. في هذه الكوريغرافيا، لا يُقاس النفوذ فقط بالانتصارات بل بمدى وضوح صورة الأعداء المقهورين أمام عدسة الكاميرا. لم يكن المستهدف من محاولة الإذلال هذه، ذات الطابع المسرحي، السجين بقدر ما كان الجماعة التي يمثلها. فقد حمل الفعل منطق الإذلال السياسي المزدوج: وجه يركّز على الضحية ليحوّله إلى مجرّد أداة في عرض السيطرة ووجه آخر موجّه نحو جمهور الجلاد نفسه، يتغذّى على الشحنة العاطفية للمشهد.
هذا المنطق ذاته يحكم المشاهد المتكررة للإذلال المسرحي التي يسارع الجنود الإسرائيليون إلى تصويرها، ثم يتداولها الإسرائيليون العاديون بحماس على وسائل التواصل الاجتماعي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. فلماذا إذن تحظى هذه الحاجة المنحرفة – أي الهوس بنشر صور الإذلال واستعراض القوة عبر الإهانة – بجاذبية سياسية كبرى لدى الإسرائيليين؟
اقتصاد الإذلال
الجواب يكمن في اقتصاد الإذلال العاطفي. فتنفيذ الفعل وحده لا يكفي، بل يجب أن يُرى ويُتداول ويُعاد عرضه مرارًا ليؤكد صورة المسيطر عن نفسه ويعزز لدى الجمهور شعورًا بالقوة المشتركة. زالعرض لا ينفصل عن الفعل ذاته؛ فالمشهد يحوّل العنف إلى سردية، والسردية إلى شرعية، يمكن بدورها أن تُستثمر كعملة سياسية. فالجسد الهزيل لزعيم سياسي وصرخات المتوسلين طلبًا للرحمة وانتهاك الحدود الشخصية، جميع هذه المشاهد تتحوّل إلى شحنات عاطفية تغذي إحساس الجلاد بالهيمنة بينما تطمئن المشاهد الإسرائيلي بأن القوة ليست مجرد ممارسة بل عرض علني؛ ليست مجرد فعل بل ملكية مشتركة.

هكذا ينبغي فهم ألاعيب بن غفير. فشكواه الأساسية ليست أنّ السجون عاجزة عن حماية الدولة، بل أنها عاجزة عن إذلال من فيها بما يكفي. بالنسبة لبن غفير، كان نظام الاعتقال الإسرائيلي أكثر انضباطًا أكثر تحفظًا وأقل استعراضًا مما ينبغي. وقد أدان مرارًا ما يعتبره تهاونًا مفرطًا من قِبَل مصلحة السجون، حتى إنه أقال مديرها في كانون الأول/ديسمبر 2023 بحجة أنه “متساهل أكثر مما ينبغي وغير صارم بما يكفي”.
لقد دعا علنًا إلى إجراءات عقابية مثل تقليص حصص الطعام للأسرى الفلسطينيين، مُقدّمًا التجويع كوسيلة ردع، وذهب إلى حد القول — بعبارات مشوّهة — إنه من الأفضل إطلاق النار على الأسرى في الرأس بدلًا من منحهم المزيد من الطعام. كما وثّقت منظمات حقوقية أنّ سياساته تقوم على اعتماد الحرمان من الغذاء والماء والرعاية الطبية والنظافة والزيارات القانونية بشكل منهجي، هذا إلى جانب ممارسة الإذلال الرمزي مثل إجبار المعتقلين على إعادة طلاء جدران السجن أو استعراضهم كغنائم. بل إنه احتفى بإنشاء زنازين تحت الأرض صُممت لتكثيف العزلة والعذاب النفسي.
في خطاب بن غفير وممارساته، يجب أن تكون السجون، ما دامت عاجزة عن تنفيذ الإعدام، موقعًا للإذلال المستمر حيث يُقاس مدى النجاح بوضوح الانحطاط المعروض. ما يجسّده بن غفير على مستوى السياسات يعكس، في صورة مكثفة، منطقًا استيطانيًا أوسع: الحاجة المستمرة لتذكير الذات بالهيمنة. فالسيطرة، بعيدًا عن كونها ملكية مستقرة، لا تثبت بذاتها بل يجب أن تُعاد ممارستها وأن تُعرض وتُجدّد.
هذا الاحتياج الدائم للتأكيد يكشف هشاشته: فشعور المستوطن بالتفوق يعتمد على العودة المستمرة إلى مشاهد الإخضاع، وكأن القوة لا يمكن التحقق منها إلا في اللحظة التي تُمارَس فيها على الآخر. وهكذا تصبح السيطرة أقل من كونها حالة ثابتة وأكثر من كونها أداءً قلقًا تطارده دائمًا إمكانية الزوال إذا لم يُعد تمثيلها بلا انقطاع.
إن الخوف من هذا التلاشي هو بالضبط ما يغذي الحاجة القهرية للإذلال، وهو بالضبط ما يجعل القدرة على الإذلال تمنح إحساسًا زائفًا بالسيطرة. هذه المفارقة المزدوجة هي ما يعطي الإذلال قوته السياسية: الهشاشة تتنكر في هيئة قوة، والقوة تتجدد عبر الهشاشة. وعلى هذا النحو، تتحوّل سيكولوجيا السيطرة إلى شكل من أشكال الإدمان. ينظر المستوطن حوله: هل صفعتَ أحدهم اليوم؟ هل حصلتَ على جرعتك؟ فالإذلال يمنح نشوة عابرة وتدفقًا لحظيًا من اليقين بأن التفوق لا يزال قائمًا. لكن، مثل أي مخدّر، يزول تأثيره سريعًا ليترك وراءه رغبة أكثر إلحاحًا.
كل فعل من أفعال الانحطاط يُسكّن مؤقتًا قلق احتمال انزلاق التفوق، لكنه يعمّق في الوقت نفسه التبعية لإعادة تكراره. وبهذا الشكل تكشف السيطرة عن جوهرها المرضي: فهي لا تستطيع أن تستمر من دون صناعة دائمة للانحطاط. لا يمكنها أن تستريح إلا إذا أُجبر الآخر على الركوع. وهكذا يغدو عرض القوة أقل صلة بالأمن وأكثر ارتباطًا بإشباع هوس داخلي، شهوة لا تشبع للتأكيد تنخر في الادعاء بالدوام الذي تسعى إلى ترسيخه.
ما يجعل هذه العِلّة مستمرة ليس فقط إدمان المستوطن على الإذلال، بل استعداد العالم لتزويده بما يحتاج. فالنظام العالمي يهيئ الشروط التي تسمح لازدهار هذا الهوس: صمت مؤسسات يُفترض بها التنديد، دروع دبلوماسية تدرأ المحاسبة، وتدفّق لا ينقطع من السلاح والموارد يضمن أن كل فعل إذلال مدعوم ماديًا. يُستدعى القانون الدولي كمبدأ، لكنه يُعلّق عمليًا، يُعبَّر عن الغضب بالكلمات، لكنه يُفرغ في الأفعال.
هذه العِلّة ليست محصورة داخل المستعمرة الاستيطانية بل هي معولمة ويغذيها استثمار العالم الضمني في الحفاظ على تراتبية تُصبح فيها بعض الحيوات قابلة للانتهاك بلا نهاية. فما يبدو مرضًا إسرائيليًا هو في الحقيقة ترتيب كوكبي، لأن العالم يسمح ويكافئ حتى هذا الإدمان على الإذلال، ما دام يخدم اصطفافاته الاستراتيجية.
رد الفعل الفلسطيني
لكن قد يُطرح سؤال: ماذا عن “الديكور”؟ ماذا عن الفلسطينيين الذين يعانون داخل هذا المشهد؟ هل اختزال الفلسطينيين إلى أدوات عرض وأجساد تُستعرض للإذلال دليل على السيطرة التامة التي تفرضها إسرائيل عليهم؟ ثمة شيء من ذلك: فعندما دخل بن غفير زنزانة أحد أكثر القادة الفلسطينيين شعبية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، كان هدفه إذلال النظام السياسي الفلسطيني.
سواء أكان مقصودًا أم لا، فإن صمت محمود عباس وجمود اللجنة المركزية لفتح منذ بداية الإبادة، وحتى حين عُرض أحد أبرز قادتهم كأداة في مسرح بن غفير الشعبوي، لا يؤكد إلا عمق العجز. قد لا يكون البرغوثي نفسه شعر بوخز الإذلال في تلك اللحظة، لكن بنية الإذلال لم تكن بحاجة إلى انهياره الذاتي لأنها لم تكن موجّهة إليه أساسًا. لقد أظهر بن غفير التناقض الكامن في قيادة فلسطينية تواصل العمل تحت ظل المحو، منسّقة أمنيًا، مراقبة شعبها، ومُشغّلة للآلة نفسها التي تضعفها. لم يكن بحاجة إلى اختراع المشهد؛ لقد ضاعف فقط ما هو قائم أصلًا.
يعبّر كثير من الفلسطينيين عن هذه المواجهات بطرق مختلفة. نعم، كثير منا يشعر بالانحطاط، بالخوف من المدى الذي يمكن أن تبلغه الساديّة البشرية. أن تُوقَف على حاجز وتُضرب على أيدي جنود إسرائيليين بلا سبب أمر صادم. أن تتعرض للتحرش الجنسي على الحواجز أمر صادم. أن تُهان وتُعامل كحيوان أمر صادم. إنها تجارب تخلق صدمات عميقة، خصوصًا للأطفال الذين تعتقلهم إسرائيل وتنتهكهم بطرق متعددة.
لكن هذه ليست القصة كاملة. فإلى جانب شعور الإذلال، هناك استراتيجيات للمراوغة وإيماءات للسخرية. يروي البعض أنهم ضحكوا في وجه الجنود أثناء تعرضهم للضرب، محوّلين الضربات إلى لحظات تكشف عبثية القوة. ويصف آخرون كيف يصبح الإذلال مألوفًا، متغلغلا في تفاصيل الحياة اليومية، يُحتمل لا بوصفه انهيارًا بل كشرطٍ يُدار، وأحيانًا حتى يُستغل. تكشف هذه الاستجابات المتعددة أن مسرح الإذلال لا يسير وفق نص واحد، بل يُعاش ويُقاوَم من قِبَل من وُضعوا في موقع “الديكور”.
أتذكر قصة رواها لي صديقان قبل نحو عقد، تجسد هذا التوتر بوضوح مؤلم. كانا قد أُسِرا على يد جنود إسرائيليين، تم إغماض عينيهما بعصابة وكُبّلت أيديهما خلف ظهريهما بالأصفاد، ثم صُوّرا فيما الجنود يتناوبون على ضربهما. ما بقي في ذاكرتيهما لم يكن الألم، بل التفاعل الغريب الذي نشأ: حين صرخ أحدهما ضحك الآخر ساخرًا من صديقه حتى وهو يتألم. ازداد غضب الجنود، عاجزين عن استيعاب سبب عدم أخذ ضحاياهُم للضرب بجدية. فالضحك، بدلًا من أن يكسر المشهد عمّقه، مستدعيًا مزيدًا من الضربات.
يكشف هذا المشهد شيئًا عميقًا عن سيكولوجيا الإذلال وهشاشة السيطرة. فالعنف لا يهدف فقط إلى جرح الجسد، بل إلى تثبيت نصٍّ يتأكد فيه المسيطر من اعتراف المقهور بقوته. أما الضحك فقد زعزع النص. لم يكن إنكارًا للألم بل رفضًا لجعل الألم يصبح المعنى الوحيد للحظة.
في ذلك الضحك — مهما بدا قاسيًا بين الصديقين — جرى إزاحة الإذلال؛ إذ صار الضحية في آنٍ واحد متألّمًا ومشاهدًا، محوِّلًا المشهد إلى عبث. وهناك الكثير من هذه القصص، وعدد لا يُحصى مما لم يُروَ بعد. وإلى جانبها، يطفو سؤال آخر غالبًا عندما ينفجر المستوطنون بعواطفهم، يجوبون المكان وكأنهم مدفوعون لتجديد سلطتهم عبر العنف أو الخطاب. السؤال بسيط في ظاهره: “شو مالهم؟” — ما الذي استفزهم؟ وخلفه يتردد سؤال أعمق وأكثر إزعاجًا: ما الذي يعتريهم حقًا؟
المصدر: موندويس