هل انتهت آخر أوراق إيران؟
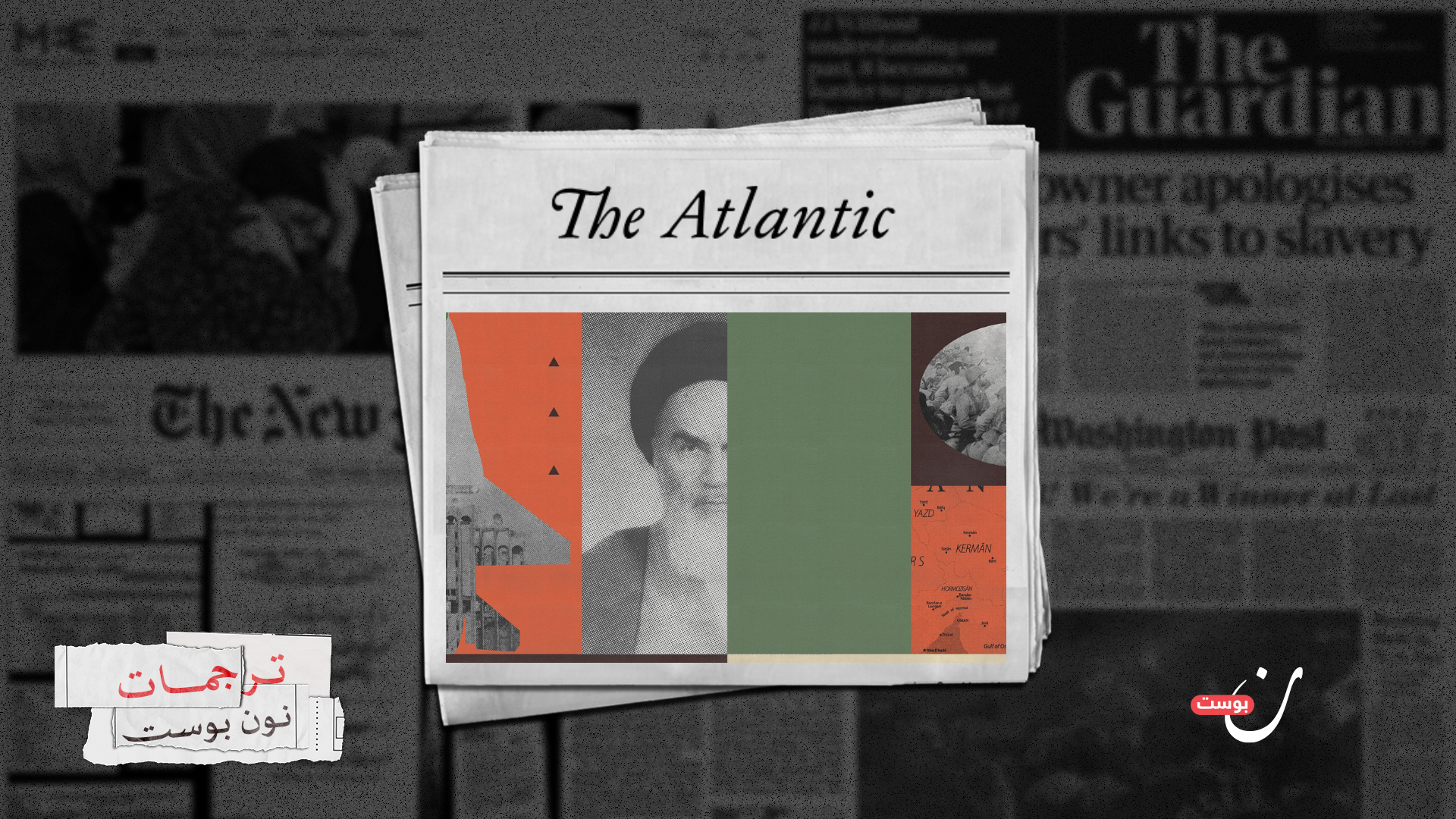
ترجمة وتحرير: نون بوست
بعد وقت قصير من نهاية الحرب الإيرانية العراقية، نظّم معهد الولايات المتحدة للسلام منتدى في واشنطن العاصمة لمناقشة مستقبل الشرق الأوسط. اقترح المشاركون أفكارا معقدة لإرساء السلام في المنطقة، قبل أن يتكلم مايكل ليدين – من تيار المحافظين الجدد – بشكل مثير للجدل.
قال: “لقد سمعتم حجج مؤيدي السلام، أنا أقف لأتحدث باسم الحرب”. وأضاف أن الصراع، الذي استمر من 1980 إلى 1988 وقتل ربما مليون شخص، كان “حربًا جيدة”. وأكد أيضًا أن أي “سلام” بين الولايات المتحدة وحكومة مارقة مثل حكومة إيران سيكون وهميًا، ومقدمة لمزيد من الحروب.
وقال لي ليدين في 2013 إن السلام هو ما يحدث “عندما يفرض طرف شروطه على الطرف الآخر”. وأضاف أنه لا يكفي أن يتوقف الطرفان عن القتال، يجب أن يخسر أحدهما. توفي ليدين في مايو/ أيار، بعد أن أمضى أكثر من خمسة عقود في الجدال ضد السلام، أو على الأقل ضد السلام الوهمي، مع إيران.
حظيت الحرب بفرصتها بعد أسابيع قليلة من وفاته. في 13 يونيو/ حزيران، نفّذت إسرائيل اغتيالات استهدفت كبار المسؤولين الإيرانيين وعطّلت دفاعاتهم الجوية. وخلال 12 يومًا من المواجهات، تبادلت إسرائيل وإيران الضربات الصاروخية، ما أسفر عن مقتل نحو ألف إيراني وعشرات الإسرائيليين.
أما “محور المقاومة” الإيراني، الميليشيات والحلفاء، فلم يشاركوا في المعركة. وفي 22 يونيو/ حزيران، قصفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية، معلنةً انتهاء الحرب. وأكدت إدارة ترامب أن البرنامج النووي الإيراني “تم القضاء عليه بالكامل”، رغم غياب أي دليل واضح يثبت هذا الادعاء. لو كان مايكل ليدين على قيد الحياة، كان سيشير إلى أن إيران لم تقبل أي شروط لوقف إطلاق النار حتى في ختام الحرب، وأن موقفها الرسمي يظل أنها لم توافق على أي هدنة على الإطلاق.
مع عودة النقاش حول ما بعد الحرب، أود أن أطرح فكرة تكرار المواقف أو “ديجا فو”. فالمنطقة معرضة للعودة إلى وضعها الافتراضي، وهو سلام يتسم بصفات الحرب، حيث تخطط إيران لمهاجمة أعدائها دون القيام بذلك فعليًا، والعكس صحيح.
قال لي مايكل دوران، زميل أول في معهد هدسون: “هذا النظام يحتضر، لكنه قد يستمر هكذا لعشرين عامًا أخرى. لقد تلقوا ضربة، لكن لا أرى أي مؤشر على قرب سقوطهم”. وفي الماضي، تعافت إيران من أزماتها عبر تعديل استراتيجيتها وإيجاد طرق مبتكرة لتقويض الولايات المتحدة وإسرائيل ومصالحهما، ومن المتوقع أن تتعافى مرة أخرى.
حتى قبل أن يتضح أن “محور المقاومة” ليس سوى “محور الغياب عن الحدث”، تكبدت الجمهورية الإسلامية هزائم مذلة: تفجيرات واغتيالات داخل إيران نفسها؛ تدمير حزب الله، أكثر وكلائها تطورًا؛ التفكيك البطيء والدموي لوكيل آخر، حركة حماس؛ وانهيار حليفها الرئيسي، نظام بشار الأسد في سوريا.
في ديسمبر/ كانون الأول، صرح المرشد الأعلى علي خامنئي (86 عامًا)، بأن مأزق بلاده يذكّره بأسوأ فترة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، وهي الحرب مع العراق. ولفت إلى أن قليلين من الحاضرين كانوا على قيد الحياة، لكنه كان موجودًا، عندما قصفت الطائرات العراقية طهران.
قال خامنئي متحدثا عن تلك الفترة: “كنت ألقي خطابًا في مصنع قرب مطار طهران. رأيت طائرة عراقية تقترب وتلقي قنابلها على المطار ثم تغادر. لقد شهدنا هذه الأمور”. وأضاف أن الاعتقاد بأن هذه اللحظات الصعبة كانت انتكاسات هو اعتقاد خاطئ. وتحدث بتفاؤل عن حلفاء إيران: “جبهة المقاومة ليست مجموعة أجهزة يمكن كسرها أو تفكيكها أو تدميرها، فهي لا تضعف تحت الضغط، بل تصبح أقوى”.
كان بعض ما قاله خامنئي مجرد شعارات. لم يكن خامنئي ليُلقي خطابًا يعترف فيه بأن “الشيطان الأكبر” و”الشيطان الأصغر” قد انتصرا. ومع ذلك، فإن روايته لتاريخ محور المقاومة، منذ ولادته بدافع الضرورة، مرورًا بنجاحاته، وصولاً إلى الصعوبات الحالية، دقيقة إلى حد كبير. على مدار العام الماضي، زرت عدة دول استغلت فيها إيران مواردها المحدودة بطرق مبتكرة.
كانت الرحلة بمثابة مسح ميداني لآثار الدمار واليأس. فالمحور الذي منح إيران عقدين من الصمود و”السلام”، ترك آثارا مدمرة في الأماكن التي مرّ بها. كان هذا الدمار متعمدًا؛ فإيران تفضل الحلفاء الضعفاء على الأقوياء، وتحبّذ الحكومات الفاسدة والقابلة للفساد على تلك التي تلبي مطالب مواطنيها.
هدف إيران هو إقامة حكم ثيوقراطي شيعي، وهو مطلب في حد ذاته، ووسيلة لمواجهة الحكومات الديمقراطية والعلمانية والسنية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة. وقد سوّق خامنئي لشعبه فكرة أن الجمهورية الإسلامية إمبراطورية لا تتأثر بالهجمات، بل تزداد قربًا من هدفها وقوة عند تعرضها للهجوم، ويجب عليها بالتالي التحلي بالصبر والثبات، مع التركيز على البقاء للتعلم من إخفاقاتها. أما بالنسبة لأعداء إيران، فقد قدم لهم عن غير قصد حجة معاكسة: هزيمة إيران تتطلب خوض الحرب بقوة والآن، وعدم منحها أي فرصة للبقاء، ومن ثم فرض سلام دائم.
محور المقاومة هو مفهوم بسيط: شبكة من حلفاء إيران المسلحين، منتشرين في أنحاء المنطقة وعلى أهبة الاستعداد للقتال ضد أعداء إيران. بحلول منتصف عام 2024، كانت هذه الشبكة تشكل طوقًا حول إيران نفسها، وهو ما تطلق عليه إيران خط “الدفاع المتقدم” الذي يُبقي أعداءها منشغلين على بعد مئات الأميال من حدودها.
كانت أبرز ركائز هذا المحور، حزب الله في لبنان، والميليشيات الشيعية في العراق، وحكومة الحوثيين في اليمن، والحكومة العلوية في سوريا، وحركة حماس في غزة. دعمت إيران، وهي أكبر دولة ذات أغلبية شيعية في العالم، هذه الجماعات، ومعظمها من الأقليات الشيعية، من خلال المتابعة، وتقوية الأطراف الأكثر قدرة على تحقيق الأهداف، وبناء الثقة والمشاعر المشتركة. كان النظام الإيراني وحلفاؤه يتحدثون عن “وحدة الساحات”، ما يعني أن الهجوم على أحدهم يمكن أن يثير ردًّا من آخر في مكان بعيد.
لسنوات، عمل أعضاء المحور على تعزيز قدراتهم ونفذوا عمليات متكررة، شملت هجمات صاروخية على إسرائيل واستهداف قواعد أمريكية في العراق. وقبل أن تبدأ إسرائيل هجومها ضد حزب الله في سبتمبر/أيلول 2024، كان مؤيدو إيران وخصومها على حد سواء يرون في هذه الاستراتيجية نهجًا لافتًا.
قال لي دبلوماسي أمريكي الشهر الماضي إن “هذه الاستراتيجية الإيرانية تعمل حتى يومنا هذا”، وأضاف أن الوقت في صالح إيران: “أظن أننا سنخرج من المنطقة قبل أن ينتهي النظام الإيراني”.
وقال لي سياسي شيعي لبناني إن على الولايات المتحدة وإسرائيل التوقف عن التصرف مثل الخاسر الذي لا يتقبل هزيمته. قال مبتسمًا وبصوت يحمل مزيجًا من الصبر والتعاطف، مثل مدرب كرة قدم للأطفال يقدم درسًا في الروح الرياضية: “لا تلوموا إيران. إذا لعبنا وخسرتَ الكرة وسجلت أنا الهدف، فذلك خطؤكم. تابعوا طريقكم”.
في غضون بضعة أشهر، انهار خط دفاع المحور تقريبًا، ولم يبقَ سوى الحوثيين على حالهم نسبيًا، وظلوا صامدين أمام الهجمات الإسرائيلية والأمريكية.
رغم أن المحور في حالة من الفوضى حاليا، إلا أنه لم يكن مشروعا فاشلًا. لقد وضع قواعد الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط لمدة 20 سنة، وأتاح لدولة فقيرة ومعزولة، يديرها أنصار طائفة دينية صغيرة، أن تُبقي الدول الأقوى والأغنى في حالة استنفار، تنفق مليارات الدولارات فقط للحفاظ على الوضع القائم، حيث كانت تلك الدول تتعرض بشكل دوري لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.
دُفعت الجمهورية الإسلامية إلى تبني هذه الاستراتيجية بعد فشل غيرها. مباشرة بعد ثورتها عام 1979، ركزت إيران على أعدائها الداخليين، وقمعت من رفضوا دعم زعيم الثورة، روح الله الخميني، وأحيانًا قتلتهم. في 1980، عندما استولى صدام حسين على حقول النفط على الحدود الإيرانية، ظنًا منه أن إيران منشغلة داخليا ولا تستطيع الاعتراض، رأت طهران فرصة لمواجهة الأعداء الخارجيين.
لم تسمح إيران للعراق بأخذ أراضيها، بل قاومت واستعادتها خلال عامين. سعى صدام للسلام، لكن إيران رفضت وحوّلت الحرب إلى معركة وجود استمرت ست سنوات. وكانت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى تراقب المشهد بارتياح، فيما دعمت الملكيات السنية العراق عندما كان على وشك الانهيار. دفعت الحرب هنري كيسنجر إلى أن يطلق أحد أكثر تصريحاته غرابة، فقد نُقل عنه قوله: “من المؤسف أن لا يخسر كلاهما”.
لكن كليهما خرج خاسرا بالفعل، وكانت الخسائر فادحة. يجب أن نعود إلى معارك باشنديل أو السوم أو ستالينغراد لنجد دوامة مماثلة من العنف بلا أي جدوى مثلما حدث في الحرب الإيرانية العراقية. استخدم العراق أسلحة كيميائية وطرق قتل شاذة أخرى، مثل وضع أسلاك مكهربة في المستنقعات وصعق المشاة الإيرانيين أثناء عبورهم. ( قال ضابط عراقي لصحيفة لوس أنجلوس تايمز عام 1984 “نحن نقليهم مثل الباذنجان”). أما إيران، فاعتمدت هجمات الأمواج البشرية وجندت أطفالًا لكشف الألغام.
وفي كتابه عن تلك الحرب، ينقل الباحث إفرايم كارش عن ضابط عراقي واجه موجة بشرية إيرانية قوله: “يهللون بـ”الله أكبر” ويستمرون بالتقدم، ونحن نستمر بإطلاق النار، نحرك رشاشاتنا عيار 50 ملم كالمناجل. رجالي أعمارهم ثمانية عشر، تسعة عشر عامًا، أكبر ببضع سنوات فقط من هؤلاء الأطفال. رأيتهم يبكون، وأحيانًا اضطر الضباط لركلهم للعودة إلى القتال. ذات مرة جاء أطفال إيرانيون على دراجاتهم نحونا، وضحك رجالي جميعًا، ثم بدأ هؤلاء الأطفال برمي قنابلهم اليدوية، فتوقفنا عن الضحك وبدأنا إطلاق النار”.
انتهت الحرب عام 1988 دون مكاسب استراتيجية لأي طرف. كان الطرفان منهكين. توفي الخميني عام 1989، وخلفه رجل دين صغير السن يبلغ من العمر 49 عامًا، يُدعى علي خامنئي، ليصبح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية التي كانت حينها مجرد ظل مشوه لنسختها الثورية السابقة.
أغلب من تولوا مناصب عسكرية خلال السنوات الماضية، بمن فيهم مهندس محور المقاومة، الجنرال قاسم سليماني، شاركوا في الحرب الإيرانية العراقية وتعلموا الدرس الأساسي: الحروب الكبرى كارثية ويجب تجنبها.
بعد هذه التجربة، قضت إيران التسعينيات وأوائل القرن الجديد كبحار في ميناء: تتجول، تتورط في مشاكل، دون وضع خطة بعيدة المدى أو رؤية واضحة. ونظرًا لسمعتها الدولية كدولة مارقة وخطيرة، لم يكن أمامها خيار سوى الابتكار. قال مسؤول استخبارات أمريكي سابق: “نظر الإيرانيون إلى أنفسهم بجدية. قالوا: لا نملك تكنولوجيا، ولا أصدقاء، ولا مال. نحتاج إلى نهج غير تقليدي”.
بدأت هذه المقاربة في لبنان. في عام 1982، بعد عدة سنوات من الحرب الأهلية اللبنانية، غزت إسرائيل لبنان لتفكيك منظمة التحرير الفلسطينية، التي كان مقرها بيروت. دربت إيران حزب الله ودعمته لمواجهة إسرائيل والولايات المتحدة والميليشيات اللبنانية السنية والمسيحية. لم يكن أي طرف في الحرب بريئًا، لكن حزب الله تميز برفضه الصريح لقواعد الحرب والدبلوماسية، وأخذ الرهائن وعذبهم، وهاجم السفارات والمدنيين داخل البلاد وخارجها، وكان رائدًا في استخدام التفجيرات الانتحارية. في عام 1983، فجّر أحد عناصره نفسه وقتل 241 جنديًا وضابطًا أمريكيًا في ثكناتهم قرب مطار بيروت الدولي، ويقال إنه كان يبتسم أثناء اجتياز نقطة التفتيش واقتحام المبنى.
وُجد حزب الله ليُقاتل. في عام 1989، عندما وافقت جميع الفصائل اللبنانية على التخلي عن السلاح والتحول إلى كيانات سياسية، ظل حزب الله مسلحًا من أجل الاستمرار في معركته ضد إسرائيل. تواصلت المواجهة حتى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000، وهي لحظة أكد فيها الحزب هيمنته، وأثبتت فيها إيران نجاح نموذج حزب الله.
استغل الحزب انتصاره لحفر أنفاق وتخزين صواريخ بغرض الهجوم على إسرائيل. أصبح لدى إيران قوة قتالية متمرسة، تكونت بتكلفة منخفضة من متطوعين عرب شيعة، دون تعريض أي إيراني للموت في ساحة المعركة. وعندما قتل حزب الله أمريكيين وإسرائيليين، لم تكن العواقب وخيمة. طرد الحزب المحتلين، وصمد أمام إسرائيل في حرب استمرت شهرًا عام 2006. ولاحقًا، عندما بدا أن النظام السوري على وشك السقوط أمام السنة، عبر حزب الله الحدود لترهيب السوريين والحفاظ على نظام الأسد.
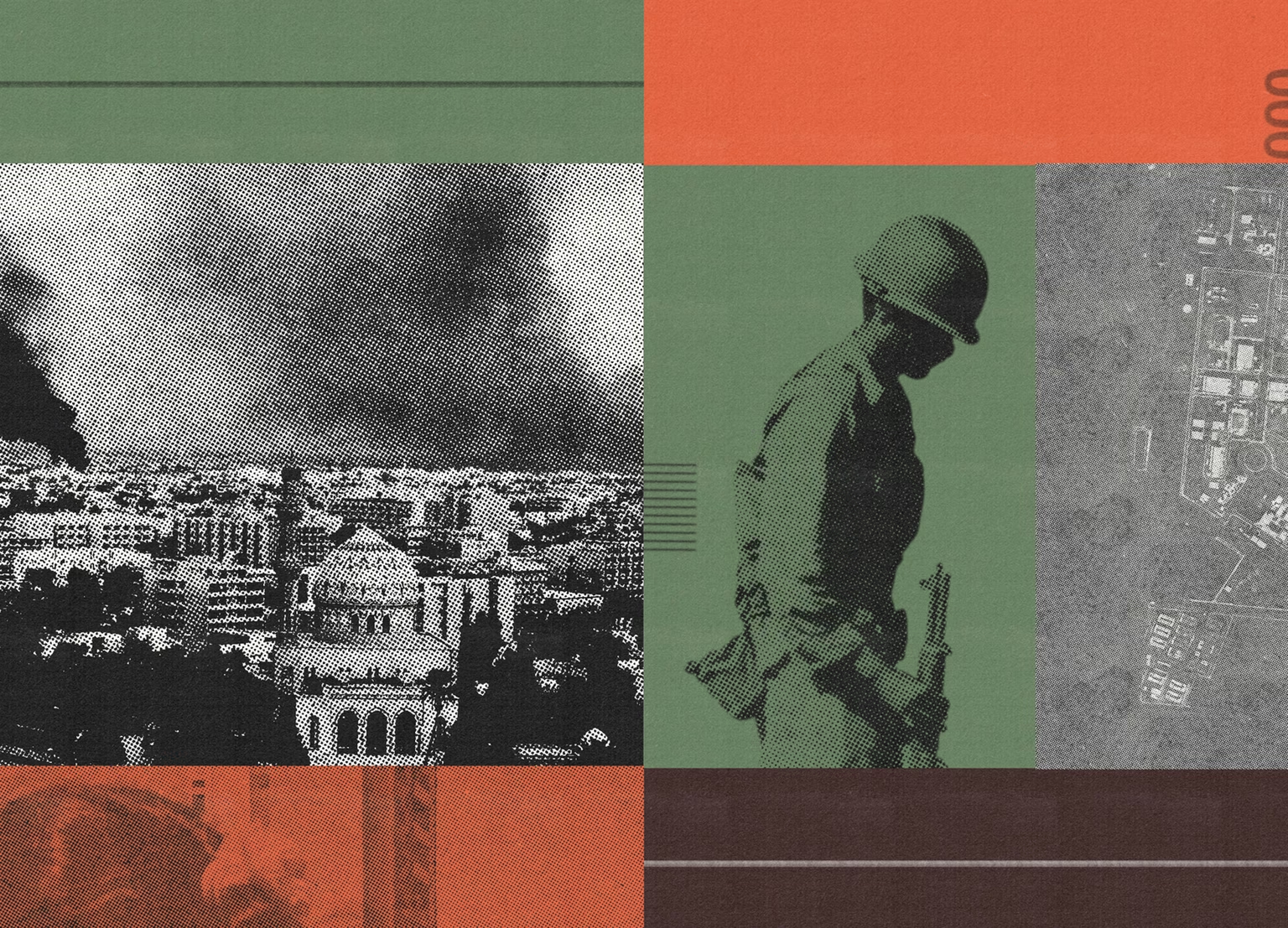
اتبعت تجربة حزب الله وصفة من ثلاث خطوات: إنشاء وكيل؛ تسليحه للقتال بكل الوسائل؛ الانتظار حتى يتفوق على العدو ويصمد أطول فترة ممكنة. أما البديل عن إنشاء وكيل، فهو إيجاد وكيل جاهز. وبما أن الشرق الأوسط يعج بالعداء تجاه الولايات المتحدة، وكذلك تجاه الحكومات المحلية، فقد وجدت إيران هؤلاء الوكلاء بسهولة.
كان بإمكان أي عضو في المحور أن يزدهر طالما وُجد فراغ، أي حينما لا توجد حكومة كفؤة تفرض سلطتها. دعمت الفوضى هذه المقاربة، مما أتاح لإيران توفير الأسلحة والتدريب. معظم الوكلاء، وليس كلهم، كانوا من الشيعة. فمثلاً حماس سنية، والحوثيون في اليمن والعلويون في سوريا يمارسون أشكالاً من التشيع تختلف عن النموذج الإيراني.
صاغ صحفي ليبي مصطلح “محور المقاومة” عام 2002، كبديل لتسمية “محور الشر” التي أطلقها الرئيس جورج دبليو بوش على إيران والعراق وكوريا الشمالية في العام ذاته، وسرعان ما بدأ الإيرانيون يستخدمون المصطلح الجديد.
تماما مثلما احتاجت إلى أن تحتل إسرائيل لبنان لترعى حزب الله، كانت إيران بحاجة إلى أن تحتل الولايات المتحدة العراق حتى تزرع وكلاء جدد لمحور المقاومة هناك. لم ترحب إيران بالغزو في البداية، كان ردها الأول تجميد برنامجها النووي بأكمله، على الأرجح خوفًا من أن تكون الهدف التالي.
سارت الأشهر الأولى من الاحتلال الأمريكي للعراق بشكل جيد نسبيًا مقارنةً بالسنوات التي تلتها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، كان حينها – ولا يزال حتى الآن وهو في سن الخامسة والتسعين – بمثابة نقيض للخميني، على الأقل في نظرته لدور علماء الدين في السياسة.
يفضل السيستاني التأثير في الشأن السياسي عن بُعد بدلًا من السيطرة على الدولة والحكم مباشرة. أدرك المسؤولون الأمريكيون أنهم محظوظون لأن السيستاني يختلف عن الخميني في هذا الصدد، وبمرور الوقت بذلوا جهودًا كبيرة لكسب رضاه والحرص على مناداته بالألقاب الرسمية (سماحته، السيد) التي لم يكلفوا أنفسهم باستخدامها مع علماء دين آخرين.
صبر السيستاني خلال الأشهر الأولى للاحتلال حال دون انخراط الشيعة العراقيين في القتال ضد القوات الأمريكية بحماسة. أما السنة العراقيون فقد قاوموا الأمريكيين لكن دون تأثير يُذكر. كان نجاح الأمريكيين محبطًا للقيادات العليا في إيران. أخيرًا، في 2004، تحركت طهران عبر الطريقة الوحيدة التي بدت فعالة: تحويل الصراع إلى النموذج اللبناني من خلال إيجاد وكيل، وتسليحه، وتركه يقاتل نيابة عنك. وهكذا أصبح العراق دليلًا على أن هذا النموذج يمكن أن ينجح في مختلف أنحاء المنطقة، وكان حزب الله النسخة المتكررة لولادة وكلاء إيران الجدد.
بحلول فبراير/ شباط 2004، كان هناك شخصيتان من خارج العراق تعملان بهدوء على تحويل الشيعة في العراق ضد الاحتلال، وتجهّزهم عسكريًا لإلحاق الأذى بالأمريكيين.
الأول هو قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، والثاني عماد مغنية، القائد العسكري في حزب الله وأحد أبرز الجهاديين الشيعة المطلوبين عالميًا. مات الرجلان في نهاية المطاف على يد الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنهما نجحا قبل ذلك في تقويض مصالح أعدائهما بتكلفة منخفضة.
لأن السيستاني في العراق لم يحرّك أتباعه عسكريًا لمواجهة الولايات المتحدة، لجأت إيران إلى رجل دين آخر، وهو المشاكس مقتدى الصدر، ابن محمد صادق الصدر، المرجع الأعلى الذي اغتيل على الأرجح بأمر من صدام حسين عام 1999. لم يكن منصب آية الله وراثيًا؛ فالعلماء عادة ما يكونون شيوخًا ذوي لحى بيضاء تميزوا بعلمهم. أما الصدر، الذي كان يبلغ 29 عامًا وقت الغزو، فقد تميز بدعمه للمقاومة.
زار إيران للمرة الأولى عام 2003 والتقى بالمرشد الأعلى خامنئي. وفي الأشهر التي تلت عودته، حشد أتباعه في ميليشيا أطلق عليها اسم جيش المهدي. وبحلول أوائل 2004، كان جيش المهدي يخوض حربًا شاملة مع القوات الأمريكية في شوارع النجف. كانت الولايات المتحدة أفضل تسليحًا وتدريبًا، لكن مجرد اندلاع المعارك كان مؤشرًا مقلقًا للأمريكيين وحلفائهم.
كان الصدر مختلفا عن القيادات الأمريكية في أرض المعركة بشكل مثير للمخاوف. كان شابًا ممتلئ الجسد، وقد أظهر فشل الأمريكيين في تحييده حدود قدرتهم على السيطرة على الوضع. في مؤتمر صحفي، أعلن قائد القوات البرية الأمريكية في العراق، الجنرال ريكاردو سانشيز، أن هدفه في النجف “قتل مقتدى الصدر أو القبض عليه“. لكن من اللافت أن الصدر كان يلقي الخطب أمام الجماهير، بينما بدا سانشيز، خلال مؤتمره الصحفي، وكأنه مختبئ في أحد الملاجئ.
في السنوات التالية، كان لجيش المهدي والإيرانيين هدف مشترك: إلحاق أكبر قدر من الخسائر بالقوات الأمريكية المحتلة. كان لدى العراق كمية كبيرة من الأسلحة الصغيرة والذخيرة، التي كانت قادرة على قتل الأمريكيين، لكنها كانت غالبًا ما تصطدم بمركباتهم المدرعة. ومع استمرار الاحتلال، أصبح العراقيون بارعين في صناعة العبوات الناسفة في الأقبية والكراجات والمختبرات الصغيرة المنتشرة في بغداد والأنبار.
كانت مساهمة إيران تتمثل في استثمار خبرات البحث والتطوير من مناطق عملياتها الأخرى، خاصة لبنان، لتعزيز قدرة العراقيين على القتل. العنصر الإيراني الأساسي كان العبوات الناسفة الخارقة. بدلاً من التفجير في كل الاتجاهات مثل القنابل البدائية، تركز هذه العبوات قوة الانفجار في نقطة محددة، وتشكل كرة معدنية منصهرة ثم تُطلقها مثل المدفع.
وتقدّر الولايات المتحدة أن ما لا يقل عن 603 من أصل نحو 3,500 جندي أمريكي قُتلوا في العراق كانوا ضحايا ميليشيات شيعية. أصيب عدد أكبر بجروح، وكان معظم هذه الخسائر نتيجة مباشرة ومقصودة للمحور الإيراني الناشئ.
منح النجاح على الساحة العراقية إيران الثقة لتطبيق النموذج في مناطق أخرى. في سوريا، كان لديها نظام حليف بقيادة الأسد، وعندما بدأ تماسكه يضعف في 2011 مع اندلاع الحرب الأهلية السورية، أرسلت إيران جنودها للمساعدة في قمع الانتفاضات السنية المدعومة أمريكيًا. لكن القوة الفعلية للحفاظ على الأسد كانت لبنانية، فقد عاد حزب الله للظهور بعد فترة من الركود منذ عام 2000، وسحق المتمردين. كما شاركت ميليشيات شيعية عراقية، بعد انتهاء الاحتلال الأمريكي، بالتوازي مع مرتزقة روس، في الحفاظ على حالة الجمود في سوريا. وبحلول 2018، كان الأسد يسيطر على دمشق وحلب، بينما انحصر وجود المتمردين في إدلب.
مدفوعة بهذا النجاح، بدأت إيران في إحياء أو إنشاء وكلاء جدد في مناطق أخرى. في البحرين والسعودية، وجدت شيعة متحمسين للإطاحة بالأنظمة الملكية السنية.
وفي اليمن، وجدت شريكًا غريبًا ومميزًا يتمثل في جماعة الحوثيين. تقود جماعة الحوثي عائلة من رجال الدين الذين يتسمون بجنون العظمة، وقد بدأوا بالتنبؤ بحرب مدمرة منذ أوائل القرن الحالي. بمساعدة إيران وحزب الله، تمكن الحوثيون من طرد الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والانخراط في حرب عن بعد مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
يرجع نجاح الحوثيين جزئيًا إلى استخفافهم الشديد بقيمة الحياة البشرية – بما في ذلك حياتهم – كما يرجع إلى الأسلحة المتطورة التي حصلوا عليها من إيران. في أواخر 2023، أطلقوا صواريخ باليستية مضادة للسفن على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر. كانت تلك أول مرة تُستخدم فيها مثل هذه الصواريخ في هجوم فعلي في تاريخ العالم.
بحلول منتصف العقد الثاني من الألفية، بدأ وكلاء إيران يتواصلون ويتشاركون الخطط ويتبادلون الخبرات التقنية ويعملون بشكل متناغم. جعلت إيران جيشها التقليدي زائداً عن الحاجة، واستبدلته ببديل أكثر مرونة وإبداعًا. قال لي مسؤول استخبارات أمريكي سابق: “فجأة أصبح لديهم لوحة مفاتيح كاملة ليعزفوا لحنا، بدلًا من نغمة أو نغمتين فقط”. هذه التعددية الصوتية سمحت للوكلاء بالتناغم والتزامن، بينما بقيت الولايات المتحدة وحلفاؤها دائمًا خارج الإيقاع.
استقر رأي كبار المحللين على أن غزو العراق كان أحد أكبر الأخطاء الاستراتيجية للسياسة الخارجية الأمريكية، وأن المستفيد منه كان إيران. كتبت هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز في عام 2006: “لقد مكّنت إدارة بوش إيران أكثر مما كان يتصوره أشد آيات الله تفاؤلا”.
تحققت هذه المكاسب بسرعة، ثم تبددت بالسرعة ذاتها، إذ انتقلت إيران من حالة العجز خلال الحرب مع العراق، إلى النظام الذي لا يُهزم بعد عقدين تقريبًا، ثم إلى هزيمة ساحقة بعد عقدين آخرين. لكن فشل محور المقاومة كان حتميا، وكانت مؤشرات هذا الفشل واضحة قبل أن يبدأ المحور في التمايل.
لم تهتز أي دولة في المنطقة بحدة كما اهتزت لبنان، ولم تحظَ أي دولة مثلها باهتمام إيران المتواصل. هذه السمات ليست مصادفة. في صيف 2024، التقيت بالمؤرخ مكرم رباح في مكتبه بالجامعة الأمريكية في بيروت. شبّه رباح حزب الله بـ”مستشاري إيران الاستراتيجيين، الدماغ الذي يُشغّل الوكلاء، القوة التي تجعلهم يتحركون”، ووصفه بأنه “ماكينزي جهادي” يضاعف من قوة وكلاء إيران.
وأضاف أن عبقرية حزب الله في هذا المجال جاءت على حساب كفاءته في أي مهمة قد تجعل لبنان دولة ديمقراطية وظيفية.
تابع رباح: “حزب الله طفيلي يقتل مضيفه”. هذا الفصيل وُجد من أجل القتال والاستعداد للمعارك، مما يخلق نقاط ضعف وحدودا، لأنه لا يتقن شيئا آخر. هذا يجعله بلا حلفاء، هشا، فاقدا للقدرة على الابتكار، مبتكرة، ومفارقةً، يجعلها عرضة للضرر حتى أثناء المعارك.
وأكد رباح أن حزب الله لم يسعَ قط لأن يصبح قوة سياسية قوية ودائمة، لأنه لم يُصمّم لذلك أصلاً. منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية، اعتبر الحزب لبنان قاعدة له، وتنقل في المنطقة في سلسلة مغامرات دموية، مع تراجع اهتمامه بشؤون وطنه. وقال: “السياسة الداخلية أصبحت مصدر إزعاج لحزب الله”. وقارن رباح بين حزب الله وحركة أمل الشيعية التي نزعت سلاحها بعد الحرب الأهلية وكرّست جهودها لإتقان فنون السياسة، من مساومات في الكواليس، ومناورات برلمانية، واستغلال النظام الفاسد ضمن حدود مقبولة.
وأضاف رباح أن أعضاء حزب الله “الذين يحاولون ممارسة السياسة هم في الواقع من الاستخبارات أو الجيش. كلهم إسبرطة، لا أثينا”.
وتابع قائلا: “الأحزاب السياسية الأخرى حملت السلاح للحصول على مقعد أفضل على الطاولة، لكن حزب الله لم يهتم أبدًا بأن يكون هناك دولة. لبنان أصبح مجرد غلاف بالنسبة له، شيء يحميه بينما يقاتل في الخارج”.
وأوضح رباح أن القتال في الخارج أنهك حزب الله. وبسبب استخدام جنوده للهواتف ونشر الصور على الإنترنت، استطاع الإسرائيليون رسم خريطة كاملة للحزب. وفي النهاية، تحول الحزب إلى مشكلة إقليمية بدلًا من أن يكون مشكلا محليًا. وقال رباح: “لقد أصبحوا وحشًا لا يمكن إعادته إلى الحظيرة”.
لا جدال في أن الوضع في لبنان أصبح كارثيا. هناك مناطق من بيروت يبدو أن الدولة تخلت عنها، بعد سلسلة من الكوارث التي كان يمكن لحكومة ذات كفاءة – ولو محدودة – أن تتفاداها. في عام 2020، انفجر مرفأ بيروت عندما اشتعلت النيران في 2,750 طنًا من نترات الأمونيوم داخل أحد المستودعات.
عادةً ما يتطلب الأمر انفجارًا نوويًا لتدمير مدينة بتلك الطريقة المفاجئة والمروعة. في وسط بيروت، لا تزال النوافذ مكسورة والمباني غير صالحة للسكن. في عام 2019، اكتشف اللبنانيون أن نظامهم المصرفي قد خدعهم بشأن حساباتهم المصرفية، إذ اختفى المال تماماً. فقدت الليرة اللبنانية معظم قيمتها، وإذا سافرت اليوم إلى بيروت التي كانت في السابق مركزاً مصرفياً، فمن الحكمة أن تحمل معك العملات الأجنبية كما يفعل المهربون. أكبر لوحة إعلانية شاهدتها في وسط بيروت كانت تشير لخدمة تساعدك على الحصول على جواز سفر ثانٍ.
ما أطلق عليه الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز توماس فريدمان ذات مرة “قاعدة بوتري بارن – إذا كسرتَ شيئًا، فأنتَ مالكه”، لها نظير في الحروب الأهلية: إذا كانت لديك الأسلحة، فأنت تتحمل المسؤولية. وحزب الله، باعتباره الأكثر تسليحًا وعنفًا في لبنان، أراد الأسلحة دون تحمل المسؤولية. ومع انشغاله بمغامراته في سوريا والعراق واليمن، ورعاة يجب إرضاؤهم في طهران، لم يجد الحزب الوقت ولا الدافع لبناء الدولة التي يدّعي الدفاع عنها.
تحدثت مع فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، الذي قال إن الدعم الذي تقدمه إيران لحزب الله أخلّ بتوازن النظام اللبناني، الذي صُمم لضمان مشاركة كل الطوائف في الحكم: المسيحيون والسنة والشيعة والدروز. وأضاف أن أي دعم يحظى به فصيل لبناني من طرف خارجي يؤدي إلى اختلال التوازن، وتختل معه القدرة على الحكم.
وأوضح السنيورة: “في الديمقراطية، هناك أغلبية تحكم ومعارضة غير مهمشة تسعى فعليًا للإطاحة بالأغلبية عبر الانتخابات”. وأكد أن ما لا يمكن أن ينجح أبدًا هو نظام تتعايش فيه الحكومة مع كيان في الظل ليس له نوايا ديمقراطية.
واقتبس السنيورة من القرآن الآية: “لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا”، معتبرا أن الدولة أو العائلة أو الشركة لا تحتمل أكثر من قائد واحد، مثلما كان يقول والده: “السفينة تغرق إذا كان له أكثر من قبطان”.
على مدى نحو ربع قرن، ظل حزب الله بلا منافس حقيقي كأداة تهديد لإسرائيل، وكان ذراع إيران الرئيسية في الردع والعقاب: “إذا اقتربتم منا، سنستخدم ضدكم حزب الله”. انتهت تلك الحقبة بشكل بطيء عبر الانهيار المأساوي لسوريا ولبنان كدولتين فاعلتين، ثم تسارع الانهيار حين بدأت إسرائيل باستهداف حزب الله في أماكن غير متوقعة.
في سبتمبر/ أيلول 2024، نفّذت إسرائيل عملية تفجير استهدفت أجهزة النداء التي يستخدمها عناصر حزب الله، ما أسفر عن إصابات خطيرة. أظهرت العملية دقة لافتة في التنفيذ، وعكست مستوى متقدمًا من المعرفة ببنية الحزب ومواقع أفراده وقياداته، الأمر الذي أثار تساؤلات حول حجم الاختراق الأمني والاستخباراتي.
اجتاحت إسرائيل جنوب لبنان واحتلته مرة أخرى، وانتهى التدخل باتفاق بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، كان مهينا حزب الله ولبنان على حد سواء. أكدت الحكومة اللبنانية أنها ستبقي جنوب لبنان خاليًا من أي وجود عسكري لحزب الله، بينما احتفظت إسرائيل بحقها في الدفاع عن نفسها. نظرًا لأن إسرائيل لم تعتبر هجماتها على حزب الله حربًا عدوانية من الأساس، فإن تأكيد هذا الحق شكّل تهديدًا بالعودة إلى لبنان مجددا من أجل مزيد من التدمير. كان الاتفاق محرجا لإيران أيضًا، إذ كان من المفترض أن تدافع عن وكلائها وترد الجميل بعد سنوات طويلة من القتال نيابة عنها. الآن لا يبدو أن إيران ترغب بحمايتهم، وربما لا تستطيع ذلك.
على نحو موازٍ، بدأت إسرائيل بتفكيك حركة حماس. حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تُنهِ إسرائيل مهمتها بعد، وصمود الحركة بعد نحو عامين من القصف والحصار، يُعدّ بالنسبة لأنصارها انتصارًا بحد ذاته. لكن قدرة حماس على تهديد إسرائيل وإطلاق الصواريخ بشكل مستمر لم تكن يومًا هدف إيران الأساسي. تكمن قيمة حماس بالنسبة لطهران في أنها تشكل تهديدًا للسلطة الفلسطينية، النظام العلماني الذي يحكم رام الله، والموالي بالتبعية للحكومات العربية العلمانية الأخرى التي تمثل أهدافًا لطهران.
لو تمكنت حماس من السيطرة على الضفة الغربية كما فعلت في غزة عام 2007، لكان ذلك يعني إقامة دولة إسلامية على حدود الأردن، أحد أقرب حلفاء إسرائيل والولايات المتحدة. يشكل اللاجئون الفلسطينيون أكثر من نصف سكان الأردن، وهو ما يشكل عاملا لزعزعة الاستقرار بشكل دائم. الحرب في غزة لم تدمر حماس، لكنها قضت على النسخة التي كانت تخدم أهداف إيران الاستراتيجية. حماس باقية، لكنها فقدت قيمتها كأصل استراتيجي لإيران.
كانت هزيمة الوكلاء حتمية. لم يكن النظام السوري قادرًا على البقاء دون حزب الله، فكان أشبه بالمريض الذي يحتاج إلى غسيل الكلى، يظل حيًا فقط عبر تدخل مكلف. مع اندلاع الحرب في سوريا، وصل جنود إيرانيون لإنقاذ الأسد، وعزز حزب الله والميليشيات العراقية القوات الحكومية، وانضم إليهم الروس 2015. لكن مع تصعيد إسرائيل ضرباتها، غادر الإيرانيون. افتقر الجيش السوري إلى الإرادة للدفاع عن مدنه، وسقطت دمشق بعد عشرة أيام فقط من بدء الهجوم.
حديث تلك الهزائم بأسرع مما كان متوقعا. لكن النموذج الإيراني تآكل حتى في الأماكن التي لم تهاجمها إسرائيل والولايات المتحدة منذ فترة. كان أكثر مثال ساخر هو العراق، بالنظر إلى أنه مثّل بعد لبنان، المكان الذي شهد أعظم نجاحات إيران. أتيحت لإيران فرصة تنصيب حكومة تُحاكي نظامها الثيوقراطي. هيمنت الأحزاب الشيعية على المشهد السياسي، وقاد سياسيون عراقيون عاشوا لسنوات في إيران خلال حكم صدام تلك الأحزاب، ووصلوا إلى منصب رئيس الوزراء.
بحلول 2008، بدأ الأمريكيون بالانسحاب، وكانت أعداد القتلى في أدنى مستوياتها منذ بداية الاحتلال. بدا أن إيران قد انتصرت، وكان معظم المراقبين يفترضون أن قاسم سليماني والحكومة الإيرانية هم من سيقرر من يتولى الحكم وكيف يحكم، سواء كانت اللعبة القادمة انتخابية أو عسكريًة.
فوجئت العديد من الفصائل الشيعية التي كانت تعتقد أنها تحظى بدعم قاسم سليماني – وقد كان تقييمها صحيحًا وخاطئًا في الوقت نفسه – بأن إيران التي رعتها جميعا، فضّلت أن تتقاتل فيما بينها على أن يسيطر أحدها على السلطة.
بدأت الخلافات الداخلية فورًا. سيطر جيش المهدي على أجزاء واسعة من البصرة، وفي عام 2008، تعرض لهجوم من الأمريكيين، ومن الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة. كان رئيس الوزراء العراقي آنذاك، نوري المالكي، شيعيا وذو صلات وثيقة بإيران، وكان كثير من الشيعة يعتقدون أنه سيستمع إلى مطالب إيران ويتجنب التصادم مع ميليشيا تابعة لها.
لكن إيران لم تفعل الكثير لوقف الاقتتال الداخلي. وفق العرف السياسي في العراق منذ ذلك الحين، كانت قيادة الحكومات المتعاقبة شيعية. والكثير من الحكومات، بما في ذلك الحكومة الحالية، مرتبطة بميليشيات شيعية لها روابط قوية مع إيران. تتميز هذه الميليشيات بالقوة، وبفضل سيطرتها على التهريب وأنشطة غير مشروعة أخرى، فهي تجني أرباحا طائلة، وهي منخرطة باستمرار في النزاعات حول عائدات التجارة غير المشروعة والفساد.
حتى وقت قريب، تمت السيطرة على ميول هذه الميليشيات إلى التنازع بفضل قاسم سليماني. فقد ساعد في إنشاء العديد منها وتنسيق عملها، وأحيانًا كان يُوظفها ضد بعضها البعض. لكن بعد أن اغتالته الولايات المتحدة في ضربة صاروخية عام 2020، بدأت هذه الفصائل غير المنضبطة في السعي وراء مصالحها الخاصة.
تم دمج العديد من هذه الميليشيات في الحكومة العراقية عام 2016 ضمن الحشد الشعبي، لكن بدلًا من تقوية الدولة، فقد أضعفتها من الداخل، مستغلة امتيازاتها الحكومية لتعزيز فسادها. وقال حمدي مالك، زميل باحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: “يستخدمون فصائل الحشد الشعبي للقيام بأشياء خارج سلطة القيادة الحكومية”. وأضاف: “تمتلك مركبات الحشد حرية الحركة بشكل كامل، ولهذا يمكنها التهريب دون قيود”.
ينبغي القول إن بغداد تشهد اليوم ازدهارًا نسبيًا. خلال زيارتي في أغسطس/ آب 2024، شعرت بالدهشة وأنا أرى المدينة التي عرفتُها سابقًا مكانا للقتل والقمع، وقد غرمتها مظاهر التجميل الحضري. انتشرت مراكز التسوق والمقاهي الحديثة، بتصاميم أنيقة تشبه ما نشاهده في دبي أو ميامي، مليئة بالرجال والنساء الذين تبدو عليهم علامات الثراء: الماكياج، والسيارات المدرعة، والأجسام الرياضية. في وسط المدينة، تناولت ساندويتش برغر من عربة طعام وجلست أستمتع بالمشروبات الباردة، دون أن أشعر بالخوف من أن يتم اختطافي وتصوير عملية إعدامي.
في زياراتي السابقة لبغداد، كنت أرغب في زيارة شارع المتنبي، الشارع الضيق الذي يكتظ ببائعي الكتب وينتهي عند أحد أعظم المقاهي الأدبية الباقية في العالم العربي. في الماضي، كان التوقف هناك مخاطرة كبيرة. عام 2007، فجّر مجهول نفسه في المكان ما أسفر عن مقتل العشرات. هذه المرة، تجولت بين الأكشاك براحة تامة. كانت المعروضات غريبة. بالإنجليزية، وجدت نسخًا من كتب تاريخ عن الآشوريين طُبعت في إنجلترا منتصف القرن الماضي. وبالعربية، وجدت كتبا لمارغريت أتوود وستيف هارفي، وحتى هتلر. كتحفة تذكارية، اشتريت ترجمة حديثة لـ”بيان يونابومبر”، وجلست أقرأها في المقهى الأدبي الذي أعيد افتتاحه، وأنا أحتسي شايًا ساخنًا.
حذّرني عراقيون من أن هذا السلام الحالي يخفي فسادًا متأصّلًا. قال علي المعموري، المستشار السابق لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لشؤون الاتصالات الاستراتيجية بين 2020 و2022: “الوضع يبدو سلميًا تمامًا ويمكنك التجول في أي مكان، لكن هناك جانبًا مظلمًا وعميقًا”.
وأضاف أن الشركات الكبرى، مثل شركات الطاقة والمصافي والمؤسسات المالية، لا تزال تعمل تحت تأثير الميليشيات: “يجب دفع أموال من أجل الحماية لهذه الميليشيا أو تلك”. وأضاف عندما أشرت إلى أن الشوارع تبدو آمنة والناس غير خائفين: “يحظون بالأمن، لكنه ليس من الشرطة أو الحكومة”. وحذّر من أن هذا الوضع سيكون خطيرا على العراق على المدى الطويل، لأن هذه العصابات التي توفر الحماية مؤقتة وقد تتحول خلافاتها إلى صراع في الشوارع. لتحقيق الازدهار الدائم، يحتاج العراق إلى بناء دولة حقيقية.
رأيت مؤشرات على بناء الدولة. صباح أحد الأيام في وسط بغداد، لفت انتباهي حوالي ثلاثين رجلاً يرتدون ملابس موحدة: بدلات سوداء بسيطة، وربطات عنق رفيعة، وقمصان بيضاء. لكن هؤلاء لم يكونوا ممثلين، بل كانوا ضباطًا متدربين في وزارة الداخلية، أحد الأعمدة الأساسية لأمن الدولة العراقية.
لكن لم تكن المواقع التي تؤشر لبناء الدولة بعيدة عن مواقع تقويضها. خطرت ببالي العبارة المشؤومة في إحدى قصائد بيرسي بيش شيلي: “أنهض وأهدمها من جديد”. وفي هذه الحالة، كان العامل المهدد يحتل موقعًا مميزًا مقابل وزارة الداخلية مباشرة: المقر الإداري لقوات الحشد الشعبي. يمتد المقر على مساحة كبيرة في وسط بغداد. على اليمين، موقع لبناء الدولة؛ وعلى اليسار، موقع لهدمها، من خلال جهود ميليشيات يُشتبه على نطاق واسع بأنها تابعة لدولة أخرى.
داخل مقر الحشد الشعبي، بالكاد يخفي قادة الميليشيات أن ولاءاتهم منقسمة بين العراق وإيران. الصور التي تجمع خامنئي وقاسم سليماني منتشرة في كل مكان. الفضائل المكوّنة للحشد تعمل أحيانًا بشكل مستقل عن الدولة العراقية، وهي أكثر وولاءً لإيران، وبعضها مدرج ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية.
قضيت ساعة في مكتب سياسي تابع لإحدى أكثر هذه الميليشيات تطرفًا، حركة حزب الله النجباء. قال حمدي مالك: “النجباء هي ببساطة أقرب ميليشيا لإيران، وهي جناحها العسكري في العراق، وتتلقى أوامرها مباشرة من طهران”. وشبّه المتحدث باسم الحركة، حسين الموسوي، علاقة الحركة بإيران بالتحالف القائم على المصالح والقيم المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مضيفًا: “انظر في المرآة، أمريكا وإسرائيل لديهما تحالفهما، ونحن لدينا تحالفنا”. الغريب، أن إيران لديها كل هؤلاء الحلفاء في العراق، وكل ذلك النفوذ، لكنهم لم يتمكنوا من تشكيل حكومة متماسكة.
أكد لي عراقيون آخرون أن سبب هذا الانقسام هو أنه حالة التشرذم تخدم مصلحة إيران. لو كنتَ مكان خامنئي أو سليماني، وقضيتَ شبابك تستمع لقصف الطائرات العراقية على طهران، أو تقرأ تقارير عن إحراق أبناء شعبك مثل الباذنجان على أيدي العراقيين، ألم تكن لتتوخّى الحذر قبل أن تشكّل حكومة عراقية قوية مثل حكومتك؟.
أي أداة يمكن أن تبنيها حكومة شيعية قد تتحوّل في حال تغير السلطة إلى أداة أمريكية، سنية أو كردية. الخيار الأكثر أمانًا لإيران كان إخراج الأمريكيين، وملاحقة السنة، وترك الفصائل الشيعية تتقاتل فيما بينها إلى الأبد. أخطر السيناريوهات بالنسبة للإيرانيين هو ظهور عراق له مصالحه ووسائله الخاصة لتحقيقها على حساب إيران. شكّلت إيران محورًا لخدمتها، لكنها فعلت ذلك بطريقة سيئة وفاسدة، حتى أصبحت تفضل خدمة مصالحها في العراق دون أي اعتبار آخر.
قبل عامين فقط، بدا أن إيران توجه ثلاثة بنادق نحو إسرائيل. الأول حزب الله بصواريخه ذات الصيت الواسع، والثاني العراق بفصائله المقاتلة المتمرّسة القادرة على إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ، وربما إرسال مقاتلين عبر سوريا، والثالث اليمن. عندما قررت إسرائيل توجيه ضربة لإيران، لم يطلق سوى سلاح واحد فقط. فاجأت الضربة الأولى حزب الله ودمرته تقريبًا. وكانت الفصائل في العراق، بطبيعة الحال، قلقة من أن تواجه نفس المصير الذي واجهه حزب الله. أما الحوثيون في اليمن، فقد شنوا هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة نحو المدن الإسرائيلية. ولكن من دون شركاء، لم تكن هذه الهجمات كافية لتأكيد التهديد الذي كان يمثلّه محور المقاومة.
بحلول عام 2025، كان محور المقاومة في حالة فوضى. لا يزال قادة إيران يرفضون المواجهة المباشرة كما في السابق. عدم وجود مواجهة مباشرة أو غير مباشرة يعني غياب الردع. منح تفوق إسرائيل على الجبهات الأخرى الثقة لبدء الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو/ حزيران، والتي كان آخر أداة استراتيجية متبقية لإيران فيها صواريخها الباليستية. انتهت الحرب بانتصار إسرائيلي كاسح، فيما وجدت إيران نفسها مضطرة للبحث عن وسائل جديدة لمعاقبة إسرائيل وردعها في حال قررت استئناف الهجوم.
كم من الوقت ستستغرق إيران لإيجاد بديل لمحور المقاومة؟ عندما وجدت نفسها بلا خيارات في السابق، استغرق الأمر 15 عاما لتجد طريقًا جديدًا. ربما لا تتعافى أبدًا، وقد يتحول المحور إلى آخر فكرة استراتيجية ناجحة لإيران. وربما تكون الفكرة التالية أفضل بكثير، مثل سلاح نووي يُنتج في الخفاء، أو شيء أكثر ذكاءً مما يمكن لعقلي الصغير تصوره.
يرى مايكل دوران، من معهد هدسون، أن مصير إيران قد يشبه مصير كوبا بعد كاسترو: أن تحل القيادة العسكرية محل الجيل الأول من القادة أصحاب الكاريزما. وقال لي: “حسب بعض القراءات، انتهى عهد الملالي منذ زمن، ونحن الآن أمام نظام الحرس الثوري”. وأضاف أن أيديولوجية النظام تتحول من الفكر الشيعي الثوري إلى القومية الفارسية. لكن هذا التحول لا يعني زوال العداء مع الولايات المتحدة وإسرائيل. إيران المنهكة، والتي فقدت جزءًا من جاذبيتها، ستواصل البحث عن طرق لإزعاج إسرائيل والولايات المتحدة. هذا السلوك يمثل سمة ثابتة وفريدة للجمهورية الإسلامية. حتى عندما بدا النظام أكثر ميلاً للسلام مع الولايات المتحدة عبر الاتفاقات والتسويات، عمل جاهداً في أرض الواقع على تحقيق العكس.
وقال كريم سجادبور، الباحث في مركز كارنيغي للسلام الدولي: “المقاومة جزء لا يتجزأ من هوية الجمهورية الإسلامية”. وأضاف أن خامنئي قام ببعض المناورات والتعديلات التكتيكية، لكن محاولة قيادة حركة ثورية دولية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، غير قابلة للمساومة. وأضاف: “الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، والحجاب” تبدو نقاطًا ثابتة لا تخضع لإعادة تقييم.
في عام 2015، أتاح الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما مع إيران وصولًا غير مسبوق إلى مواقعها النووية، وفرض قيودًا صارمة – لكنها مؤقتة – على التخصيب. إلا أن ذلك لم يخفف من حماس إيران لمهاجمة الولايات المتحدة وإسرائيل. قبل الاتفاق، وبعد توقيعه، كثّفت إيران دعمها لمحور المقاومة، مستغلة الموارد والمرونة الإضافية لتصبح أكثر عدوانية. عززت دعمها للأسد (مما أطال الحرب الأهلية)؛ ووثقت روابطها مع الحوثيين؛ ودعمت حزب الله بالصواريخ والأموال؛ ويُقال إنها خططت ونفذت هجمات إرهابية خارج حدودها. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، حاولت إيران، حسب ما أفادت به التقارير، اغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، والمعارِضة الإيرانية مسيح علي نجاد.
السلام ليس مطلبا مبالغًا فيه. كثير من الإيرانيين، رغم كراهيتهم لحكومتهم، رحبوا بنهاية الحرب وأدانوا الموت العبثي لمواطنيهم على أيدي حكومة بعيدة لم تكترث لحياتهم. لكن السلام يختلف من حالة لأخرى، وهذا التاريخ المليء بالأحداث الغريبة يقدم مبررات قوية للاشتباه بأن السلام الحالي سيكون مجرد فترة مؤقتة في قصة طويلة من العداء المتبادل.
عندما وافق روح الله الخميني على إنهاء الحرب العراقية الإيرانية، شبّه السلام بشرب كأس مسموم. لم يستطع، ولا يمكن لأي زعيم إيراني آنذاك، الاعتراف بأن قراره بإطالة الحرب وزيادة المآسي كان كارثيًا. والسلام في نهاية الحرب الأخيرة مع إسرائيل يتسم بالقدر ذاته من انعدام البصيرة وعدم الاعتراف بالخطأ.
يتساءل كثير من الإيرانيين لماذا تنفق حكومتهم كل هذا المال والجهد على صراعات مع إسرائيل والولايات المتحدة وحلفائهما، بدلًا من مواجهة فسادها الداخلي. لا مؤشرات على أن الحكومة تفكر في إعادة تقييم أولوياتها؛ بل ستواصل دائمًا البحث عن طرق جديدة وجريئة لتحقيق تلك الأولويات بحماسة متجددة. معاناة الإيرانيين كانت تكفي لتغيير ذلك النهج، لكن تصميم إيران على نشر هذه المعاناة بين حلفائها وأعدائها يجعلها جارًا بالغ السوء، سواء في السلم أو في الحرب.
المصدر: ذا اتلانتك