“إذا صممنا على النجاح، فسوف ننجو معًا”.. حوار مع الروائي السوري فواز حداد
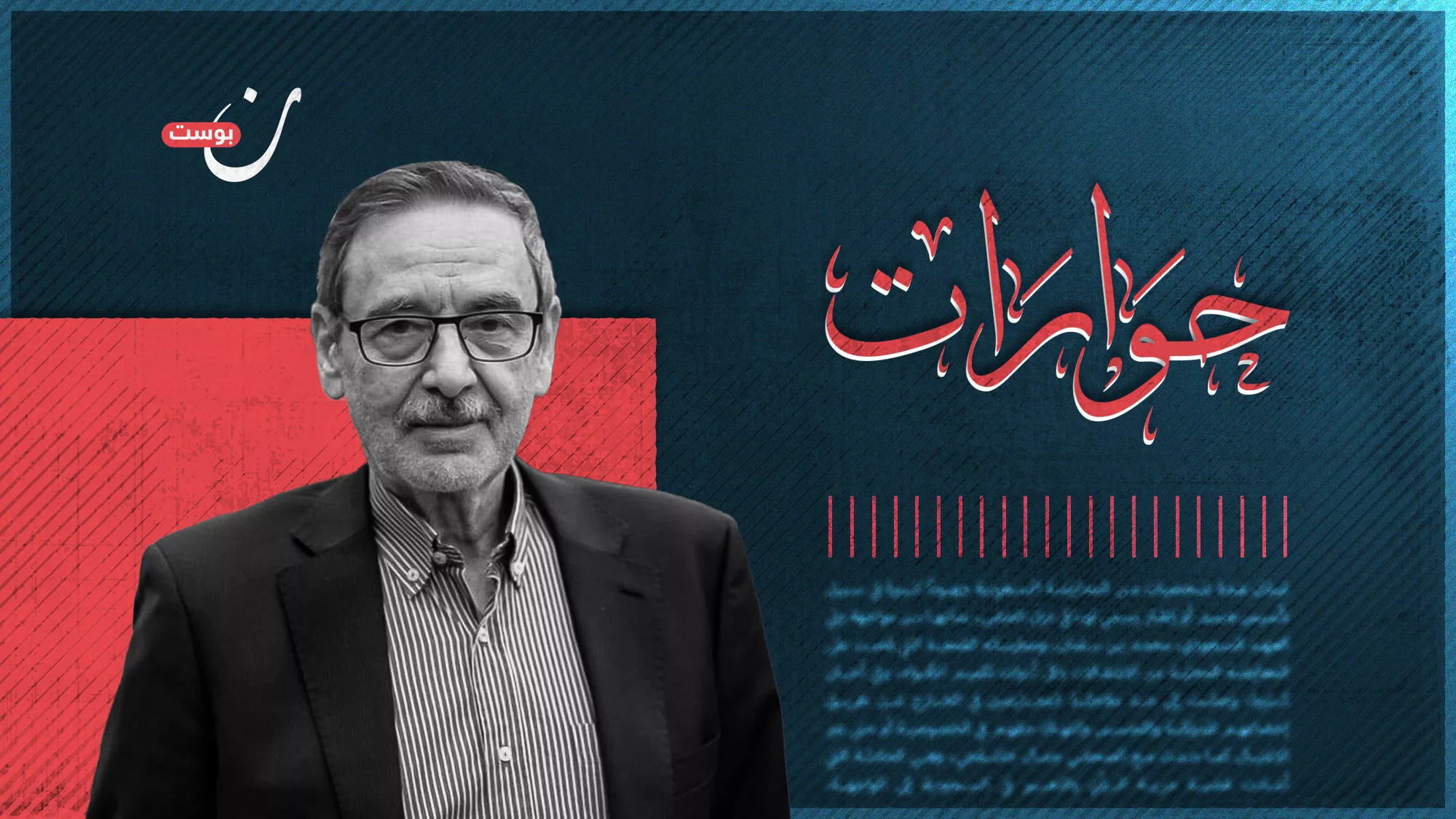
في تاريخ الرواية السورية، يبرز اسم فواز حدّاد كأحد أهم الأصوات التي سجّلت التحولات الكبرى وحفرت عميقًا في طبقات الذاكرة والواقع، ليكتب عن الإنسان السوري في مواجهة السلطة والتقلبات والأزمنة العاصفة. منذ بداياته، ظلّ مشروعه السردي منشغلاً بالبحث عن الحقيقة خلف جدران القمع والأيديولوجيا، متتبعًا العلاقة المعقدة بين الفرد والمجتمع والسلطة، ما جعل أعماله الممتدة على عقود تشكّل أرشيفًا روائيًا يلاحق ما أهملته السياسة وطمسته الخطابات الرسمية.
في هذا الحوار الخاص مع “نون بوست”، يستعيد حدّاد ملامح هويته الأدبية، ويتأمل مسار الرواية السورية تحت وطأة الرقابة، ويقف عند أثر الاستبداد والطائفية في صياغة البنى السردية، كما يناقش دور المثقف في زمن التحولات العظمى، ويستشرف مآلات الثقافة السورية بعد سقوط الاستبداد.
هنا حديثٌ مع روائي ظلّ وفيًّا لدمشق التي كتبها بأطوارها المختلفة، وللسوريين الذين شكّلوا مادة رواياته، بوصفهم كائنات من لحم ودم، تحمل أوهامها وهزائمها وأحلامها.
كيف ترى اليوم هوية فواز حداد الروائية، في ضوء التحولات العاصفة التي مررتَ بها أنت شخصيًا، ومرّت بها الرواية السورية في مشهدها الأوسع؟
للروائي عادةً مجموعة من الهويات، رغم وجود هويات مستقرة، مثل هويتي ككاتب عربي سوري. أما عن ديني، فالأمر يعنيني وحدي، سواء كنت متدينًا أو لست متدينًا، وهذا لا يعني أنني لا أدافع عن الإسلام عندما يتعرض لسوء الفهم، أو تتخذ ضده مواقف متشنجة. عدا عن النزوع نحو الحقيقة، التي لا تغفل الهوية الإنسانية التي تجمعني مع البشر في أي مكان. وهي نوع من الهويات التي تنشأ عن الارتباط بقضايا إنسانية، لا تميز بين إنسان وآخر. لست وحدي، هذا ما يظهر في أعمالنا الروائية السورية والعربية، التي لا تنفصل عن الرواية العالمية، وإن كانت الأولوية للاهتمام بمجتمعاتنا، أسوةً بغيرنا من الروائيين الذين يكتبون عن بلدانهم وأنفسهم أيضًا.
ارتبطت أعمالي الروائية ببلدي سورية، وكتبت عن دمشق لأنها المدينة الأقرب لي، بحكم ولادتي فيها وصلتي الحميمة بها. كتبت عن مرحلة الانتداب والاستقلال، ثم مرحلة الانقلابات، ومن ثم عنها كبلد عالق في دكتاتورية، قضينا جلّ أعمارنا فيها، فأخذت هي أيضًا نصيبًا من رواياتي.
في الواقع، لم أكن أؤرخ لهذه المراحل، وإنما كنت أتتبع حياتنا في ظل أوضاع متغيرة، معقدة ومتشابكة وأحيانًا عاصفة. ما نصيبنا نحن البشر من التفاعل معها والانفعال بها اجتماعيًا وسياسيًا؟ إلى أي حد تؤثر في حياتنا اليومية وسلوكنا وخصوصياتنا؟ إنها بشكل ما عنا نحن؛ ضعفنا، عظمتنا، طموحاتنا، سقطاتنا، خسائرنا، نكباتنا. إنها عن مآثرنا وعذاباتنا، هزائمنا وانتصاراتنا. إنها عن الإنسان في داخلنا، وما يحمله من ثراء قيمي وأخلاقي، عن العيش بكرامة. طبعًا لا يشترط أن يشاطرني الآخرون هذا النظر، إذ لكل روائي خصوصيته.
إلى أي مدى شكلت الرقابة السورية ما قبل سقوط الأسد عاملاً حاسمًا في تقنين المواضيع والثيمات الروائية التي تتناولها الرواية السورية؟ وكيف انعكست تلك الرقابة في الأدب الذي تنتجه؟
ألقت الرقابة بظلها على الأدب طوال فترة نظام الأسد، وغدت هناك موضوعات مسموح بها وموضوعات محظور الاقتراب منها، إلى حد كانت الرقابة تلاحق حتى تلك الإيماءات التي توحي بانتقاد ما للسلطة. وكي نضع الرقابة في نصابها الحقيقي، فقد كانت مرتكزة على الكتاب المؤدلجين بعثيًا، الذين أخذوا على عاتقهم المراقبة في اتحاد الكتاب، وفي الصحافة الثقافية. فبرزوا كسلطة ثقافية غاشمة تنحو إلى اتهام الكتاب بالرجعية والبرجوازية والعشائرية، والتخلف عن المسيرة الظافرة للاشتراكية، وفيما يعد بالطائفية والتأسلم والإرهاب، تحت زعم اختلاق تيار أدبي تقدمي نظيف من الرجعية الاجتماعية والدينية، بينما كان اضطهاد الرأي المختلف، والمساس بكل ما يعتقد بأنه يلمح إلى السلطة والحزب والرئاسة.
فأصبحت الموضوعات الشائعة تلك التي توصف بأنها تنشر تحت راية الفن الجميل، ما يخفي بشاعة ما يمارس في الواقع. فازدهرت موضوعات الدونجوان الثقيل الظل اللاهث وراء النساء، والثوري المغامر بحياته ضد الإمبريالية، ونضالاته المتوهمة في السجون، على أن تكون في الزمن البرجوازي وفي عهد الوحدة. طبعًا، لم يروا السجون والمخابرات التي استباحت البلد كلها.
كثير من أعمالك اعتُبرت بمثابة تشريح للمنظومة السياسية والاجتماعية السورية، إلى أي مدى شكلت مقاومة الاستبداد حافزًا في البنى السردية في الأعمال الروائية التي أنتجتها؟
يكتب الروائي عن العالم الذي نشأ فيه، والبشر الذين يعيش معهم، كيف يراهم على السطح وفي العمق. الفارق بينهما هو الذي يشكل الرواية، إنه الفارق بين الادعاء والحقيقة، ما تظهره السلطة وما تبطنه، وينطبق هذا أيضًا على النفس البشرية، والعلاقات بين الناس. هذا ببساطة، من دون تعقيد.
هذه المشهدية، إذا كانت تعمل على الواقع، ولا تدور في إطار الخيال فقط، تحتاج إلى تفكيك البنية التي سنتطرق إليها، وهي عملية روائية بحتة، يتحقق نجاحها في أسلوب الأداء من خلال السرد، الذي يختلف من رواية لأخرى، حتى لو حملت بصمة الكاتب، كذلك من ناحية الفن الذي يلعب دوره في طرائق توصيله إلى المتلقي.
حين تكتب عن الخوف والقمع والأيديولوجيا والتطرف، كيف تحافظ على التوازن بين ثقل هذه القضايا وجمالية الرواية بتعبيرها الإبداعي؟
ليس هناك جمالية معروفة ولا موحدة للرواية يمكن الرجوع إليها لنقتفي أثرها، إضافة إلى الموضوعات التي يطرحها، من ناحية كثافتها، بساطتها، تعقيدها، وتنويعاتها. الرواية عالم متسع وشاسع حسب تيارات الأدب في العالم. عمومًا، تختلق الرواية جمالياتها، وتختلف من روائي لآخر، عدا أنها لا تقع تحت الحصر، إلى حد القول إن هناك جمالية القبح، التعذيب، السجن… الجمالية هنا، ليست التبرير ولا التسويغ، ولا إضفاء جمال ما، بل وضعها ضمن إطار بالغ التعبير عنها، بشكل يتحسس القارئ ما هو الألم في العمق، لا استعذابه، والتأثر فيه من فرط الانخراط فيه شعوريًا، ويذهب به إلى حدود الإدانة المطلقة، وربما التماهي معه، وجعل القارئ يبكي من شدة التأثر.
يمكن القول إنها الجمالية المضادة للجمالية المتعارف عليها.
روايتك “السوريون الأعداء”، اتهمها البعض بأنها تغذي الطائفية وتشعل الفتيل أكثر، بينما يصفها البعض الآخر بأنها رواية تفسر صعود الطائفية السورية وتكشف من أسسها وبنى عليها حكمه ومؤسساته، كيف كتبت روايتك عن هذا الموضوع الحساس الذي يشغل السوريين؟
كتبت هذه الرواية للإجابة على الكثير من الأسئلة، أحدها الطائفية، فجرى إنكارها، واتهمت بها، واتخذوا من مجزرة حماه دليل إدانتي من ناحية أنه لا يجوز التطرق إليها، ولا مناقشتها على الإطلاق، وأن النظام كان على حق في الدمار الذي حاق بها، وأن المجازر المرتكبة كانت لتكون عبرة للسوريين. إنها درس في القمع الجيد. كانت إدانتي لمجزرة حماه التي طاولت الإبادة، فرصة لاتهامي بالتأسلم… أي شيء إسلامي يجعلهم يرتعدون حنقًا وغيظًا، وهذا من ضيق النظر، يعتقدون أنه سند لادعائهم بأنهم علمانيون نجباء، فأثبتوا أنهم طائفيون حتى العظم، تحت شعارات ديماغوجية.
أي كتابة تتعرض للطائفية كانت تتهم بالطائفية، لهذا السبب يجب ألا تُهمل أبدًا، ولأنها تحكمت بمجتمعاتنا، كان مطلوبًا تجاهلها، لا معالجتها. هكذا عطب ينبغي الكشف عنه بمنتهى الصراحة، خاصة أنها نشرت الحقد والتطرف. ظهر في مجازر النظام، ومجازر المتأسلمين بالمقابل. الدولة آنذاك تصرفت كدولة غازية لبلدها وعدوة لمواطنيها، الذين ارتكبوا هذه الجرائم تفاخروا بها، قتلوا وأحرقوا ونهبوا، ولم تكن إلا توطئة لما أقدم عليه الابن المجرم، فقتل وحرق ونهب عموم سوريا، وكان في إنجازه عملًا وحشيًا مستوحى من حماه، أتاح له الوقت ليتفوق على الأب بالمجازر والبراميل المتفجرة والكيماوي.
هل تشعر أن الرواية ما زالت قادرة على التأثير في وعي القارئ العربي، أم أن أزمنة الصورة السريعة والسوشال ميديا قلصت دور الأدب؟
أكثر ما تستطيع فعله الرواية هو التأثير في وعي القارئ، ومحاولة إثراء نظرته إلى البشر والقيم والعالم والحياة بشكل يمسه في العمق، هذا هو ساحتها. أما التغيير المطلوب فيقع العبء على القارئ، وذلك بالتفاعل مع الواقع. هناك كتب وروايات دعت إلى الثورة، لكن لم تحدث، هذا فعل شعبي تشارك فيه أحزاب ونقابات ومؤسسات، والبشر.
صحيح أن الصورة ووسائل الاتصال قلصت من دور الأدب، لكنها لم تتمكن ولن تستطيع أن تحل محله. لقد انتزعت منه قدرًا غير قليل من الوقت المخصص للقراءة، في الواقع سرقته من أوقات الفراغ.
ما تعبر عنه الرواية لا تتفوق عليها وسائل الاتصال مهما بلغت حرية التعبير. قد تفلح في التهييج والتحريض وتبادل الآراء، عمومًا تبقى في حدود الثرثرة المسلية وأحيانًا المفيدة، لكن الطابع السطحي والتسرع الذي تتميز به هذه الوسائل يجعلها تخسر قدرتها على التأثير الجدي، ويتفوق عليها الأدب ليس بالعمق فقط، وإنما بصناعة الأفكار، وما يتمتع به من القدرة على تصدير أدب وفن حقيقيين.
في زمن الأزمات والتغيرات العظمى، يثار سؤال: ما جدوى الثقافة؟ كيف يمكن أن نقدم نموذجًا ثقافيًا سوريًا جامعًا، ما هو دور المثقف اليوم وكيف يغير في السردية الشللية الناخرة ويقضي عليها؟
في زمن الأزمات والمتغيرات الكبرى، لا جدوى عندها إلا للثقافة؛ هي التي تساعد البشر على التبصر والصمود والبقاء في وجه التحديات. البشر بحاجة إلى دافع وهدف يسمو بهم عن الخلافات الصغيرة، وإدراك حركة التاريخ، والوعي لما يواجهون من أخطار، وعدم الاستسلام لليأس والانهزامية. الثقافة هي التي تجمع الناس وراء ما يتجاوز عزلتهم نحو حوارات جماعية.
الأسد قضى على الثقافة، تعامل مع المثقفين كعملاء له، أو رماهم في السجون. بعد التحرير، انكشف أمراض المثقفين؛ الشللية والطائفية، التفاهة والغطرسة وامتلاك الحقيقة، وكراهية الإسلام، كدليل على التقدمية متذرعين بالإرهاب. لم يتعلموا ما يجب أن يتعلموه وهو النظر إلى الواقع. الأيديولوجيات القديمة بحاجة إلى إعادة النظر فيها، العالم انطلق إلى أيديولوجيات أكثر توحشًا، تعمل عليها نخبة من المليارديرية، يريدون ابتلاع العالم، يحددون النسل بالأوبئة والجوع والقتل بالجملة. الجشع لا يقف عند حد.
بعد أن انتصرت الثورة، وبعد أن انتهت حقبة الأسدين، هل تغيّرت رؤيتك لسوريا التي كتبت عنها وعن مجتمعها؟ هل من الممكن أن نرى نتاجًا أدبيًا جديدًا يتوّج السلسلة السورية التي كتبت عنها بانتصار الثورة؟
في بواكير هذه المرحلة، يمكن التبشير بأن الإنسان السوري باتت لديه الإمكانية كي يفكر ويعبر بحرية، ولو كانت مرحلة انتقالية، لكنها واعدة… هناك الكثير مما يمكن كتابته، لدينا ما هو مختزن في داخلنا، يمكن أن ندعه حتى ينضج. ما يجعلنا نتردد، ولا نحزم أمرنا، ما يبدو وكأنه فوضى شاملة. هناك من يريد الانفصال عن سوريا، ومن يريد عرقلة السلطة الجديدة بكافة الوسائل، ومن يحاربها بالسلاح والاغتيالات والخطف والسرقة والقتل، يؤازرهم بعض المثقفين. يعتقدون أنه لا يمكن أن تكون مثقفًا إن لم تنتقد السلطة بشراسة ودونما هوادة، وكأنه إذا كنت مثقفًا جيدًا، يمكنك أن تكذب وتبالغ في الأخطاء وتختلق جرائم… نعم، السلطة تخطئ، وقد تخطئ كثيرًا، وأكثر مما يجب. إذا كنت معارضًا، فانتقد بمسؤولية.
هناك من يجهد في التفكير بالتخلص من آفات الماضي، ما زلنا نحمل الكثير من الأمراض والعاهات تحت تأثير نصف قرن من الجرائم المتراكمة… ألا نتساءل كيف سيشفى منها شعب ممزق، في الخيام ومشرد وجائع ويشكو من الغلاء والبرد والحر وبلا كهرباء؟ الكثير من الرجال الأحياء عاشوا زمان الأسدين، كيف يمكن التخلص من هذه اللعنة؟ وعلى أي نحو يجب أن نفهم هذا الماضي؟ وهل من الممكن أن نستعيد رشدنا؟ بالمناسبة، كما نرى اليوم، هناك نزعة تخشى التغيير، وتنشد استمرار الماضي بمختلف الذرائع، وكأنهم لا يعرفون أنه إذا سقطنا هذه المرة، فقد لا نقف ثانية. وإذا صممنا على النجاح، فسوف ننجو كلنا معًا.
أستاذ فواز، بعد أن كنت مرآة سردية للمجتمع السوري وأحداثه، ها هي الثورة السورية انتصرت؛ من رواياتك “السوريون الأعداء”، و”الشاعر وجامع الهوامش”، و”تفسير اللاشيء”، وصولًا إلى “يوم الحساب” و”جمهورية الظلام”، وأخيرًا “الروائي المريب”. هل ترى أن هذه الروايات تشكل سجلًا روائيًا متكاملًا للمجتمع السوري وتحولاته؟ وهل يمكن اعتبارها وثيقة أدبية لفهم ما جرى ويجري في سوريا، مقارنةً بين الماضي الذي اشتغلت عليه سرديًا والراهن السوري اليوم؟
لقد عملت على سردية، ليست كاملة ولا وافية. الحدث السوري أكبر منا جميعًا، ستأتي أجيال من المؤرخين والباحثين والأدباء لتعمل على ما يزيد عن خمسين عامًا ليس من الاستبداد فقط، بل من الأكاذيب والادعاءات والتحريف والتزوير والزيف وغسيل الأدمغة والنفاق والرياء، والاستهانة بالبشر، واعتبار التعذيب والقتل أسلوبًا للبقاء إلى الأبد… هذه أمراض حقيقية دخلت في نسيج البشر والحياة. كانت مادة للخضوع، ليس الشفاء منها بالسهل، أو حتى ترميم حياتنا واستعادة ما فقدناه. اليوم، من المهم التفكير بحرية، وليس بتسيب.
لقد عملت على فترة امتدت نصف قرن، بكتابة سبع روايات، كتبت عنها لأنني كتبت عن الحياة، من خلال ما عشته وما عرفته أو رأيته وتأثرت فيه، وكان هذا تبعًا لوجهة نظري. أي كيف عبرت عنه روائيًا. هناك الكثير سيأتون غيري ويكتبون، ومنهم من بدأ يكتب عنها منذ سنوات. هذا جرحنا، هناك من طعننا في الصميم، ودمر العالم الذي عشنا فيه.
نعم، يمكن اعتبار ما كتبته وثيقة أدبية روائية، يمكن في المستقبل الاستئناس بها. المهم بالنسبة لي، أنني وضعت سرديتي على خارطة الرواية.
بين الجوائز العربية والاحتفاء النقدي، ما الذي يعنيه لك الاعتراف الأدبي مقارنة بالاعتراف من قارئ بسيط يجد نفسه في نصوصك؟
الجوائز العربية، اختلاق عربي نشأ مشوّهًا، وعُوّل عليه، لكنه لم يكن صحيًا، ظهر وهو يحمل أمراض الثقافة والمثقفين. نادرًا ما كانت نتائج الجوائز المعتمدة، وأقصد المشهورة، حقيقية فعلًا، طالما أنها تخضع للتجاذبات غير الأدبية. لم تعد الجوائز سوى تلك المظاهر الثقافية التي بدأت الدول العربية تعتني بها وتتذرع بها، لكنها مجرد مظهر مخادع، توزع طبقًا لحساباتها، أوكلتها لجهات تعمل لحساباتها. كذلك الحفاوة النقدية، أغلبها مفتعل ولا يستحق. ابحث عما وراءها، فستجد أنها للإيحاء بحياة ثقافية نشطة، بينما هي لتصدير مثقفين ينحازون لما تمليه عليهم الأنظمة.
طبعًا لا أعمم ولا يجوز، هناك أعمال رائعة تمكنت من احتلال موقع بارز، لكنها لم تكن بالقدر الكافي لوطن عربي يمتلك من القدرات الهائلة ما يفوق هذا الحصاد.
الحفاوة الحقيقية وبلا منازع هي القارئ. ولا بأس بأن نذكر بواقع غياب الناقد، بالتالي أصبحت ذائقة القارئ هي الحكم على الكتاب والكاتب. وأقول إن حظي معه كان جيدًا، وتقديري له كان عاليا. كما وجدني، وجدتُه.
أخيرًا، إن أردت أن تترك للقارئ العربي جملة واحدة عن الثقافة السورية اليوم، ماذا تقول؟
إنها في طور إعادة الولادة، وفي الواقع تجديدها، وعلى أمل الاستعداد الموعود به، وبشكل أدق، استئناف دورها الذي حمل شرف ريادته واستمر به الكثير من الأدباء الراحلين الذين استطاعوا شق الطريق لنا وللآخرين ولهؤلاء القادمين الجدد، وكان في ظروف صعبة تجلّت بنظام قمعي لا يعبأ بالحريات. آن الأوان ليمتلكوا أقدارهم الأدبية.