مصطلح “معاداة السامية”.. من النشأة إلى التوظيف كسلاح ضد الخصوم
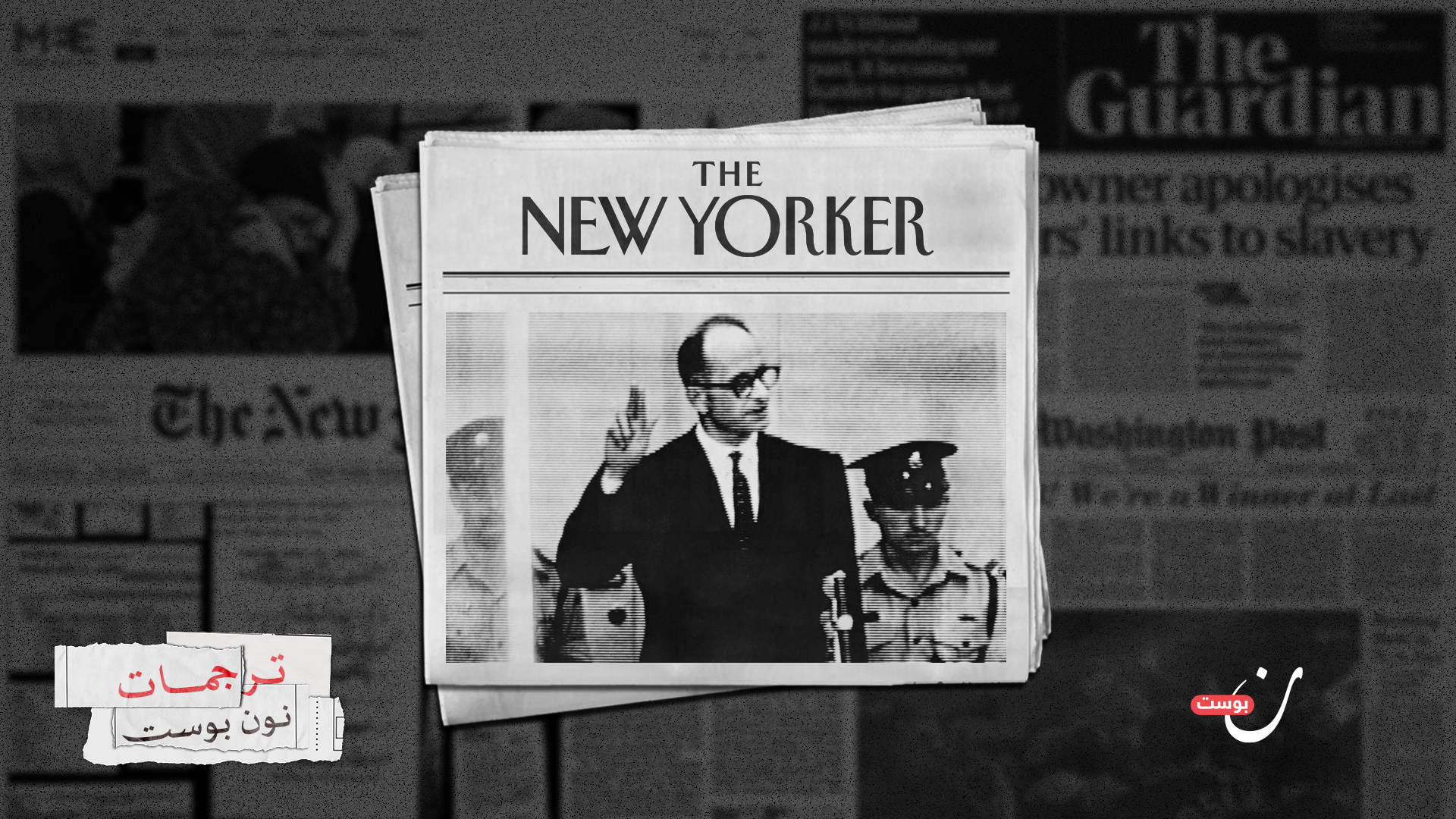
ترجمة وتحرير: نون بوست
لطالما كان تحديد هوية اليهود مسألة شائكة، لكنه نادراً ما كان لغزاً بالنسبة لأعدائهم. صوّرهم ستالين على أنهم “كوزموبوليتانيون بلا جذور” يتآمرون مع “الإمبرياليين الأمريكيين” لزعزعة استقرار الاتحاد السوفيتي. وفي مخيلة هتلر المحمومة، كانوا جراثيم تفتك بالعرق “الآري” النقي. وُصموا بأنهم منحرفون شهوانيون، ومتآمرون ذوو نفوذ مطلق، وبأنهم عتاة البلاشفة والرأسماليين في آن واحد.
وفي الآونة الأخيرة، كثيراً ما يتم الخلط بين “اليهودي” و”الصهيوني”، حيث أصبحت كلمة “صهيوني” تُستخدم كوصمة يمكن أن تعني أي شيء من “استعماري استيطاني” إلى “فاشي” أو “عنصري”. أما المعنى القديم للصهيونية – أي تأسيس دولة يهودية لحماية اليهود من الاضطهاد – فقد تلاشى إلى حد كبير من الخطاب العام.
معارضة الصهيونية لا تعني بالضرورة معاداة السامية، والسياسيون اليمينيون الذين يتهمون الطلاب المؤيدين لفلسطين بمعاداة السامية ليسوا في موقع يؤهلهم لإطلاق مثل هذا الحكم. أقامت إدارة ترامب، التي تتظاهر بالدفاع عن اليهود، علاقات مع متطرفين معادين للسامية. تناول ترامب العشاء مع أشخاص ينكرون بصراحة حدوث الهولوكوست، كما صرّح ذات مرة بأن من بين المتظاهرين النازيين الجدد الذين يرفعون شعارات معادية لليهود، يوجد “بعض الأشخاص الطيبين جداً”.
إن وجود حكومة يمينية متطرفة، تزخر بالقوميين المؤمنين برابطة الدم والأرض، وتدّعي حماية أقلية يهودية، كان سيبدو في فترة ما أمرًا غريبا للغاية.
عندما تفقد الكلمات دلالاتها الأصلية ويُعاد توظيفها كأدوات للهجوم اللفظي، يتحول الفضاء العام إلى غابة من الاتهامات والترهيب، وحتى العنف. السياسيون اليمينيون الذين يصفون كل من ينتقد إسرائيل بمعاداة السامية هم انعكاس لأولئك الذين يفترضون أن كل اليهود صهاينة، وأن كل الصهاينة عنصريون. ومن المزايا العديدة لكتاب مارك مازوفير الرائع والمناسب في توقيته “عن معاداة السامية”، هو سعيه لإحياء السياق التاريخي لكلمة أضحت مصطلحًا عامًا يُراد به الإدانة.
هناك يهود يؤمنون بأن غير اليهود قد كرهوا اليهود بشكل دائم وأنهم سيبقون كذلك. من هذا المنظور، تُعتبر معاداة السامية ظاهرة فريدة وأزلية وثابتة. يرى بن صهيون نتنياهو، المؤرخ الكبير المتخصص في تاريخ محاكم التفتيش الإسبانية، أن تاريخ اليهود هو “سلسلة من المحارق”.
ويرفض ابنه بنيامين، رئيس وزراء إسرائيل الحالي، أي نقد يوجَّه لبلاده بسبب العنف الذي تمارسه ضد الفلسطينيين، باعتباره مظهرا آخر من مظاهر “كراهية إسرائيل” المتجذرة عبر العصور. ويرى أن دوره الذي ارتضاه لنفسه هو حماية اليهود من محرقة أخرى، حتى لو أدانه العالم بأسره. بل إن الإدانات العالمية تعزز قناعته بأن منتقدي سياساته يفعلون ذلك “بسبب الحقيقة البسيطة، أننا موجودون”.
يخالف مازوفير، وهو مؤرخ دقيق ومنهجي، هذا الرأي. يلاحظ أن معاداة السامية ليست ظاهرة جديدة، لكن طبيعة هذا العداء تغيرت تغيرًا جذريًا بمرور الزمن. وفي دراسته لتاريخ معاداة السامية، يتجاوز مازوفير إلى حد كبير التحيزات الدينية المسيحية في حقبة ما قبل الحداثة. ويتعامل مازوفير، على غرار حنة آرنت من قبله، مع كراهية اليهود باعتبارها نتاجا للحداثة الأوروبية، التي اشتد عودها في أواخر القرن التاسع عشر مع تشكل العديد من الدول القومية.
كان ذلك عصر الأحزاب السياسية، والصحافة، والتمويلات الضخمة، وسيادة القانون. في معظم أنحاء أوروبا، أصبح اليهود المحرَّرون مواطنين يتمتعون بحقوق كاملة في المدن الكبرى، بعد أن كانوا أقلية خاضعة للعائلات الأرستقراطية.
هذه المساواة، وتلاشي العلامات التي تميز اليهود – كالملابس الغريبة، واللغة غير المألوفة، والتقاليد المبهمة – كانت مصدر قلق لكثيرين، وليس فقط للحاخامات المحافظين الذين رأوا سلطتهم تتآكل. مثّل ذلك في نظر البعض تسللًا لعناصر خارجية غير جديرة بالثقة إلى صلب المجتمع. لم يرحب الجميع بالدول الليبرالية القائمة على المساواة، والتي انبثقت عن الثورتين الفرنسية والأمريكية.
كان المحافظون الفرنسيون يتوقون للعودة إلى النظام القديم القائم على الكنيسة والحكم الملكي، بينما كان القوميون الألمان يتطلعون إلى مجتمع متجذر في ثقافة الأرض الأم.
ارتبط الموقف من اليهود ارتباطًا وثيقًا بالرؤية تجاه الدولة الحديثة. صاغ الصحفي الألماني فيلهلم مار مصطلح “معاداة السامية” عام 1879 في خضم حملته لإلغاء مسار تحرير اليهود. ويرى مازوفير في ذلك “نوعا من رد الفعل المضاد لإيقاع الحداثة المتسارع الذي حملت وعدًا بحياة أفضل، وعودة إلى أنماط معيشية أقدم وأكثر ألفة”.
في تسعينيات القرن التاسع عشر، بلغ هذا التوتر ذروته بشكل دراماتيكي في فرنسا مع قضية دريفوس. أُدين النقيب ألفريد دريفوس، وهو يهودي، بالخيانة ظلمًا. كانت فرنسا قد تعرضت للإذلال عام 1871 على يد بروسيا في حرب عبثية أشعلتها بنفسها، وكان دريفوس، المتهم بتسريب أسرار عسكرية للألمان، كبش فداء مناسبًا في تلك اللحظة المأساوية. وبصفته ثريًا، متعدد اللغات، ومولودًا في إقليم الألزاس الفرنسي-الألماني، فقد جسّد الصورة النمطية لليهودي الكوزموبوليتاني الذي لا يمكن الوثوق بوطنيته.
لكن القضية كانت أعمق من مجرد محاكمة. أصبح دريفوس محوراً لصراع بين رؤيتين مختلفتين لفرنسا. المدافعون عنه، المعروفون باسم “الدريفوسيين”، كانوا في الغالب من الليبراليين المؤيدين للجمهورية العلمانية الديمقراطية. أما المعارضون، “المناهضون لدريفوس”، فكانوا في الغالب من الكاثوليك الراديكاليين الذين يكرهون كل ما تمثله الدولة الحديثة. كانوا يكرهون الليبراليين، واليساريين، والكوزموبوليتانيون، واليهود – وإن لم يكن بالضرورة بهذا الترتيب.
ورغم تبرئة دريفوس في نهاية المطاف، فإن الربط بين اليهود والليبرالية الكوزموبوليتانية ظل قائمًا. وُجدت معاداة السامية في اليسار أيضا، وقد صورت اليهود كرأسماليين جشعين، خاصة في فرنسا. لكن التحريض على اليهود بقي في معظمه ممارسة يمينية، من قوميين معادين لليبرالية رأوا في تلك الأقلية تهديدا لنقاء مجتمعاتهم العرقية أو الدينية.
وفي خضم التوتر الذي ساد القرن التاسع عشر بين “الأمة” و”الدولة”، كان الكثير من أنصار “الأمة” من المعادين للسامية. وقبل الهولوكوست، كان هذا الموقف يعتبر مقبولا بين المحافظين.
كان من بين الحاضرين في محاكمة دريفوس، تيودور هرتزل، وهو يهودي نمساوي-مجري، ليبرالي، مندمج، وعلماني، غطّى الجلسات كصحفي في باريس. بعد أن شاهد تجريد دريفوس من رتبته أمام جمهور ساخر، استنتج هرتزل (الذي لم يتوسع مازوفير في الحديث عنه) أن السبيل الوحيد ليعيش اليهود في أمان هو تأسيس دولة قومية خاصة بهم.
استشعر هرتزل خطر المشاعر القومية المتصاعدة في الإمبراطورية النمساوية-المجرية التي كانت على وشك أن تتفكك. لم يكن لليهود في عهد الإمبراطور فرانز جوزيف وطن يلجؤون إليه، على عكس التشيك أو المجريين. وقد وفرت الإمبراطورية لجميع رعاياها درجة من الحماية، ولهذا كان اليهود من بين آخر وأكثر أنصار فرانز جوزيف ولاءً.
كتب جوزيف روث، الروائي اليهودي المولود في غاليسيا، روايته “مسيرة راديتزكي” (1932) كمرثية لذلك العالم المفقود. بمجرد انهيار الإمبراطورية النمساوية-المجرية بعد الحرب العالمية الأولى، أصبح اليهود هدفا رئيسيا للقوميين.
تزامن أفول الإمبراطورية مع انتشار نظريات المؤامرة حول مجموعات سرية يهودية دولية يُقال إنها تتلاعب بالسلطة عبر المال والشبكات الخفية، من أجل حكم العالم. أثارت الوثيقة الروسية المزيفة “بروتوكولات حكماء صهيون”، التي نُشرت عام 1903، اضطرابات في العديد من البلدان بدرجات متفاوتة.
بعد توغلهم في سيبيريا عام 1918، سمع اليابانيون عن “البروتوكولات” من السكان المحليين، وأصبحوا مقتنعين بنفوذ اليهود لدرجة أنهم قاموا لاحقًا بحماية اليهود في آسيا من عمليات الترحيل النازية. لقد استنتجوا أن شعبًا بهذه القوة يجب أن يكون في صفهم.
تشكّل هذا التصور جزئياً بسبب أن يعقوب شيف، وهو مصرفي يهودي في نيويورك، ساعد في تمويل الحرب اليابانية ضد روسيا عام 1905. وظهر منطق مشابه خلال الحرب العالمية الأولى، حين سعى الحلفاء للحصول على دعم مالي من اليهود. ويشير مازوفير إلى أن ذلك ربما أثّر على آرثر بلفور، وزير الخارجية البريطاني، الذي تعهّد عام 1917 بدعم “إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين”.
لم يرحب جميع اليهود بهذه البادرة، حاجج جوزيف حاييم ليفي، وهو عالم اقتصاد بريطاني، قائلًا: “إذا أعلنّا أننا غرباء… فلا أفهم على أي أساس يمكننا أن نصرخ بأننا نُعامل كأجانب ظلمًا”. وفي رأيه، “الشيء الوحيد الذي يبدو أن الصهيونية ستحققه هو خلق أساس منطقي لمعاداة السامية”.
المعركة في فرنسا، وأماكن أخرى، بين مفهومين للدولة – أحدهما ليبرالي ديمقراطي، والآخر متجذر في العرق والدين والأرض – انعكست في رد فعل اليهود على معاداة السامية. كان أحد الردود هو بناء دولة يهودية، والآخر هو النضال من أجل تحرير جميع الشعوب المضطهدة من خلال سياسات عالمية، غالبًا ما كانت يسارية. تصور كارل ماركس أن “المسألة اليهودية” ستتلاشى بمجرد أن تحكم البروليتاريا. وبالنسبة للعديد من المهاجرين اليهود في الولايات المتحدة، حلت الماركسية في القرن العشرين محل اليهودية كعقيدة مشتركة.
للأسف، لم يجد اليهود المتشككون في الصهيونية، الذين فضلوا اعتبار أنفسهم كوزموبوليتانيين، ملاذا آمنا. ندد المعادون للسامية باليهود، معتبرين أنهم رأسماليون وشيوعيون في آن واحد – وهما عقيدتان عالميتان. كان رجال الأعمال والثوريون على حد سواء يميلون إلى تجاهل الحدود.
كان هتلر مهووسًا بفكرة “اليهودية-البلشفية”، وادعى جوزيف غوبلز، وزير الدعاية في النظام النازي، أن “هذه الشيطانية ما كان لها أن تولد إلا في دماغ بدوي لا أمة له ولا عرق ولا وطن”.
يجادل المؤرخ الروسي يوكين هيلبيك في كتابه الجديد الرائع “عدو العالم رقم 1″، بأن جنون الارتياب الذي أصاب هتلر بشأن “اليهودية-البلشفية” كان السبب الرئيسي للهولوكوست. قال هيلبيك إن هتلر سعى لإبادة اليهود لأنه كان بحاجة إلى تدمير البلشفية. وفي إطار هذه الرؤية، حوّل الغزو الألماني للاتحاد السوفيتي عام 1941 جميع اليهود إلى بلشفيين. يمجد هيلبيك فضائل الأممية الماركسية – ربما بشكل مفرط -، إذ يزعم أن مناهضة العنصرية كانت سمة بارزة في الحياة السوفيتية، وأن المقاومة البطولية لألمانيا النازية كانت مدفوعة أساسًا بالأيديولوجية الشيوعية.
أطروحة هيلبيك مثيرة للاهتمام لكنها تحمل قدرا من المبالغة. لم يكن ستالين، لأسباب سياسية في الغالب، صديقًا لليهود. تم طرد اليهود من وزارة الخارجية السوفيتية عام 1939، عندما وقّع الاتحاد السوفيتي اتفاقية مع ألمانيا النازية، وتلت ذلك محاكمات صورية معادية للسامية بعد فترة وجيزة من هزيمة ألمانيا. وعلى أي حال، صاغت الدعاية السوفيتية الحرب ضد ألمانيا بمصطلحات وطنية لا أيديولوجية، حيث قاتل الشعب من أجل “روسيا الأم” أكثر مما قاتلوا من أجل ستالين أو ماركس.
كانت إيمان هتلر بـ”اليهودية-البلشفية” راسخا تماما مثل قناعته بأن روزفلت وتشرشل دميتان في يد “بارونات المال اليهود”. كان مقتنعًا بأن واشنطن ولندن قد “تهوّدتا”. كان ذلك اعتقادًا شائعًا بين القوميين والعنصريين. كان هيوستن ستيوارت تشامبرلين – الذي وُلد بريطانيًا، وأصبح مواطنًا ألمانيًا، وتزوج ابنة ريتشارد فاغنر، وأُعجب بهتلر – من بين الذين رأوا أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد تلوّثتا بشدة بسبب المهاجرين.
أما الوحشية النازية ضد مواطني الاتحاد السوفيتي، والتي كانت أكبر بكثير مما فعله النازيون ضد الحلف الأنجلو-أمريكي، فلم تكن مرتبطة بالأيديولوجيا، بقدر ارتباطها بالعرق. كانت شعوب الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية في نظر النازيين “أعراقًا أدنى”، وليست مجرد دمى في أيدي اليهود الأثرياء ذوي النفوذ المطلق.
ما رجّح كفة السعي لإنشاء وطن لليهود على حساب النضال العالمي ضد معاداة السامية، هو الهولوكوست. بالنسبة لمئات الآلاف من الناجين – الذين كانوا يقبعون في مخيمات النازحين، بلا مأوى، وغير مرغوب فيهم في كل الدول تقريبًا – كانت فلسطين هي الملاذ الوحيد. تحولت الفكرة إلى ضرورة. تأسست دولة إسرائيل عام 1948 كرد فعل على قرون من الإذلال والإقصاء التي بلغت ذروتها في عمليات القتل الجماعي. لكن الأمر استغرق وقتًا قبل أن يصبح الولاء لإسرائيل وإحياء ذكرى الهولوكوست ركيزتين توأمين للهوية اليهودية، في إسرائيل والخارج.
لم يكن لدى دافيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، اهتمام كبير بالتوقف عند الكوارث التي حدثت مؤخرا في أوروبا. كان يريد تنشئة نوع جديد من اليهود، الأبناء الأبطال للأرض التاريخية. وفي محادثة مع ناحوم غولدمان، أحد مؤسسي المؤتمر اليهودي العالمي، اعترف بن غوريون بأن صراع إسرائيل مع العرب لا علاقة له بالهولوكوست، بل يتعلق كليًا بالأرض. ومع ذلك، ظل يستدعي ذكرى المذابح النازية للتأثير على الرأي العام: عشية أزمة السويس عام 1955، قال أمام الكنيست إن “العقيدة النازية تُسمع من جديد على ضفاف النيل”.
انتقل العديد من اليهود من أوروبا والشرق الأوسط إلى الدولة الجديدة بدافع المثالية أو اليأس. لكن معظم يهود الشتات لم يروا بعد أن مصير إسرائيل مرتبط بمصيرهم. بغض النظر عما كان يعتقده غير اليهود في قرارة أنفسهم، فإن النازيين جعلوا معاداة السامية بشكل علني أمرًا غير لائق، بل أمرا بغيضًا. وكما يلاحظ مازوفير، “استفاد اليهود الأمريكيون من الازدهار الذي أعقب الحرب وشاركوا في الطفرة الاستهلاكية ومتعة الحياة في الضواحي”.
مع ذلك، صوّر بن غوريون إسرائيل من البداية على أنها وطن لجميع اليهود. في عام 1952، أعلنت حكومته أن “دولة إسرائيل تعتبر نفسها نتاجا للشعب اليهودي بأسره”. كما رأى في محاكمة أدولف أيخمان، المسؤول النازي عن تنفيذ الهولوكوست، والتي عُقدت في القدس عام 1961، فرصة لربط مصير إسرائيل بذكرى الإبادة الجماعية.
وفي كلمته الافتتاحية، قال المدعي العام، جدعون هاوزنر، إنه لا يقف وحده: “معي ستة ملايين مُدّعٍ”. وكتبت حنة آرنت، التي كانت حاضرة، أن المحاكمة كانت تهدف إلى أن تُظهر للشباب الإسرائيلي “ماذا يعني أن تعيش بين غير اليهود، وإقناعهم بأنه لا يمكن لليهودي أن يكون آمنًا ويعيش حياة كريمة إلا في إسرائيل”.
ربما كان بإمكان مازوفير أن يتوسع أكثر في الحديث عن تلك اللحظة. الرسالة الأوسع لم تكن موجهة للإسرائيليين فحسب، بل لليهود في كل مكان: أي تهديد لإسرائيل هو تهديد لجميع اليهود. ربما كان محقًا في عدم المبالغة في تأثيرها. مازال يهود الشتات يفوقون اليهود الإسرائيليين بكثير من حيث العدد، وقد كان النشطاء اليهود مؤثرين في حركة الحقوق المدنية الأمريكية، مما حافظ على زخم النهج الليبرالي-اليساري الأممي في محاربة التحيز العنصري.
عارضت آرنت، على سبيل المثال، استخدام محاكمة أيخمان لأغراض دعائية تخدم الدولة الإسرائيلية. كانت تعتقد أن أيخمان يجب أن يُحاكم أمام محكمة دولية، لأن تواطؤه في الإبادة الجماعية كان جريمة ضد الإنسانية، وليس ضد اليهود فحسب.
جاء التحول الحاسم عام 1967، عندما هزمت إسرائيل جيرانها العرب في حرب الأيام الستة واحتلت أراضٍ عربية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان وغزة والقدس. شعر اليهود، خاصة في الولايات المتحدة، بالتضامن مع الدولة اليهودية. أحسوا بالفخر لتفوق إسرائيل في ساحة المعركة، وهذه المرة – أكثر من فترة محاكمة أيخمان – عادت صدمات الماضي إلى الواجهة.
يستشهد مازوفير بعالم الاجتماع مارشال سكلير، الذي درس ضاحية أمريكية نموذجية في شيكاغو أطلق عليها اسم “ليكفيل”. كتب سكلير أن الاستجابة هناك عكست الشعور بأن يهودها قد نجوا من الهولوكوست “بالحظ”. لكن حرب الشرق الأوسط “أعادت إلى الوعي إمكانية تكرار ذلك التاريخ – احتمال حدوث هولوكوست جديد”.
أصبح من السهل التوفيق بين الولاء لإسرائيل والولاء للولايات المتحدة. بل أصبح من الممكن النظر إلى إحياء ذكرى الهولوكوست كجانب من جوانب الشعور الوطني الأمريكي، ومن هنا جاء لاحقًا متحف ذكرى الهولوكوست في ناشيونال مول بواشنطن العاصمة. لم تعد إسرائيل وحدها، بل الولايات المتحدة أيضًا، حصنا لليهود من محرقة جديدة.
الاندماج، والزواج المختلط، والابتعاد عن الأحياء اليهودية، وضعف الروابط الدينية، كلها عوامل جعلت مصير إسرائيل وذكرى الهولوكوست أكثر مركزية في الهوية اليهودية العلمانية. منذ الستينيات، بدأ اليهود وغير اليهود، خاصة في ألمانيا، ينظرون إلى الحرب العالمية الثانية من خلال عدسة الهولوكوست. وقد ساهمت المذكرات والنصب التذكارية والأفلام ومشاريع إحياء ذكرى الهولوكوست في تعزيز هذه الفكرة لدى الرأي العام. ومثلما دعا الأمريكيون من أصل أفريقي إلى إحياء ذكرى العبودية لجذب التعاطف السياسي، وجد اليهود في الهولوكوست مصدرا للاعتراف الجماعي بقضيتهم.
كتب مازوفير أن اليهود الأمريكيين لم يبدأوا بـ”تبني فكرة المحرقة، ليس فقط كتاريخ، بل كتحذير للمستقبل وجزء لا يتجزأ من تصورهم لأنفسهم” إلا بعد حرب عام 1967. ما إن بدأ تصوير التهديدات لدولة إسرائيل على أنها تهديدات وجودية لليهود في كل مكان، بدأ الخط الفاصل بين معاداة السامية وانتقاد إسرائيل، أو الصهيونية نفسها، يتلاشى. وحسب تعبير مازوفير: “كانت الحقبة التي يمكن فيها مناقشة معاداة السامية دون الإشارة إلى إسرائيل على وشك الانتهاء”.
يصف مازوفير الرأي القائل بأن الجامعات الأمريكية “بؤر للمعاداة المؤسسية للسامية” بأنه ادعاء “سخيف”، وهو محق في ذلك. تقول نكتة يهودية قديمة إن بعض مناهضي الصهيونية يكرهون إسرائيل أكثر قليلًا مما هو ضروري.
يعود ذلك بشكل كبير إلى ما حدث عام 1967. بمجرد احتلال إسرائيل للأراضي العربية خارج حدود عام 1948، أصبح النضال الفلسطيني في صلب المعركة العالمية ضد الاستعمار والنيوكولونيالية. وبما أن الاستعمار غالبًا ما يُنظر إليه على أنه الخطيئة الأصلية للغرب، فقد تم تحميل إسرائيل مسؤولية خمسة قرون من الحملات الاستعمارية الأوروبية.
لم تُؤسس دولة إسرائيل لتكون إمبراطورية توسعية – فلم يكن لليهود طوال تاريخهم أي عاصمة إمبراطورية – لكن الاستيطان اليهودي على الأراضي العربية بعد عام 1967 حوّل الفلسطينيين بحكم الأمر الواقع إلى رعايا تحت سلطة احتلال.
قد يكون وصف الأراضي المحتلة بأنها تمثل شكلا من أشكال “الفصل العنصري” أو “الاحتلال الاستيطاني” موضع نقاش، لكنه ليس في حد ذاته رأيا معاديا للسامية. كما أن وصف القتل الجماعي للمدنيين في غزة بأنه إبادة جماعية أمر مثير للجدل أيضًا، لكن بعض الإسرائيليين الوطنيين المعارضين لحكومتهم بدأوا باستخدام هذا المصطلح. قال ديفيد غروسمان، الروائي والناقد المخضرم للسياسة الإسرائيلية، وهو يهودي ليبرالي يؤمن بالقيم الإنسانية، مؤخرًا في مقابلة صحفية إنه لم يعد قادرا على أن يتجنب استخدام مصطلح الإبادة الجماعية.
ومع ذلك، هناك ما يدعو للقلق عندما يستخدم منتقدو إسرائيل الهولوكوست كسلاح بلاغي ضد الدولة اليهودية. يصف مازوفير كراهية اليهود بأنها ظاهرة يمينية إلى حد كبير، لكن اللافتات التي تصور آن فرانك ترتدي الكوفية، أو نجمة داود مشوهة بالصليب المعقوف، ترسل رسالة فجة: اليهود سيئون مثل النازيين.
هذه الإيماءات سبقت حكومة نتنياهو الحالية. في عام 2002، شبه الروائي البرتغالي خوسيه ساراماغو محنة الفلسطينيين في رام الله بمحنة اليهود في أوشفيتز. مثل هذه المقارنات تُعقد بسهولة بالغة، وبقدر كبير من الثقة بالنفس، كما لو أن الشعور بالذنب تجاه ما حدث لليهود يمكن تخفيفه قليلًا من خلال تشبيههم بالنازيين. وكما قال الصحفي اليهودي الألماني هنريك برودر ذات مرة: “لن يغفر الألمان لليهود أبدًا أوشفيتز”.
في الوقت نفسه، حدث شيء غريب لدولة إسرائيل. كان بن غوريون رجلًا قاسيًا، ولم ينكر أبدًا أن الاستيطان اليهودي يتضمن استخدام العنف. مع ذلك، كان سيُصدم على الأرجح لو رأى حكومة إسرائيلية عازمة على التطهير العرقي من خلال القصف والتجويع. يعزو غروسمان، في تأملاته للوحشية التي بدأت في عهد نتنياهو، هذه الممارسات أيضًا إلى عام 1967: “لقد أفسدَنا الاحتلال… لقد أصبحنا أقوياء جدًا عسكريًا، ووقعنا في إغراء القوة المطلقة: فكرة أننا نستطيع أن نفعل ما نشاء”.
ربما بدأ الانحلال قبل ذلك. لم يكن الصهاينة المعتدلون من اليسار يريدون أبدًا أن تتشكل السياسة الإسرائيلية من خلال العدوان العنصري. منذ هرتزل، كان الكثير منهم يأمل بتسوية سلمية مع العرب، ولا يزال عدد صغير من الليبراليين يحلم بحل الدولتين. لكن المفكرين الأكثر تشددًا رفضوا ذلك منذ البداية. في 1923، جادل زئيف جابوتنسكي، مؤسس الصهيونية التصحيحية – وهو تيار أكثر تشددًا وتطرفًا داخل الحركة الصهيونية – بأنه “لا يمكن أن يكون هناك اتفاق طوعي بيننا وبين عرب فلسطين”، لأنه “لا يوجد مثال واحد على أي استعمار تم بموافقة السكان الأصليين”.
من المحتمل أن جابوتنسكي كان سيوافق المحتجين في الجامعات اليوم بأن الصهيونية مشروع استعماري. لكن ما لم يكن ليتوقعه، هو أن تصبح إسرائيل يومًا ما نموذجًا يحتذي به اليمين المتطرف في أوروبا والولايات المتحدة. يتمتع فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، بعلاقات دافئة مع نتنياهو، ويتبادلان عبارات الثناء، رغم أن أوربان ذاته يروج لنظريات المؤامرة المعادية للسامية، والتي تستند بشكل مباشر إلى “بروتوكولات حكماء صهيون”. يُحتمل أن معارضي دريفوس كانوا سيجدون في دولة إسرائيل الحالية ما يروق لهم أكثر مما كان سيجده أنصاره.
عندما خسر شمعون بيريز انتخابات عام 1996 أمام نتنياهو، يُقال إنه صرّح: “خسر الإسرائيليون، وفاز اليهود”. يبدو أنه كان يقصد أن إسرائيل قد انقسمت إلى أمتين، مثل فرنسا في عصر دريفوس: “الإسرائيليون” كمواطنين في دولة حديثة، و”اليهود” كأفراد في مجتمع قائم على رابطة العرق والأرض. كان ذلك إحدى الطرق لوصف انهيار السياسة العلمانية ذات التوجه اليساري في إسرائيل.
من الواضح أن الأدوار التقليدية قد انعكست بشكل غريب. تبنت الدولة اليهودية القومية العرقية، بينما يدّعي العديد من منتقديها عالميا، بمن فيهم عدد لا بأس به من اليهود، أنهم يناضلون من أجل المظلومين في كل مكان. إن وصف كل هؤلاء بأنهم معادون للسامية لا معنى له. ماذا عن محاولة إلصاق هذه التهمة بأشخاص مثل محمود خليل؟
خليل هو طالب دراسات عليا سابق في جامعة كولومبيا (يحمل البطاقة الخضراء)، اعتقلته سلطات الهجرة والجمارك في مارس/ آذار لدوره في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، وسُجن لأكثر من 100 يوم. غرّد ترامب بأنه “طالب أجنبي راديكالي مؤيد لحماس”، محذرًا من شن المزيد من الاعتقالات لأولئك المتورطين في “أنشطة مؤيدة للإرهاب، ومعادية للسامية، ومعادية لأمريكا”.
في الواقع، كان خليل يتفاوض نيابة عن “ائتلاف كولومبيا لسحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري”، وهي مجموعة ترى أن عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين عيّنة من نظام عالمي من القمع الرأسمالي والاستعماري والعنصري. وتعدّ “فلسطين” من وجهة نظرهم، “القضية الأولى للتحرر الجماعي… نحن ندعم الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني، ولجميع الشعوب”.
قد يبدو هذا الطرح سطحيا أو مجانبا للصواب، لكنه ليس معاداة للسامية، بل يندرج تمامًا ضمن التقليد اليهودي الليبرالي-اليساري العالمي المقاوم لمعاداة السامية. بل إن خليل نفسه – وهو فلسطيني مولود في سوريا ومتزوج من أمريكية – يمكن أن يُطلق عليه لقب “كوزموبوليتاني بلا جذور”. أما سجنه على يد إدارة ترفع شعار “أمريكا أولًا” دفاعًا عن حكومة مليئة بالعنصريين الذين يتغاضون عن قتل وتجويع المدنيين، فهو أمر يضر بالولايات المتحدة، ويدمر الفلسطينيين، ولا يخدم إسرائيل، ويسيء لليهود بكل تأكيد.
المصدر: نيويوركر