أمة تتعلّم لتعيش: التعليم الفلسطيني كسلاح ضد المحو
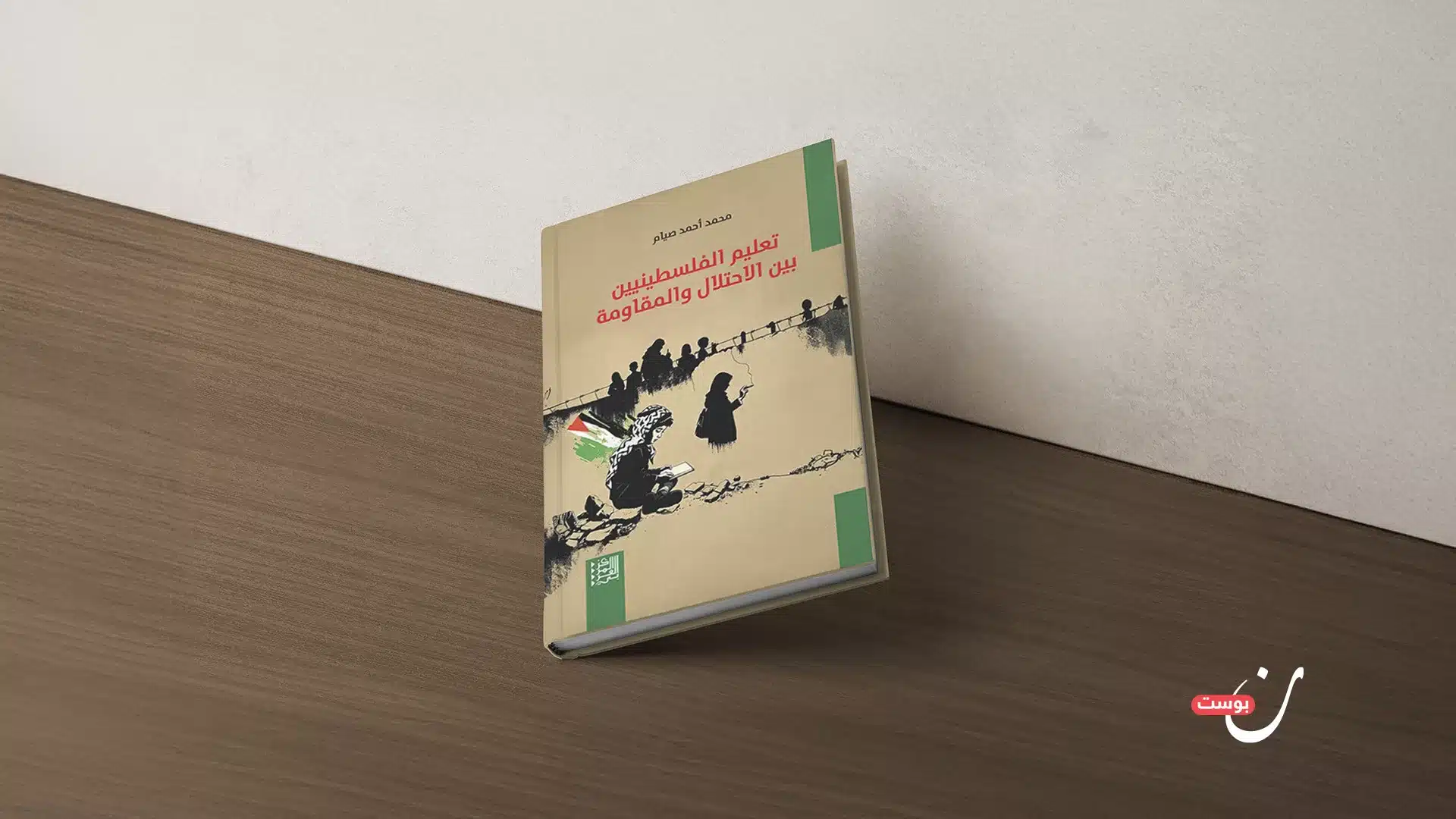
يُعدّ كتاب “تعليم الفلسطينيين بين الاحتلال والمقاومة”، الصادر مؤخرًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (بيروت)، للباحث محمد أحمد صيام، المتخصص في دراسات النزاع والأمن، إضافةً نوعيةً للمكتبة العربية في فهم العلاقة الجدلية بين القمع الاستعماري والفعل الوجودي الفلسطيني، حيث يتجاوز الكتاب النظر إلى التعليم باعتباره مجرد نظام تربوي أو خدمي، ليؤكد الفرضية المركزية التي يقوم عليها هذا التحليل: التعليم في فلسطين هو، في جوهره، فعل سياسي ووجودي بامتياز، ومحور أساسي في الصراع على الهوية والبقاء.
منذ عام 1967، تعامل الاحتلال الإسرائيلي مع التعليم الفلسطيني بوصفه “قضية أمنية استراتيجية”، مدركًا أن هذا التعليم قد يتحول في أي وقت إلى سلاح ووسيلة مقاومة في يد الشعب. هذه النظرة الأمنية هي التي برّرت سياسات الاستهداف الممنهجة الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره عبر تدمير منظومته القيمية والفكرية والتربوية. نحاول، في هذا المقال، تقديم قراءة تحليلية معمّقة للمحاور الرئيسية التي تناولها الكتاب، ممثلةً في آليات الاحتلال للتدجين، واستراتيجيات المقاومة المتبلورة، والدور الجوهري للمعلم كحارس للهوية.
التعليم كخط دفاع وجودي
بدايةً، يشير صيام إلى أن فهم عمق الصراع حول التعليم في فلسطين يتطلب تأطيره ضمن مفهوم “الاستعمار الاستيطاني”، وهو استعمار لا يقتصر على السيطرة على الأرض، بل يهدف إلى إحلال الشعب المستعمِر محل السكان الأصليين. وعليه، يصبح التعليم هدفًا استراتيجيًا، حيث إن تدمير منظومته هو جزء من استراتيجية الإبادة المعرفية (Epistemicide)، التي تسعى إلى شل قدرة المجتمع الفلسطيني على إنتاج المعرفة الذاتية، وحفظ الذاكرة، وتكوين الوعي النقدي اللازم للتحرر.
يركز الكتاب على أن استهداف الاحتلال للتعليم الفلسطيني يتم عبر ثلاثة أبعاد رئيسية: استهداف المؤسسات التعليمية من جامعات وكليات ومدارس وبنية تحتية؛ حرمان الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من حقّ التعلّم؛ وأخيرًا، استهداف العلماء وقمع الكفاءات الفلسطينية بالاغتيال أو الاختطاف أو السجن داخل فلسطين أو خارجها، بهدف منعهم من المساهمة في رفع نسبة الوعي ومطلب الحرية لدى الشعب الفلسطيني. إن تزامن هذا الاستهداف المادي والمعرفي يثبت أن الاحتلال يشنّ حربًا على المستقبل الفلسطيني وعلى رأسماله البشري، مؤكدًا أن التعليم ليس خدمة، بل هو بنية تحتية مقاومة يجب إزالتها.
آليات الاحتلال لتدجين الوعي والتأثيرات الهيكلية
في الفصل الثاني، يتتبع صيام سياسات الاحتلال الممنهجة لتدجين الوعي الفلسطيني، وهي سياسة تتنوع بين التدمير المادي، والهندسة البيروقراطية، والإبادة المعرفية الصامتة، حيث اتبع الاحتلال سياسة ممنهجة لاستهداف التعليم الفلسطيني خلال الفترة من 1967 وحتى 2023، شملت تدمير المدارس وتقييد الحريات الأكاديمية. هذا الاستهداف المادي يهدف إلى إضعاف المنظومة التعليمية وتدهورها، ما أدّى إلى ارتفاع معدلات الهجرة بين الكفاءات التعليمية وتفاقم الأزمات النفسية والاجتماعية.
أما في القدس المحتلة، فإن آليات السيطرة تتخذ شكلاً بيروقراطيًا معقدًا يُعرف بـ “الأسرلة”، إذ تتحكم بلدية الاحتلال بتراخيص البناء والتوسعة للمدارس، ما يخلق نقصًا حادًا في الغرف الدراسية ويؤدي إلى اكتظاظ الصفوف. هذه القيود الإدارية ليست مجرد تحديات لوجستية، بل هي عنف هيكلي يهدف إلى إجبار الطلبة في أحياء مثل سلوان والعيسوية على الدراسة في مبانٍ غير مؤهلة أو مستأجرة، مما يزيد من معدلات التسرّب ويؤثر سلبًا على جودة العملية التعليمية.
وأيضًا، يكمُن الهدف الأعمق لهذه الآلية في إعادة تشكيل وعي الطالب القدسي، وتحويله من “حامل لمشروع وطني” إلى مجرد “فرد مندمج شكليًا في مدينة موحَّدة”. هذا النوع من التدجين الناعم يهدف إلى تحقيق الاقتلاع الثقافي دون الحاجة إلى الإغلاق العسكري المباشر، ما يضع الأهالي وإدارات المدارس بين خيارين صعبين: إما قبول المنهاج الإسرائيلي، وإما مواجهة خطر فقدان الاعتراف والانغلاق. كما تهدف السياسات التعليمية لسلطات الاحتلال بشكل أساسي إلى تجهيل الطالب الفلسطيني وعزل ماضيه عن حاضره، لطمس معالم مستقبله، فيما يتضمن ذلك تجهيل الطالب بتاريخ القضية الفلسطينية وتطوراتها، وتشويه التاريخ العربي والإسلامي لإفقاد الطالب الثقة بأمته وتاريخها وحضارتها، وكذلك تأكيد شرعية وجود الاحتلال واغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني.
إن هذه السياسات لا تستهدف المحتوى فحسب، بل تستهدف النخبة القادرة على إنتاج الوعي. فاستهداف العلماء بالاغتيال أو الاختطاف لا يُمثل خسارة فردية، بل هو ضربة استراتيجية لمجمل المجتمع، ويهدف إلى منع هذه الكفاءات من المساهمة في رفع نسبة الوعي ومطلب الحرية لدى الشعب الفلسطيني. ومن خلال هذه الإجراءات، يضمن الاحتلال إضعاف القدرة المستقبلية على قيادة مشروع التحرر، وتؤكد أن التعليم (بمعناه الواسع: منشآت، ومناهج، وكفاءات بشرية) هو محور المقاومة الذي يجب تدميره.
لذا، تُعتبر الآثار النفسية والاجتماعية لانتهاكات الاحتلال جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التدجين. إن عمليات الإغلاق المستمر، والإجراءات التعسفية، والعقاب الجماعي، خاصةً خلال الانتفاضة الأولى، كان لها أثر كبير على مستوى التحصيل والأداء الأكاديمي، ما أدّى إلى انتقال الطلاب من صف إلى آخر دون إكمال المنهج المقرّر، وقد ساهم في خلق فجوات تعليمية كبيرة. كما أن التأثيرات النفسية الصعبة التي ألحقتها الحروب بالطلاب، إلى جانب سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحصار، تؤثر بشكل طبيعي على العملية التعليمية كمنظومة، وعلى التحصيل الدراسي.
إن الحاجة المُلِحّة لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي المتخصص وتنمية المناعة النفسية للطلاب، حسب وصف صيام، تثبت أن الحرب على التعليم هي حرب على الوعي الجمعي والمناعة النفسية، وهذه الآثار ليست مجرد نتائج جانبية للنزاع، بل هي جزء من استراتيجية التدجين الهيكلي لتقليل قدرة المجتمع على التنظيم السياسي والمنافسة المستقبلية.
التعليم الشعبي: استراتيجيات المقاومة وتأكيد ملكية الفعل
في مواجهة آليات الاحتلال التي تسعى إلى تدمير المنظومة التعليمية وإضعافها، أظهر الفلسطينيون قدرة هائلة على التكيّف والابتكار، وتحويل التعليم إلى فعل مقاومة جماعي يهدف إلى استرداد السيادة المعرفية، حيث أدرك الشعب الفلسطيني أن التعليم سلاح فعّال في مواجهة الاحتلال. لذلك، فإن الفعل التعليمي يكتسب طابعًا وجوديًا؛ فالمقاومة لا تقتصر على الفعل العسكري، بل تشمل المقاومة المعرفية التي تحافظ على الهوية والثقافة.
يُعتبر “التعليم الشعبي”، والذي يتناوله صيام في الفصل الثالث من كتابه، الذي ظهر مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى في نهاية عام 1987، إحدى أبرز أدوات المقاومة ضد الإبادة المعرفية، كردّ فعل على إغلاقات سلطات الاحتلال للمدارس والجامعات لفترات طويلة. فلم يكن التعليم الشعبي مجرد حل بديل لسدّ الفجوة التي أحدثتها الإغلاقات، بل كان فعلًا جوهريًا لاسترداد ملكية التعليم؛ إذ خلاله “يقرّرون معًا ماذا يتعلّمون، وكيف؟”. هذا التحول يعني تأسيس سيادة تعليمية ومعرفية مستقلة عن السيطرة الاستعمارية.
أيضًا، تجسّدت فكرة التعليم الشعبي في الانتفاضة الأولى من خلال نشاط “لجان الأحياء”، حيث قام المعلمون بتشكيل لجان خاصة بهم، وتضمّنت مهامهم حصر أعداد الطلبة وأعمارهم، وتوزيعهم على الصفوف والمراحل، وإعداد البرامج المدرسية المطلوبة، بمساعدة المتطوعين من طلبة الجامعات والمثقفين. ورغم محاربة الاحتلال لهذه اللجان وملاحقة الناشطين واقتحام البيوت والجوامع التي احتضنت هذه الأنشطة، استمرت المبادرة، مؤكّدة على الإصرار والتحدّي.
كذلك، تناول صيام دور فضاءات المقاومة غير التقليدية، وفي مقدّمتها السجون. يُنظر إلى حرمان الأسرى من التعلّم كجزء من سياسة الاستهداف، لكن الأسرى حوّلوا السجن، وهو مكان السيطرة القصوى، إلى مختبر للوعي ومركز للتعليم التحرري. يُعتبر إضراب الأسرى من أجل التعليم استمرارًا لثقافة المقاومة، حيث يُمارس التعليم داخل السجون كوسيلة لزيادة الوعي للثورة ولضمان الحرية والاستقلال، مصارعًا الفكر الصهيوني ومؤكّدًا الإرادة الوجودية للشعب.
وفي القدس، حيث تتجذّر سياسات الأسرلة، اضطلع المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية بدور مركزي كبديل عملي في ظل الغياب الرسمي الفلسطيني، حيث وفّرت الجمعيات المقدسية دعمًا ماليًا للمدارس التي رفضت التزام المنهاج الإسرائيلي، وغطّت تكاليف التشغيل ورواتب المعلمين وشراء الكتب. ومع الوقت، تجاوز هذا الدعم حدود الاستجابة المؤقتة ليُصبح خيارًا استراتيجيًا يحافظ على التعليم الوطني والهوية في بيئة محكومة بالمنع والهيمنة.
المعلّم الفلسطيني: الحارس الوجودي للهوية
في مواجهة محاولات الطمس والاستيعاب الثقافي، ينهض المعلّم الفلسطيني بدور يتجاوز حدود العملية التعليمية التقليدية ليُصبح حاملًا للمشروع الوطني وحارسًا للهوية. فقد أظهرت الدراسات أن دور المعلّم في تعزيز الهوية الوطنية جاء بدرجة كبيرة، بوزن نسبي بلغ 81%. المعلّم هو حجر الزاوية الذي يضمن انتقال الثوابت الوطنية للأجيال الجديدة. وينقسم دوره إلى أربعة مجالات رئيسية مترابطة: التاريخي، والسياسي، والبيئي، والاجتماعي، ما يُثبت شمولية ومركزية دوره في صياغة الوعي الجمعي.
في البيئة الفلسطينية، يُصبح المعلم وكيلًا للمقاومة المعرفية عبر توظيف “المنهج الخفي” (Hidden Curriculum) لتعزيز الوعي. يشمل المنهج الخفي القيم والخبرات والتفاعلات غير الرسمية التي يتم تمريرها للطالب. ففي المناطق الخاضعة للسيطرة المباشرة، أو حيث يُفرض منهاج هجين (كما في بعض مدارس القدس)، يتحول المعلّم إلى مُرشّح (Filter) يقوم بتفسير وتوجيه المحتوى الرسمي بشكل يخدم الهدف الوطني، ما يُؤكد على أهمية تمكين المعلّم ليكون شريكًا فاعلًا في تخطيط المناهج وتعديلها وتطويرها.
أيضًا، يتجسد الدور الوجودي للمعلّم في مساهمته في الإصلاح والتطوير المجتمعي، وتنمية المناعة النفسية والاجتماعية للطلبة. إن الآثار النفسية الناتجة عن الصدمات المستمرة تتطلب دمج الدعم النفسي الاجتماعي ضمن النظام التربوي، فوفقًا لمنظور علم النفس التحرري، يجب ربط التعافي النفسي بالمشروع السياسي التحرري والوعي الجمعي. في هذا السياق، يُصبح دور المعلّم حيويًا في مساعدة الطلاب على فهم مسبّبات الصدمات (آليات القمع الاستعماري)، وتشجيعهم على القيام بأدوار مناهضة للقمع السياسي والاجتماعي. هنا، يُصبح التعليم ليس مجرد علاج فردي، بل أداة للشفاء الجمعي والتمكين الاجتماعي، مما يُحوّل الطالب من متلقٍّ للصدمة إلى فاعل نشط ووكيل للتغيير.
التعليم هدفًا للتحرر
وفي الفصل الخامس، يعطي صيام ما أفضى إليه من استنتاجات وتوصيات، إذ يُؤكّد أن التعليم الفلسطيني يُمثّل ساحة مركزية للصراع، وهو بعيد كلّ البعد عن كونه قضية تربوية محايدة. إن شراسة الاستهداف الأمني والاستعماري، الذي يسعى إلى الاقتلاع والتجهيل، لم تنجح في تفكيك البنية التعليمية أو تجريدها من طابعها الوطني. بل، وعلى العكس من ذلك، أدّت هذه الضغوط إلى تبلور استراتيجيات مقاومة مرنة ومبتكرة، مثل التعليم الشعبي في الأحياء و”جامعة السجن”. لقد أظهر الفلسطينيون قدرتهم على الحفاظ على نظام تعليمي يتّسم بالجودة النسبية، حتى إن البنك الدولي أشاد به ووصفه بالأفضل عربيًا، وهو ما يُمثّل تناقضًا صارخًا بين محاولات الاحتلال لتدمير النظام من جهة، وبين الإصرار المجتمعي على الحفاظ عليه وتطويره من جهة أخرى. هذا الصمود يعكس جوهر التعليم كبنية تحتية وجودية للبقاء.
كما يُؤكّد الصراع الجدلي بين القمع الاستعماري والمقاومة التعليمية على الطابع السياسي والوجودي للتعليم. عند إغلاق المدارس وتدميرها (الإبادة المادية)، كما حدث في حرب الإبادة على غزة، كانت الاستجابة الوجودية هي إطلاق التعليم الشعبي في الأحياء والمنازل، ما أدّى إلى استعادة ملكية التعليم وتأكيد السيادة المعرفية. وفي مواجهة تجهيل الطالب وتشويه المناهج (الإبادة المعرفية)، برز دور المعلم الحيوي في المنهج الخفي وتعزيز الهوية (حيث جاء دوره بنسبة 81% في تعزيز الهوية الوطنية)، ما يضمن الحفاظ على الذاكرة الوطنية ورفض محاولات الطمس. كما أن استهداف العلماء وحرمان الأسرى، قوبل بثقافة المقاومة التعليمية داخل السجون، مُحوّلًا فضاء السيطرة القصوى إلى مركز للوعي الثوري. وأخيرًا، شكّل العنف الهيكلي والضغوط النفسية دافعًا لدمج الدعم النفسي التحرري في المنهج، لبناء المناعة النفسية الجمعية والربط بالمشروع السياسي.
إن القراءة المعمّقة، من خلال كتاب صيام أو غيره من دراسات تحررية، لآليات الصراع والمقاومة في الوعي الفلسطيني، تفرض علينا استخلاص ضرورات وجودية في مسار التحرر. يكمن جوهر هذه الضرورة في تحرير مجال الدعم النفسي والاجتماعي، لا كاستجابة علاجية فردية، بل كفعل جماعي مناهض للقمع، يتم دمجه في النسيج التربوي ليتشابك مع الوعي التحرري الجمعي. ويتوازى ذلك مع ضرورة تمكين المعلم، وتحويله من مجرد ناقل للمعلومة إلى استراتيجي للهوية، مزوّد بالأدوات اللازمة لتضمين الثوابت الوطنية وتاريخ المجتمع في ثنايا المنهج الخفي.
ولا يمكن لهذا التحوّل أن يكتمل دون دعم مالي ولوجستي مستدام للمبادرات الأهلية التي تُشكّل خط الدفاع الأول ضد سياسات الأسرلة والتدجين، لا سيما في مراكز الصراع كمدينة القدس، لضمان رفض المناهج المفروضة والحفاظ على جودة التعليم الوطني. وتتضافر هذه الجهود الداخلية مع ضرورة تكثيف التحرك القانوني والدولي، لتوثيق وفضح جرائم الاحتلال المرتكبة بحقّ المؤسسات التعليمية، والمطالبة بحقّ الشعب الفلسطيني في التعليم داخل بيئة آمنة وغير مضطربة.
ونهايةً، يظلّ كتاب “تعليم الفلسطينيين بين الاحتلال والمقاومة” شاهدًا على حقيقة لا تقبل الجدل: إن التعليم، في عيون المحتل، سلاح يجب إخضاعه؛ وفي وجدان الشعب الفلسطيني، هو فعل وجودي أصيل، وبنية أساسية للصمود تقود حتمًا إلى التحرير.