“لحظة محاسبة إسرائيل ستأتي من المجتمع اليهودي”.. حوار مع الباحث الأمريكي دانيال زغبي
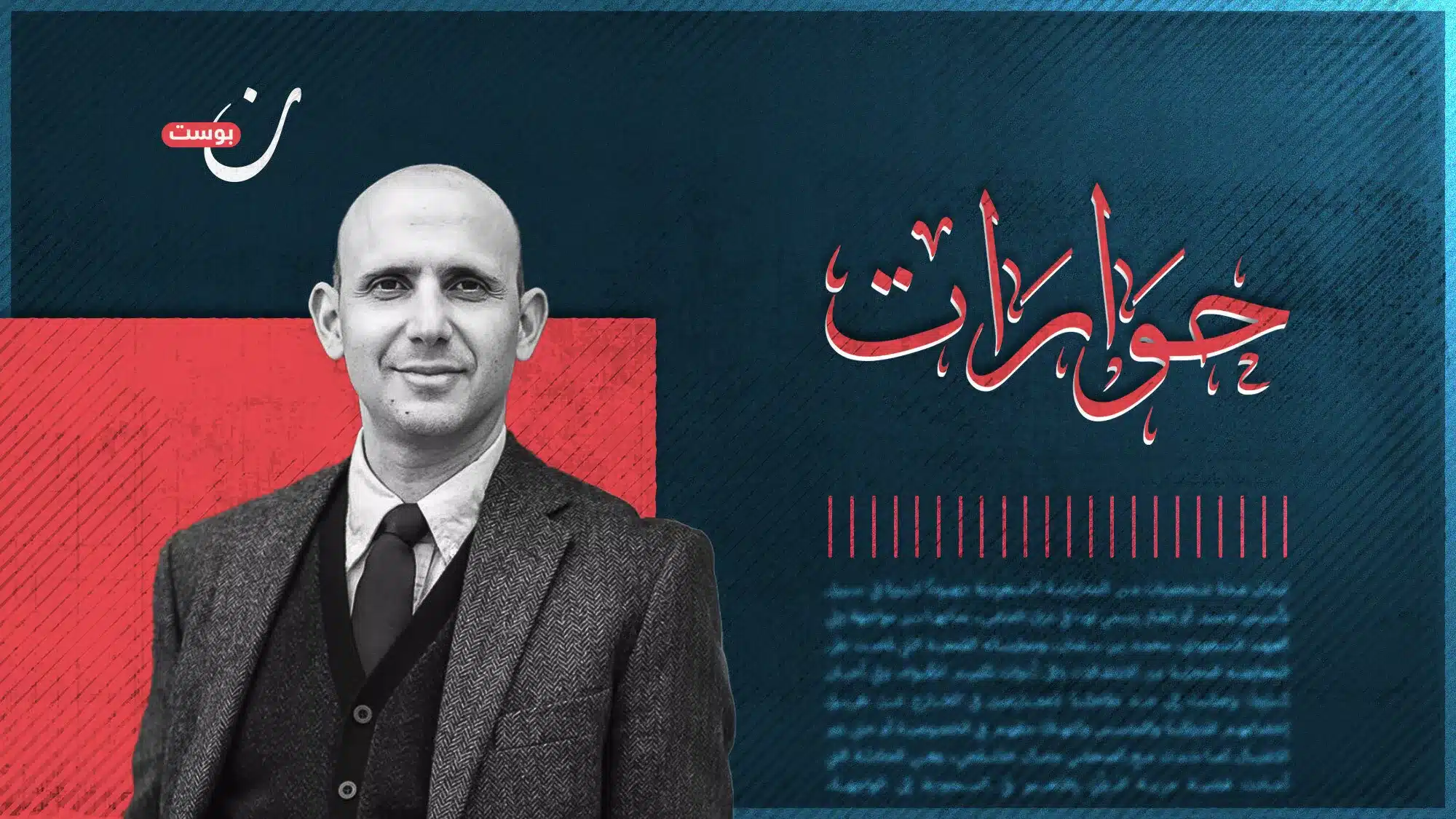
Also available in: English 🔗
منذ أن رست أولى سفن الأميركيين على شواطئ المشرق في القرن التاسع عشر، مع المبشّرين والمدارس البروتستانتية في بيروت وصيدا ويافا وتدخل منها إلى القدس والناصرة ودمشق، لم تكن العلاقات العربية الأميركية تُدار بمنطق المصالح بقدر ما كانت تُستكشف بفضول القوى الصاعدة، فأمريكا لم تكن قد أصبحت قوّة عالمية بعد، ولا المنطقة العربية كانت محور الصراع الدولي وإن كانت في قلب التنافس الأوروبي، لكن تلك اللحظة التأسيسية زرعت بذور احتكاك طويل سيشتدّ ويأخذ أشكالًا جديدة كل عقد.
مع الحربين العالميتين، بدأت واشنطن ترى الشرق الأوسط بوصفه الجسر الجغرافي والسياسي الذي يربط ثلاث قارات، قبل أن يتحوّل النفط، منتصف القرن العشرين، إلى العقدة التي قلبت ميزان العلاقة، من علاقة ذات طابع ثقافي إنساني إلى علاقة إستراتيجية تقودها الطاقة والأمن والتحالفات العسكرية، وبعد 1945، باتت واشنطن الوريث الحقيقي لنفوذ بريطانيا في المنطقة، تدعم أنظمة، وتسقط أخرى، وتعيد رسم الخرائط وفق هواجس الحرب الباردة.
تسارعت التحوّلات.. انقلاب إيران 1953 (اعترفت CIA عام 2013 بأنها حاكت مؤامرة الانقلاب على رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيًا محمد مصدق)، العدوان الثلاثي عام 1956، النكسة 1967 التي شجعت واشنطن على تبني “إسرائيل” وليصبح دعمها ركيزة ثابتة، ثم صدمة النفط 1973 التي جعلت العرب للمرة الأولى يمسكون بورقة ضغط حقيقية بوجه الولايات المتحدة، ما اضطرّ واشنطن لإعادة تعريف علاقتها بالمنطقة، ثم بعد اتفاقية كامب ديفيد، أصبح السلام المصري-الإسرائيلي حجر الأساس الذي حكم سياسات الإدارات المتعاقبة من كارتر إلى كلينتون.
دخل القرن الجديد وقد ترسخت ثلاث مسلّمات في العقل الأميركي: أمن إسرائيل، استقرار أنظمة الحلفاء، ومحاربة “الإرهاب”، شكّلت هجمات 11 سبتمبر نقطة التحوّل الأكبر، فغزت الولايات المتحدة بلدين مسلمين، أفغانستان والعراق، وأعادت هندسة المنطقة بقوة السلاح لا بقوة السياسة، ثم جاء الربيع العربي ليكشف هشاشة هذا الفهم الأميركي للشرق الأوسط، فبدت واشنطن متردّدة، مرتبكة، وغير قادرة على التنبؤ بطبيعة التحوّل الذي كان يتشكّل أمامها.
واليوم، بعد السقوط المدوّي لنظام الأسد وصعود قيادة جديدة في دمشق، والتغيّرات في مواقع الطاقة عالميًا، وتنامي الدورين الصيني والروسي وصعود لاعبين جددًا كتركيا والهند وإيران، يبدو سؤال هل تفهم واشنطن الشرق الأوسط؟ أكثر إلحاحًا.. هذا ما نحاول استكشافه وفهمه مع الباحث الأمريكي دانيال زغبي.
من هو؟
ضيفنا دانيال زغبي Daniel Zoughbie، هو باحث أميركي في السياسة الخارجية ودبلوماسية الشرق الأوسط، تركز أبحاثه المنشورة على قرارات الرؤساء الأميركيين وأثرها على الصراعات الإقليمية، لا سيما النزاع الفلسطيني‑الإسرائيلي. يحمل دكتوراه من جامعة أوكسفورد في العلاقات العامة، ويعمل حاليًا في جامعة كاليفورنيا بيركلي، حيث يقود مبادرة بحثية حول التنمية والدبلوماسية والدفاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
شغل سابقًا مناصب في جامعات هارفارد وستانفورد وجورج تاون، وجامعات عدة أخرى، وصدر له كتابان:
- نقاط التردد: جورج دبليو بوش والصراع الإسرائيلي الفلسطيني (2014)
- (Indecision Points: George W. Bush and the Israeli-Palestinian Conflict)
- نكش عش الدبابير: السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط من ترومان إلى ترامب (2025)
- (Kicking the Hornet’s Nest: U.S. Foreign Policy in the Middle East from Truman to Trump)

في هذا الحوار، نسكتشف مع د. زغبي -الذي انهمك بدراسة السياسات الخارجية لـ 13 رئيسًا أمريكيًا خلال 80 عامًا في الشرق الأوسط- الذهنية التي تدير البيت الأبيض فيما يتعلق بالعلاقة مع منطقتنا، ونقلّب معه بعض صفحات كتابيه المذكورين، ونحاول استشراف مستقبل العلاقات العربية الأمريكية “المترددة”.
إلى الحوار..
— بدا المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك “محتارًا للغاية” وعاجزًا عن حل “اللغز الحقيقي” وراء عدم قبول دول المنطقة مثل مصر والسعودية باستقبال الشعب الفلسطيني الذي تعمل إسرائيل على تهجيره من أرضه، وكأنّ تهجير شعب من أرضه هو السلوك البديهي.
من خلال دراستك لـ80 عامًا من السياسة الأميركية ونهج جميع إدارات البيت الأبيض خلال تلك الفترة..
هل ترى أن واشنطن تفهم حقًا الديناميات الاجتماعية والسياسية في الشرق الأوسط؟
– الأمر نسبيّ.
أعتقد أن العديد من صنّاع السياسة الأمريكيين على مدى العقود الثمانية الماضية أظهروا فهمًا عميقًا جدًا لديناميكيات الثقافة والمجتمع والاقتصاد في الشرق الأوسط؛ أو على الأقل، قدّموا رؤية بالغة التطور للطبيعة البشرية ولطبيعة النظام الدولي. أشخاص مثل جيرالد فورد (رئيس أمريكي، 1974-1977)، والجنرال جورج سي. مارشال (وزير خارجية ثم وزير دفاع أمريكي، حاز جائزة نوبل للسلام بسبب خطته الشهيرة التي حملت اسمه)، والسفير جورج كينان (مستشار في الخارجية الأمريكية، عرف كمهندس للحرب الباردة) أدركوا حجم الرهانات. لكن في كثير من الأحيان، لم يُصغِ إليهم أحد. واليوم، يتم تهميش خبراء يتمتعون بقدرات مماثلة بالطريقة نفسها.
القومية هي السبب المحوري للصراع، القومية هي الفكرة القائلة بأن الدولة القومية – سواء في شكلها العلماني أو الديني – أهم من أي شيء آخر، ولقد مات 120 مليون شخص خلال القرن الماضي بسبب القومية.
القومية متغيّر قوي جدًا جدًا في السياسة الدولية، ولهذا السبب فإن أفضل أمل لدينا لحل الصراع العربي-الإسرائيلي-الفلسطيني هو البحث عن طرق لإشباع التطلعات القومية لكلا الطرفين.
كما أوضحت في كتابي “نكش عش الدبابير”، فإن جيرالد فورد (بدعم من وزير خارجيته هنري كيسنجر) أصاب في نهجه، لقد ضغط على الإسرائيليين للتفاوض بجدية مع المصريين، حتى إنه ذهب إلى حد التهديد بإعادة تقييم العلاقة مع إسرائيل، وفي النهاية، أفضى ذلك إلى معادلة: الأرض مقابل السلام. هذا السلام هو حجر الزاوية للأمن الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة اليوم. لقد واجه فورد حليفًا بحقائق قاسية وتعرض لشتى أنواع الشتائم، لكنه فعل الشيء الصحيح.
يجب تطبيق نفس المبدأ على الوضع الحالي.
— بعد تتبعك لسياسات 13 رئيسًا أمريكيًّا..
لماذا تبدو بعض الثوابت الأميركية -مثل الالتزام بأمن “إسرائيل” ومحاربة الإرهاب- أقوى من أي تغيير في إدارات البيت الأبيض؟
– الأمن الأمريكي يقوم أساسًا على ثلاث ركائز – الدفاع والدبلوماسية والتنمية، لكن صنّاع السياسة الأمريكيين أضعفوا قدرات التنمية والدبلوماسية، وأصبحوا يركزون بشكل شبه كامل على الدفاع (متمثلًا في العمليات العسكرية السرية والعلنية)، وقد كان هذا أمرًا مؤسفًا بالنسبة للولايات المتحدة وللآخرين، بما في ذلك حلفاؤها في الدول العربية والإسلامية.
من السهل جدًا الركون إلى تلك العقيدة التبسيطية القائلة إن “القوة تصنع الحق”، بينما يُعد الانخراط في العمل الشاق المتمثل في المصالحة – أي الدبلوماسية والتنمية – أمرًا أكثر صعوبة بكثير.
أحب الإشارة إلى الجنرال جورج سي. مارشال الذي أعادت خطته التي تحمل اسمه بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، فلقد فهم أن المرء لا يستطيع العيش بحدّ السيف إلى الأبد، وفي الحقيقة، قدّم مارشال حزمة مساعدات ضخمة لأعدائه السابقين، إذ لم يرغب في تكرار خطأ الحرب العالمية الأولى حينما نثر الحلفاء الملح على أرض أعدائهم وجعلوها بورًا.
أحد الأمور المثيرة التي خَلُصَ إليها كتابي هو مدى الهزيمة الذاتية في “العيش بحد السيف”. هل الولايات المتحدة أكثر أمانًا، هل إسرائيل أكثر أمانًا، هل إيران أكثر أمانًا، هل تركيا أكثر أمانًا، هل العالم العربي أكثر أمانًا، هل الجنس البشري برمته أكثر أمانًا اليوم مما كان عليه قبل عقود؟
وعلى الرغم من الإنفاق الدفاعي الهائل، تتعامل الولايات المتحدة الآن مع منافسة أمنية غير مسبوقة – هذه القضية النووية مع إسرائيل وإيران يمكن أن تجر بسهولة روسيا أو حتى الصين إلى صراع في الشرق الأوسط من شأنه أن يشعل العالم.
السؤال عن سبب دعم الولايات المتحدة لمصالح إسرائيل سؤال مثير للاهتمام، عندما أُسأل عن هذا – وكثيرًا ما يحدث ذلك – أطرح ما أعتقد أنه سؤال أكثر أهمية: لماذا تدعم الولايات المتحدة إجراءات “مؤيدة لإسرائيل” ليست في مصلحة الولايات المتحدة ولا إسرائيل؟ إن من مصلحة الولايات المتحدة إقامة دولتين على أساس حدود 67، وهذا أيضًا من مصلحة إسرائيل، كما أنه من مصلحة فلسطين أن يكون لها دولة، وهو من مصلحة العالم العربي.
منذ زمن بعيد، كتب “جورج بول”، وهو أحد أبرز وكلاء وزارة الخارجية الأمريكية، مقالًا بعنوان “كيف تنقذ إسرائيل رغم أنفها؟“، وكانت هذه هي وجهة نظره أيضًا.
وأعود هنا إلى كتابي والفرضية المركزية التي يقوم عليها: لقد سمحت الولايات المتحدة بضمور قدراتها الدبلوماسية والتنموية، وباتت تعتمد بشكل مفرط على الدفاع: حروب، وانقلابات، وصفقات سلاح.
أما فيما يتعلق بالإرهاب، فإن السياسة الخارجية الأمريكية لم تؤدِ إلا إلى تفاقم المشكلة؛ فكيف ولماذا ظهر تنظيم القاعدة؟ وماذا عن داعش؟
— هل ما نشهده تجاه سوريا اليوم، يمثّل تحول مؤسساتيًا في سياسة الولايات المتحدة، أم أنه استثناء مرحلي مرتبط برؤية ترامب الشخصية وصفقاته الدولية؟
كيف تقيّم انفتاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القيادة السورية الجديدة؟
– هذا سؤال تصعُب الإجابة عليه لسببين:
الأول، أن عملية اتخاذ القرار لدى “دونالد ترامب” عصيّة جدًا على الفهم، إذ لا يبدو أن هناك الكثير من العمليات المنهجية التي تسبق قرارات إدارته، فهو يعتمد على حدسه.
أما الثاني، فهو أن الصعود المذهل للرئيس السوري الجديد – الذي كان قائدًا في تنظيم داعش وسجينًا سابقًا لدى الولايات المتحدة في العراق – يُعدّ أمرًا غريبًا للغاية، من الواضح أنه مرتبط بالاستخبارات التركية، وهي جزء من حلف الناتو، وهذه قصة خلفية يمكن للمرء أن يؤلّف عنها كتابًا كاملًا.
في الولايات المتحدة، أعتقد أن هناك انفتاحًا عامًا تجاه الحكومة الجديدة في دمشق. فالشرع يقوم بجولة عالمية لإعادة تقديم نفسه — يلتقي بمدير الـCIA السابق الجنرال ديفيد بترايوس، ويجري مقابلات إعلامية، وما إلى ذلك.
لكن الأسئلة الحقيقية هي: إلى متى سيتمكن الرئيس السوري الجديد من البقاء في السلطة، بالنظر إلى الانقسامات الطائفية العميقة في بلاده؟
وبغضّ النظر عن النقطة السابقة، هل ستكون حال البلاد أفضل مما كانت عليه قبل إزاحة الأسد عن السلطة؟

— التبشير بالديمقراطية والدفع بها حول العالم، هو جزء أساسي من العقيدة الأمريكية المعلنة، لكن واشنطن لم تبدُ متحمسة كثيرًا للربيع العربي ربما باستثناءات محدودة كما في ليبيا، في حين بدت مترددة ومرتبكة في محطات أخرى عن اتخاذ إجراءات فعلية حاسمة، وفي دول كمصر بدت مرتاحة للانقلابيين العسكر الذين أطاحوا بأول حكومة منتخبة في تاريخ البلاد..
كيف تقرأ الموقف الأمريكي من ثورات الربيع العربي؟
– فكرة نشر الديمقراطية الأمريكية في الشرق الأوسط هي فكرة خاطئة من أساسها، خصوصًا عندما تكون محمولة على رؤوس الرماح، أو حين تتم تحت ظروف الاحتلال. وكما أوضّح في كتابيّ “نكش عش الدبابير”، و”نقاط التردد”، فإنه لا توجد دولة عظيمة بما يكفي لتعتبر أن شكل حكمها هو المصير المحتوم للبشرية.
أنا أعيش في الولايات المتحدة، ويعجبني نظامها السياسي، على علّاته. لكن يجب دائمًا العمل على حفظ الديمقراطية وحمايتها، واستحضار كلمات جون كوينسي آدامز (رئيس أمريكي، 1825-1829) الذي قال: ليس من واجب أمريكا أن “تخرج إلى العالم باحثةً عن وحوش لتدميرها”.
لقد أدرك أن المغامرات الخارجية ستلحق الضرر بالديمقراطية الأمريكية نفسها، وحرب العراق الثانية خير دليل على ذلك.
— في كتابك “نقاط التردد” تدرس تردد جورج بوش الابن في الملف الفلسطيني، وفي “نكش عش الدبابير” تتحدث عن تردد باراك أوباما في سوريا؟
كيف يشبه هذا التردد ذلك، من حيث الأسباب، والظروف، والمآلات؟
أنت محق في عقد هذه المقارنات، فهناك قواسم مشتركة بالفعل، ففي عهد بوش، دفع التحالف المحافظ نحو التدخل العسكري، ولا سيما في العراق وفلسطين. وفي عهد “أوباما”، دفع أنصار التدخل الليبرالي (Liberal interventionists) نحو التدخل العسكري أيضًا، ولا سيما في ليبيا.
ولكن من نواحٍ أخرى، أعتقد أن حالة التردد التي اعترت “جورج دبليو بوش” فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني تختلف بشكل كبير عن سياسة “أوباما” تجاه الثورات العربية. لقد كان لدى “بوش” سياستين محددتين بوضوح ولكنهما متباينتان (لا يمكن التوفيق بينهما): “التوازي” (Parallelism) و”التتابع” (Sequence)، وكان يتأرجح بينهما جيئة وذهابًا، إذ لم يستطع حسم أمره؛ وكان هذا هو موضوع كتابي الأول “نقاط التردد” (Indecision Points).
نصت سياسة “التوازي” على أن التنازلات الإسرائيلية-الفلسطينية يجب أن تكون متبادلة، وأن المفاوضات يجب أن تمضي قدمًا بهدف التوصل إلى اتفاق سلام. أما سياسة “التتابع” فكانت تعني أنه يجب على الفلسطينيين أولًا إجراء إصلاحات – للقضاء على الطغاة والإرهاب – وبعد ذلك فقط يمكن أن تبدأ مفاوضات السلام.
أما سياسة “أوباما” تجاه الثورات العربية فقد كانت مشوشة لأسباب مختلفة. وكما أوضحت في كتابي “ركل عش الدبابير”، فقد انجرف أوباما إلى حملة تغيير النظام في ليبيا، مما شكل مثالًا مروعًا لأي دولة تفكر في التخلي عن برنامجها النووي. والدرس المستفاد هنا بالنسبة لكوريا الشمالية وإيران هو: لا تتخلوا عن برامجكم النووية، وإلا فقد ينتهي بكم الأمر مثل القذافي.
وفي الحالة المصرية، يجب أن نفهم أنه حدثت عدة انقلابات بعد الحرب العالمية الثانية: عبد الناصر ضد الملك فاروق، ومرسي ضد مبارك (مدعومًا بمظاهرات حاشدة)، ومرسي ضد الدستور المصري (انقلاب ناعم)، والسيسي ضد مرسي (مدعومًا أيضًا بمظاهرات حاشدة)، وأنا أفصل كل هذه الأحداث في كتابي.
وفي سوريا، تدخل الروس لمنع تغيير النظام، وتراجعت الولايات المتحدة عن فكرة تغيير النظام بشكل شامل، لكن الولايات المتحدة ظلت تدعم العمليات السرية التي أدت في النهاية إلى تولي قائد سابق في “داعش” مقاليد الحكم في البلاد بعد سنوات.
هذه العملية، التي أصفها أيضًا في الكتاب، كانت تحمل اسم “تيمبر سيكامور” (Timber Sycamore)، وكانت تديرها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
وكما أوضحتُ أعلاه، فإن السؤال الكبير هو: إلى أين ستؤول الأمور في النهاية؟ يأمل المرء أن تستقر سوريا وألا تنزلق إلى أتون الصراعات الطائفية.
— مع تزايد الاكتفاء الذاتي النفطي في الولايات المتحدة..
هل فقد الشرق الأوسط وزنه الاستراتيجي التقليدي في واشنطن، كما ألمح بذلك المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك؟ أم أن الصراع على الطاقة اليوم يدور حول النفوذ في شبكات التوزيع لا الإنتاج فقط؟
– لا أعتقد ذلك.
وكما أوضّح في كتابي، علينا أن ننظر إلى الحقائق؛ فالشرق الأوسط يقع عند ملتقى ثلاث قارات كبرى: آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وتضم المنطقة ممرات مائية استراتيجية يمر عبرها جزء كبير من نفط العالم وتجارته.
وحينما أُغلقت قناة السويس لفترة وجيزة بسبب حادث ملاحي، تكبد العالم خسائر بمليارات الدولارات. كما أن ما يقرب من نصف احتياجات الصين النفطية يمر عبر مضيق هرمز، ولن تقف الصين مكتوفة الأيدي إذا ما تعطل هذا التدفق.
أضف إلى أن أكثر من أربعة مليارات من اليهود والمسيحيين والمسلمين يقدّسون أجزاء من الشرق الأوسط بوصفها أراضي مقدّسة.
والآن، باتت المنطقة تتحول إلى مركز لبناء منشآت ضخمة للطاقة ومراكز البيانات اللازمة لتشغيل ثورة الذكاء الاصطناعي.
والأهم من ذلك كله، تمتلك إسرائيل ما يقرب من 200 سلاح نووي، وتُعد إيران دولة على العتبة النووية، في حين تمتلك المملكة العربية السعودية سلاحًا نوويًا “جاهزًا تحت الطلب” بموجب اتفاقية الدفاع المشترك مع باكستان، وإذا لم يتم وقف الانتشار النووي، وأصاب الضعف حلف الناتو، فقد تسعى تركيا هي الأخرى لامتلاك أسلحتها النووية الخاصة.
هذه ليست منطقة يمكن لأي قوة عظمى أن تتحمل تجاهلها.
— إلى أي مدى تسهم السياسات الأميركية – بقصد أو بدون – في تعقيد الصراعات الداخلية في العالم العربي؟ وكيف تبرّر الإدارات الأميركية شراكتها المستمرة مع أنظمة استبدادية في المنطقة؟
– كل قوة عظمى أو قوة إقليمية ستسعى إلى تعزيز نفوذها، ولهذا، فإن مسؤولية الأزمة الحالية التي تشهدها المنطقة ينبغي أن تتوزع على العديد من الأطراف.
وفي الوقت ذاته، ينصب تركيز كتابي على السياسة الخارجية الأمريكية، لا على السياسة الخارجية للصين أو روسيا، وتُظهر الأدلة بوضوح مدى قصر النظر الذي اتسمت به السياسة الأمريكية. فعلى سبيل المثال، أدت سياسة منع الانتشار النووي التي اتبعتها واشنطن في الشرق الأوسط، جنبًا إلى جنب مع سياساتها ذات الصلة في جنوب آسيا، إلى دفع العالم نحو منافسة أمنية بالغة الخطورة.
أما قضية “الديمقراطية مقابل الاستبداد” فهي مسألة أخرى بالغة الأهمية.
أنا أعيش في الولايات المتحدة، وأفضل العيش في مجتمع ديمقراطي، لكنني أدرك أيضًا أن الولايات المتحدة لا يمكنها فرض نمط حياتها على المجتمعات الأخرى، أو على الأقل لا يمكنها فعل ذلك دون تكبد تكلفة باهظة. كما لا يمكن للولايات المتحدة أن تعيش كجزيرة معزولة، بحيث تختار الانخراط فقط مع الدول التي تتبنى نفس نظام الحكم فيها.
وهذا يعني أن على الولايات المتحدة التعامل مع دول أخرى قد لا تكون ديمقراطية، ويعني أيضًا أنها ملزمة باحترام الثقافات وأنماط الحياة الأخرى. ولكن هذا لا يعني أن تغض الولايات المتحدة الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما عندما تؤدي تلك الانتهاكات إلى تقويض مصداقيتها وقدرتها على تحقيق أهدافها الوطنية.
— إلى أي مدى ما تزال حماية “إسرائيل” وأمنها محددًا للسياسة الأميركية والبوصلة المطلقة لكل تحركاتها في المنطقة؟
هل تتوقع أن نشهد يومًا تنظر فيه الإدارات الأمريكية لـ”إسرائيل” كفاعل مستقل يُحاسَب وليس فقط يُحمى؟
– يجب على السياسة الخارجية الأمريكية أن تسترشد بالمصلحة الوطنية، لكن الواضح، من خلال قراءة ثمانين عامًا من التاريخ، أن الولايات المتحدة لا تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة في المنطقة؛ بل إنها لا تخدم مصلحة أي طرف سوى أولئك الذين يجنون المكاسب من وراء هذه الفوضى الخطيرة.
كما أود أن أجادل – وقد فعلت ذلك في الكتاب – بأنه إذا كان أحد أهداف أمريكا المعلنة هو حماية أمن إسرائيل، فإن الولايات المتحدة لا تبلي بلاءً حسنًا في هذا الصدد. إن المنافسة الأمنية الراهنة، التي تُعرّض المصالح الأمريكية والإسرائيلية والعربية للخطر، تشكل وضعًا مقلقًا للغاية.
وللإجابة على سؤالك الأخير: أعتقد أن لحظة المحاسبة لإسرائيل ستأتي من داخل المجتمع الإسرائيلي ومن المجتمع اليهودي العالمي. فقد صرّح رئيس الوزراء السابق “نفتالي بينيت” بأن نتنياهو قد أوصل البلاد إلى شفا حرب أهلية. ورغم كل عمليات الاغتيال والاستعراضات التكنولوجية المتطورة، فشل نتنياهو حتى الآن في هزيمة حماس، وحزب الله، والحوثيين. كما فشل أيضًا في تحقيق هدفه النهائي المتمثل في الإطاحة بالنظام في إيران. وفي هذه المرحلة، لا أعتقد أن الصين أو روسيا ستسمحان بحدوث ذلك، حتى لو كان لديه سبيل لتغيير النظام.
وفي سياق هذه المحاسبة، أعتقد أن السياسة الأمريكية قد تشهد تحولًا، ولكن على الدول التي تنتقد إسرائيل أن تقوم بدورها هي الأخرى، لتثبت وجود أفق سياسي ذي مصداقية كبديل للحرب. لقد كانت “مبادرة السلام العربية” بالغة الأهمية في هذا الصدد، وثمة حاجة الآن إلى دفعة جادة من قبل العالمين العربي والإسلامي لإحياء هذه الرؤية.
يجب التعامل مع الملف النووي بشكل مباشر وحازم – عبر الدبلوماسية – وكذلك الأمر بالنسبة للقضية الفلسطينية، ففي رأيي، القضيتان مترابطتان، ولا سيما بعد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، كما أن للصين وروسيا دورًا مهمًا لتلعباه في هذا الشأن.
— لديك اهتمامات عديدة بعيدًا عن السياسة بشكل مباشر، وأريد أن استغل الفرصة للاستفادة من خبرتك في أحد هذه الجوانب المثيرة للاهتمام وأسقطها على السياسة.
تطبق منظمة Microclinic International التي أسستَها مقاربة “العدوى الاجتماعية الإيجابية”.. هل يمكن استخدام المنطق نفسه في التغيير السياسي أو المجتمعي، على غرار الوقاية من الأمراض؟
– هذا سؤال رائع بالفعل! نعم، لقد قمتُ بالكثير من العمل الريادي، بما في ذلك في مجال الصحة العامة العالمية في الشرق الأوسط، وأهم ما اكتشفته هو أنه -كما ذكرتَ- فإن السلوكيات الجيدة مثل السلوكيات السيئة معدية وتنتشر عبر الشبكات الاجتماعية.
فكّر مثلًا في التدخين: لماذا يبدأ طفل بالتدخين؟ لأن شخصًا ما أثّر عليه، المشاهير، الموسيقى، الأفلام، العائلة، الأصدقاء، أو حتى الغرباء. ولماذا نسمّي أزمة المواد الأفيونية “وباءً”؟ لأنها تقوم على العدوى الاجتماعية! فالسلوكيات معدية اجتماعيًا، وهذا قد يكون إيجابيًا أو سلبيًا.
يمكن للتأثير الاجتماعي أن يدفع الشخص إلى الإقلاع عن التدخين، أو تناول غذاء صحي، أو ممارسة النشاط البدني. ولهذا نقول دائمًا: الصحة الجيدة مُعدية… فانشرها!
ونعم، أؤمن بإمكانية تطبيق هذه المبادئ على السياسة، سلبًا أو إيجابًا، إذ يمكن للأصدقاء أو أفراد العائلة أن يدفعوا بعضهم بعضًا إلى العنف، أو اللامبالاة، أو تدمير المؤسسات الاجتماعية، أو نشر الأكاذيب، ويمكنهم أيضًا استخدام الشبكات الاجتماعية لحث الآخرين على التصويت، ورفض العنف، ونشر الحقيقة، وتعزيز المشاركة المدنية.
وما تقوم به أنت بوصفك مؤثرًا اجتماعيًا يُعد مثالًا ممتازًا على العدوى الاجتماعية الإيجابية.
هذا الحوار هو باكورة حوارات مكتوبة أجريها مع باحثين ومفكرين غربيين، كانت لهم نتاجات أكاديمية أو فكرية قيّمة في قضايا تمسّ منطقتنا العربية أو تستكشف العلاقات العربية الغربية، وتهدف بشكل أساسي لفهم ما يدور في العقل الغربي عن منطقتنا.