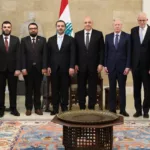تتجاوز المشاهد التي تظهر فيها مدارس في مصر، حيث يرتدي الأطفال الزي العسكري ويرددون هتافات وطنية تحت إشراف ضباط، كونها مجرد أنشطة لغرس الوطنية أو الانضباط. إنها في جوهرها نقطة تكثيف فلسفية تكشف عن رؤية الدولة تجاه الطفل والمواطنة، فالنظام هنا لا يرى في التلميذ كائنًا مستقلاً يمتلك القدرة على التفكير النقدي والتخيل، بل “جنديًا صغيرًا قيد التشكيل” يتم إعداده بشكل ممنهج للانخراط في منظومة الطاعة الشاملة.
تشير هذه الظاهرة، التي يمكن وسمها بـ “عسكرة التعليم”، إلى استراتيجية تاريخية ومكررة في الأنظمة الشمولية، من روسيا الستالينية إلى الصين الماوية، حيث تتحول المدرسة من فضاء للتحرير المعرفي إلى “معمل لإنتاج الطاعة”. وفي مواجهة هذا النموذج القمعي، يبرز تصور المفكر البرازيلي باولو فريري، الذي يرى أن جوهر التربية هو التحرر عبر الحوار، محذِّرًا من “النموذج البنكي” الذي يحوّل التعليم إلى مجرد إيداع للمعلومات في عقول صامتة.
من هذا المنطلق، يهدف هذا المقال إلى تحليل ظاهرة عسكرة التعليم عبر ثلاثة محاور أساسية: النظر إلى جذورها التاريخية والفلسفية، ومن ثم دراسة آثارها النفسية والاجتماعية على التكوين المبكر، وأخيرًا، مناقشة البدائل التربوية المستنيرة المستوحاة من فلسفة التحرر الفريرية.
“عسكرة التعليم” وسياقها المصري
تمثل عسكرة التعليم استراتيجية سيادية ترمي إلى تحويل الفضاء المدني، الذي من المفترض أن يكون مساحة للحوار والتساؤل، إلى فضاء خاضع للمنطق العسكري القائم على الأمر والتنفيذ. في السياق المصري، يُنظر إلى هذه العسكرة كجزء من رؤية المؤسسة العسكرية الأبوية تجاه المجتمع، حيث يُنظر إلى المواطنين على أنهم “عيال” يجب “رعايتهم وضمان سلوكهم وتربيتهم الفكرية”. وقد تجلى ذلك بوضوح في محاولات عسكرة المجال العام، بما في ذلك تحويل بعض المدارس الفنية إلى مدارس فنية عسكرية كخطوة أولى، وتعميم أناشيد عسكرية معينة في المدارس. فعلى سبيل المثال، شهد عام 2019 تحوّل 27 مدرسة فنية إلى مدارس فنية عسكرية كخطوة أولى لتعزيز هذه السيطرة.
من منظور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورغم تصريحاته الرسمية عن أهمية التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء المجتمعات المتقدمة، فإن الإجراءات المتخذة تهدف إلى دمج المؤسسة التعليمية بشكل أعمق ضمن إطار “الأمن القومي” ورؤية الدولة الأبوية. وقد أشار السيسي إلى أن شباب مصر هم الأمل، معتبرًا أن “كل شاب وشابة بالأكاديمية العسكرية المصرية مشروع له قيمة كبيرة”، في ربط مباشر بين قيمة الشباب والانخراط في هذا الإطار العسكري. وتُبرر هذه الاستراتيجية رسميًا بأنها دعم لقطاع التعليم بخبرات عسكرية وأكاديمية متطورة، مما قد يوحي للمواطن بالفخر أو القبول. كما ذكر الرئيس السيسي أن الأكاديمية العسكرية المصرية تهدف إلى صقل الضباط والطلبة وتأهيلهم، وأنها تقدم التعليم والرعاية والحماية للطلاب.
لكن ما تُريده سلطوية السيسي هو تهميش مدنية المهمة التعليمية ذاتها، وإعادة صياغة المفهوم المدني للتعليم، واستبدالها بالمنطق العسكري الذي لا يقبل الجدل أو التساؤل. إن عسكرة التعليم تمثل آلية لضمان “تربية فكرية” تتسق مع رؤية النظام الشمولية القائمة على الطاعة المطلقة بدلًا من الفاعلية النقدية. فبدلاً من أن تعمل المدرسة على تحقيق التنمية المستدامة من خلال الفكر والتحليل والإبداع لقياس المهارات الفكرية والمعرفية للطالب، تتحول إلى أداة للهندسة الاجتماعية التي تسعى لإنتاج جيل “مُهذّب ومُؤدَّب” يتقبل سلطة المؤسسة العسكرية كحارس أبوي على المجتمع، ما يحوّل التعليم من عملية تحرر إلى أداة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني للسلطة عبر غرس الانضباط المطلق والخضوع في المراحل المبكرة من التكوين. إنها عملية تحويل تدريجي للسلطة الأبوية الأيديولوجية إلى سلطة قسرية سلوكية مباشرة في المؤسسات المدنية.
المدرسة كمعمل لإنتاج الطاعة
لفهم العمق الفلسفي لظاهرة عسكرة التعليم، يجب النظر إليها عبر عدسة المفكرين الذين حللوا دور المؤسسة التعليمية كأداة للسيطرة الشمولية. يرى الفيلسوف الفرنسي لوي ألتوسير أن المدرسة هي الجهاز الأيديولوجي المهيمن للدولة (ISA)، وهي الأداة الأكثر فعالية لإعادة إنتاج علاقات الإنتاج الرأسمالية عبر بث الأيديولوجيا. فالمدرسة، منذ نشأتها الحديثة، تعمل كأداة مركزية في تشكيل الأفراد وتوجيههم نحو ما يُسمى بـ “المواطن الصالح”، ولكن وظيفتها الخفية هي إنتاج الخضوع والطاعة، وتقويض النزعة النقدية.
في سياق الأنظمة الاستبدادية، وخاصة عند تطبيق العسكرة، يضعف الفارق بين جهاز الدولة القمعي (RSA) وجهازها الأيديولوجي (ISA). فالعسكرة تمثل تدخلًا مباشرًا للقوة القمعية (الجيش والشرطة) في صميم عمل الجهاز الأيديولوجي (المدرسة). وهذا التدخل يسهل عملية “الاستجواب الأيديولوجي” (Interpellation)، حيث يتم استدعاء الأفراد وتحويلهم إلى “رعايا” (Subjects) مطيعين. عندما يرتدي الطفل الزي العسكري ويُلقن الهتافات، فإن عملية الاستجواب تتم بشكل فوري وعنيف، حيث تُفرض الهوية العسكرية على هويته المدنية، ويتم دمج القوة المادية بالسلطة المعرفية، ما يضمن تحويل العقل الصامت إلى جسد مطيع.
التعليم في الأنظمة الشمولية
ظاهرة استخدام التعليم كأداة للسيطرة ليست حكرًا على نظام بعينه، بل هي سمة متكررة في تاريخ الأنظمة الشمولية التي تسعى لتشكيل وعي جماعي موحد يخدم السلطة. ففي روسيا الستالينية والصين الماوية، شكلت المدارس أداة رئيسية لتشكيل وعي جماعي موحد. كان الهدف هو تعلية قيمة الانضباط وتقليل مساحة السؤال، لإنتاج مواطنين مكرسين لخدمة الحزب والدولة. في هذه الأنظمة، كان التعليم يهدف إلى تكييف الأفراد مع الأيديولوجيا المفروضة، حيث يتم استبدال الحرية الفكرية بالولاء المطلق.
على الرغم من أن بعض الجهود الإصلاحية في المنطقة العربية ركزت على إزالة المحتوى الذي يحض على “العنف”، مثل إزالة بعض آيات “الجهاد” من الكتب الدراسية لتقليل احتمالات تجنيد الطلاب ضمن تنظيمات مسلحة، إلا أن عسكرة التعليم تمثل استبدالًا لأيديولوجيا “متطرفة” بأخرى. فبدلًا من إنتاج مواطن مفكر ومستقل في إنتاج وعيه المعرفي، يتم إنتاج “جندي موجه” وولاؤه مُصاغ بشكل مطلق للسلطة، ما يعيد تعريف الوطنية بأنها طاعة للسلطة وليس التزامًا بالمبادئ المدنية النقدية. هنا، يصبح الهدف المشترك للأنظمة الشمولية في استخدام المدرسة هو الهندسة الاجتماعية التي تسعى لتغيير وعي المضطهدين ليتكيّفوا مع واقعهم، بدلًا من منحهم أدوات لتغيير ذلك الواقع.
باولو فريري وعسكرة “النموذج البنكي”
يقدم المفكر البرازيلي باولو فريري إطارًا نقديًا جذريًا يمكن من خلاله تحليل خطورة عسكرة التعليم، إذ يرى فريري أن جوهر التربية هو التحرر لا التلقين، وأن أي علاقة تعليمية لا تقوم على الحوار تُعد علاقة قمعية. استخدم فريري مصطلح “النموذج البنكي” (Banking Concept of Education) في كتابه المؤثر “تربية المضطهدين”، حيث شبه العلاقة التعليمية بعملية مصرفية؛ فالمعلم يودع المعلومات في عقول الطلاب الصامتة الذين يُنظر إليهم كحاوياتٍ فارغة أو أوعية.
هذا النموذج لا ينتج معرفة حقيقية، بل “إنتاج طاعة”. وقد أوضح فريري أن الممارسات التي يعززها هذا النموذج تعكس المجتمع القمعي ككل، وتتمحور حول تسلط المعلم وسلبية الطالب. فالمعلم يعرف كل شيء والطلاب لا يعرفون شيئًا؛ المعلم يفكر والطلاب يُفكر بهم؛ المعلم يؤدب والطلاب مُؤدَّبون. إن هذا النموذج يخدم مصالح “الظالمين” (Oppressors) لأنه يمنع التوعية النقدية (Conscientização) ويشجع المضطهدين على التكيف مع وضعهم، ما يسهل فعل وممارسة الهيمنة عليهم.
تعد عسكرة التعليم التطبيق العملي والراديكالي للنموذج البنكي. إن الطاعة المطلقة هي القاسم المشترك بين النموذج البنكي (الاستماع السلبي) والمؤسسة العسكرية (التنفيذ الفوري للأوامر). في البيئة البنكية المُعسْكرة، لا يتم الاكتفاء بإيداع المعلومات المعرفية؛ بل يتم إيداع الأوامر والسلوكيات الجاهزة (مثل الهتاف والتشكيل). هنا، القيمة لا تكمُن في فهم المضمون، بل في التنفيذ الميكانيكي والفوري. إن العسكرة تصادر منذ البداية إمكانية أن يرى الطفل العالم “كمساحة للتفكير لا كأوامر للتنفيذ”. وبذلك، يتم تحويل الخضوع الأيديولوجي السلبي (الاستماع) إلى خضوع سلوكي وتنفيذي (الارتداء والتهليل). هذا المأزق الفلسفي يمثل تجسيدًا ماديًا لأسوأ ما حذر منه فريري، حيث يتم إقامة قطيعة بين الفرد والعالم، ويصبح وجود الشخص مُجرّدًا من الفعل الخلّاق.
يمكن تلخيص التناقض الجذري بين النموذج المُعسكَر والتربية التحررية لفريري في النقاط التالية، حيث الهدف الأساسي هو سعي النموذج البنكي المُعسكَر لإنتاج الطاعة، وتثبيت الأيديولوجيا، وإعادة إنتاج الخضوع. في المقابل، تهدف التربية التحررية إلى التحرر، والتوعية النقدية، ومنح الأدوات اللازمة لتغيير الواقع أيضًا. دور المعلّم: يمثل المعلم في النموذج المُعسكَر السلطة المطلقة (الضابط/الحارس) والمودِع للمعرفة. بينما يكون دوره في النموذج التحرري ميسرًا وشريكًا وحواريًا.
أما فيما يخص جوهر التفاعل، فإن النموذج المُعسكَر يعتمد على الإملاء والتلقين والتأديب، بينما يقوم النموذج التحرري على الحوار والمشاركة وطرح المشكلات، كما النتيجة على الطفل، حيث يُقاد نحو التكيف مع القمع، وصمت العقل، وقمع النزعة النقدية، بينما تعزز التربية التحررية الفاعلية الذاتية، والتساؤل، ورؤية العالم كمسار للتغيير.
الأثر الوجداني لعسكرة الفضاء التربوي
إن الآثار المترتبة على عسكرة التعليم ليست مجرد أيديولوجية، بل تتغلغل في التكوين النفسي والاجتماعي للأطفال، خاصة في المراحل المبكرة من النمو، حيث تعتمد البيئة العسكرية على التسلسل الهرمي والامتثال المطلق، ما يتناقض جذريًا مع متطلبات التطور العقلي الصحي. فالمدرسة في هذا السياق تفشل في تعليم الأطفال “كيف نفكر”، وتفرض عليهم “ماذا نفكر”. هذا التركيز على الوحدة السلوكية الموحدة، من خلال الزي العسكري والهتافات الموحدة، يخنق التفكير النقدي في مراحله التكوينية.
أيضًا، تتطلب العملية التعليمية التحررية أساليب كشفية وتفاعلية لغرس القيم، مثل حل المشكلات وتمثيل الأدوار. أما العسكرة، فتفرض أساليب الأوامر والقدوة القسرية، ما يؤدي إلى ضمور القدرات المعرفية التي تعتمد على “الاختلاف والتساؤل والتجريب”. العقل الذي يعتاد على الامتثال السلوكي الموحد (التربية الطائفية مثلاً) يجد صعوبة بالغة في الانخراط في التعددية الفكرية والاجتماعية لاحقًا، ما ينتج أجيالًا مبرمجة للقبول لا للابتكار.
لفهم التأثير الأعمق للعسكرة، يمكن تطبيق النموذج الإيكولوجي الاجتماعي (Social Ecological Model) لعالم النفس التنموي يوري برونفنبرينر. فيما يوضح هذا الإطار كيف أن نمو الطفل يتأثر بـ “الضغوط والدعم المنبعث من بيئات أخرى”. مثلًا، في البيئات العسكرية، يواجه الأطفال تحديات نفسية حقيقية، مثل القلق المتزايد الناتج عن التنقل المتكرر، إلى جانب الصعوبات المرتبطة بالتعايش مع أحد الوالدين المصاب جسديًا أو نفسيًا أو معنويًا. عندما يتم إدخال الطقوس العسكرية (Acculturation and Ritual) إلى المدرسة المدنية، يتحول نظام المدرسة ليصبح امتدادًا لمؤسسة الدولة العسكرية.
هذا الإدماج القسري يعرض جميع الأطفال بشكل اصطناعي لضغوط بيئية قاسية، ويرفع مستوى التوتر المؤسسي العام. يتم إزالة شبكات الدعم المدنية التقليدية، وتصبح البيئة التعليمية مصدرًا مستمرًا للقلق بدلاً من أن تكون ملاذًا آمنًا. وقد أظهرت الأبحاث أن غياب الدعم الأداتي والوجداني يمكن أن يزيد من ضعف الأطفال ويؤثر على قدرتهم على الصمود في مواجهة الضغوط، إذ العسكرة تؤكد على الانضباط الخارجي والمفروض على حساب التطور الوجداني الداخلي.
تنعكس عسكرة البيئة التعليمية بآثار نفسية وتربوية عميقة على النمو المبكر للأطفال. فعلى مستوى النمو العقلي والمهارات المعرفية، تُضعف هذه البيئة القدرة على التفكير النقدي وتُقوِّض مهارات التساؤل وحل المشكلات، إذ تتحول المدرسة إلى ما يشبه “مصنعًا للطاعة”، يُعاد فيه إنتاج التلقين ويُقصى التعلم القائم على التجريب والاكتشاف. أما على صعيد التطور الوجداني والاجتماعي، فتؤدي الممارسات والانضباط العسكري إلى ارتفاع مستويات القلق والتكيف القسري، وإلى تشويه مفهوم الأمان ذاته، لأن الطقوس العسكرية تخلق جوًا ضاغطًا وموجهًا بشكل قسريّ، ما يترك أثره السلبي على الصحة النفسية للأطفال.
وفي ما يتعلق بتكوين الهوية والمواطنة، تُسهم العسكرة في تشكيل “جندي صغير” لا “مواطن حر”، أي فردٍ مُنصاع للأوامر بدلًا من أن يكون فاعلًا وناقدًا ومُسائلًا. فحين تُصادر المدرسة قدرة الطفل على النظر إلى العالم بوصفه مجالًا للتفكير، تصبح الطاعة هي القيمة العليا التي تُبنى عليها شخصيته المدنية.
نحو تربية تحررية
تكمن المقاومة الفكرية لنموذج عسكرة التعليم في العودة إلى الفلسفات التربوية التي تضع تحرير العقل والوعي في صلب مهمتها، وفي مقدمتها فلسفة باولو فريري التي تعلي من قيمة الحوار والوعي النقدي.
تنطلق التربية التحررية من رؤية مفادها أن العلاقة بين المعلّم والطالب يجب أن تقوم على الحوار لا الإملاء. في هذا النموذج، يصبح الحوار جوهر الظاهرة الإنسانية والعملية التعليمية. كما أن إتاحة الفرصة للطلاب في الحوار ومناقشة الأفكار هي أعلى درجات ممارسة التربية التحررية. هذا النموذج يعترف بالمعرفة المسبقة للطالب ويشركه في عملية إنتاج المعرفة، ما يجعله شريكًا فاعلًا لا مستقبلاً سلبيًا.
إن المربي الذي يتبنى هذا النهج يجب أن يكون “حواريًا” (Dialogical) من البداية، ولا يمكن تبرير استخدام الأساليب القمعية أو البنكية كإجراء مؤقت بحجة الضرورة أو المصلحة. هذا تحدٍ مباشر للأنظمة التي تبرر تدجين الأطفال بحجة “الوطنية” أو “الانضباط”. ويقدم فريري بديلاً جذريًا للنموذج البنكي وهو “تعليم طرح المشكلات” (Problem-Posing Education). في هذا البديل، لا يتم النظر إلى المعرفة كوديعة ثابتة، بل كنتيجة لعملية إنسانية إبداعية وخلاقة تتطلب التساؤل والاستقصاء.
الهدف من تعليم طرح المشكلات هو استبدال هدف الإيداع بالهدف الأسمى المتمثل في طرح مشكلات الوجود البشري في علاقته بالعالم. هذا المنهج يعتمد على “الأمل” (revolutionary futurity) في أن الطلاب سيغيرون العالم، بينما النموذج البنكي يسعى فقط لتغيير الناس ليناسبوا النظام القائم. يتطلب هذا المنهج تحويل دور المعلم ليصبح “ميسِّرًا” (Facilitator) للتعلم لا “حارسًا” للأيديولوجيا والسلوك.
إن عملية فك عسكرة التعليم تتطلب إعادة صياغة شاملة لفلسفة المدرسة ذاتها. يجب أن تتحول المدرسة إلى مؤسسة تُحرّر ولا “تُدجّن”، وتُدرِّب التلميذ على الاختلاف، والتساؤل، والتجريب، والربط بين المعارف وواقعه الاجتماعي والسياسي، وأن يُكوَّن الأستاذ تكوينًا عميقًا في علوم التربية يضعه في موقع الميسِّر للمناقشة والبحث. علاوة على ذلك، لا ينبغي أن تقتصر التربية على المواطنة على الدروس النظرية الجافة، بل يجب أن تُدمج كممارساتٍ ميدانية في مراحل مبكرة. ويمكن تحقيق ذلك عبر محاكاة المجالس التمثيلية، وتنظيم المنتديات، وتشجيع النقاش العمومي داخل الفصول الدراسية، كما يجب الاستفادة من الأساليب الكشفية مثل حل المشكلات، وأسلوب تمثيل الأدوار، واللعب، لغرس القيم بطريقة تفاعلية ومناسبة للقدرات العقلية والوجدانية للأطفال.
ثمن الطاعة المصطنعة
لقد كشف تحليل ظاهرة عسكرة التعليم في مصر عن أنها ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي عملية تكريس ممنهج للاستبداد الأبوي عبر المؤسسة التعليمية. إن هذه العملية تعطل التطور المعرفي والوجداني للأطفال وتصادر مستقبل المواطنة الفاعلة لصالح إنتاج جيل من المنفذين المبرمجين. إنها التطبيق الأشد تطرفًا للنموذج البنكي الذي يهدف إلى إنتاج الطاعة المطلقة، ما يلغي الفضاء المدني الفكري اللازم للتساؤل والتحرر. إن الثمن الذي يدفعه المجتمع مقابل هذه الطاعة المصطنعة هو خسارة قدرة الأجيال الناشئة على التفكير النقدي والمساهمة الخلاقة في تغيير واقعهم.
لكن، في النهاية، وبناءً على هذا التحليل الفلسفي والتربوي العميق، يغدو تعزيز مدنية التعليم والتربية التحررية أمرًا حتميًا. يتطلب هذا التوجه الشروع في مسارات استراتيجية تهدف إلى فك الارتباط القسري بين المنطق العسكري والمؤسسة التربوية. أولًا، يجب العمل على الإصلاح التشريعي لوظيفة المدرسة المدنية، عبر سن أطر قانونية واضحة تمنع أي تدخل مباشر للأجهزة العسكرية أو الأمنية في إدارة المدارس أو الإشراف على الأنشطة المنهجية، لضمان أن المؤسسة التعليمية تعمل بالإقناع والحوار لا بالقمع. ثانيًا، يجب تحويل فلسفة المناهج برمتها من التلقين العقائدي الموحد، سواء كان وطنيًا مُعسكَرًا أو دينيًا طائفيًا، إلى نظام تربوي قائم على الحوار والمنطق والتفكير النقدي، لتعزيز الفاعلية الذاتية للطفل. ويتطلب ذلك أيضًا تأهيل الأستاذ ليصبح ميسرًا، عبر تكوينه بعمق في علوم التربية ومنهجية فريري الحوارية، ليفتح آفاق التساؤل بدلًا من أن يكون حارسًا للسلوكيات الموجهة.
كما أن تعزيز التربية الديمقراطية المبكرة لا يمكن أن يتم عبر دروس نظرية جافة، بل من خلال إدماجها كممارساتٍ ميدانية في الفصول الدراسية، تشجع على محاكاة المجالس التمثيلية والنقاش العلني والاختلاف، لتدريب الأطفال على تقبل التعددية الفكرية. وأخيرًا، فإن الهدف الأسمى يبقى هو الاستثمار في التحرر العقلي، عبر خلق بيئة مدرسية تشجع بشكل فعال على “الاختلاف والتساؤل والتجريب”، وهذا المسار وحده هو الشكل الأكثر فاعلية لمقاومة تدجين المؤسسات وإنتاج مواطن فاعل وناقد لا جندي صغير مطيع.