يشهد الوعي الجماعي في الولايات المتحدة تحولًا تدريجيًا لكنه متزايد في طريقة تعاطيه مع القضية الفلسطينية، بفعل تراكم نضالات شعبية وصعود أصوات جديدة تطرح سرديات مغايرة لما كان سائدًا لعقود، فلم تعد فلسطين محصورة في بعدها الجغرافي أو رهينة التناول الإعلامي الموسمي، بل تحوّلت إلى مرآة تعكس تناقضات داخلية في المجتمع الأميركي حول مفاهيم الحرية والمساواة.
وفي الحين الذي تتسارع فيه أدوات القمع لإسكات هذا التحول، تتسع في المقابل دوائر الفهم والتضامن، لتُعيد طرح فلسطين كعلامة فارقة في معركة القيم العالمية، وهذا الحضور وإن كان متناميًا، لا يزال يصطدم بجدران سياسية وإعلامية وثقافية صلبة، تحاول تجريمه أو تشويه أو تهميشه.
في هذا الحوار المطوّل، نرافق البروفيسور كرم دعنا في تحليلٍ واسع لتحولات الرأي العام في الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، ودور الشتات في إعادة صياغة مفاهيم النضال، كما نسلّط الضوء على البُعد البنيوي للنكبة، وعلى التحديات التي تواجه الطلاب الفلسطينيين في الجامعات، ونقف عند المفارقة الكبرى: كيف أصبحت فلسطين، رغم محاولات المحو والتهميش، جزءًا لا يتجزأ من معارك الداخل الأميركي حول الحرية والمساواة؟
كرم دعنا هو أستاذ جامعي فلسطيني-أميركي، يشغل حاليًا منصب “أستاذ أليسون ماكغريغور للتميّز والبحث التحويلي”، وهو أيضًا المؤسس والمدير الأول لـ “معهد أبحاث المسلمين الأميركيين” (American Muslim Research Institute) في جامعة واشنطن بوتل (University of Washington Bothell).
وُلد دعنا في مدينة الخليل بالضفة الغربية ونشأ فيها، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة أواخر التسعينيات، حيث تابع مسيرته الأكاديمية وحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية، مع تركيز على السياسات المقارنة ودراسات الشرق الأوسط.
تتمحور أبحاث دعنا حول عدد من المواضيع المتقاطعة، مثل الإسلاموفوبيا والسياسات التمييزية في أميركا، تقاطعات الدين والعرق والسياسة، والنضال الفلسطيني في الشتات والسرديات العابرة للحدود، والتحولات في الرأي العام الأميركي تجاه القضية الفلسطينية، والعدالة الاجتماعية والتحالفات التضامنية بين الأقليات.
في كتابه الصادر عام 2025، بعنوان: “الوقوف مع فلسطين: المقاومة العابرة للحدود والتطور السياسي في الولايات المتحدة”، يقدم دعنا قراءة معمقة لمسار تطور الخطاب حول فلسطين داخل المجتمع الأميركي، ويستعرض كيف ساهم النشطاء الفلسطينيون في المهجر في بناء حركة تضامن مؤثرة، رغم محاولات الإقصاء والتضييق السياسي.
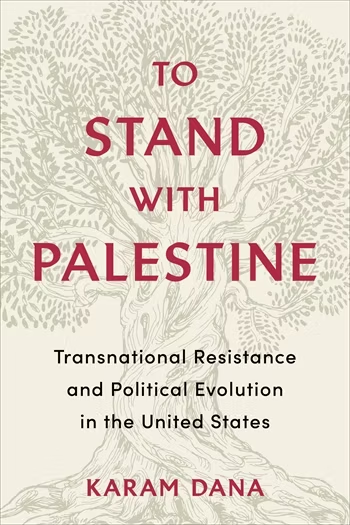
ما الذي دفعك لكتابة هذا الكتاب؟ وما الرسالة التي تأمل أن يتلقاها القرّاء منه؟
أولًا، أنا فلسطيني وُلدت ونشأت في فلسطين، ثم هاجرت إلى الولايات المتحدة في أواخر التسعينيات، وقد لاحظتُ أن فلسطين والفلسطينيين ومعاناتهم لم تكن مفهومة بشكل جيد من قِبل الأميركيين.
لطالما وجدتُ من الغريب أن الأميركيين لا يفهمون جوهر القضية الفلسطينية، وأن السعي لتحقيق العدالة في فلسطين والدعوات الفلسطينية لذلك، لم يُنظر إليها بوصفها سعيًا مشروعًا، بطبيعة الحال.
لذلك، بدأت أتساءل: لماذا؟ وهذا كان أحد الدوافع التي حفزتني لكتابة هذا الكتاب. عملية الكتابة استغرقت وقتًا طويلًا، وكان فيها جانب من التأمل الشخصي، إلى جانب التفاعل مع طيف واسع من القضايا.
الدافع الآخر هو أنني لاحظتُ وجود تغيير في طريقة تناول قضية فلسطين ومعاناة الفلسطينيين في الولايات المتحدة، خصوصًا خلال الخمسة عشر إلى العشرين عامًا الماضية، وازداد زخمه مع الوقت، ووجدت في ذلك شيئًا جديرًا بالتفسير والتوثيق.
ومن الناحية المهنية، أنا أدرس العرب الأميركيين وكيف تتم “عنصرتهم” (أي معاملتهم كجماعة عرقية) داخل السياق الأميركي، سواء كانوا عربًا أم مسلمين، وهذا أتاح لي أن أفهم المشهد السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة، وأتأمل كيف يمكن دراسة جماعة كالفلسطينيين الذين يُنظر إليهم من خلال عدسة عنصرية أو بوصفهم “هوية قومية إشكالية”.
إذن، هذه مجموعة من الدوافع التي اجتمعت معًا. أما عن الشق الأخير من سؤالك، المتعلق بما أرجو أن يحصل عليه القارئ من هذا الكتاب، فأعتقد أنني أقدّم إجابات لأسئلة يطرحها كثيرون، مثل: لماذا لم يكن الأميركيون يفهمون القضية الفلسطينية سابقًا؟ ولماذا نشهد الآن تغيرًا؟ وما الذي تغيّر بالضبط؟. ومن هنا، أقدّم تحليلًا شاملًا وسلسلة من الأسئلة العميقة التي تتناول هذه القضية.
برأيك، ما هو أكثر ما يُساء فهمه في السردية الفلسطينية؟
الأمر المثير للاهتمام هو أن الثقافة الأمريكية، عمومًا، تتبنّى فكرة الوقوف إلى جانب الضعفاء، أو كما يُقال: “الوقوف مع الطرف الأضعف”. فهناك ذلك التصوّر الأمريكي حول الإنسان العصامي، الذي يشق طريقه من القاع إلى القمة. الأميركيون يفخرون كثيرًا بهذه الصورة، وهي جزء من سرديتهم الوطنية، ولو تأملت في الأفلام، ستلاحظ أن الجمهور الأمريكي، ثقافيًا، يميل للتعاطف مع الشخصيات التي لا تملك السلطة.
لكنني شعرت دائمًا أن هذا لا ينطبق، بشكل واضح، عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين. والسؤال هو: لماذا؟ هناك أسباب عديدة لذلك، لكن في جوهرها، أعتقد أن المسألة تتعلّق بمفهوم الاستشراق، كما طرحه المفكر إدوارد سعيد عام 1978-1979. الاستشراق هو عدسة فكرية ينظر من خلالها الغرب إلى العالم العربي والإسلامي، إلى المسلمين والفلسطينيين. هذه العدسة تنتج تصوّرات مشوهة وسلبية، وتُنتج صورًا نمطية متجذرة في الثقافة والسياسة الغربية.
وهذا ما يجعل الفلسطينيين يُساء فهمهم. وهذه فقط واحدة من بين أسباب عديدة. كما أن ما يُحيرني شخصيًا هو أنه لو استُبدلت كلمة “فلسطيني” بأي جنسية أخرى في أي سياق يتعلّق بالعدالة، ستجد تعاطفًا، لكن عندما يتعلق الأمر بفلسطين، لا يهم ما إذا كان الشخص يمينيًا أو يساريًا، فالموقف غالبًا ما يكون سلبيًا. إنها ما يُعرف بـ”الاستثناء الفلسطيني”.
كثير من الباحثين أشاروا إلى هذه الظاهرة: أن تكون تقدميًا في كل القضايا، من حقوق الإنسان إلى النضالات ضد الاستعمار، ما عدا فلسطين. وهناك عدد لا حصر له من الأمثلة على الطريقة التي يُصوَّر بها الفلسطينيون، وتُشوَّه قضيتهم، وكيف يُوصم المدافعون عن حقوقهم بالإرهاب.
أعتقد أن هذه بعض من المفاهيم الخاطئة السائدة. وقد شعرت دائمًا أنه لو عرف الناس الحقيقة، لو نظروا إلى التاريخ كما هو، لكان تعاطفهم مع الفلسطينيين أكبر، لأن ما يطلبه الفلسطينيون ببساطة هو المساواة في الحقوق، وأن يُعاملوا بكرامة. وأعتقد أن هذه القيم، في العمق، تلامس القيم الأمريكية العامة. بالطبع، هناك سياق سياسي معقد يعمل في الخلفية ويحول دون ذلك، لكنني مقتنع أنه إذا فهم الأمريكيون الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون يوميًا، فإن نظرتهم للصراع ستتغيّر.
ومن الأمثلة اللافتة في هذا السياق أن معظم الأميركيين يعرفون من هو المسيح، أليس كذلك؟ يعرفون قصته، لكنهم لا يعرفون أن بيت لحم، حيث وُلد، تقع في فلسطين، وهي مدينة فلسطينية عربية مسيحية. هذا الجزء من الرواية غائب تمامًا عن المخيلة الأميركية تجاه الفلسطينيين، وهذا غياب قوي ومؤثر.
من المدهش أن تبني هويتك على قصة دينية مركزية، ومع ذلك تُقصي جزءًا أساسيًا منها، فكيف يتعاطف الأمريكيون مع المسيحيين حول العالم، لكن لا يفعلون ذلك مع المسيحيين الفلسطينيين؟ هذا أيضًا مثير للاستغراب.
لذلك أعتقد أن هناك تداخلًا لعدة عوامل، لكن في النهاية، الأميركيون يرون أنفسهم أو يحبون أن يروا أنفسهم كـ”أناس طيبين”، أما على مستوى الحكومة، فهذه قصة أخرى تمامًا. فالتعاطف كان غائبًا منذ فترة طويلة، وأعتقد أن هذه واحدة من أكبر المفاهيم الخاطئة التي لا تزال قائمة حتى اليوم.
ناقشتَ في كتابك تحوُّل السردية حول فلسطين و”إسرائيل” في الولايات المتحدة خلال العقدين الأخيرين.. فهل يمكنك أن تحدد لنا التغييرات التي لاحظتها؟
نعم، أول ما يمكن ملاحظته هو أنه عندما كانت تُذكر فلسطين في السابق، كان يتم تجاهلها تمامًا، وتجريدها من الشرعية، ولم تكن تؤخذ على محمل الجد بأي شكل من الأشكال. وأي شيء سلبي يحدث للفلسطينيين، كان يُبرَّر ويُصوَّر على أنه أمر مشروع. فمثلًا: كان يُقال إن ادعاء الفلسطينيين بأحقيتهم في الأرض غير شرعي، وأن هذه الأرض تعود “للشعب اليهودي”، دون التفكير – ولو نظريًا – بأن هناك أناسًا يعيشون في فلسطين منذ زمن طويل، بعضهم كانوا من اليهود، وبعضهم من المسلمين والمسيحيين، وكلهم لديهم ارتباط تاريخي وثقافي عميق بالأرض.
لكن ما تغيّر هو أن التعاطف مع الفلسطينيين بدأ بالظهور تدريجيًا، وخصوصًا خلال الـ15 إلى 20 سنة الماضية، وإن كان هذا التحول بدأ يتشكل قبل حوالي 25 عامًا. أصبحنا نرى تحوّلًا في طريقة الحديث عن فلسطين في المجال العام الأمريكي.
من الملاحظات المهمة أن النظرة النمطية القاطعة بأن “الفلسطينيين إرهابيون، ولا يمكنهم أن يقدموا أي رواية تُعتبر شرعية” قد بدأت تتغيّر. وهذا بحد ذاته تغيير جوهري. كما أصبح هناك ميل لفهم معاناة ونضال الفلسطينيين من خلال مقارنتها بنضالات شعوب مضطهدة أخرى، وهو منظور أكثر قبولًا ثقافيًا داخل المجتمع الأمريكي.
ولا يعني هذا أن حركات التحرر، مثل حركات السود في الولايات المتحدة، لم تفكر في فلسطين سابقًا؛ فقد فعلت ذلك بالفعل وعبّرت عنه، لكن لم يكن ذلك واضحًا في المجال العام كما هو اليوم. ولذلك أقول إن التغير الأكبر لم يحدث في السياسات الرسمية، بل في المجال العام والثقافة الشعبية، حيث باتت تظهر سرديات بديلة تتناول فلسطين بشكل أوسع وأكثر تعاطفًا.
ومن المثير للاهتمام أن كلما تم استبدال “فلسطين” بـ”إسرائيل” في الخطاب العام، كانت النتيجة في الواقع هي تسليط الضوء أكثر على فلسطين. إن محاولة محو فلسطين تُبرز وجودها بقوة. هذه حقيقة بسيطة لكنها قوية جدًا: حين تحاول أن تشرعن طرفًا عبر محو الطرف الآخر، فأنت في الحقيقة تثير الانتباه إلى الطرف الذي تحاول محوه.
إنها عمليًا وجهان لعملة واحدة: كيف تعرّف إسرائيل وشرعيتها يعني أيضًا كيف تُعرّف فلسطين أو تُنكرها. سواء أعجبنا ذلك أم لا. ومن هنا، أرى أن التحول الكبير هو أن هذه الثنائية أصبحت تُطرَح وتُناقَش، وأصبح من الشائع سماع كلمة “فلسطين” في الخطاب الأمريكي، خصوصًا على وسائل التواصل الاجتماعي، التي لعبت دورًا كبيرًا خلال السنوات الـ25 الأخيرة في تحفيز هذه المحادثات، حتى بات الحديث عن فلسطين أقرب إلى التيار العام في بعض الأوساط، بل وأصبحت فلسطين في صلب النقاشات السياسية والثقافية الأمريكية.
لطالما كنت أقول إن قضايا كثيرة في السياسة الأمريكية مرتبطة بشكل عميق بالقضية الفلسطينية، والناس بدأوا فقط الآن يكتشفون ذلك، رغم أن العلاقة كانت قائمة منذ زمن بعيد، فإذا أردت أن تتناول قضايا مثل حرية التعبير أو العدالة القانونية في الولايات المتحدة، لا بد أن تمر بفلسطين، شئت أم أبيت.
هناك أيضًا تغير ملحوظ في الخطاب الأكاديمي، حيث أصبح هناك عدد أكبر من الأصوات التي تكتب وتدرّس عن فلسطين، أكثر بكثير مما كان عليه الحال قبل عشرين عامًا. آنذاك، كان مجرد ذكر كلمة “فلسطين” في الجامعة كفيلًا بإثارة الريبة. أما اليوم، فإن ذكر فلسطين يُربط بالدفاع عن حقوق الإنسان، وبالسياسات الإنسانية.
إذن، نحن نشهد تحولًا في الخطاب، وتغيّرًا في الرواية، وفي الطريقة التي يُنظر بها إلى القضية الفلسطينية. وأيضًا، هناك فهم أوسع لماهية الصهيونية، وزيادة في الوعي والتعليم حولها. وهذا التغير يمكن رصده من زوايا متعددة، لكن أبرز مؤشر عليه هو أن فلسطين باتت حاضرة بشكل إيجابي أكثر في الفضاء العام، وهذا بحد ذاته تطورٌ لافتٌ ومهم.

حسنًا، إذن أنت تقول إن جزءًا كبيرًا من هذا التحول مرتبط بالتعاطف؟
حسنًا، نعم، التعاطف جزء من الأمر، لكنه أيضًا مرتبط بازدياد الوعي والتعليم. لذا، على سبيل المثال، هذا هو جوهر الكتاب بأكمله، لأشرح الفكرة بشكل شامل، هذه هي الركائز الأربع التي يقوم عليها كتابي، والتي أعتقد أنها تفسر تحوّل السردية حول فلسطين:
أولًا، الفلسطينيون أنفسهم أعادوا صياغة فهمهم لنضالهم. على سبيل المثال، بعد الانتفاضة الثانية، وخلالها، تعرض الفلسطينيون لعنف هائل وقمع شديد. وأدركوا حينها أنهم لا يستطيعون الانتصار عبر الحرب التقليدية أو الصراع العسكري المباشر.
ومن هذا الإدراك، ظهرت مبادرات مثل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وكانت بمثابة نداء مفتوح إلى العالم، تقول فيه: “نحن لا نستطيع المواجهة وحدنا. نحتاج إلى دعم الضمائر الحية في العالم. نحتاج منكم أن تساعدونا في الدفاع عن فلسطين.”
ثانيًا، لعب الفلسطينيون في الشتات دورًا مهمًا في تغيير السردية، فهناك أجيال من الفلسطينيين الذين استقروا في دول مختلفة، بما فيها الولايات المتحدة، وهذا الانتشار أدى إلى حضور فلسطيني في الفضاءات العامة، السياسية والثقافية.
نحن نتحدث الآن عن الجيل الثاني والثالث، بل ربما الرابع، من الفلسطينيين في أمريكا، الذين أصبحوا أكثر قدرة على التعبير عن القضية الفلسطينية، والدفاع عنها، وإنتاج سرديات جديدة ومؤثرة عنها. هذه القوة الفلسطينية الخارجية، من داخل المجتمعات الغربية، ساهمت في تحويل فلسطين إلى قضية قابلة للنقاش والتعاطف، لا مجرد ملف صراع بعيد.
ثالثًا: ظهور الإنترنت، وهو عامل عالمي لكنه بالغ الأهمية، لأن هذا الاختراع لم يوفر فقط محتوى جديدًا، بل منح الناس قدرة غير مسبوقة على إيجاد بعضهم البعض والتواصل والتنظيم. في البدايات، كان المحتوى موجودًا، لكنه يصعب العثور عليه، ثم تطورت محركات البحث، وأصبح الوصول إلى المعلومة أسهل، ثم جاءت وسائل التواصل الاجتماعي، التي مثّلت قفزة جديدة؛ حيث أصبح بإمكان الناس بناء مجتمعات افتراضية وتبادل الروايات والتضامن والتعبئة الجماهيرية على نطاق واسع.
رابعًا: العامل الأميركي الداخلي، والذي يرتبط بتحولات في الداخل الأميركي نفسه، فمثلًا، في أواخر التسعينيات، بدأت ظاهرة عنف الشرطة تأخذ شكلاً جديدًا، وظهر مستوى غير مسبوق من “عسكرة الشرطة”، خاصة خلال احتجاجات منظمة التجارة العالمية في سياتل في نوفمبر عام 1999.
في ذلك الوقت، نزل عدد كبير من النشطاء إلى شوارع سياتل للاحتجاج على الاجتماع الذي ضم ممثلين من مختلف دول العالم لمناقشة قضايا “حرية التجارة”، بينما كان النشطاء يطالبون بـ”العدالة في التجارة”، وشارك حينها في الاحتجاجات نشطاء من قضايا بيئية وغيرها.
من هذه اللحظة، نشأ ما يمكن تسميته بـ”مبرر عام” لعسكرة الشرطة، فقد تمت مواجهة الاحتجاجات آنذاك بعنف غير مسبوق، إذ بدا أن الدولة بدأت تتبنى مقاربة جديدة في استخدام القوة الأمنية. وبالطبع، لا يعني هذا أن عنف الشرطة لم يكن موجودًا قبل عام 1999، فحركة الحقوق المدنية الأمريكية مليئة بأمثلة على ذلك، لكن ما تغيّر هو مستوى القوة الممنوحة للشرطة.
أصبح هناك نوع من الانفصال بين الدولة والمجتمع الأمريكي، إذ بات واضحًا أن الحكومة وقوات الشرطة قادرة على ممارسة العنف بصور لا تحظى بقبول مجتمعي واسع، وهذا ما خلق انقسامًا حقيقيًا داخل المجتمع، بغض النظر عن الانتماء الأيديولوجي، يمينًا كان أم يسارًا. هذا الانقسام، لاحقًا، تجلّى في مواقف أوسع، وفتح المجال لطرح تساؤلات أعمق حول الدولة والعنف والقانون، وهو ما ساعد بشكل غير مباشر على إعادة التفكير في قضايا مثل فلسطين والعدالة العالمية.
جانب آخر مهم من هذا التحول يرتبط بالدين في الولايات المتحدة، وبشكل أكثر تحديدًا بالصهيونية المسيحية. هذا التيار، المنتشر خصوصًا بين الإنجيليين البروتستانت، يحمل رؤية لاهوتية تؤمن بأن عودة اليهود إلى “أرض إسرائيل” شرطٌ مسبق لعودة المسيح ونهاية الزمان، أي أن دعم إسرائيل ليس سياسيًا فحسب، بل مرتبط بعقيدة دينية ونبوءة آخر الزمان.
ومن أبرز من روّج لهذه الرؤية هو القس واللاهوتي جون هيغي (John Hagee)، الذي كتب عن حرب كبرى ستقع كجزء من تحقيق نبوءة نهاية العالم. بناءً على هذا الاعتقاد، كان دعم إسرائيل بين قطاعات واسعة من المسيحيين الأميركيين مبررًا دينيًا ووجوديًا، لكن هذه الرواية بدأت تضعف مع تراجع حضور الكنائس وانخفاض نسب الممارسين على مدار الثلاثين إلى الأربعين عامًا الماضية.
ووصل الأمر إلى نقطة أصبح فيها ذلك الخطاب (الصهيوني المسيحي) أقل تأثيرًا بكثير مما كان عليه في السابق، مما أضاف طبقة جديدة من التحوّل. وبالإضافة إلى ذلك، برزت حركة “حياة السود مهمة” (Black Lives Matter)، والتي ساهمت بشكل خاص في تقديم تعريفات جديدة لمفهوم العدالة والمساواة.
ومع أن حركة الحقوق المدنية كانت ولا تزال مهمة ومحورية، فإنها سلطت الضوء على حقيقتين مهمتين: أن هذا نضال عابر للحدود القومية (transnational struggle)، وأنه رغم وجود مساواة قانونية ظاهرية بين الأشخاص سواء كانوا سودًا أو بيضًا أو آسيويين أو عربًا، فإن ذلك لا يعني أن المؤسسات الرسمية في الدولة تُمارس هذه المساواة فعلًا، وهو ما يتجلّى في عنف الشرطة ضد السود، مثلًا.
نتيجة لذلك، بدأت تظهر في الولايات المتحدة مفاهيم جديدة حول ما تعنيه العدالة، وما يعنيه أن تكون جزءًا من المجتمع، وأن تنال مساحة من المساواة والاحترام. ويمكن أيضًا الإشارة إلى حملات مشابهة، مثل “أوقفوا كراهية الآسيويين” (End Asian Hate)، والتي لعبت دورًا موازيًا في توسيع هذه المفاهيم.
وفي النهاية، فإن تراكب هذه العوامل ساهم في فتح مساحة جديدة داخل المجتمع الأمريكي لفهم القضية الفلسطينية بشكل أعمق وأكثر تعاطفًا مما كان عليه في السابق ضمن هذه الشبكات الأوسع من الظلم البنيوي.
إلى جانب حركة “حياة السود مهمة” والمجتمعات المناضلة الأخرى في الولايات المتحدة، كيف أسهمت هذه التقاطعات في خلق تضامن أوسع مع فلسطين، لا سيما من قِبل النشطاء اليهود الأميركيين؟
نعم، أعتقد أن هذه نقطة مهمة تطرحها، وقد كتبت عنها باستفاضة في الكتاب. في التسعينيات تحديدًا، ظهر ما يُعرف بـ”المؤرخين الجدد”، وهم مجموعة من المؤرخين الإسرائيليين الذين كانوا يعملون ضمن الأوساط الأكاديمية داخل إسرائيل. وقد أُتيح لهم الوصول إلى الأرشيفات الرسمية، فبدأوا بكتابة أبحاث وكتب عن أحداث عام 1948، وعن النكبة، استنادًا إلى وثائق وأدلّة لم تُكشف من قبل.
وهكذا، بدأ السرد الرسمي لدولة إسرائيل يتعرض للتحدي من قِبل باحثين إسرائيليين يهود أنفسهم، لكن وفي الوقت ذاته، داخل السياق الأمريكي، برزت أصوات نقدية من يهود أمريكيين أيضًا، وهذا العدد في تزايد مستمر، سواء على مستوى الأكاديميين أو الناشطين، بل وحتى بعض الحاخامات، وهو أمر لافت.
وهذا الحضور المتنامي خلق اليوم في الولايات المتحدة حالة من الصراع الداخلي بين تيارين داخل المجتمع اليهودي: تيار يريد الحفاظ على الوضع القائم فيما يخص إسرائيل ودعمها، وتيار يهودي أمريكي آخر يقول بوضوح: “هويتي لا تتطلب مني أن أرتبط بالصهيونية أو بإسرائيل، وكوني يهوديًا لا يعني أنني أؤيد انتهاك حقوق الإنسان”. وهذا تحول بالغ الأهمية.
على سبيل المثال، ظهرت منظمات مثل “يهود من أجل السلام” (Jewish Voice for Peace)، وهي منظمة تدافع عن حقوق الفلسطينيين، وهناك أيضًا منظمة “If Not Now”، بالإضافة إلى منظمات أخرى مماثلة.
وبالإضافة إلى هذا الحراك، هناك أيضًا تحولات ثقافية داخل الولايات المتحدة حول مفاهيم مثل “الاندماج” و”المساواة”. قبل نحو 15 سنة، على سبيل المثال، لم يكن زواج المثليين مقبولًا على نطاق واسع، أما اليوم فقد أصبح أكثر قبولًا،
أي أن هناك مساحة أكبر اليوم لظهور أفكار جديدة داخل المجتمع الأميركي، وهذه التحولات شكّلت الوعي السياسي والاجتماعي لدى جيل الشباب.
وهنا نقطة مهمة: جيل الشباب الأمريكي اليوم أكثر تقدمية، وأكثر انفتاحًا، وأكثر تنوعًا عرقيًا وثقافيًا من الأجيال السابقة، وهو جيل يرى العالم من منظور عالمي. شخص في سيول (كوريا الجنوبية) قد يستطيع اليوم فهم شخص في مكسيكو سيتي أو أوتاوا أو جوهانسبرغ، بشكل أفضل مما يستطيع شخص أكبر سنًا في بلده أن يفعل.
لذلك، هذا الجيل الشبابي، وهنا لا أتحدث عن العمر فقط، بل عن الروح العامة، أصبح أكثر وعيًا بمفاهيم العدالة والمساواة، وأكثر انخراطًا في النضالات التي يشعر أنها تعبّر عنه. وبناءً على ذلك، بدأ هذا الجيل يتفاعل ويتحرك سياسيًا حول قضايا يراها محورية، مثل فلسطين.
وهكذا، كل هذه التحولات، سواء في السرد الفلسطيني، أو في الحراك الشبابي، أو في التأثيرات الأكاديمية والدينية، اجتمعت لتخلق واقعًا جديدًا، حيث بات التعاطف مع الفلسطينيين أكثر وضوحًا وانتشارًا داخل المجتمع الأميركي، لكن وبالطبع، كلما زاد هذا التعاطف، كلما ظهرت قوى مضادة تسعى للرد والضغط والاحتواء. إنها معركة متصاعدة.
والتنبؤ الذي أقدمه في الكتاب هو أن هذه المواجهة في تصاعد مستمر، ويمكننا أن نرصد ذلك بوضوح في السنوات العشر الماضية على الأقل داخل الولايات المتحدة، وأعتقد أننا اليوم نعيش ذروة هذا التصاعد، وهي مرحلة ستشهد المزيد من المواجهة بين خطاب التضامن مع فلسطين، والقوى التي تريد الحفاظ على الوضع القائم.
بما أننا نتحدث عن ذلك، متى سيكون لدينا لوبي فلسطيني قادر على مجاراة قوة اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة؟
هذا سؤال مثير للاهتمام، لأنه من الأمور التي كنت أفكر فيها كثيرًا: هل المسألة تتعلق فقط بـ”اللوبي”؟ أعني، هل الأمر يقتصر على الضغط السياسي؟ نعم، من المؤكد أن وجود لوبي أمر مهم، لكن إذا كنت تمارس الضغط وتحاول إقناع الناس بسردية يصعب عليهم فهمها، فلن تحقق أي تقدّم.
لذلك، نجد أن السردية الصهيونية تُقدَّم بشكل يسهل قبوله داخل الثقافة الأميركية: “أميركا مبنية على القيم المسيحية، وهذه القيم قريبة من اليهودية، وهناك ما يُعرف بالتقاليد اليهودية المسيحية المشتركة.” وهكذا، تصبح القصة أكثر تقبّلًا، لكن جزءًا كبيرًا من المشكلة هو الطريقة التي تم بها “تجريم” العرب والمسلمين وتصويرهم كغرباء، هذا ما يجعل من السهل إقصاؤهم ورفض روايتهم.
الآن، أنت تسألني: متى سيكون هناك لوبي فلسطيني قوي قادر على تغيير السياسة؟ لا أعرف. صراحةً، من الصعب تحديد ذلك. وربما لا يكون “اللوبي” وحده هو الحل لما نواجهه عالميًا، لكنني أعتقد أيضًا أن تغيّر الرأي العام يؤدي في النهاية إلى تغيّر السياسات، ففي نهاية المطاف، السياسة تابعة للرأي العام. وإذا بدأ الناس في تغيير مواقفهم، فإن السياسة ستلحق بهم.
ومؤخرًا، منذ بضعة أسابيع فقط، ظهرت بيانات جديدة تُظهر أن عدد الأميركيين المتعاطفين مع الفلسطينيين تجاوز لأول مرة عدد المتعاطفين مع إسرائيل. وهذا يحدث لأول مرة في التاريخ. نحن إذن نتجه في هذا المسار. وإذا لم يستجب السياسيون لما يطلبه ناخبوهم، فإنهم سيفقدون مواقعهم في نهاية المطاف، وسيحل مكانهم سياسيون أكثر انسجامًا مع توجهات الناس. وبالتالي، ستدخل الرواية الفلسطينية المشهد السياسي من هذا الباب.
وأود أن أضيف هنا شيئًا مهمًا، عندما نتحدث عن “اللوبي”، غالبًا ما نفكر فقط في الذهاب إلى “الكونغرس” أو “كابيتول هيل” والتحدث إلى النواب، لكنني أرى أن “الضغط” يشمل أيضًا أشكالًا أخرى من المناصرة، مثل الحديث عن المساواة والحقوق الفلسطينية، وهذه بدورها شكل من أشكال الضغط أيضًا.
وأعتقد أيضًا أن وجود شخصيات عامة مثل جيجي حديد، وبيلا حديد، ووالدهما محمد حديد، وهم مؤثرون في عالم الموضة ولديهم شهرة عالمية. هؤلاء عندما يتحدثون عن فلسطين، فإنهم يساهمون في تغيير الرأي العام. أنا لا أقول إن كل شخص يجب أن يكون مثل جيجي حديد حتى يؤثر على السياسة، ليس هذا ما أعنيه، لكنني أؤمن بأن من لا علاقة له بفلسطين إطلاقًا، إذا سمع القصة بصدق، فإن ذلك يُحدث فرقًا ويُغيّر وجهة نظره.
أما عن سؤال: “متى سيحدث ذلك؟” فهو سؤال وجيه، لكنني أؤمن تمامًا بأن العدالة للفلسطينيين ستتحقق في نهاية المطاف، وأتمنى أن يتم ذلك بطريقة سلمية، حيث تسود المساواة، ويصبح معيار الحقوق هو العدل، لا الامتياز أو التفوّق.
أن نخلق عالمًا يُعامل فيه الناس بمساواة، ويحصل فيه الجميع على حقوقهم، ولا تكون هناك جماعة متميزة على حساب الأخرى. هذا هو الهدف. وأعتقد أننا نسير في هذا الاتجاه. لا يمكن تجاهل العدالة إلى الأبد. هذا لم يحدث يومًا ولن يحدث. ولو علّمتنا التجربة التاريخية شيئًا، فهو أن تجاهل مطالب الشعوب بالعدالة لا يدوم.
في إحدى محاضراتك، أشرتَ إلى أن النكبة واتفاقيات أوسلو كانتا تهدفان إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني، لكن النتيجة كانت عكسية. هل يمكنك أن تشرح كيف ولماذا حافظ المجتمع الفلسطيني على صموده رغم هذه المحاولات؟ وفي ضوء ذلك، هل تعتقد أن الإبادة الجارية في غزة تترك أيضًا أثرًا دائمًا، وربما تحويليًا، على المجتمع الفلسطيني ككل؟
هذا سؤال بالغ الأهمية، وأعتقد أنه في جوهره يصل إلى لبّ هذه المحادثة كلّها.
في عام 1948، خلال النكبة، تم تدمير المجتمع الفلسطيني عمدًا. تم تفكيكه وسحقه بشكل متعمّد، فما بين 750 ألف إلى 900 ألف فلسطيني أصبحوا لاجئين، ليس فقط في الدول العربية المجاورة، بل أيضًا في أماكن مختلفة حول العالم.
ما حدث فعليًا هو أن إسرائيل، من حيث لا تقصد، خلقت مجتمعًا فلسطينيًا خارج فلسطين، ومن قلب هذه الكارثة، برزت فرصة؛ فجأة بدأ الفلسطينيون في الشتات يتواصلون ويتحدثون مع بعضهم البعض، ليس بالضرورة في إطار تنظيمي، بل كنتاج طبيعي لحياتهم في أماكن متعددة حول العالم، وشعورهم بضرورة الحفاظ على هويتهم.
أنا أجادل بأن الهوية الفلسطينية لم تعد مرتبطة فقط بالجغرافيا. نعم، لا شك أن فلسطين كأرض مركزية في الهوية، لكن اليوم، هذه الهوية باتت عابرة للحدود، وتنتشر في فضاءات متعددة، وهو أمر قوي ومؤثر.
إذا كانت إسرائيل تستطيع أن تسيطر على الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، أو داخل أراضي 48، وأن تسجنهم وتفرض عليهم الحواجز وتراقبهم… فإنها لا تستطيع فعل ذلك مع كل الفلسطينيين المنتشرين خارج فلسطين. ربما يمكنها السيطرة على الجغرافيا، لكن هناك قوى فلسطينية خارجية تضغط على ممارسات إسرائيل من الخارج.
أما اتفاق أوسلو، فقد خلق انقسامات داخل المجتمع الفلسطيني، للأسف، ليس فقط على المستوى السياسي، بل الجغرافي أيضًا. اليوم، لتنتقل من رام الله إلى نابلس أو من رام الله إلى بيت لحم، هناك حواجز تقطع الطريق. هذا التعقيد في الحياة اليومية هو أحد منتجات أوسلو. لكن، ما أثر كل ذلك على المجتمع الفلسطيني؟ المثير للاهتمام هو أن “الصمود” بات في صميم الهوية الفلسطينية. مهما كانت الظروف قاسية، يبقى الفلسطينيون، ويتمسكون بهويتهم، ويواصلون التعبير عن أنفسهم.
بل إن الفلسطيني أصبح رمزًا عالميًا للمظلومين، من تعرضوا للتجريد من إنسانيتهم، للشيطنة، للتهميش عبر التاريخ، ومع ذلك يستمرون في البقاء والصمود.
أما بالنسبة للإبادة الجماعية في غزة، فهل غيرت من شكل النقاش؟ الإجابة: نعم، بشكل كامل، وليس فقط داخل فلسطين أو في أراضي 48 أو الضفة أو غزة، ولا حتى فقط في المخيمات بالدول العربية المجاورة، بل أيضًا في الشتات الفلسطيني العالمي.
بل أوسع من ذلك، لقد أثرت هذه الإبادة في معنى “الإنسانية” نفسها. لقد كشفت هذه الإبادة عن البنية الاستعمارية التي تمنح امتيازات لفئات معينة من البشر (البيض، الغربيين، الأوروبيين)… مقابل إقصاء آخرين (البُنيّين، أبناء الجنوب العالمي).
هذا ليس مقارنة صارمة أو بسيطة، لكن السؤال واضح: هل حياة من يعيش في الجنوب العالمي تُعادل حياة من في الشمال العالمي؟ وما يجري في غزة كشف التمييز الممنهج بأبشع صوره، وفضح المعايير المزدوجة بطريقة قاسية وصريحة. وهذا أثر على كيفية تفكير الناس في العالم بمفهوم “العدالة” و”الكرامة الإنسانية”.
وأعتقد أن هناك لحظة حساب قادمة، حيث سيقول كثيرون: “ما كان ينبغي أن يحدث هذا”، لكن للأسف، بين الآن وتلك اللحظة، سيُزهق مزيد من الأرواح، وسنشهد مزيدًا من الدمار. إنها إبادة موثّقة بطريقة غير مسبوقة في التاريخ. يُبث كل شيء حيًّا، الناس ترى، ومع ذلك لا يتحرك أحد.
وفي النهاية، سيُقاس مفهوم “الإنسانية” لدينا على ضوء هذه الإبادة. ولا أقصد بـ”المجتمع الدولي” هنا الغرب فقط، بل العالم بأسره. سيتوجب على الجميع أن يعترف: “فلسطين هي المعيار الذي تبدأ عنده إنسانيتك”.
هذه أسئلة صعبة، وقد لا تحدث إجاباتها الآن، وربما تحدث الآن فعلًا، لكنها ستصبح في النهاية مركز النقاش العالمي حول المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية.
بالانتقال إلى الحملة التي شنتها إدارة ترامب ضد الجامعات، كيف تنظر إلى اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، خاصةً من موقعك كأستاذ جامعي؟ وما أكثر ما أثار قلقك في قضيته، وفي التوجه الأوسع نحو تعليق أو إلغاء تأشيرات الطلاب؟
هذه المسألة جزء أساسي من النقاش الدائر اليوم. لطالما كانت الجامعات الأميركية مساحة مركزية لحرية التعبير لعقود طويلة، وكانت تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التغيير داخل المجتمع، لكن حين يتعلق الأمر بملاحقة النشطاء الفلسطينيين أو المؤيدين لهم، فالأمر أصبح مخيفًا، فالجامعة كانت دومًا تُعتبر فضاءً آمنًا للتعبير عن الأفكار والنقاش،
لكن حين يُختزل أي نداء بالمساواة للفلسطينيين في أنه دعوة لقتل اليهود، فنحن أمام مشكلة حقيقية.
وهذه المشكلة متعددة الطبقات: أولًا، علينا أن نطرح سؤالًا: ما الفرق بين معاداة السامية وانتقاد الصهيونية؟ هل يمكن أن تكون ضد الصهيونية أو ضد سياسات إسرائيل من دون أن تُتهم بمعاداة اليهود؟
هذه ليست قضية محمود خليل فقط، أو الطلاب الذين أُلغيت تأشيراتهم، بل هي قضية تتعلق بمدى سماح المجتمع للنقاش والحوار بين وجهات نظر مختلفة، تستند إلى الوقائع والمنطق. هل يمكن للناس أن يختلفوا بحرية، أم أن ذلك لم يعد مقبولًا؟
هذه مسألة تتعلق بحرية التعبير، وحرية التعبير تُعتبر، كما نعرف، من أقدس القيم في الثقافة الأميركية، فإذا فُقدت هذه القيمة، فلدينا أزمة حقيقية. لكنني أود أن أقول أيضًا، إذا أردنا اليوم أن نحافظ على حرية التعبير في الولايات المتحدة، فعلينا أن نُعيد النظر في كيفية الحديث عن فلسطين. كيف نتناولها في الجامعات، في الصحف، في وسائل الإعلام، في الثقافة الشعبية؟
وهناك جانب آخر لا يقل أهمية، هذه الإجراءات تهدف إلى التخويف والترهيب. وهي تحمل تبعات واقعية خطيرة؛ طلاب قد يخسرون تعليمهم، أعمالهم، حتى بيوتهم، وحياتهم تتدمر. أنا لا أُهوّن من حجم الأزمة، بل أقول إن هناك محاولات مستمرة للتصدي لها، قانونيًا ومجتمعيًا.
وبرأيي، هذه السياسات التي تنتهجها إدارة ترامب، والتي تمثل تيار اليمين المتطرف، تواجه اليوم حالة من التعبئة في الاتجاه المعاكس، لكن المشكلة في أميركا اليوم، هي الاستقطاب الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين. والمؤسف أن الحزب الديمقراطي لم يفعل شيئًا يُذكر بخصوص فلسطين أو الإبادة الجارية في غزة.
ومع ذلك، أعتقد أن هناك تحولًا يجري. هناك طعون قانونية، وهناك حراك شعبي. فهل يُشعرني ذلك بالأمل؟ أنا متشائم ومتفائل في آنٍ معًا، وهذا شعور متناقض، لكنّه واقعي، لأنه، ببساطة، لن يتغير شيء قبل أن نصل إلى نقطة الغليان. وهذه حقيقة مؤلمة.
تُقال عبارة شهيرة: “في البداية يتجاهلونك، ثم يسخرون منك، ثم يحاربونك، ثم تنتصر”. ما يحدث اليوم في الجامعات الأميركية هو المرحلة الثالثة: المقاومة والرد العنيف، مما يعني أن الحراك الفلسطيني بدأ يحقق تأثيرًا حقيقيًا. وهذا يفسر لماذا ظهرت كيانات مثل “ديمقراطيون من أجل إسرائيل”، لأن هناك ضغطًا داخل الحزب الديمقراطي من مؤيدين لفلسطين، استدعى من البعض أن يُنشئوا جسمًا يدافع عن إسرائيل داخل الحزب ذاته.
هذا يعكس وجود تحوّل فعلي في الرأي العام. والجيل الشاب، كما نعرف، هو من يُغيّر العالم. هذا ليس جديدًا. لقد حدث في الحرب على فيتنام، وحركة الحقوق المدنية، وBlack Lives Matter، وغيرها. والآن، فلسطين ليست استثناء.
في الحقيقة، قضية فلسطين باتت مسألة مركزية في النقاش الأميركي، وفي منظومة القيم الأميركية. ولذلك، لا يمكن الحديث عن العدالة، أو عن القيم الأميركية، من دون أن نضع العدالة للفلسطينيين في صلب هذا النقاش سواء في أميركا أو في أي مكان آخر.
هل تعتبر أن المشكلة تقتصر على إدارة ترامب، أم أن سياسات الحزب الديمقراطي، خاصة في عهد بايدن، لعبت دورًا في تأزيم الوضع؟
بالطبع يتحمّلون المسؤولية. ما أقصده هو أن الأسلحة لا تزال تُمنح لإسرائيل، والذخيرة لا تزال تُقدَّم لها. سواء من الحزب الديمقراطي أو الجمهوري، للأسف، هذا الواقع لم يتغير بالنسبة للفلسطينيين.
نحن نتحدث هنا عن السياسة، عن تنظيمات سياسية تعمل داخل المجال السياسي، عن مؤسسات الدولة، لكن حين نتحدث عن الشعب كجزء من الفضاء السياسي، فإن التغيير الحقيقي سيأتي من الناس، وليس من السياسات في البداية، السياسات ستتغير لاحقًا، لكن البداية يجب أن تكون من الناس.
أما عن مسألة إن كانت قضية فلسطين بدأت مع ترامب، فالإجابة بالتأكيد: لا. غزة قُصفت خمس مرات من قبل، ووقعت حروب متكررة ضد شعب أعزل. والاحتلال مستمر منذ عقود، كما أن الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ويعيشون داخل “إسرائيل” يواجهون تمييزًا صارخًا في الحصول على الموارد.
هناك أيضًا نظام الحواجز العسكرية، ونظام بطاقات الهوية، ونظام التصاريح المعقد، وكلها موجودة منذ زمن طويل. ومع ذلك، لا يزال الفلسطينيون يواصلون الحديث عن قضيتهم، بينما لم تفعل أميركا سوى القليل جدًا إزاء ذلك.
قضية فلسطين، للأسف، كلما تُركت دون حلّ، تفاقمت أكثر، وتحوّلت إلى تهديد أكبر مع مرور الوقت. وهذا ما وصلنا إليه اليوم. فلسطين أصبحت مسألة مركزية في السياسة العالمية، في السياسة الأميركية، في السياسات الإقليمية والجيوسياسية.
إذا لم يتم التعامل معها بجدية، وإذا لم تُحل على أساس العدالة والمساواة، فإننا جميعًا سنواجه مشكلة.
أي من القيم التي نتمسك بها: الديمقراطية، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، المساواة. لن يكون لها أي معنى إن لم تُطبّق على الفلسطينيين.
والواقع، كما نراه اليوم، هو أن هذه القيم لم تعد تعني شيئًا. لذلك، إذا أردنا الحفاظ على أي ذرة من تلك القيم، يجب أن تكون فلسطين في قلب المطالبة بالعدالة والمساواة.
الآن، وصلنا إلى النهاية، لكن قبل أن ننهي، أود أن أسألك: ما الذي تودّ إضافته أو قوله عن الإبادة الجماعية في غزة، والتي استمرت لأكثر من عامين حتى الآن، دون أن تُتخذ أي خطوات جدّية لوقفها؟
من الواضح أن الأمر محزن جدًا، بل إن كلمة “محزن” لا تكفي لوصفه. الشعور بأنه لم يُفعل شيء يُذكر حيال ذلك، يضيف طبقة أخرى من اليأس. أفكّر في هذه الإبادة كل يوم، كل لحظة أستيقظ فيها، كما أظن أن كثيرين يفعلون، سواء كانوا فلسطينيين أو غير فلسطينيين.
أعتقد أن هذه لحظة فارقة لكل شخص لديه ضمير، مهما كان موقعه، أو خلفيته، أو هويته الدينية، سواء كان مسلمًا أو مسيحيًا أو يهوديًا أو لا دينيًا أو بوذيًا أو غير ذلك. الناس ذوو الضمير، أظن أن معظمهم يشعر أن ما يحدث ليس صوابًا، وأنه إذا كان هذا هو ما تمثّله “الإنسانية”، فنحن كجنس بشري قد فشلنا في هذا المشروع الأخلاقي.
ما حدث خلال العامين الماضيين كشف أن القيم التي طالما تحدّثنا عنها، مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ترتبط فقط بفئة معينة من الناس للأسف، ليسوا من أصحاب البشرة السمراء أو الشعوب المهمّشة.
علينا أن ننظر بعمق داخل أنفسنا ونتساءل: أين أقف من هذه القيم؟ هذه ليست مجرد مسألة أخلاقية، بل هي لحظة وجودية بالنسبة للبشرية. وليس لأنني أدرس فلسطين أقول إن فلسطين هي كل شيء، لكنها أصبحت في هذه اللحظة القضية الأكثر مركزية وإلحاحًا في العالم.
عندما نتحدث عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وعن أطفال يُقتلون بأعداد غير مسبوقة منذ الحروب العالمية في القرن العشرين، فإننا نتحدث عن شيء مروّع فعلاً، ومع ذلك، لم يتحرك العالم لإيقافه، أو حتى لإبطائه.
في الواقع، أظهرت بعض التسريبات مؤخرًا أن إدارة بايدن لم تطلب حتى وقف إطلاق النار، بل واصلت إرسال الأسلحة. والسؤال هنا: كيف يستطيع إنسان أن يعتبر نفسه إنسانيًا، ثم يسمح بحدوث شيء كهذا؟
استثناء الفلسطينيين يجب ألا يكون موجودًا. لا ينبغي أن يكون هناك استثناء للأطفال الفلسطينيين، المسلمين، العرب، أو اليهود، أو أصحاب البشرة السمراء أو البيضاء. يجب أن يكون هناك حد أدنى من الاحترام للحياة الإنسانية والكرامة البشرية، لكننا، في رأيي، بلغنا الحضيض. لم أكن أتخيّل أبدًا أننا سنصل إلى هذه الدرجة من الانحدار، لكننا وصلنا.
ومع ذلك، ورغم كل ما سبق، أريد أن أقول: رغم حزني العميق وتشاؤمي حيال حال العالم، ما زلت متفائلًا لأن الصمود الفلسطيني ونظرته للمستقبل سيبقيان جذوة الأمل حيّة. ربما لا نرى التغيير الآن، لكن التغيير يحتاج وقتًا، ويكون مؤلمًا في كثير من الأحيان، لكن في نهاية المطاف، سيحصل الفلسطينيون على العدالة، وسيُعترف بمطالبهم في المساواة،
وسيجبر العالم على التعاطي مع هذه القضية، عاجلاً أم آجلاً.









