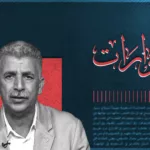ربما لا تذكر كتب التاريخ الولايات المتحدة كضالعٍ مباشر أو لاعبٍ رئيسي في نكبة الفلسطينيين عام 1948، مقارنة بالدور البريطاني، إذ لا تُظهر أرشيفات القنصلية الأميركية في القدس إشارات واضحة إلى علم استخباراتي مباشر بنوايا العصابات الصهيونية، ولا بتفاصيل عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي التي طالت السكان الأصليين في فلسطين التاريخية.
لكن “عملية النكبة”، بما أفرزته من تهجير لثلثي الشعب الفلسطيني داخل البلاد آنذاك، وما تبعها من قيام الكيان واستمرار سياساته على مدى 77 عامًا، لا تدع مجالًا للشك في الدور الأخطر الذي لعبته ولا تزال الولايات المتحدة، في تثبيت أركان النكبة ومضاعفة آثارها ومخرجاتها.
ابتداءً من التحايل على الحق الفلسطيني، وليس انتهاءً بمحاولات المحو المادي والمعنوي للوجود الفلسطيني، تصدّرت واشنطن المشهد، لا كمتواطئة أو متسترة فحسب، بل كشريك فاعل، غالبًا ما يسبق يد الاحتلال في تنفيذ المخطط.
ولأن تتبّع أوجه التورط الأميركي في النكبة الفلسطينية يتطلب مساحة أوسع، نخصّص هذا المقال للتركيز على الدور الأميركي في محو واحدة من أبرز ركائز النكبة: قضية اللاجئين وحقهم في العودة.
يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه محاولات تصفية مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، وخلق نكبة جديدة في قطاع غزة، دون أن يُمنح أصحاب الأرض حتى صفة “لاجئ”، فما هي أدوات الولايات المتحدة في إغلاق ملف النكبة ومحو ذاكرتها؟ وما الذي دفع إدارة ترامب إلى شنّ حرب مفتوحة على “الأونروا”؟ وكيف تنظر واشنطن إلى مشاريع تفكيك المخيمات في الضفة وتهجير الفلسطينيين خارج القطاع؟.
سلام لا مكان للاجئين فيه
إذا كان لا بد من شماعة تاريخية تُعلّق عليها الولايات المتحدة فشل عملية السلام في الشرق الأوسط، مقابل توغل حليفتها “إسرائيل” في سياساتها الإستعمارية، فهي دون شك حق العودة، إذ لطالما اعتبره الساسة الأميركيون “معضلة أمام السلام”، بزعم أنه يهدّد الأمن الإسرائيلي ويُعد “حلاً غير واقعي ولا قابل للتطبيق”.
وقد انعكست هذه الرؤية في جميع المبادرات الأميركية للسلام خلال العقود الأربعة الماضية، بدءًا بمشروع السلام في الشرق الأوسط الذي طرحته إدارة رونالد ريغان عام 1982، ودعت فيه صراحة إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة.
ثم جاءت إدارة كلينتون التي، رغم اعتبارها قضية اللاجئين ضمن ملفات الحل النهائي في سياق اتفاق أوسلو، عادت في قمة كامب ديفيد عام 2000 لطرح خطة تُنهي حق العودة فعليًا، عبر توطين اللاجئين في مناطق “أ” و”ب” داخل الضفة الغربية أو في دول ثالثة، إلى جانب اقتراح تشكيل صندوق تمويل دولي لتأمين “حل إنساني بديل” يُركّز على دمج اللاجئين خارج المخيمات وتجاوز دور الأونروا تدريجيًا.
خارطة الطريق التي قدّمتها إدارة جورج بوش الابن أسقطت بدورها حق العودة من مقترح “حل الدولتين”، رغم تقديمها كقفزة نوعية في الخطاب الأميركي، فقد رأت واشنطن في مأسسة السلطة الفلسطينية وتمويلها وفق شروط أميركية بديلًا عمليًا عن دور الأونروا، باعتبارها جهة أممية مستقلة نسبيًا عن الإملاءات الأميركية.

لاحقًا، جاءت “صفقة القرن” التي طرحتها إدارة دونالد ترامب (2017–2018) لتُعلن صراحة ما كانت الإدارات السابقة تلمّح إليه: وقف تمويل الأونروا وتصفية قضية اللاجئين نهائيًا، عبر تطبيع وجودهم في الدول المضيفة ونزع صفة “اللجوء” عنهم. وكان عرّاب هذه الخطة جاريد كوشنر، الذي مارس ضغوطًا سرية على لبنان والأردن لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين كمواطنين، تمهيدًا لتذويب هويتهم القانونية والسياسية.
وكشفت مراسلات داخلية عن مساعٍ حثيثة قادها كوشنر لإلغاء وكالة الأونروا ودمج خدماتها ضمن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، المعنية باللاجئين على مستوى عالمي، ما من شأنه تمييع القضية الفلسطينية وإذابة خصوصيتها في بحر من أزمات النزوح والصراعات الدولية والمآسي الإنسانية.
وعلى مدى عقود، عارضت الولايات المتحدة القرار الأممي 194، الذي يُعدّ المرتكز القانوني لحق العودة، ولم تكتف بذلك، بل سعت إلى دعم مشروع إسرائيلي مضاد، أعدّه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بتوجيه من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يروّج لرواية عن تهجير قسري طال يهودًا من الدول العربية والإسلامية بين عامي 1947 و1970.
بحسب هذا المشروع، بلغ عدد هؤلاء “اللاجئين اليهود”، كما تسميهم الوثيقة، نحو 800,000 شخص، وتطالب “إسرائيل” بتعويضهم ماديًا، وتطرح ملفهم دوليًا كمقابل “متوازن” لملف اللاجئين الفلسطينيين، في محاولة واضحة لابتزاز الفلسطينيين ودفعهم للتخلي عن حق العودة تحت غطاء “الحلول المتوازنة”.
عودًا على بدء
مع انطلاق حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة مساء السابع من أكتوبر 2023، اتخذ التواطؤ الأميركي في تهجير الفلسطينيين قسرًا، في إطار عملية تطهير عرقي جديدة، بُعدًا أكثر وضوحًا ووقاحة، فمع الردّ الإسرائيلي الأولي على عملية طوفان الأقصى، بدأت التقارير الأمنية ترد إلى البيت الأبيض حول نزوح داخلي لمليون فلسطيني خلال الأسبوع الأول وحده.
وفي تسريب لاحق كشفت عنه وكالة “رويترز“، ضمّ سلسلة رسائل إلكترونية بين كبار موظفي البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية، ورد أن الصليب الأحمر الدولي نبّه المسؤولين الأميركيين لما قد تكون “إسرائيل” تُخطّط له بشأن تهجير جماعي منظم، مما أثار صدمة داخلية دفعت بعضهم إلى القول إنهم “يرتجفون حتى النخاع”.
لكن، كالعادة، لم يغيّر هذا شيئًا، فقد واصل البيت الأبيض دعمه غير المشروط لحرب الإبادة، بل صعّد من وتيرة التمويل والتسليح بصورة منقطعة النظير إلى الحد الذي خرج فيه وزير الخارجية أنطوني بلينكن، بعد عام من المجازر، لينفي صحة تقارير منظمات حقوقية حول تهجير ما يقارب مليوني غزّي أي نحو 90% من سكان القطاع.
الشريط ذاته يتكرر بعد 77 عامًا، فأرشيف القنصلية الأميركية في القدس ما يزال شاهدًا على الموقف الأميركي من نكبة 1948، وما تخلّلها من عمليات تهجير ممنهج واسعة النطاق، فرغم محاولة “إسرائيل” تبرير تلك الجرائم أمام المبعوث الأميركي جيمس ماكدونالد، حيث زعم الرئيس الإسرائيلي الأول حاييم وايزمان أن هجرة الفلسطينيين كانت “معجزة إلهية” سهّلت تأسيس الدولة، إلا أن ماكدونالد أدرك باكرًا أن ما يجري ليس عفويًا ولا قدريًا، بل مخطط منظّم ارتكز على مذابح مدروسة وممارسات إرهابية لإفراغ الأرض من أهلها.

في برقيتين أرسلهما القنصل الأميركي العام توماس واسون إلى وزارة الخارجية في أيار/مايو 1948، قبيل وقوع النكبة بأيام، أشار بوضوح إلى أن قوات الهاجاناه لن تتوقف عند حدود الدولة المرسومة في خطة التقسيم الأممية، بل ستواصل التوسع في الأراضي الفلسطينية ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، سعيًا لتحقيق حلم بن غوريون بالسيطرة على كامل فلسطين، وهو ما يعني، بحسب وصفه، ارتكاب جرائم تطهير عرقي متوقعة.
وخلال عام 1948، وثّق مسؤولون أميركيون في القنصلية بالقدس مذابح العصابات الصهيونية، وعلى رأسها الأرغون وشتيرن، بحق القرويين الفلسطينيين، مشيرين في برقياتهم إلى أن الهدف من هذه الهجمات، والتي “يتوقع تكرارها”، هو بثّ الذعر في صفوف المدنيين ودفعهم إلى الفرار، وقد أرسل كل من توماس واسون وروبرت ماكاتي تقارير إلى الخارجية الأميركية أكدوا فيها أن معظم الضحايا كانوا من النساء والأطفال وغير المسلحين.
ولم تغب عن أعين الدبلوماسيين الأميركيين مظاهر النهب المنظم والتدمير الممنهج لممتلكات الفلسطينيين، في محاولة واضحة لمنعهم من العودة إلى بيوتهم، وقد صرّح بذلك صراحةً القنصل العام جون ماكدونالد، الذي تابع عن كثب عمليات التدمير في الأحياء العربية بالقدس، وما تلاها من تهجير نهائي للسكان الأصليين.
ورغم هذا الرصد المبكر، لم تتخذ الولايات المتحدة أي موقف لوقف هذه الجرائم، بل على العكس، تسارع تمويلها وتسليحها للكيان الوليد منذ نشأته، وأصبحت الراعي الأول لمشروع الإحلال الاستيطاني، المتمثل بطرد السكان الأصليين من أراضيهم، وخصصت لذلك ميزانيات ضخمة منذ خمسينيات القرن الماضي، لا تزال تتضاعف حتى اليوم.
الأونروا وإعادة تعريف اللاجئين
تمتد محاولات السياسيين الأمريكيين لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين: الأونوروا بعيداً في الزمان؛ فمع انفتاح أبواب الحرب المفتوحة على الإرهاب والتي تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر، لم تسلم الوكالة من التضييقات الأمريكية بتهم “دعم وتمويل الإرهاب” وظل الكونجرس الأمريكي يثير بطلب من نواب موالين للصهيونية شبهات للتحقيق في ملفات الوكالة ومهامها في الأراضي المحتلة.
تمتد محاولات الساسة الأميركيين لتصفية وكالة الأونروا بعيدًا في الزمن، إذ لم تسلم الوكالة من التضييق منذ بداية التسعينيات، عندما بدأ الكونغرس الأميركي، بتحريض من نواب موالين للصهيونية، بطرح شبهات متكررة حول طبيعة تعريف “اللاجئ الفلسطيني”، ومناهج التعليم التي تعتمدها الوكالة، وسلوكها “غير المحايد” في الأراضي المحتلة، ما أدى إلى تأجيل التمويل الأميركي مرارًا، وربطه بشروط صارمة تهدف إلى “إصلاح ما اعتبره الكونغرس تشددًا سياسيًا في سياسات الأونروا”.
ثم، مع انطلاق “الحرب على الإرهاب” عقب هجمات 11 سبتمبر، فُتحت جبهة جديدة ضد الوكالة، تحت تهمة “دعم وتمويل الإرهاب”، وأصبح وجود الأونروا ذاته موضع تشكيك أمني وسياسي في الخطاب الأميركي، ما مهّد لمزيد من الضغط المؤسسي عليها.
لكنّ قدوم إدارة دونالد ترامب عام 2017 شكّل نقطة تحوّل أكثر تطرفًا، حيث اتخذت المواجهة بعدًا أكثر جرأة وصراحة،
ففي تلك الفترة، أرسل نحو 22 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ، بقيادة النائب دوغ لامبورن عن ولاية كولورادو، رسالة رسمية إلى البيت الأبيض، دعوا فيها الرئيس ترامب إلى تصفية حق العودة الفلسطيني باعتباره يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة تجاه “السلام”.
وجاء في الرسالة: “ما يُسمى بحق العودة لـ5.3 مليون لاجئ فلسطيني إلى أراضي إسرائيل كجزء من عملية السلام ليس مطلبًا واقعيًا، وهناك أيضًا شك كبير في دقة هذا الرقم”.
وقد لاقى الطلب الجمهوري لدى ترامب آذانًا صاغية؛ ففي عام 2018، أعلن ترامب للمرة الأولى عن تجميد 65 مليون دولار من التمويل الأميركي لوكالة الأونروا، ثم سرعان ما قطع كامل المساهمة الأميركية البالغة أكثر من 300 مليون دولار سنويًا، والتي كانت تُشكّل نحو 30 إلى 40% من ميزانية الوكالة.
ورغم أن إدارة جو بايدن أعادت ضخ التمويل بين عامي 2021 و2023 بمبالغ تراوحت بين 150 و344 مليون دولار سنويًا، إلا أن اتهامات وُجّهت لعدد من موظفي الأونروا بالضلوع في هجمات 7 أكتوبر أعادت فتح ملف تجميد الدعم، وقد تبنّى الكونغرس الأميركي قانونًا يوقف تمويل الوكالة حتى مارس 2025، لتأتي إدارة ترامب الثانية في فبراير 2025 وتُصدر قرارًا تنفيذيًا رسميًا بوقف التمويل نهائيًا.
بدأت هذه الحملة الأميركية ضد الأونروا من منظور سياسي واستراتيجي أوسع، فالوكالة، بنظر مؤيدي “إسرائيل” في واشنطن، تُكرّس قضية اللاجئين لا تحلّها، بل وتُوسّعها زمنيًا وجغرافيًا، فمنذ تأسيس الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر عام 1949، كان هدفها الأصلي توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلدان التي لجؤوا إليها،
لكن هذه المهمة سقطت من أجندتها تدريجيًا، بضغط من الدول المستضيفة التي رفضت مشاريع التوطين، فاقتصرت مهام الوكالة على الإغاثة والتعليم والخدمات.
ومع الوقت، وسّعت الأونروا تعريف اللاجئ الفلسطيني ليشمل الأبناء والأحفاد وكل من انحدر من لاجئي نكبة 1948، ما يعني أن صفة اللجوء تورّث وتستمر حتى يتحقق الحق بالعودة، وبذلك تحوّلت قضية اللاجئين من 700 ألف لاجئ أصلي إلى أكثر من 5.9 مليون لاجئ، موزّعين بين الداخل والخارج، والعداد لا يزال في ازدياد مستمر.
شكّلت هذه المعضلة هاجسًا دائمًا للمشرّعين الأميركيين، مع تزايد الدعوات الدولية للتشبّث بحق العودة كشرط جوهري لأي سلام مستدام في المنطقة، وباتت الأونروا الوجه العلني لمظلومية اللاجئين الفلسطينيين، والتجسيد اليومي لوجود هذه القضية العالقة، والمذكّر الدائم بضرورة حلّها في إطار الاعتراف الكامل بحق العودة.
ولذا، بدأت الجهود تتكثّف لاقتلاع الوكالة من جذورها وإنهاء دورها نهائيًا، باعتبارها العقبة الرمزية والوظيفية الأكبر أمام تصفية قضية اللاجئين، ففي نهاية العام الماضي، أصدر الكنيست الإسرائيلي قانونين يمنعان الأونروا من العمل داخل المناطق الخاضعة لما يسمى بـ”سيادة إسرائيل”، مع الإبقاء على أنشطتها مؤقتًا في الضفة الغربية وقطاع غزة،
وبذلك تم إلغاء الاتفاق القائم منذ عام 1967 بين الوكالة وحكومة الاحتلال، والذي كان يُجيز لها العمل في الأراضي التي احتُلّت لاحقًا.

هذه الخطوة، التي يُرجّح أن تتبعها قيود جديدة تخنق عمل الوكالة حتى في ما تبقى من فلسطين التاريخية، تعني بوضوح أن “إسرائيل” ترفض الاعتراف بمن تم تهجيرهم داخليًا داخل حدود “الدولة”، وهم يشكّلون ثلث السكان الأصليين على الأقل، لا سيما في القدس، حيث تدير الأونروا سبع مدارس أساسية.
يبدو ذلك كخطوة أولى نحو محو صفة “اللاجئ” عن فلسطينيي الداخل، وتحويل النكبة إلى ملف تاريخي مغلق،
وقد باركت الولايات المتحدة هذه الخطوة الإسرائيلية، واعتبرتها “حقًا سياديًا” مشروعًا لدولة الاحتلال.
أما على الصعيد الأميركي، فقد اتفقت الإدارات المتعاقبة تاريخيًا على إهمال حق العودة وتجاهل صفته القانونية الملزمة، مكتفية بالقول إن أي حل لهذه المسألة “يجب أن ينبثق عن اتفاق بين الطرفين”، ولا يمكن فرضه من جانب واحد، غير أن إدارة ترامب ذهبت أبعد من ذلك؛ ففي عام 2018، ساومت الأمم المتحدة على تمويل الأونروا، مشترطة تغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني ليقتصر فقط على من تضرروا بشكل مباشر من نكبة 1948، أي جيل يكاد يندثر، ما يعني تحويل قضية اللاجئين إلى مسألة رمزية قابلة للإطفاء.
وتسارعت لاحقًا خطوات الإدارة لتصفية الوكالة بالكامل، فلم تكتف بقطع التمويل والتواطؤ مع “إسرائيل” لتجفيف وجودها ميدانيًا، بل تعدّت ذلك إلى رفع الحصانة الدبلوماسية عنها، لتتيح مقاضاة الأونروا داخل المحاكم الأميركية، قفي تطور لافت، قدّمت وزارة العدل الأميركية مؤخرًا مذكرة إلى محكمة فيدرالية في نيويورك ضمن دعوى رفعها إسرائيليون من ذوي قتلى سقطوا يوم 7 أكتوبر، طالبوا فيها بمليار دولار من التعويضات، متهمين الأونروا بأنها دعمت “الإرهاب الفلسطيني” في غزة، وقد استجابت المحكمة برفع الحصانة القانونية عن الوكالة، وسمحت باستمرار المحاكمة ضدها داخل الأراضي الأميركية.
وليست هذه الدعوى الأولى، ففي عام 2024، تقدّم اتحاد لجماعات مناصرة لإسرائيل، تحت مسمى “لافِي إت إيل”، بدعوى ضد اللجنة الوطنية لوكالة الأونروا، اتهموا فيها الوكالة بـ”دعم الإرهاب والتواصل مع حماس” بسبب عملها في القطاع، غير أن الوكالة حينها، وفي ظل إدارة بايدن، تمتّعت بحصانة قانونية حالت دون المضي في المحاكمة.
وقد جاء رفع الحصانة القضائية عن الأونروا تتويجًا لشهور من الضغط المنهجي الذي مارسه مشرّعو الكونغرس الموالون لإسرائيل، والذين عملوا على تقديم سلسلة من المبادرات ومشاريع القوانين تهدف إلى خنق الوكالة ماليًا وقانونيًا، والتي تنوّعت بين مشاريع لوقف تمويل الوكالة وربط المساعدات الأميركية بشروط سياسية وأمنية صارمة، مثل مشروع “إصلاح الأونروا 2023″، الذي دعا إلى قطع أموال دافعي الضرائب الأميركيين عن الوكالة ما لم “تفكّ ارتباطها بالمتشددين وذوي الأجندات المعادية لإسرائيل”.
وفي موازاة ذلك، تم الدفع بمشروع قانون آخر أكثر خطورة بعنوان: “LAIBL — تقييد حصانة الداعمين للتشدّد القاتل” والذي قادَه السيناتور الجمهوري تيد كروز، بمشاركة عدد من المشرّعين ذوي الخلفيات الصهيونية، وطالبوا فيه بشكل مباشر برفع الحصانة القضائية عن الوكالة والعاملين فيها، تمهيدًا لملاحقتها قضائيًا داخل الولايات المتحدة.
السور الحديدي: قتل لذاكرة النكبة
أطلقت “إسرائيل” في يناير الماضي عمليتها العسكرية المسماة “السور الحديدي”، والتي استهدفت حتى الآن ثلاثة مخيمات لجوء رئيسية في شمال الضفة الغربية: طولكرم، ونور شمس، ومخيم جنين، مع توغل محدود في كل من طوباس ونابلس.
وقد باشرت قوات الاحتلال عمليات هدم وإخلاء واسعة داخل هذه المخيمات، أسفرت حتى الآن عن تهجير أكثر من 40,000 لاجئ فلسطيني، وهم أبناء وأحفاد من شهدوا نكبة 1948 وهُجّروا إلى الضفة الغربية بعد اقتلاعهم من مدنهم وقراهم الأصلية في الداخل الفلسطيني. ووفقًا لتصريحات الأمم المتحدة، فإن هذا التهجير يُعدّ الأكبر منذ احتلال الضفة عام 1967.
وتأتي هذه العملية في ظل صمت أميركي مطبق، يعكس تواطؤًا واضحًا مع المخطط الإسرائيلي، ويتماشى تمامًا مع “صفقة القرن” التي قدّمها دونالد ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى، ويسعى الآن لإعادة إحيائها دون بلبلة، فـ”الصفقة”، التي كانت تضمن ضم الضفة الغربية لـ”إسرائيل”، مقابل إقامة كيان فلسطيني هزيل منزوع السلاح ومحدود السيادة، استثنت حق العودة بالكامل من أي مسعى “سلامي”، واعتبرت قضية اللاجئين مجرد عقبة مالية يمكن تسويتها عبر التعويض والتوطين الدائم.
تعمل “إسرائيل” في الوقت الراهن على هدم المعمار المميز لمخيمات الضفة الغربية، ذلك الذي يحمل ذاكرة النكبة، ويُعبّر عن طابع عمراني فريد يميز المخيم عن المناطق الحضرية المحيطة، ويُكرّس ارتباطه الرمزي بحتمية العودة، ضمن محاولة لإماتة الذاكرة الجمعية المرتبطة بالمخيم، وفرض قطيعة وجودية مع فكرة اللاجئ والعودة، وتكريس القبول بـ”الواقع” كبديل عن الحق التاريخي.
تحت ذريعة “الاكتظاظ السكاني” وصعوبة تحرك جنودها في أزقة المخيمات الضيقة، والتي “تسهّل على المقاومين التخفي” كما تزعم، تسعى “إسرائيل” إلى إعادة تشكيل الطبوغرافيا الحضرية للمخيم، عبر تفكيك ملامحه البنيوية، وتطبيع سِماته العمرانية مع محيطه المدني.
وقد رأت الأمم المتحدة وعدد من منظمات حقوق الإنسان أن أدوات هذه العملية العسكرية وحجمها يتجاوز بكثير ادعاءات “تقليم أظافر المقاومة”، لا سيما تلك المرتبطة بـ”حماس” أو “الجهاد الإسلامي”، اللتين تصنّفهما إسرائيل كـ”أذرع إيرانية”. وأكدت هذه الجهات أن القوة المستخدمة تناسب حربًا شاملة لا عملية أمنية محدودة، مشيرة إلى أن ما يجري لا يمكن فصله عن مشروع تطهير عرقي ميداني.
ويرى مراقبون أن استخدام هذا النوع من القوة في المخيمات، خصوصًا في مناطق “ج” المصنفة وفق اتفاقية أوسلو، يهدف إلى خلق أغلبية يهودية، من خلال تهجير كثيف ومنهجي للفلسطينيين في محاكاة مباشرة لما فعلته العصابات الصهيونية عام 1948 في قرى ومدن الداخل.
غزة بدون فلسطينيين
كعادته، جاء موقف دونالد ترامب تجاه التهجير وحق العودة صادمًا وأكثر فجاجة من سابقيه؛ فالرجل لم يكتفِ بإنكار حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، بل اقترح علنًا ودون أن يرفّ له جفن “تنظيف غزة من الفلسطينيين”، مؤكدًا أن على السكان الرحيل، “دون أي حق في الرجوع”. نكبة جديدة، يُسوّق لها ترامب ببرود داخل مكتبه البيضاوي وفي المحافل الدولية، بوصفها “حلًا دائمًا”، لا أزمة إنسانية متواصلة.
وقد مارست إدارته، خلال الشهرين الماضيين، ضغوطًا بلطجية على كل من الأردن ومصر لقبول توطين سكان قطاع غزة بشكل دائم، فيما واصلت البحث عن دول أخرى “تستقبل الغزيين” معظمهم من أحفاد مهجّري النكبة، إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 80% من سكان القطاع هم من نسل اللاجئين من مدن وقرى الداخل الفلسطيني.
واللافت أن هذه الخطة تستند إلى إطار نظري مسبق، وضعه البروفيسور جوزيف بيلزمان، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج واشنطن، ضمن ورقة سياساتية صدرت في يوليو 2024، بعنوان: “رؤية اقتصادية لإعادة إعمار غزة: منهجية البناء والإدارة والتملّك”، وقد أرسلها حينها إلى فريق ترامب الانتخابي كجزء من مقترحات “الحلول المستدامة” لغزة.
لكن فكرة تملك الولايات المتحدة لقطاع غزة ليست وليدة اللحظة، ففي أعقاب الانسحاب الأحادي من القطاع عام 2005، بقيادة حكومة أريئيل شارون، طرحت إدارة جورج بوش الابن تصورًا مفاده أن غزة يمكن أن تتحول إلى منطقة استثمار دولي مُدارة أمنيًا واقتصاديًا، عبر شركات أميركية تُشرف على الإعمار والخدمات، تمهيدًا على المدى الطويل لتوطين السكان في سيناء المصرية.
حاول البيت الأبيض لاحقًا التخفيف من وقع تصريحات ترامب المنفلتة، بعد أن واجهت معارضة دولية شرسة، فخرجت كارولين ليفييت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بتصريح يفيد أن التهجير “مؤقت فقط”، بينما ادعى وزير الخارجية ماركو روبيو أن الأمر لا يتعدى “إجلاءً داخليًا مؤقتًا” ريثما يُعاد إعمار القطاع، ليُسمح بعدها للسكان بالعودة إلى منازلهم.
لكن، ومنذ إعلان ترامب خطته في الرابع من فبراير، لم يتوقف عن تكرار الإصرار على تنفيذها، بصرف النظر عن التناقضات في توقيت وشكل التنفيذ. وقد تلقّت “إسرائيل” هذه الإشارات كضوء أخضر سياسي نادر، لتبدأ فورًا في الانقلاب على الهدنة الهشّة، وتتنصل من شرط عودة السكان إلى شمال القطاع. ومعها، بدأت مرحلة جديدة من حرب التجويع والإبادة المكثفة، لدفع ما تبقى من المدنيين نحو الجنوب، تمهيدًا للترحيل في اللحظة السياسية المناسبة.
وفي تسريب نشرته صحيفة “هآرتس“، نُقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع مغلق مع ضباط في جيش الاحتياط اتهموه بإدارة “حرب استنزاف بلا هدف” سوى إطالة عمره السياسي، أي أنه يدير حربًا “مدروسة”، لا رد فعل عشوائي على ما وصفه بـ”العمل الإرهابي”، وأن هدفها الأساسي هو: “تدمير قطاع غزة قدر الإمكان، كي لا يعود للفلسطينيين مكان يمكنهم العودة إليه… عليهم أن يرحلوا”.
أخيرًا، تُثبت السياسات الأميركية تجاه قطاع غزة والضفة الغربية أنها ليست خروجًا مفاجئًا عن السياق، بل امتداد طبيعي لنهج استراتيجي متواصل، مهّد عبر العقود إلى خنق الوجود الفلسطيني وحصره في أضيق الجغرافيات الممكنة، ففي الخارج، لم يكن اللاجئون بمنأى عن الملاحقة؛ إذ سعت الولايات المتحدة إلى توطينهم قسرًا في المجتمعات المستضيفة، وطيّ ملفهم نهائيًا.
أما في الداخل، فلم تتوقف محاولات محو صفة اللجوء من حيث الجوهر. وفي غزة، طرح ترامب خطة إعادة التوطين دون حتى أن يذكر صفة “لاجئ”، رغم أن معظم سكان القطاع هم في الأصل لاجئون من مدن وقرى الداخل الفلسطيني المحتل. وفي الضفة الغربية، دعمت واشنطن محو مخيمات اللاجئين من الخارطة العمرانية، وإعادة هندستها لكسر علاقتها بالذاكرة الجمعية.
ما يجمع هذه المسارات الثلاثة هو أنها ليست سوى التطبيق العملي المتأخر لـ”صفقة القرن”، تلك الخطة التي ظن البعض أنها ماتت، لكنها ما زالت تنفَّذ بندًا بندًا.