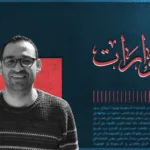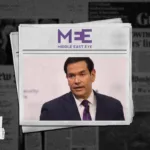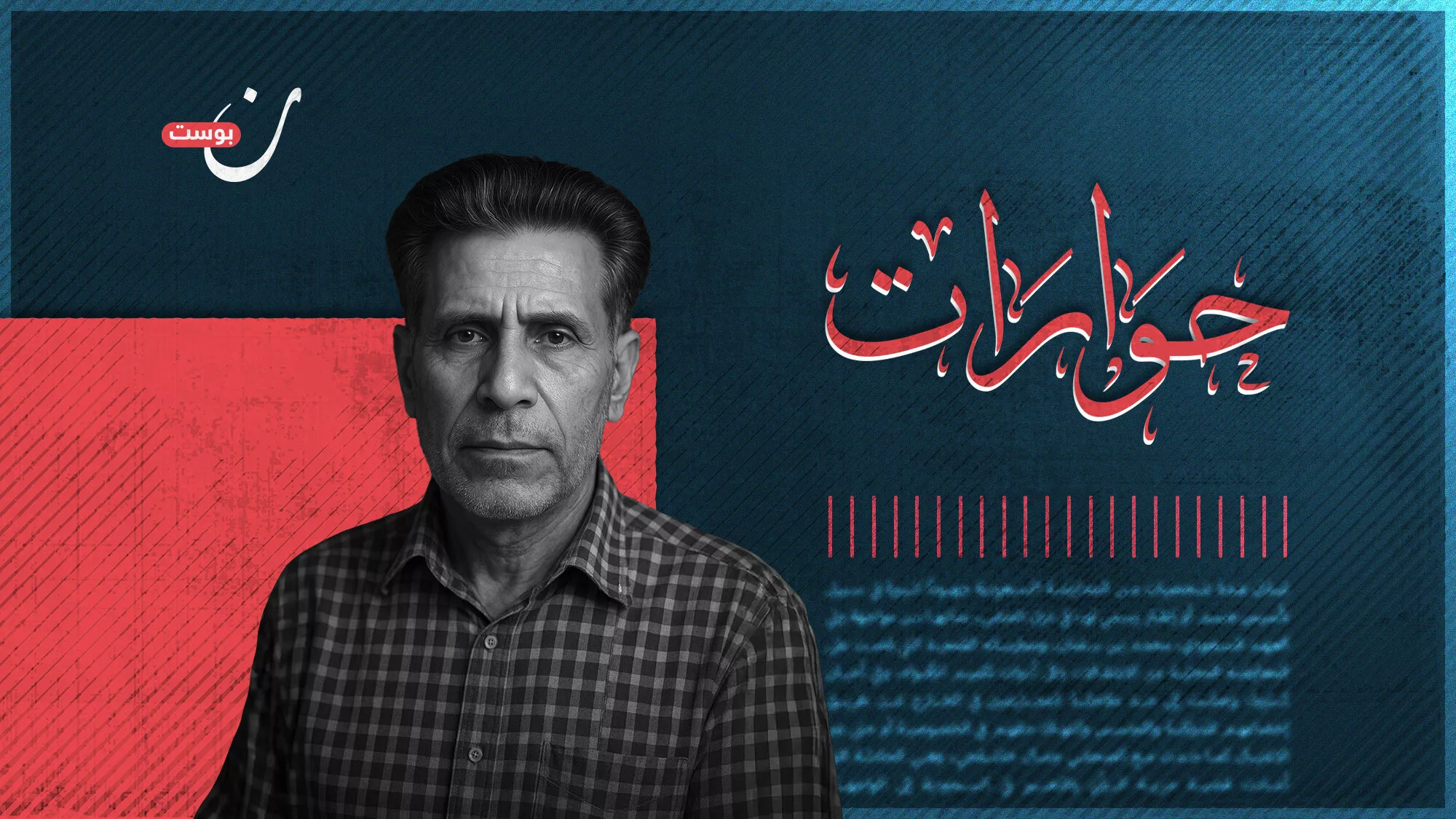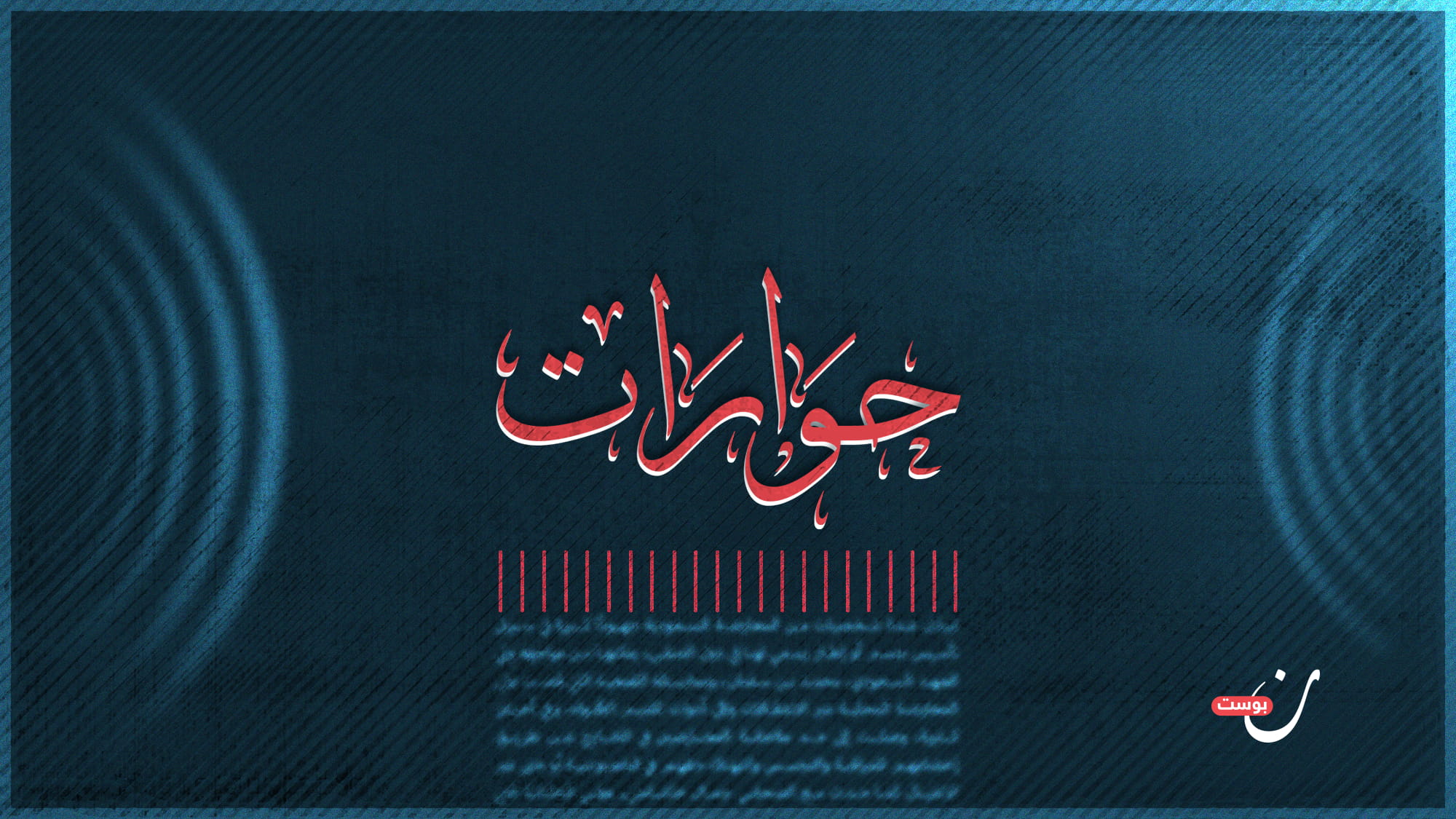في ظل حرب إبادة ممنهجة طالت كل مقومات الحياة في قطاع غزة، بات التمسك بالأمل في حد ذاته فعلَ مقاومة، ومع تصاعد محاولات الاحتلال لقتل الحياة والمستقبل، أصبح الحفاظ على العملية التعليمية أحد أكثر أشكال الصمود صعوبة وضرورة في آنٍ معًا. فالتعليم، بما يمثِّله من استمرارية للحياة والمعنى، تحوَّل إلى معركة يومية في مواجهة القصف والجوع والانهيار النفسي والحرمان من أبسط البنى التحتية.
لكن الأكاديمي، على الرغم من كونه إنسانًا يرزح تحت وطأة المعاناة، يبقى يحمل رسالة سامية، والتمسك بهذه الرسالة في قلب المذبحة هو شهادة على قدرة الفلسطيني على اجتراح الحياة من تحت الركام. وفي هذا السياق، تبرز نماذج ملهِمة اختارت البقاء، ومواصلة أداء دورها في أكثر الظروف قسوة، ومن بينها الدكتور عبد ربه العنزي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة.
في هذا الحوار الخاص مع “نون بوست”، يتحدث الدكتور العنزي عن تجربته الشخصية بصفته أكاديميًّا يدرِّس في ظل حرب الإبادة، وعن صراعه اليومي مع القصف والموت من جهة، والواجب التعليمي من جهة أخرى. يحكي عن لحظة فقدان مكتبته الخاصة، وعن طلابه الذين تحدوا الحرب ليواصلوا دراستهم، وعن الكلفة النفسية التي يدفعها الأكاديمي يومًا بعد يوم.
كما يقيِّم التجربة التعليمية في غزة في خلال الحرب، ويختتم برسالة صريحة إلى المجتمع الأكاديمي الدولي: “ما نحتاجه ليس شعارات، بل دعم حقيقي يعيد الأمل لما تبقَّى من بنية التعليم ومعناه”.
بدايةً، كيف تصف تجربتك الأكاديمية والمهنية في خلال هذه الحرب الممتدة؟
لا شك في أن التجربة الأكاديمية والمهنية في خلال هذه الحرب الطويلة كانت من أصعب ما يمكن أن يُعاش، على جميع المستويات: على مستوى الطالب، والأستاذ، ووسائل التدريس، وحتى على مستوى البيئة العامة التي تُفترض لإنجاح أية عملية تعليمية.
فالعملية التعليمية ليست مجرد محاضرة تُلقى، بل هي منظومة متكاملة تقوم على معلم وطالب وأداة تدريس، ضمن مناخ دراسي آمن ومستقر. وفي سياق حرب إبادة كالتي نعيشها، تضرَّرت هذه المنظومة بأكملها، وتعرضت مكوناتها للتنكيل، والتخريب، وأحيانًا التدمير الكامل.
أنا في نهاية المطاف مواطن فلسطيني، أعيش في قطاع غزة، وأمرُّ يوميًّا بما يمر به طلابي وكل أبناء شعبي، من قصف ونزوح دائم، واغتيالات تطال الأصدقاء والأحبة، وظروف معيشية قاسية تُهدِّد أساسياتِ البقاء.
وعلى الرغم من كل ذلك، أواصِل أداء دوري الأكاديمي، أحاول تدريس الطلاب، وإعداد المحاضرات، والتواصل مع الإدارة الجامعية، لكن هذا كله يجري في ظل بيئة نفسية مُنهَكة، وضغط دائم، وخوف مستمر. الاستنزاف النفسي الذي نعيشه بصفتنا أكاديميين هنا لا يمكن وصفه، ولم يختبره أي أكاديمي في أي مكان آخر في العالم بهذه الصورة القاسية.
ما أبرز التحديات التي واجهتموها في جامعة الأزهر للحفاظ على استمرارية العملية التعليمية؟ وكيف تعاملتم مع الانقطاع المتكرر للإنترنت والكهرباء، واستهداف المقار الجامعية؟ وهل لجأتم إلى بدائل معينة لضمان التواصل مع الطلبة؟
التحديات كانت عديدة ومركبة، تبدأ من فقدان المناخ التعليمي كليًّا. فدون حرم جامعي، ودون طالب متفرغ لتلقِّي التعليم في ظروف طبيعية، ووسط انهيار نفسي واجتماعي ومادي يطال الجميع، تصبح العملية التعليمية شبه مستحيلة.
حتى نحن بصفتنا أعضاء هيئة تدريس تعرَّضنا لما يمكن وصفه بـ”الاغتيال المعنوي”، إذ طالتنا الضغوط من كل اتجاه، ولا أبالِغ حين أقول إننا كنا نكافح نفسيًّا قبل أن نكافح أكاديميًّا.
المقار الجامعية نفسها تعرضت للقصف والتدمير. الحرم الجامعي في منطقة المغراقة دُمِّر بالكامل، والمبنى المركزي في مدينة غزة طاله القصف والتجريف، ثم النهب والتخريب لاحقًا. لم يتبقَّ شيء، لا أثاث، لا أجهزة، لا وثائق، ولا أية مقدرات علمية. وحتى السيرفرات وقواعد البيانات الأساسية للجامعة استُهدِفَت ودُمِّرَت.
هذا الدمار لم يكن بفعل القصف فقط، بل أيضًا نتيجة حالة الفوضى التي أعقبت ذلك، والتي للأسف أسهمت في تكريس أهداف الاحتلال بشكل غير مباشر.
وأما التحدي الأقصى فهو ببساطة “تحدي البقاء”. كثير من طلابنا وزملائنا في الهيئة التدريسية استُشهدوا، وبعضهم قُتلت عائلاتهم بالكامل ومُسحت أسماؤهم من السجل المدني. نحن لا نتحدث هنا عن ظروف صعبة فحسب، بل عن معركة حياة أو موت، يومية، نعيشها بصفتنا أكاديميين وطلاب.
في تجارب سابقة، مثل جائحة كورونا، واجهنا تحديات صعبة، لكننا كنا نملك الحد الأدنى من البنية التحتية الرقمية، والكهرباء والإنترنت، واستطعنا التواصل عبر المنصات الرقمية وابتكار بيئة تعليمية عن بُعد.
لكن ما نواجهه اليوم مختلف تمامًا، لا يوجد كهرباء، ولا إنترنت، ولا حتى قدرة على الاتصال الخلوي أو الثابت. البنية التحتية دُمِّرت بالكامل، وحتى أدواتنا الأساسية للتواصل الأكاديمي لم تَعُد موجودة.
لذلك، لا يمكن القول إننا واجهنا هذه التحديات عبر بدائل عملية، بل الحقيقة أننا أعدنا تدوير كل ما يُتاح في هذا الواقع، بهدف ضمان استمرارية العملية التعليمية، ونحن نعيش مرحلة شديدة القسوة وغير مسبوقة في تاريخ التعليم الجامعي.
على المستوى الشخصي، ما أصعب المواقف التي واجهتها في خلال محاولتك الحفاظ على انتظام التعليم؟
تعرضت شخصيًّا للكثير من المواقف الصعبة، لكن يبقى أصعبها لحظة تدمير منزلي على يد قوات الاحتلال. في ثقافتنا، ليس البيت مجرد مأوى، بل هو امتداد للروح، ومخزن للذكريات، ومكان للأمان العائلي، بل هو التعبير المادي والرمزي عن الاستقرار والسكينة. فقدانه بهذا الشكل كان أشبه بتمزيق جزء من الذات.
كذلك، تعرض بيت والدتي في المغراقة للتدمير الكامل والتجريف، في سياق مسح الاحتلال للمنطقة من أجل إقامة ما يُعرَف اليوم بالموقع العسكري “نيتساريم”. ولم يكن ذلك مجرد استهداف لمكان، بل كان تدميرًا لطفولتي، ولذكرياتي، ولأصل انتمائي العاطفي والعائلي.
ومن أشد المواقف وجعًا أيضًا استشهاد ابنة أختي وعائلتها بالكامل – هي، وزوجها، وأطفالهما – في قصف مباشر من الاحتلال. سبعة أفراد أُبيدوا في لحظة واحدة، ولا كلمات تصف هذا الألم.
لم يكن ذلك فحسب. سيارتي قُصفت ودُمرت، وقطعة الأرض التي أملكها جُرِّفَت بالكامل. ونجوتُ من الموت أكثر من مرة، بفارق ثوانٍ فقط، لا دقائق ولا ساعات. كنت أغادر موقعًا، فيقصف بعدها بلحظات. ولم تكن هذه النجاة المتكررة سوى بعناية الله.
وأما المشهد اليومي فعذاب متواصل. أن تتابِع أخبار من تحبهم، جيرانك، وطلابك، وأهلك، وشعبك، وتراهم يسقطون تباعًا، هو استنزاف نفسي لا ينتهي. الصور التي نراها كل يوم تجاوزت في فظاعتها كل ما قرأته أو تابعته عن الإبادات الجماعية في التاريخ، سواءٌ في “الهولوكوست” أو إبادة الأرمن أو رواندا أو البوسنة. ما يحدث في غزة اليوم أحد أبشع وجوه الإبادة الجماعية في التاريخ المعاصر.
وهنا، لا تُقتَل بالقنابل فحسب، بل تُقتَل من أجل لقمة الخبز، وجرعة الدواء، وشربة الماء. تُقتل بصواريخ هي الأحدث في ترسانة العالَم، تفتِّت العظام والحجارة والطرقات، وتزلزل أرضًا صلبة. أن تعيش وسط هذا كله، وتحاول في الوقت ذاته الحفاظ على انتظام التعليم، أمر صعب جدًّا لا يشبهه شيء.
نعلم أن مكتبتك الخاصة قد احترقت نتيجة القصف، هل يمكن أن تخبرنا عن هذه اللحظة؟ وكيف أثَّرت عليك علميًّا ونفسيًّا؟
نعم، دُمِّرت مكتبتي وحُرِقت بالكامل، وكان ذلك من أقسى ما تعرضت له من فقدان في هذه الحرب. صحيح أن القصف طال منزلي وسيارتي وكل ما أملك ماديًّا، لكن فقدان المكتبة كان الجرح الأعمق والأشد ألمًا، ولا يفارقني هذا الشعور على الرغم من مرور الأيام.
لم تكن مجرد رفوف كتب، بل كانت تعني لي الكثير علميًّا وعاطفيًّا، فقد بدأت بجمعها منذ أوائل التسعينيات، أي حتى قبل دخولي ميدان التدريس الجامعي. كنت أتعامل مع كل كتاب فيها كما لو كان أحد أبنائي. كنت أعتني بها وأحافظ عليها بحرص شديد.
وطوال أكثر من 35 عامًا، ظللتُ أُثرِي هذه المكتبةَ بصعوبة بالغة، خاصةً في ظل الحصار على قطاع غزة، فكنت أستغل كل فرصة سفر، سواءٌ لي أو لأصدقائي، لأجلب كتبًا جديدةً أضيفها إلى مجموعتي.
المكتبة كانت تضم آلاف الكتب في مختلف التخصصات، وكنت قد قسمتُ محتواها في السنوات الأخيرة على أكثر من مكان، جزء في منزلي، وآخر في بيت والدتي، وثالث في مكتبي بالجامعة. وللأسف، كل هذه الأماكن تعرضت للقصف والتدمير، ولم يتبقَّ لي حتى ورقة واحدة من تلك الكتب التي جمعتها على مدى عقود.
هذا الفقدان، وإن لم يكن أثمن من فقد الأحبة، كان ضربةً قاسيةً لي على المستوى الشخصي والعلمي. الكتب كانت رفيقة دربي، ومصدر إلهامي، وساحتي اليومية للمتعة والتأمل والمعرفة. واليوم، أشعر وكأنني فقدت جزءًا من نفسي مع احتراق تلك المكتبة، التي كانت تحمل بين دفتيها قصتِي مع العلم والحياة.
هل تذكر موقفًا معينًا شكَّل مفترقًا في تجربتك، مثل البحث عن الإنترنت في ظروف خطيرة، أو إعطاء محاضرة من موقع غير آمن؟
نعم، ثمة العديد من اللحظات الصعبة التي عشتها، والتي أصبحت جزءًا من روتين الحياة اليومية لأي أكاديمي يحاول أداء رسالته في قطاع غزة اليوم. من أبسط المهام إلى أخطرها، كنا مجبرين على خوض تحدٍّ يومي للبحث عن مصدر كهرباء أو اتصال بالإنترنت، فقط لنتمكن من التواصل مع طلابنا أو إتمام محاضرة.
في كثير من الأحيان، كنت أضطر إلى قطع مسافات طويلة جدًّا بحثًا عن نقطة فيها إنترنت وطاقة، وما إن أصل حتى أُفاجأ بانقطاع الاتصال، فأبدأ من جديد رحلة البحث الشاقة نحو موقع آخر. هذا التكرار بحد ذاته كان مرهقًا نفسيًّا وجسديًّا.
أذكر موقفًا لا يفارق ذاكرتي، عندما كنت أرتاد أحد المقاهي، برفقة زميلي عميد كلية الحقوق في جامعة الأزهر، لاستخدام الإنترنت وإعطاء المحاضرات عن بُعد. هذا المكان تحديدًا، تعرض للقصف في أحد المساءات، وأدى القصف إلى استشهاد عدد من الموجودين فيه، وإصابة آخرين. ولو كنا موجودين لحظة القصف، لكُنَّا دون شك من بين الضحايا.
ليست هذه اللحظات استثناءً، بل صورة يومية متكررة، نعيشها بصفتنا أكاديميين في سعينا الحثيث إلى إتمام مهمتنا التعليمية، على الرغم من الحرب والخطر. أن تعطي محاضرة في مكان غير آمن، أو أن تُخاطر بحياتك من أجل إرسال ملاحظة إلى طلابك، هذا هو الواقع الذي نعيشه، وهذه هي الرسالة التي نصرُّ على الاستمرار في حملها.
في ظل المخاطر اليومية، ما الذي منحك الدافع إلى الاستمرار وألَّا تنقطع عن دورك الأكاديمي؟ وهل شعرت أن إصرارك الشخصي ترك أثرًا في زملائك أو طلبتك، ورفع من معنوياتهم؟
ما يدفعني إلى الاستمرار في العمل الأكاديمي، حتى في قلب هذه الحرب، أن التعليم بات يشكِّل بالنسبة إليَّ نافذةً نفسيةً دفاعية، وآليةَ مقاومة ذاتية في وجه القهر والموت والدمار. وسط المذبحة اليومية والإبادة الجماعية، كان لا بد من نافذة نطل منها على شيء مختلف، نافذة تُعيد بعض التوازن الداخلي، وتمنحنا شعورًا بأننا ما نزال أحياء.
العمل والتعليم والتواصل مع الطلبة كان نوعًا من “الهروب إلى الأمام”، لكنه كان هروبًا إيجابيًّا. ليس من الواقع، بل في اتجاه الأمل. كنت أضع روحي على حافة نافذة العمل الأكاديمي لأرى شيئًا أجمل من هذا الركام: طالب يتفاعل، وحوار علمي يشتعل، وحياة تُسترد من بين الركام.
كما أن الإصرار على الاستمرار لم يكن مجرد موقف شخصي، بل هو جزء من تمسكي بهذه الأرض، وبالحياة، وبقناعتي العميقة أن الوجود في غزة لا يجب أن يكون مجرد صمود سلبي، بل فعلًا إيجابيًّا مقاومًا ومبادرًا، من موقع العلم والتعليم.
وأما بخصوص الأثر في الزملاء والطلبة، فأستطيع القول إنه كان لإصراري فعل إيجابي ونقطة إشعاع نقلت الطاقةَ الإيجابيةَ إلى من حولي. حاولت دائمًا أن أدفعهم إلى الخروج من دوائر الإحباط والسوداوية التي فرضتها حرب الإبادة، وأن أفتح لهم نافذة أمل كما فتحتها لنفسي.
كان التأثير نسبيًّا ومتفاوتًا، كما هو الحال في كل البيئات البشرية، فتأثر بعض الزملاء تأثرًا كبيرًا، وتأثر بعضهم الآخر جزئيًّا، لكن في كل الأحوال شعرت أن الرسالة وصلت، وأن روحي المقاومة انعكست – ولو جزئيًّا – على محيطي الأكاديمي.
كيف تقيِّم هذه التجربة: هل استطاع التعليم العالي في غزة أن يصمد ويؤدي دوره على الرغم من الحرب؟
أستطيع القول بثقة إننا، على مستوى التجربة التعليمية، حقَّقنا إنجازًا نوعيًّا واختراقًا مهمًّا في وجه هذا الواقع الكارثي. أن نعيد الحياة إلى العملية التعليمية في ظل حرب إبادة ومجزرة يومية هو بحد ذاته إنجاز كبير.
كنا نُكمل المسِيرة بينما تحيط بنا كل مفردات البؤس الإنساني، والقصف، والقتل، والجوع، والنزوح، والخوف، والانهيار النفسي والمعنوي. وعلى الرغم من ذلك، اخترنا أن نستمر، أن نمنح طلابنا بارقة أمل في مستقبل أفضل، أن نقول لهم: ما زال ثمة ما يستحق الحياة، وما زال بالإمكان التشبث بالحلم.
لم يكن التعليم هنا مجرد نشاط أكاديمي، بل كان فعل مقاومة ونافذة نجاة. كل محاضرة، وكل تواصل مع طالب، كان بمثابة تجسيد لإرادة الحياة. فاستمرار العملية التعليمية لم يوفِّر محتوى علميًّا فقط، بل حافظ على حبل الحلم مشدودًا في قلوب كثير من الطلاب الذين ما يزالون يؤمنون بالغد، ويريدون أن يعيشوا، ويأملون أن يكونوا جزءًا من مستقبل مختلف.
ولذلك، فإن التعليم في هذا السياق كان وما زال دافعًا حقيقيًّا للبقاء. إنه فرصة لاكتساب معنى جديد للحياة، وسط الدمار والتنكيل الذي نقترب من عامين كاملين على بدايته. فمَن نجا من الموت يكون قد حقق إنجازًا، ومَن واصل تعليمه على الرغم من كل شيء يكون قد دافع عن حلمه، عن نفسه، وعن شعبه.
من هنا، فإن استكمال العملية التعليمية في ظل هذه الظروف لم يكن خطوة رائعة فحسب، بل كان ضرورةً إنسانيةً ووطنيةً وأخلاقية.
كونكم تدرِّسون تخصصًا حساسًا كالعلاقات الدولية والدبلوماسية، كيف لاحظتم تفاعل الطلبة مع هذا المجال في ظل الحرب؟ وهل لمستم تغيُّرًا في وعي الطلبة أو إدراكهم لدور تخصصهم، خاصةً بعد ما شاهدوه من أداء المجتمع الدولي ومؤسسات القانون الدولي؟
ما يمكنني قوله بثقةٍ أن الطلبة الذين أدرُّسهم اليوم – ونحن في الفصل الخامس من التعليم في خلال الحرب – فاجأوني بدرجة تفاعلهم الإيجابي واللافت، على الرغم من كل ما يمرون به من ظروف قاسية.
جزء كبير منهم، خاصةً في برامج الدراسات العليا، يتمتع بمستوى معرفي ونفسي متميز، وأستطيع القول إنهم من بين أفضل من مرُّوا عليَّ في تجربتي الأكاديمية الممتدة لما يقارب العشرين عامًا.
وجدت أمامي نماذج طلابية ذات طموح كبير؛ تتابع بجدية، وتحلِّل بوعي، وتُقبِل على التخصص بروح مسؤولة، وهو ما أذهلني فعلًا بصفتي أكاديميًّا. شعرت بأننا أمام طاقات واعدة، يمكن أن تُشكِّل إضافةً نوعيةً لمستقبل الشعب الفلسطيني في مجالات السياسة والعلاقات الدولية.
وأما على صعيد الوعي، فقد لمست تطورًا حقيقيًّا لدى الطلبة في فهم طبيعة تخصصهم ودوره، خاصةً في ظل ما يشاهدونه من أداء المجتمع الدولي، ومواقف المنظمات الأممية، ومحدودية فعل القانون الدولي تجاه المأساة في غزة. هذا كله جعلهم يعيدون التفكير في كثير من المفاهيم، ويطوِّرون وعيًا نقديًّا أكثر نضجًا، ويطرحون أسئلة عميقة حول التوازنات الدولية، والمعايير المزدوجة، والأدوات الدبلوماسية الفعالة.
أعتقد أن هذه التجربة القاسية – على الرغم من مرارتها – شكَّلت حالةً تعليميةً وتحليليةً غير تقليدية، ومنحت التخصص أبعادًا واقعيةً ومعايَشةً ميدانية، ستُرافقهم علميًّا وإنسانيًّا، في خلال الحرب وما بعدها.
أخيرًا، ما الذي تطالِب به المجتمع الأكاديمي الدولي تجاه ما يتعرض له التعليم في غزة؟
في الحقيقة، وصلتنا في خلال الفترة الماضية عدة اتصالات من أطراف دولية، وأجريتُ مؤخرًا حوارًا مع صحيفة لوموند الفرنسية حول هذا الموضوع تحديدًا. وأستطيع أن أقولها بوضوح: لسنا بحاجة إلى دعم معنوي أو كلمات تضامن فارغة، أو حتى دعاء أو صلوات لأجلنا. من يريد لنا أن نعيش ونستمر، عليه أن يقدِّم دعمًا حقيقيًّا وملموسًا.
قطاع التعليم في غزة، وخاصةً التعليم العالي، يحتاج إلى مقومات مادية عاجلة، تُعيد إليه القدرة على الاستمرار والتأثير. لا يمكننا أن نُطوِّر أداءنا أو نوسِّع مساهمتنا بينما الجامعات مدمَّرة، و”السيرفرات” مفقودة، والبنية التحتية منهارة. نحتاج إلى دعم مباشر يُوفر الإنترنت، والمعدات، والأماكن المناسبة للتدريس، فضلاً عن الشروع الجاد في عملية إعادة إعمار المؤسسات التعليمية.
ليس المطلوب مجرَّد التضامن، بل إن المطلوب إسهام فعلي في إعادة بناء بنية تحتية تعليمية تمكِّننا من النهوض من بين الأنقاض.
وعلى المستوى السياسي، فإن على المجتمع الدولي والأكاديمي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية، وأن يضغط لوضع حدٍّ لهذا الاحتلال المجرم، الذي يضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. لا يمكن استمرار هذه الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، ويجب أن يكون التعليم أحد خطوط الدفاع الأولى عن الحياة والكرامة والحق في المستقبل.