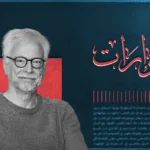ترجمة وتحرير: نون بوست
في الثاني من أبريل/ نيسان، ألغت جمعية استكشاف إسرائيل فجأةً ما كان سيُصبح أكبر وأعرق تجمع سنوي لعلماء الآثار في البلاد؛ حيث أُلغي المؤتمر الأثري، وهو حدث سنوي يُعقد منذ ما يقرب من 50 عامًا، من قِبل منظميه إثر ضغوط مارسها وزير التراث اليميني المتطرف، عميخاي إلياهو، لاستبعاد الأستاذ في جامعة تل أبيب رافائيل (رافي) غرينبرغ، وكتب الوزير على منصة “إكس”: “لن أسمح لعشاق الأكاديميا الذين يعملون على الترويج لمقاطعة زملائهم من علماء الآثار بأن يبصقوا في بئر التراث الذي يشرب منه شعب إسرائيل”.
في نظر إلياهو والمنظمات غير الحكومية اليمينية التي حرضت على استبعاد غرينبرغ، كانت أبرز إهانة لهم من قبل غرينبرغ هي رسالة مفتوحة كتبها قبل شهر، حث فيها زملاءه الإسرائيليين والدوليين على مقاطعة “المؤتمر الدولي الأول حول الآثار والحفاظ على المواقع في يهودا والسامرة” في فندق دان القدس الفاخر في النصف الشرقي من المدينة، وهو المؤتمر الأول من نوعه الذي يًعقد في أرض محتلة معترف بها دوليًّا.
ورغم انعقاد المؤتمر الأثري في نهاية المطاف عبر الإنترنت الأسبوع الماضي بمشاركة غرينبيرغ، إلا أن الجدل الذي أحاط بالمؤتمرين يثير أسئلة أخلاقية وسياسية أعمق حول دور مجتمع الآثار في إسرائيل، في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل هجومها على التراث الثقافي الفلسطيني والمواقع الدينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتتحرك الحكومة نحو ضم الضفة الغربية، وذلك من خلال استخدام علم الآثار نفسه كسلاح.
وفي مايو/ أيار، بدأت وزارة التراث الإسرائيلية رسميًا أعمال التنقيب في سبسطية، شمال نابلس بالضفة الغربية، بهدف تحويل الموقع إلى “حديقة شومرون الوطنية”، مما يفصل الأكروبوليس والقرية القديمة عن البلدة الفلسطينية التي ترتبط بها.
غير أن التطور الأكثر أهمية بدأ في يوليو/تموز 2024، عندما قدّم عضو الكنيست أميت هاليفي من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو تعديلًا تشريعيًا يهدف إلى تطبيق قوانين الآثار الإسرائيلية على الضفة الغربية، ويهدف التشريع المقترح تحديدًا إلى توسيع نطاق اختصاص سلطة الآثار الإسرائيلية من إسرائيل إلى المنطقة (ج) من الضفة الغربية، أي حوالي 60 بالمئة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويمثل مشروع القانون تتويجًا لحملة استمرت خمس سنوات شنتها المجالس الإقليمية للمستوطنين وجماعات اليمين المتطرف لتصوير الفلسطينيين على أنهم تهديد وجودي لما يُسمى مواقع التراث “الوطني” (أي اليهودي) في الضفة الغربية، ووصفت منظمة “عيمك شافيه” الإسرائيلية غير الحكومية اليسارية هذا التشريع بأنه “تجربة لتحقيق الضم من خلال الآثار”.

ربما أبطأت المقاومة التي واجهتها سلطة الآثار الإسرائيلية لتوسيع نطاق نفوذها في الضفة الغربية من زخم هذا التوجه، لكنها لم تُعرقل الهدف الأكبر. وفيما يبدو أنه تحول إستراتيجي؛ اقترح المشرّعون في اجتماعات اللجان الأخيرة تشكيل هيئة جديدة تابعة لوزارة التراث لإدارة الأنشطة في جميع أنحاء الضفة الغربية، وليس فقط في المنطقة “ج”، حيث تتجنب هذه الخطوة الجدل الدائر مع السعي لتحقيق نفس النتيجة: فرض القانون المدني الإسرائيلي على آثار الضفة الغربية.
في الواقع، واجه هذا الحل البديل ردود فعل أضعف بكثير من المؤسسة الأثرية، باستثناء “عيمك شافيه”، التي شارك في تأسيسها غرينبرغ، وتركزت مقاومة المجتمع الأثري للتشريع المقترح بشكل كبير على آثاره على علم الآثار الإسرائيلي وسمعة إسرائيل الدولية.
وناقشت مجلة “+972″ غرينبرغ حول ما قد يعنيه هذا التشريع الأخير بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية – وهو ما أغفله بعض أشد المعارضين علنًا – الذين يعانون بالفعل من مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين المدعوم من الدولة. كما بحثنا العلاقة المشحونة بين علماء الآثار الإسرائيليين والفلسطينيين، و”تسييس” علم الآثار الإسرائيلي، والمناشدات الليبرالية للحرية الأكاديمية، ولماذا لا يتحدث لدى علم الآثار الإسرائيلي عن تدمير غزة.
تم تحرير المقابلة من أجل الطول والوضوح.
بدايةً، هل تعتبر تأجيل مؤتمر الآثار في أبريل/ نيسان، بعد أن حرض وزير التراث على منع مشاركتك، تطورًا إيجابيًا أم سلبيًا؟
لطالما كانت علاقتي بالمجتمع الأثري معقدة منذ عقود، لأني كنتُ شديد الانتقاد لما أسميه التراث الاستعماري لعلم الآثار الإسرائيلي، لكن هذا المؤتمر نُظم من قِبل مجموعة من علماء الآثار الشباب، وكان في الواقع فرصةً للحديث – ولو لبضع دقائق – عن بعض القضايا الحساسة في سياقٍ أثريٍّ بحت.
كنتُ سأتحدث عما أسميه أنا وعالم الآثار اليوناني والأستاذ بجامعة براون، يانيس هاميلاكيس، “إضفاء طابعٍ أثريٍّ” على اليونان وإسرائيل، هاتان دولتان اللتان قدّرهما الغرب منذ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لأجل ماضيهما. وتاريخيًا، دفع هذا الغرب، ومن بعده الحركة الصهيونية، إلى التقليل من شأن كل من كان يعيش فيهما ممن يُفترض أنهم لم يكن لديهم فهمٌ صحيحٌ للماضي.

كان ادعائي في الورقة البحثية التي كنت سأقرأها في المؤتمر هو أن علم الآثار لعب دورًا في “تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم”، وأن الأمر لم يبدأ بعلم الآثار الإسرائيلي، بل بعلم الآثار الاستعماري الأصيل في القرن التاسع عشر، أي علم الآثار البريطاني والألماني والفرنسي، ثم ورث الإسرائيليون ذلك [الإرث]، وبصفتهم مستعمرة استيطانية، كان من المناسب الاستمرار في التمسك بهذه النظرة.
هذا النوع من النهج البدائي لعلم الآثار هو ما يُحفّز جماعات المستوطنين وأشخاصًا مثل وزير التراث الإسرائيلي. فمن وجهة نظرهم، فإن من يرتبطون بآثار محددة من عصور وثقافات محددة هم وحدهم من لهم الحق في البلاد، بينما لا حق للآخرين في الأرض، ولا في آثارها، ولا في أي شيء.
لذا، كان قبول ورقتي البحثية مفاجأة سارة بالنسبة لي؛ فقد كانت هذه فرصة لعرضها على المجتمع الأثري، الذي لا يرغب عمومًا في الحديث عن هذه القضية. وفي الوقت نفسه، أدى ذلك إلى صدام بين منظمي المؤتمر والمحرضين اليمينيين، الذين أدرجوني على القائمة السوداء لديهم منذ فترة طويلة.
غير أن سياق الصدام بين وزير التراث ومنظمي المؤتمر تردد صداه في صراع أوسع نطاقًا في إسرائيل بين ما يُسمى بالقوى المؤيدة للديمقراطية وما يُسمى بالقوى الاستبدادية أو الإثنوقراطية، ونظرًا لأن عددًا كبيرًا جدًا من علماء الآثار ينتمون إلى المعسكر الديمقراطي الليبرالي، فقد أصبح المؤتمر بالنسبة لهم قضية تتعلق بالحرية الأكاديمية وحرية التعبير.
ولهذا السبب، كان من السهل على معظم زملائي في علم الآثار [ومنظمي المؤتمر] الوقوف في صفي، أو – كما كتب لي أحد طلابي السابقين عبر واتساب – ” إنهم يصرون على حقهم في عدم الاستماع إليك، وأن يتمكنوا من اتخاذ قرار تجاهلك”، ولم يكونوا ليسمحوا لوزير التراث باتخاذ هذا الخيار نيابةً عنهم.
ومع أن الجلسة التي قدمتُ فيها عرضي الأسبوع الماضي حظيت بحضور جيد؛ حيث شارك فيها أكثر من 120 شخصًا، إلا أنها كانت استراحة قصيرة لمدة 15 دقيقة في ما كان يُعتبر في العادة فقاعة معزولة؛ حيث قُرئت حوالي اثنتي عشرة ورقة بحثية حول حفريات الضفة الغربية والقدس الشرقية من قِبل جامعة تل أبيب وباحثين آخرين أو باحثين من جامعة أرييل [في مستوطنة أرييل بالضفة الغربية]، وهي أوراق تُستبعد من معظم المحافل الدولية، كما استُبعد باحث من جامعة أرييل من المؤتمر العالمي للآثار خلال الأسبوع نفسه.

تزعم المنظمات الاستيطانية اليمينية غير الحكومية في حججها لتوسيع نطاق سلطة الآثار الإسرائيلية لتشمل الضفة الغربية أن الفلسطينيين في الضفة الغربية لا يجيدون العناية بالآثار الموجودة بينهم، بل يعمدون إلى تدميرها وتخريبها وسرقتها. هل يمكنك مناقشة التحركات التشريعية الجارية حاليًا في الكنيست لتوسيع نطاق سلطة الآثار الإسرائيلية؟ وما علاقتها بالضم؟
إن الفكرة التي ذكرتها عن عدم اهتمام السكان المحليين بالآثار أو تدميرها قديمة قدم علم الآثار نفسه، أما هنا في إسرائيل، فلديك تلك الطبقة الإضافية مما يعتبره المستعمرون الاستيطانيون حقًا إلهيًا وتاريخيًا في الأرض.
لكن خطوة توسيع نطاق سلطة الآثار الإسرائيلية لتشمل الضفة الغربية هي خطوة سياسية إلى حد كبير، لأن المستوطنين لا يهتمون حقًا بعلم الآثار. في الواقع، كانت الصهيونية بطيئةً جدًا في تبني علم الآثار في إسرائيل كوسيلةٍ “لإثبات صلةٍ يهوديةٍ بالأرض”، لأن الآثار “اليهودية” هنا في إسرائيل ليست مثيرةً للإعجاب أو واضحةً جدًا، ولا يوجد منها إلا القليل.
إنها ليست مثل المعابد اليونانية التي، كما يقول زميلي يانيس هاميلاكيس، مثل الهياكل العظمية في جميع أنحاء اليونان؛ يمكنك أن ترى وتشير إلى الرخام الأبيض والأعمدة في كل مكان. أما في إسرائيل، فمعظم الآثار التي تراها ليست يهودية، وإذا تجولت في الريف ورأيت مبنى مهدمًا أو قلعة، فمن المرجح أن يكون إسلاميًا أو مسيحيًا أو أي شيء آخر.
لذا، لا يمنح علم الآثار للمستوطنين صلة واضحة بالمكان، لكنهم مع ذلك يدعون أن الضفة الغربية بأكملها، تحت السطح، تُشكّل جزءًا أساسيًا من التاريخ اليهودي، وأنها المكان الذي كُتبت فيه التوراة.
عندما كنتُ منهمكًا في فهرسة جميع المواقع الأثرية المعروفة والمُنقّب عنها في الضفة الغربية، وحاولتُ لاحقًا ترجمة ذلك إلى خريطة للمواقع التراثية، لم يكن من الممكن هناك سوى قلة من المواقع التي يمكن أن تُنسب بشكل يقيني إلى جماعة عرقية أو دينية محددة. فمعظم المواقع انتقائية؛ إذ تضم آثارًا سبقت اليهودية بآلاف السنين، كما تضم آثارًا تعود إلى ما بعد عهد الاستقلال اليهودي في فلسطين [القديمة]، من مختلف فترات السلالات الإسلامية والسيطرة مسيحية.

إذا نظرتَ إلى أي جزء من تاريخ إسرائيل وفلسطين، في أي لحظة زمنية، فلن تجد ثقافة متجانسة واحدة على امتداد المشهد، فلا يوجد وقت كان فيه جميع سكان هذا البلد يهودًا أو مسلمين أو مسيحيين أو أي شيء آخر. علم الآثار، في جوهره، لا يوفر ذلك النوع من اليقين والنقاء الذي قد يرغب فيه وزراء الحكومة اليمينية الإثنوقراطية، لذا، كان عليهم أن يخترعوه، ثم يقولون إن الفلسطينيين يُلحقون الضرر بهذا “التراث اليهودي الحصري”، ثم يستخدمون هذا كوسيلة للاستيلاء على المزيد من الأراضي.
لذا، لدى المستوطنين هذه النظرة العملية لما يمكن أن يقدمه لهم علم الآثار، فالأمر بالنسبة لهم لا يتعلق بالآثار على الإطلاق، بل يتعلق باستخدام الآثار بفعالية كوسيلة أخرى للاستحواذ على العقارات. في “عيمك شافيه”، نُطلق على هذا الأمر علم الآثار كسلاح أو “نموذج إلعاد“، نسبةً إلى ما حدث في حي سلوان في القدس الشرقية. هناك؛ لم يستحوذ المستوطنون اليهود على منازل فلسطينية فحسب، بل على مساحات شاسعة من المساحات الأثرية الفارغة، وبربط المنازل التي استولوا عليها بالمنطقة الأثرية، سيطروا على كامل سلوان، أو على الأقل على حي وادي حلوة. إن نموذج إلعاد هو ما يسعى المستوطنون إلى غرسه في الضفة الغربية.
يبدو أن علم الآثار يُستغلّ بالطريقة نفسها التي استغلت بها مناطق إطلاق النار والمحميات الطبيعية وإعلان أراضي الدولة كسلاح ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في العقود التي تلت حرب عام 1967 وما تلاها من احتلال إسرائيلي للضفة الغربية
بالضبط.
يُصنّف موقع “عيمك شافيه” هذه التحركات التشريعية كخطوة أخرى نحو ضم الضفة الغربية. وللردّ على هذا، ألم تضمّ إسرائيل الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع بالفعل؟ حيث تخضع المواقع الأثرية في الضفة الغربية اليوم لسلطة الإدارة المدنية (فرع من الجيش الإسرائيلي)، لذا توجد بالفعل هيئة إسرائيلية تُعنى بالآثار في الضفة الغربية. وقد توغلت سلطة الآثار الإسرائيلية، التي يُفترض أن تعمل فقط داخل إسرائيل، في الضفة الغربية. فهل هذه المساعي التشريعية رمزية في معظمها؟ وكيف تُمثّل تغييرًا جوهريًا في الوضع الراهن؟
إن الطريقة التي سارت بها الأمور حتى الآن – وهي أن الإدارة المدنية الإسرائيلية لديها منشأة أثرية خاصة بها في المنطقة “ج” من الضفة الغربية، منفصلة عن إسرائيل – كانت مريحة للغاية بالنسبة لأصدقائي الأكاديميين الإسرائيليين [الليبراليين]. جميع الأعمال الأثرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تتم في إطار قانوني يحظى أحيانًا بموافقة المحكمة العليا الإسرائيلية، التي تنص على أن الاحتلال الإسرائيلي وضع مؤقت، وأن الإدارة المدنية قائمة فقط لتعزيز مصالح سكان تلك المنطقة حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي. لذا، يمكن للباحثين من الجامعة العبرية وجامعة تل أبيب وجامعة حيفا التأكيد على أن عملهم في الضفة الغربية قانوني لأنه متوافق مع القيود التي فرضتها الإدارة المدنية الإسرائيلية عليهم.
والآن، فإن هذه المبادرة لتسليم الضفة الغربية إلى سلطة الآثار الإسرائيلية تكشف زيف ادعاءاتهم، فسلطة الآثار الإسرائيلية تقوم عمليًا بضم آثار الضفة الغربية إلى إسرائيل، ومن ثم سيُطبق القانون الإسرائيلي على تلك المواقع، ومن ثم فإن أي شيء تفعله في الضفة الغربية سيكون بمثابة اعتراف بقانون الضمّ هذا، وهذا يضع الأكاديميين وهيئة الآثار الإسرائيلية في موقف غير مريح للغاية.
كتب نير حسون في صحيفة هآرتس أن مشروع القانون الحالي لتوسيع نطاق سلطة الآثار الإسرائيلية “يُحوّل علم الآثار الإسرائيلي رسميًا إلى معول للتنقيب لتعزيز نظام الفصل العنصري”. لقد كتبتَ بإسهاب عن علم الآثار الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ عام 1967. كيف كانت علاقة علم الآثار الإسرائيلي بهذه الأرض المحتلة قبل العقود القليلة الماضية؟
أعتقد أن هذه النظرة إلى علم الآثار الإسرائيلي تنتمي في الواقع إلى الأسس الاستعمارية للصهيونية، ولإسرائيل نفسها، ومن الأمور المُسلّم بها في هذه النظرة الاستعمارية للعالم أنه “إذا كنا نحب الآثار، وكل ما نريده هو الكشف عن آثار الـ 3000 أو 10000 عام الماضية، فلماذا لا يُسمح لنا بذلك؟ فنحن نمثل العلم والثقافة والتقدم”.
أُصِرّ على قول هذا لأن العلماء أو المنقّبين الوافدين خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كانوا يحتقرون السكان على حد سواء المسلمين والمسيحيين واليهود الذين التقوا بهم هنا، باعتبارهم ممثلين لماضٍ يجب تجاوزه بالعلم. فبالنسبة لهؤلاء، كان التنقيب عن الآثار يُعدّ ببساطة الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به، في كل مكان.

أودّ أن أؤكد أن “مصادرة أملاك الفلسطينيين على يد علم الآثار الإسرائيلي” يُقدم في كثير من الأحيان على أنه مجرد قيام علماء آثار إسرائيليين بالتنقيب عن آثار يهودية لتبرير استيلاء اليهود على الأرض. غير أن المسألة أعمق من ذلك؛ فكلّ عمل نقوم به، سواء في موقع يعود إلى العصر البرونزي أو إلى العصر الحجري الحديث، يُعتبر عملًا نبيلاً فقط لأننا نقوم به باسم العلم.
ويعتبر التشريع الأخير محرج لأولئك الذين يؤيدون هذا الرأي، لأن علم الآثار أصبح فجأة يُوصَف بأنه “مسَيّس”، وكأنّه لم يكن كذلك من قبل. لقد حاولت على نحو متزايد أن أوضح لزملائي، وللناس عمومًا، أن هذا الموقف المترف والمزعوم بأنه غير سياسي، هو في حدّ ذاته موقف سياسي. فالأمر لا يتم بأن يستيقظ أحدهم صباحًا ويتساءل: كيف سأستخدم علم الآثار للسيطرة على هذا التل أو هذا الوادي؟ بل إن الأمر يشبه أكثر ما يكون بحالة تُفتَح فيها مثلًا الحدود مع سوريا، ويُكتشف موقع رائع من العصر البرونزي المبكر، فيذهب عالم الآثار في عطلة نهاية الأسبوع لتفقّد الآثار قرب القنيطرة. أنا أتحدث هنا بشكل افتراضي، لكن لن يفاجئني إن كان هذا قد حدث بالفعل.
وفي العبرية يُقال “بوعل يوتسيه”؛ أي “الأمر يأتي مع الأراضي”. وهذا ما يحدث بالضبط: عندما تحتل إسرائيل مكانًا ما، لا يلبث علماء الآثار أن يتبعوها، أحيانًا في غضون أيام قليلة فقط.
يبدو أن ما نشهده الآن هو نوع صارخ للغاية من إستراتيجية الاستيطان الرامية إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي في الضفة الغربية.
نعم، إذا دقّقت النظر في منطقة غور الأردن، على سبيل المثال، ستجد أن لعلم الآثار دورًا هناك. ومرة أخرى، هؤلاء علماء الآثار يزعمون أنهم موجودون فقط من أجل العلم. ومن المصادفة، على ما يبدو، أن يكون موقعهم العلمي بجوار بؤرة استيطانية. وهكذا يصبح الأمر جزءًا من الحصار “للأراضي الفلسطينية”، أي محاصرة الرعاة الفلسطينيين والقرى الصغيرة بأشياء تُمثّل السلطات الإسرائيلية.
هناك بعض المواقع الأثرية المحددة في غور الأردن، وأنا واثق أنه إذا سألت المُنقّب هناك فسيقول: “أوه، هذا الموقع خضع لمسح أثري قبل عشرين سنة، ووجدوا فيه قطع فخارية تعود إلى العصر الحديدي. وهذا بالضبط ما يهمني. وتصادف أنني من جامعة أرئيل [الواقعة في الضفة الغربية المحتلة]، لكننا لسنا جهة سياسية، نحن فقط نبحث في الآثار.”
وفي مرحلة ما، يمكنني أن أتفهم أن زميلي في جامعة تل أبيب، المتخصص في الحقبة الرومانية والذي لا يقرأ النظريات الاجتماعية أو السياسية، قد لا يدرك الدور الذي تلعبه أبحاثه اليومية في علم آثار العصر الروماني ضمن مشروع استعماري. لكن هل يمكن لشخص يُدرّس في جامعة أرئيل ويقوم بالتنقيب في الضفة الغربية أن يساء فهم دوره؟ أعتقد أن الأمر لا يكون إلا تجاهلًا متعمدًا.

بالنظر إلى أن الطابع الاستعماري في علم الآثار الإسرائيلي يسبق احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، هل يمكنك أن تتحدث قليلًا عن ممارسات علم الآثار داخل ما يُعرف بـ”إسرائيل” نفسها، وكيف تعامل علماء الآثار الإسرائيليون مع التاريخ الفلسطيني خلال القرون القليلة الماضية؟
كانت الجامعة العبرية في القدس تحتكر علم الآثار حتى سنة 1967. وفي ذلك الوقت، كان هناك منهاج دراسي راسخ يقسم علم الآثار إلى عصور ما قبل التاريخ والفترة التوراتية والحقبة الكلاسيكية. وقد قبل جميع علماء الآثار الإسرائيليين بهذا الإطار ودرسوا ضمنه. وعندما أُنشئت الجامعات البحثية الجديدة في السبعينيات، تبنّت المنهاج نفسه تقريبًا، الذي يمتد بالتعليم حتى العصر البيزنطي تقريبًا. وكان يُسمح للطالب باختيار تخصصين، على أن يكون أحدهما بالضرورة في الفترة التوراتية.
وهذا يعني أن علم الآثار التوراتي كان هو المبرر الأساسي لوجود علم الآثار الإسرائيلي. ولم يكن هناك ما يُعرف بعلم الآثار الإسلامي؛ ففي الجامعة العبرية، لم يتجاوز الأمر وجود نشاط محدود أشبه بورشة صغيرة متخصصة في الفنون الإسلامية.
وهذا التركيز على الآثار التوراتية – القصص التوراتية، والمواقع المذكورة في الكتاب المقدس، والجغرافيا التوراتية – يجعل الحاضر والقرون القليلة الماضية بلا أهمية تُذكر. وحتى قبل 30 أو 40 سنة، كان ذلك يعني أنه عند إجراء الحفريات في المواقع القديمة، إما أن يتم تجاوز الطبقات العلوية بسرعة، أو في بعض الأحيان تُزال بالكامل من دون أي توثيق، ولم يعد ذلك يُعتبر ممارسة مقبولة اليوم.
كنت أفهم دائمًا هذا “الإغفال للتاريخ الحديث في السجل الأثري” من منظور نظري، لكن من خلال مشروعين شاركت فيهما مؤخرًا، وصلت إلى فهم أكثر حسيًّا وملموسًا لما يعنيه ذلك فعليًا. كان أولهما مشروعًا عملت فيه مع أستاذ تاريخ الفن وعالم الآثار في الجامعة العبرية، توفيق دعادلي، في موقع بيت يرح، أو أسينابرا [قرب بحيرة طبريا]. لقد خضع هذا الموقع للتنقيب مرارًا وتكرارًا، وتمّ التعريف به بشكل خاطئ كموقع روماني أو يهودي، لكن تمكنا أنا وتوفيق من إعادة تعريفه على أنه قصر أموي يعود إلى القرنين السابع والثامن الميلاديين. ولم يتبقَّ من القصر سوى الأساسات، لذلك كانت هناك عوائق موضوعية حالت دون فهم طبيعة الموقع الحقيقية.

أمضينا موسمين قصيرين في أعمال التنقيب، وكان جميع العمّال المأجورين من الفلسطينيين الناطقين بالعربية من الجليل، لذا كانت العربية هي لغة العمل في الموقع، ورغم أن لغتي العربية محدودة للغاية، لكنني، بالتعاون مع توفيق وعالم الآثار دونالد ويتكومب من جامعة شيكاغو، بدأت بدراسة الفترة الأموية وما قد تبدو عليه المساجد في ذلك العصر، وكانت تلك أول محاولة لي للخروج من النطاق المألوف.
والمحاولة الأحدث كانت في قرية قادس، وهي قرية فلسطينية هجّر سكانها سنة 1948 عندما احتلها الجيش الإسرائيلي وقوات جيش التحرير العربي بشكل متقطع، وفرّ السكان وأصبحوا لاجئين في لبنان. ولكي أفهم ما أقوم به هناك في قادس، كان عليّ أن أنخرط مع عدد كبير من الأشخاص لم يسبق لي الحديث معهم من قبل: باحثين في شؤون الشرق الأوسط، وسكان شيعة من تلك المنطقة في الجليل، وأشخاص يمكنهم أن يحدّثوني عن معارك سنة 1948 وجيش التحرير العرب، وفتحنا الأرشيفات الإسرائيلية؛ فتحوّلت العملية إلى دراسة شاملة للسياق الكامل لهذا التنقيب.
كان هذا شرحًا مطوّلًا جدًا لتوضيح السبب في أنه، عندما لا يكون هناك منهج أكاديمي أو أساس فكري يوجّه عملية التنقيب، فإنها تكون بلا معنى. فقط عندما أحوله إلى محورٍ للدراسة هو ما يُكسبه قيمة أثرية حقيقية.
وعلاوة على ذلك، فإن قوانين الآثار الإسرائيلية لا تنطبق إلا على المواقع أو القطع التي يعود تاريخها إلى ما قبل سنة 1700. أما ما يعود إلى فترات أحدث، فحتى لو جرى التنقيب عنه بطريقة أخلاقية، فلم يُفسَّر أو يُعرض يومًا بشكل ذي دلالة حقيقية.

لنعُد إلى الحاضر: كيف تفهم التناقض بين معارضة التشريع الذي يوسّع صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية لتشمل الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه المشاركة في المؤتمر الذي عُقد في فندق دان القدس الواقع في الجزء المحتل من المدينة؟
عندما يشارك أحد من جامعتي في ذلك المؤتمر، فقد يكون الهدف الترويج لطالب دراسات عليا أجرى تنقيبًا هناك، أو السعي للتقدّم المهني ونشر أبحاثهم. وربما يكونوا قد حصلوا على تمويل حكومي، ويرغبون في إظهار أنهم ليسوا في موقف عدائي تجاه الحكومة، على أمل أن يستمر الدعم المالي.
إن علم الآثار مجال مكلف للغاية، ويعتمد على الدعم الخارجي، والناس يتردّدون في معارضة الحكومة. لا داعي للبحث بعيدًا؛ انظر فقط إلى ما يحدث في أمريكا الشمالية. نحن، في اليسار الإسرائيلي، مذهولون من السرعة التي انهارت بها الجبهة الليبرالية في جامعات “آيفي ليغ” الأمريكية، ومن سرعة تخلّي الناس عن قناعاتهم في محاولة للتقرّب من الحكومة الأمريكية. إنها في الحقيقة الآلية نفسها هنا في إسرائيل؛ فالمسألة تتعلّق بمركز القوة.
ويبدأ الناس بالمناورة، فيقولون: “حسنًا، سيكون اسمي على المحاضرة، لكنني لن أُلقيها بنفسي. لن أحضر المؤتمر فعليًا، لكنني سأمنحه موافقتي الضمنية من خلال مشاركتي فيه. فالأمر في نهاية المطاف لخدمة العلم.” وأعتقد أن قلة قليلة جدًا فقط هي من ستقول صراحة: نعم، نحن نؤيد الضم والاستيطان اليهودي غير القانوني.
ولا أعتقد أن المؤتمر في القدس الشرقية المحتلة بحد ذاته على هذه الدرجة من الأهمية، وما صدمني أكثر هو مشاركة باحثين من الأكاديمية النمساوية للعلوم ومن جامعة مانيتوبا، أكثر من مشاركة الإسرائيليين أنفسهم.
كيف تفاعلت الأوساط الأثرية في إسرائيل مع الدمار الذي لحق بغزة خلال السنة ونصف السنة الماضيتين؟ والآن، بعد أن بدأ الخطاب، على الأقل لدى الليبراليين الإسرائيليين، يتحوّل من دعم غير نقدي إلى اعتبار الحرب “حربًا اختيارية” – حربًا من أجل بقاء نتنياهو سياسيًا – هل تغيّر الموقف تبعًا لذلك؟
لم يكن هناك أي رد فعل على الإطلاق، فلم تصدر أي جهة بيانًا رسميًا باستثناء منظمة “عيمك شافيه”. في بداية الحرب، أنشأنا مجموعة للمتابعة، ضمّت بعض الأشخاص من “عيمك شافيه”، إضافة إلى دوتان هاليفي وتوفيق دعادلي، وحاولنا رصد تدمير التراث الثقافي. وبعد ذلك، نشرنا أنا وشريكي في إدارة “عيمك شافيه”، ألون أراد، مقال رأي تناولنا فيه ظاهرة التدمير الشامل، وكيف ننظر نحن، كعلماء آثار، إلى السعي المتواصل نحو محو التراث الفلسطيني بأقصى قدر ممكن منذ سنة 1948.

لقد شارك بعض علماء الآثار بشكل علني في عمليات استعادة الرفات البشرية من الكيبوتسات، في المواقع التي تعرّضت للهجوم في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وقد جاء ذلك في إطار جهد من قبل المجتمع المدني في ظل غياب أي استجابة رسمية من الحكومة. لذا استخدم علماء الآثار خبراتهم للمساعدة بطريقة إيجابية، لكن بعض أفراد المجتمع استغلوا ذلك أيضًا لدعم الموقف الإسرائيلي والترويج لدعاية الحرب ضد حماس.
إن الأشخاص الذين كنت قد عملت معهم – وشاركوا في مناقشات أكاديمية حول كتابي مع يانيس هاميلاكيس – انسحبوا وأصبحوا جزءًا من مجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين الذين كانوا مستائين جدًا من رد فعل اليسار العالمي والمواقف المؤيدة للفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وكان هؤلاء علماء آثار ينتمون، إن صح التعبير، إلى “معسكر إيفا إيلوز“؛ حيث قالوا: “كنا نظن أننا من اليسار، لكن بعد أن رأينا ما يمثّله اليسار اليوم، لم نعد نعتبر أنفسنا يساريين.” وقد انزعجوا مني بشدة بسبب صراحتي، لكنهم لم يواجهوني بشيء بشكل علني، وهو أمر معتاد في هذا السياق.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد بضعة أسابيع من بدء الفصل الدراسي الخريفي في جامعة تل أبيب، بدأت إضرابًا يوميًا حيث كنت أقف، ومعي عدد قليل من الأشخاص، على عشب الجامعة حاملين لافتات تندّد بالحرب. ومع مرور الوقت، انضم إلينا آخرون، لكن العدد لم يتجاوز في أي وقت 20 أو 30 شخصًا. وكان ذلك مخالفًا لأنظمة الجامعة، وقد اقترب مني أفراد من الأمن ومشاركون في مظاهرات مضادة. ورغم صغر حجمها، شكّلت هذه الخطوة مقاومة صاخبة ولافتة.
وقال لي عدد من طلاب الدراسات العليا إن ما أفعله أمر فظيع، لأن بعض طلابي يخدمون في الجيش، في الاحتياط، وإنني بذلك أتهمهم بارتكاب جرائم حرب. وكنت أتساءل كثيرًا: من تمثّلون أنتم؟ ولماذا أنتم واثقون إلى هذا الحد بأنكم تمثّلون جميع ضباط الاحتياط؟
غير النبرة تغيّرت مع تجدّد القصف [في منتصف مارس/ آذار]. وأعتقد أن هذه هي نقطة التحوّل هنا، حقيقة أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار. ومنذ تلك اللحظة، بدأ رد الفعل الأكاديمي يتزايد بشكل كبير. وأصبح الناس أكثر استعدادًا للتعريف بأنفسهم كمعارضين للحرب. فقبل ذلك، وحتى موعد وقف إطلاق النار، لم يكن من الممكن على الإطلاق الدعوة علنًا في الحرم الجامعي إلى إنهاء الحرب؛ فقد كان ذلك يُعتبر انتهاكًا للوائح الجامعة.
إذًا، فقد تغيرت النبرة، لكن هل تتمحور معارضة الحرب بأي شكل حول الفلسطينيين ودمار غزة؟ وماذا عن زملائك في علم الآثار – كيف يتعاملون مع الدمار الكامل للمساجد والعديد من الكنائس في غزة؟
إنه سؤال أوجّهه لزملائي: أنتم غاضبون بسبب تفكيك جدار أثري في الضفة الغربية، لكنكم لم تقولوا شيئًا عن مئات المواقع التي مُسحت تمامًا في غزة.
مؤخرًا، استلمت كتابًا من زميل ألماني، وهو عالم آثار توراتي يقاربني في السن. لا أعتقد أنه أدلى بأي تصريح علني بشأن الحرب على غزة، لكنه ألّف دراسة مطوّلة من 850 صفحة تجمع كل ما هو معروف عن آثار غزة. ولم يتضمّن الكتاب أي بيان افتتاحي، باستثناء جملة تقول إننا لا نعرف ما الذي حلّ بهذه المواقع، مع تعبير عام عن الأمل في سلامة جميع الأطراف المعنية. وكل ذلك في ألمانيا [حيث تصاعد القمع ضد الخطاب المؤيد للفلسطينيين].
وهذا النوع من الاستجابة الإنسانية يُعدّ أمرًا عظيمًا؛ إنه مصدر معرفي وخدمة تُقدَّم للمجتمع. إنه يُبرز أهمية تلك الرقعة من الأرض، وتاريخها، وعمقها الحضاري، وكل ما يسعى الإسرائيليون إلى تجاهله، لكن من قام بذلك هو الباحث الألماني، وليس الإسرائيلي.
المصدر: +972