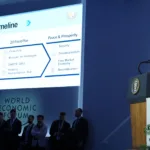بينما كانت فرنسا تتولى إدارة جزء من التراب المغربي بموجب معاهدة الحماية الموقّعة سنة 1912، خضع شمال المملكة، الممتد من حدود طنجة الدولية إلى تطوان والريف، لحماية إسبانية مستقلة، وقد اختارت مدريد مدينة تطوان عاصمة إدارية لسلطتها في المنطقة، فأنشأت فيها مقر إقامة “المقيم العام الإسباني” الذي تولّى قيادة الإدارة العليا، وتحوّلت تطوان آنذاك إلى قاعدة عسكرية كبرى، خصوصًا خلال حرب الريف ما بين سنتي 1921 و1926.
يبدأ تاريخ تطوان، أو “الحمامة البيضاء” كما يطلق عليها المغاربة، من موقعها الروماني القديم “تامودا”، ليمرّ بكونها ملاذًا أندلسيًّا للمضطهدين الفارّين من جحيم محاكم التفتيش الإسبانية، وصولًا إلى كونها اليوم نموذجًا معماريًا وإنسانيًا فريدًا وواجهةً معاصرة تُراهن على التراث كرافعة للتنمية، وذلك بعدما كانت عاصمة إدارية في ظل الحماية الإسبانية.
وقد حظيت هذه الهوية المركّبة باعتراف عالمي، حيث أدرجت اليونسكو المدينة العتيقة لتطوان ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي سنة 1997، اعترافًا بفرادتها المعمارية وتاريخها الاستثنائي، ثم عادت المنظمة نفسها سنة 2017 لتضمّ المدينة إلى شبكتها العالمية للمدن المبدعة، لما تزخر به من تقاليد حرفية وفنية.
يأتي هذا التقرير ضمن ملف “مغربية ولكن”، الذي يستعرض تاريخ عدد من المدن المغربية التي خضعت لوضعيات استثنائية إبان فترة الحماية، متتبعًا كيف انفصلت سياسيًا وثقافيًا عن محيطها الوطني، وكيف ترك الاستعمار بصماته العميقة في نسيجها العمراني وذاكرتها الجماعية، قبل أن تعود تدريجيًا إلى حضن السيادة المغربية.
إرث متراكم
يكشف تاريخ مدينة تطوان عن إرثٍ متراكمٍ كتبت فيه كل حضارة فصولها فوق ما سبقها، فتكوّنت طبقات من الرواسب الثقافية التي جعلت منها مدينةً مميّزة، وتُعَد مدينة “تامودا”، الواقعة على بُعد أميال من مركز تطوان الحالي، اللبنة الأولى للمدينة، حيث يعود تاريخ بنائها – حسب بعض الروايات – إلى القرن الثالث قبل الميلاد على يد الأمازيغ.
وقد عرفت تامودا مرحلة ازدهار اقتصادي وعسكري، قبل أن تُدمّرها ثورة إيديمون ضد الرومان، ليُعاد تشييدها لاحقًا كحصن عسكري، ثم كمستعمرة رومانية في عهد الإمبراطور أوغسطس.

أما تطوان كما نعرفها اليوم، فترجع إلى قرون لاحقة من التحولات الاجتماعية والسياسية، ففي سنة 1287، شُيِّدت بها قصبة ومسجد على يد السلطان يوسف بن يعقوب المريني، في محاولة لاستعادة السيطرة على الساحل الشمالي، ثم أعاد السلطان أبو ثابت عامر ترميمها سنة 1308، وحوّلها إلى قاعدة عسكرية مرينية يُعتقد أن هدفها كان دعم التحركات لاسترجاع مدينة سبتة التي كانت تحت التهديد الأوروبي.
ولم تسلم المدينة من ويلات الحروب؛ ففي سنة 1431 شنّت القوات القشتالية حملة عنيفة على تطوان، بدعوى أنها أصبحت مركزًا للقراصنة الذين يهاجمون السفن الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط، فتم تدمير المدينة بالكامل، وأُحرق سكانها أو بيعوا في سوق العبيد، ولم تكد تتعافى من تلك الكارثة حتى أغار عليها البرتغاليون سنة 1436، بتوجيه من بيدرو دي مينيسيس، حاكم سبتة، فدُمّرت للمرة الثانية، لتبقى مهجورة لما يقارب تسعين عامًا.
غير أن نهاية القرن الخامس عشر حملت معها صفحة جديدة؛ فمع سقوط غرناطة، اندفع آلاف المسلمين واليهود الفارّين من الأندلس نحو شمال المغرب، وكان من بينهم القائد الأندلسي علي المنظري، الذي قدّم نفسه إلى سلطان فاس، وأُعطي الإذن بإعادة بناء تطوان على أنقاضها القديمة، وهكذا دخلت المدينة مرحلة جديدة، قوامها العمارة الأندلسية، والتنظيم الحضري الدقيق، والتقاليد الحرفية الراقية التي حملها اللاجئون معهم من الضفة الأخرى.

لكن هذا التأسيس لم يمر دون مقاومة، إذ دخل الأندلسيون في صراع مع قبائل جبالة المجاورة، ما دفعهم إلى طلب الحماية من السلطان الوطاسي، الذي استجاب لندائهم بإرسال قوة من 80 جنديًا، مقابل مبلغ مالي يدفعه المهاجرون، في مقابل حماية واستقلال جزئي، شكّل لاحقًا إطارًا لنشوء مدينة ذات حكم شبه ذاتي.
ومع استقرارهم، انطلق الأندلسيون، بمساعدة قبائل المنطقة، نحو الساحل لمهاجمة الإسبان والبرتغاليين، ما أدى إلى تصعيد عسكري جديد، كانت من نتائجه تدمير ميناء المدينة سنة 1565، ورغم هذا التهديد المستمر، فقد نجح الأندلسيون في تحويل تطوان إلى مركز حضاري مزدهر، وأرسوا بذلك القاعدة التي ستُبنى عليها المدينة الحديثة لاحقًا.
عاصمة “الحماية الإسبانية”
بعد توقيع معاهدة الحماية سنة 1912، ووفقًا للاتفاقية الفرنسية-الإسبانية الموقّعة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني من السنة نفسها، اعترفت فرنسا بمنطقة نفوذ لإسبانيا في شمال المغرب، وبناءً على ذلك، صدر مرسومٌ ملكي إسباني بتاريخ 27 فبراير/شباط 1913 يُنشئ رسميًا محمية إسبانية عاصمتها مدينة تطوان، وذلك بعد ترسيم الحدود بين المنطقتين الخاضعتين للحماية الفرنسية والإسبانية، لتُقسّم البلاد فعليًا بين قوتين أجنبيتين.

وقد أدّت هذه الخطوة إلى تحوّل جذري في دور المدينة ووظائفها، فأصبحت مركزًا إداريًا لـ”جيش إفريقيا” بقيادة الجنرال فرانكو في فترة لاحقة، ما يؤكد أهميتها الاستراتيجية والعسكرية بالنسبة لإسبانيا، في سياق كان الصراع الدولي فيه على أشدّه.
أما من الجانب المغربي، فقد وصل مولاي محمد المهدي بن إسماعيل، أول ممثل للسلطان في مناطق الحماية الإسبانية، إلى المدينة، مما جعلها تلعب دورًا مزدوجًا على مستوى السلطات، فمن جهة، احتضنت إدارة مغربية على رأسها الخليفة، الذي يُعيّنه السلطان من بين شخصين تقترحهما الحكومة الإسبانية، ويتولى إصدار الظهائر، ويُعد أعلى سلطة دينية في المنطقة، حيث يدير شؤون العدل والأوقاف، ومن جهة أخرى، كانت تطوان عاصمة للمحمية الإسبانية. واستمر هذا الوضع الإداري المزدوج حتى نهاية الحماية عام 1956.
معقل المقاومة المغربية
برزت مدينة تطوان كأحد أبرز معاقل الحركة الوطنية المغربية خلال فترة الحماية الإسبانية، وكانت نقطةً محورية في النضال ضد الاستعمار، خاصةً أنها احتضنت نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة التي لعبت أدوارًا حاسمة في مقاومة الاحتلالَين الفرنسي والإسباني، ومن بينهم يبرز عبد الخالق الطريس، وعبد السلام بنونة، ومحمد داود الذين لم يقتصر دورهم على القيادة السياسية فحسب، بل امتد ليشمل تأسيس مؤسسات تعليمية ذات توجه مقاوم لسعي سلطات الحماية إلى فرض اللغة الإسبانية لغةً رسمية في المدينة، فقد أدركوا أن صيانة الهوية الثقافية واللغوية تُعد خط الدفاع الأول ضد محاولات الطمس الاستعماري.

ومن بين هذه المؤسسات، برزت “المدرسة الأهلية” (وتُعرف أيضًا بـ”المدرسة الوطنية”)، التي أُسّست في تطوان عام 1924، و”المعهد الحر”، كأهم المدارس العربية الوطنية الحرة، وقد تجاوزت هذه المدارس دورها التقليدي في التعليم، لتتحوّل إلى مراكز حيوية للاحتجاج السياسي والأنشطة الوطنية ضد الحماية الإسبانية. فـ”المدرسة الأهلية”، على سبيل المثال، كانت أول بديل فعلي عن المدارس الاستعمارية، وسعت إلى التصدي لمحاولات فرض اللغة والثقافة الإسبانية، وقد ركّزت برامجها على تعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية، بهدف تعزيز الوعي الوطني والهوية المغربية الأصيلة.
وساهمت هذه المؤسسات في تربية أجيال من النشطاء الوطنيين الذين حملوا لواء المقاومة، إذ شكّلت محاضن فكرية وسياسية، زُرعت فيها مبادئ الوطنية ومقاومة الاستعمار في نفوس الطلاب، كما أدّت دورًا حاسمًا في تنظيم الاحتجاجات السلمية والمظاهرات، مما جعلها رمزًا للنضال الثقافي والسياسي في تطوان، وأسهمت في توحيد الجهود الوطنية، معززةً بذلك دور المدينة كنقطة ارتكاز أساسية في الحركة الوطنية التي امتد أثرها إلى مدن مغربية أخرى.
هوية معمارية فريدة
باعتبارها مركزًا إداريًا للسلطتين الإسبانية والمغربية، شهدت مدينة تطوان تحسينات عمرانية ومعمارية كبيرة، حيث تم الحفاظ على طابعها التقليدي الأصيل، مع تحديث أحيائها الجديدة، مما منحها هوية حضارية فريدة ومميّزة، بقيت ملازمة لها حتى اليوم. ولا تزال ملامح الإرث الأندلسي حاضرة بوضوح في كثير من تفاصيل معمار المدينة، خاصة في قصبتها ومنازلها ورياضاتها ذات الأفنية الوا
عة، ونافوراتها الرخامية، وحدائقها الغنّاء، فضلًا عن القصور والأضرحة والزوايا، والصوامع ذات الزخارف الهندسية الدقيقة وكذا في مظهرها الخارجي المميز باللون الأبيض، والذي كان سببًا في نعتها بـ”الحمامة البيضاء”.

وقد كانت التحديثات التي خضعت لها المدينة خلال فترة الحماية جزءًا من سياسة إسبانيا لترسيخ حضورها وتعزيز سيطرتها، مع الحفاظ على رمزية المدينة التاريخية وتراثها الأندلسي العريق وحضورها الثقافي المتميّز، مما جعل المؤرخ محمد داود، صاحب موسوعة “تاريخ تطوان”، يصفها بأنها “نُسخة من المدن الإسلامية العربية في بلاد الأندلس”.
ويُميّز الباحثون بين ثلاث مراحل للمعمار الإسباني في المدينة؛ أولها مرحلة “الملكية التقليدية” بين عامي 1917 و1931، التي تميّزت ببناء منازل بطابقين، وتتركز أبرز معالمها في المنطقة الواقعة بين ساحة المشور وساحة مولاي المهدي (شارع محمد الخامس حاليًا)، ويُعد المبنى الحالي لمعهد سرفانتس، الذي كان أول بناء يُشيَّد خارج أسوار المدينة العتيقة، من رموز هذه الحقبة.
أما المرحلة الثانية، فهي “المرحلة الجمهورية” (نسبة إلى الجمهورية الإسبانية الثانية)، والتي امتدّت بين عامي 1931 و1939، وسارت على النهج ذاته إلى حد كبير، محافظة على الطابع المعماري المحافظ نفسه، مع بعض التعديلات الطفيفة التي تعكس المناخ الثقافي والفني للجمهورية في تلك المرحلة.

في حين شهدت المرحلة الثالثة، “المرحلة الفرنكاوية” (نسبة إلى فرانكو)، تحوّلًا واضحًا نحو المعمار الحديث، إذ تميّزت ببناء عمارات من أربعة طوابق، كما هو الحال في مبنى القنصلية الإسبانية الحالي، الذي شُيِّد وفق الأسلوب الكلاسيكي الذي ميّز أوروبا آنذاك.
لقد جمعت مدينة تطوان في عهد الحماية بين كونها عاصمة إدارية للمناطق الخاضعة للنفوذ الإسباني، وكونها مقرًّا لخليفة السلطان وقلبًا نابضًا للحركة الوطنية، فلعبت بذلك دورًا مزدوجًا كمركز للقرار الاستعماري، وأيضًا للنضال من أجل الاستقلال، بفضل جهود شخصيات بارزة مثل عبد الخالق الطريس، وعبد السلام بنونة، ومحمد داود الذين أسّسوا مدارس لتربية الأجيال على الوعي الوطني ورفض الاستعمار.
كما شهدت المدينة مقاومة ثقافية وأدبية قوية في وجه محاولات فرض اللغة الإسبانية، حيث تمسك أهلها باللغة العربية وتراثهم الأصيل، باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من هويتهم الوطنية، وهذه الأبعاد المتعدّدة جعلت من تطوان مدينة فريدة، ومثالًا حيًّا على إصرار الشعب المغربي على الحفاظ على هويته حتى تحقيق الاستقلال الكامل سنة 1956.