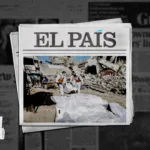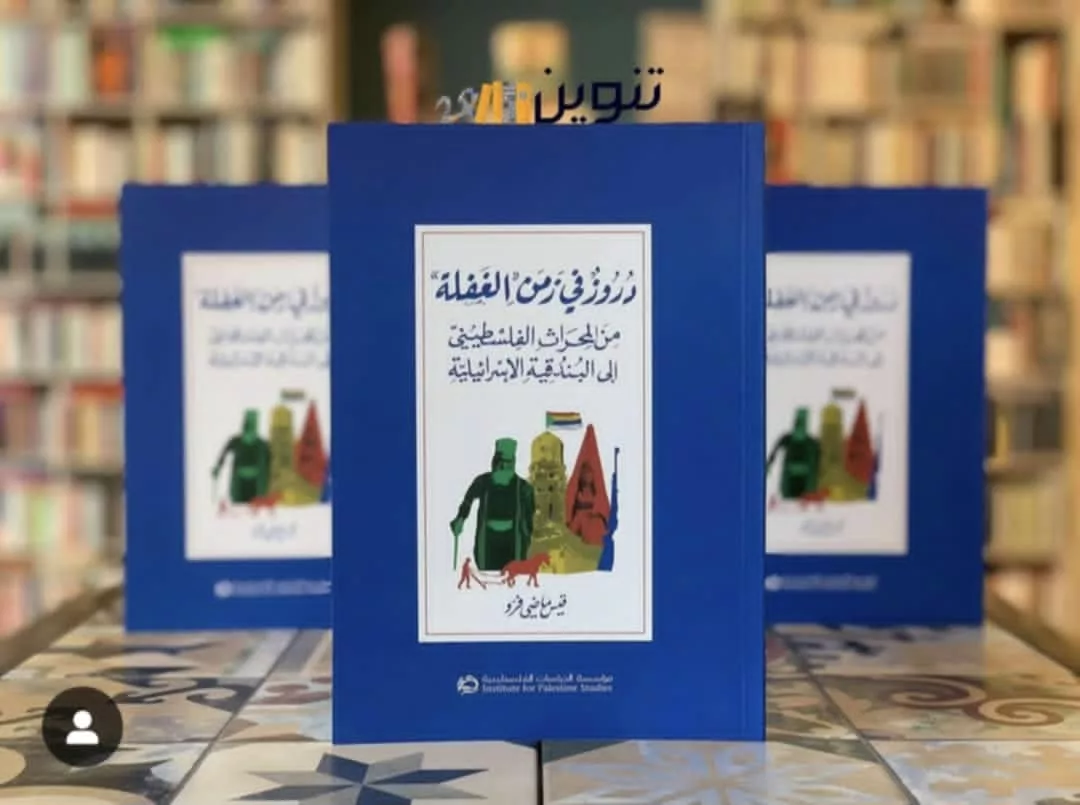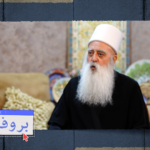في الفترة الأخيرة، منذ 7 أكتوبر وبدء حرب الإبادة على قطاع غزة، وأيضًا بعد أحداث القتل العنيفة التي شهدتها مدينة السويداء بسوريا في الأيام الأخيرة، برز مرةً أُخرى اسم طائفة الدروز ضمن صراع المشهد العسكري والجيوسياسي، كطائفة مذهبية عربية، يتوزع أبناؤها بين جغرافيات مختلفة في المنطقة العربية.
في هذا المقال، لن نرصد بالتفصيل تاريخ الدروز ونشأة مذهبهم الديني وتطوره وغير ذلك من تاريخ طويل ومعقّد، بل سنركز على الدراسة التي أعدّها الباحث والمؤرخ الفلسطيني قيس ماضي فرّو، المولود في قرية عسفيا ذات الأغلبية الدرزية بجبل الكرمل (1944–2019)، والتي نشرتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية (طبعة أولى 2019) بعنوان “دروز في زمن الغفلة: من المحراث الفلسطيني إلى البندقية الإسرائيلية” (435 صفحة).
يتناول قيس ماضي من خلالها دروز فلسطين الذين يقاتل شبابهم الآن في الجيش الإسرائيلي، ويقتلون أطفال غزة، وحين يُقتلون بأيدي المقاومة، تُقدَّم لهم العزاءات ليس من قبل الجيش الإسرائيلي فحسب، بل من شيوخ عقل الدروز أنفسهم في فلسطين، كونهم أبطالًا يقاتلون من أجل بقاء إسرائيل.
حاول قيس ماضي تتبع المسار التاريخي المعقد والمتناقض للطائفة الدرزية في فلسطين/إسرائيل، من جذورها الزراعية العميقة ضمن المجتمع الفلسطيني إلى اندماجها القسري والمعقد في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، كما أنه حاول تفكيك السياسات والمخططات الصهيونية والإسرائيلية التي تعرّض لها دروز فلسطين منذ ثلاثينيات القرن العشرين وحتى الوقت الراهن، مستندًا بشكل أساسي إلى الأرشيفات لا السردية الإسرائيلية.
يبرهن فرّو أن ما يُصوّر رسميًا على أنه “تعايش ناجح” بين الدروز والإسرائيليين يخفي في طياته واقعًا يحمل صورة قبيحة من الاستيعاب أحيانًا، الإكراه، والسيطرة غالبًا كما استخدم ماضي، بجانب الأرشيفات، منهجية التاريخ الشفوي والروايات المتناقضة، كي يقدّم صورة أكثر تركيبًا وشمولية للأحداث، ما عزز من عمق التحليل وقدّم رؤى تتجاوز الرواية الرسمية، وتأخذ بعين الاعتبار تجارب الأفراد والمجتمعات.
نحاول التركيز على أهم الأطروحات التي جاءت في دراسة قيس ماضي، لنفهم من خلالها تعقيدات الطائفة الدرزية في فلسطين حصرًا، وتناقض مواقفها، حسب كل جغرافيتها، وكل قيادة سياسية ودينية، ما يعكس مدى تعقيد المشهد الجيوسياسي في المنطقة العربية، فضلًا عن تفكيك الرؤى الجامدة عن الطائفة سواء بتمجيدهم أو تخوينهم، فهم، على عكس ما يُشاع، ليسوا وحدة مترابطة من حيث الفكر والرؤى والقرار السياسي.
من هم الدروز؟
الدروز، ويطلقون على أنفسهم أيضًا اسم “الموحدون”، هم طائفة دينية باطنية توحيدية. نشأت عقيدتهم في مصر أيام الفاطميين خلال القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين، وتطورت من فرع الإسماعيلية الشيعية، مع دمج عناصر من الفلسفات اليونانية، الغنوصية، الأفلاطونية الحديثة، الفيثاغورسية، المسيحية، والهندوسية، لتُشكّل لاهوتًا مميزًا وسريًا.
كما تتسم عقيدتهم بالتأويل الباطني للنصوص الدينية، وتُشدِّد على أولوية دور العقل والصدق. هم يؤمنون بإله واحد، ويعتبرون العديد من الأنبياء شخصياتٍ مُبجَّلة لديهم، بمن فيهم عيسى، يوحنا المعمدان، محمد، الخضر، وموسى. ويُعد النبي شعيب (جثرو)، صهر النبي موسى، النبيَّ الأكثر احترامًا وتبجيلًا في تقاليدهم.
النص الأساسي لإيمانهم العقدي هو “رسائل الحكمة”، والذي يُقسّم المجتمع الدرزي إلى فئتين، وهما “العقّال” (العارفون) الذين يمتلكون حق الاطلاع على النصوص المقدسة وحضور الاجتماعات الدينية، أما “الجُهّال” (الجاهلون) فلا يملكون هذا الحق، وهم الأغلبية بطبيعة الحال. تاريخيًا، اتسمت علاقة الدروز بالعديد من الأنظمة الإسلامية، الفاطميين والمماليك مثالًا، بالاضطهاد الشديد، بما في ذلك المذابح، وهدم دور العبادة، والتحويل القسري إلى الإسلام.
انتشرت العقيدة الدرزية في بلاد الشام (التي تشمل اليوم سوريا ولبنان وفلسطين والأردن) في الفترة ما بين 408 و410 هجريًا (حوالي 1017–1020 ميلاديًا). وتتركز تجمعاتهم السكانية الرئيسية اليوم في هذه الدول الأربع.
في فلسطين التاريخية، استقر الدروز بشكل أساسي في مناطق الجليل والكرمل، ومناطق في حيفا وطبريا وصفد وعكا، حيث بلغ عددهم حوالي 13 ألف نسمة بحلول منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، والآن تُقدَّر أعدادهم بـ150 ألفًا، كما أن استقرارهم في بعض هذه المناطق، مثل جبل الكرمل، كان حديثًا نسبيًا، وقد ارتبط ببعض التحولات التاريخية في بلاد الشام، لبنان تحديدًا، أوائل القرن الماضي.
لماذا مصطلح الغفلة؟
يُعد كتاب “دروز في زمن الغفلة” بمثابة مساهمة بحثية محورية في فهم التحولات التاريخية والاجتماعية التي طرأت على الطائفة الدرزية في فلسطين المحتلة، إذ تجاوز السرديات التقليدية، سواء الإسرائيلية التي تُصوّر الدروز ككتلة موالية للمشروع الصهيوني، أو حتى كما في الروايات العربية العمومية، بل قدّم تحليلًا معمقًا وموثقًا لمسار هذه الطائفة في ظل المشروع الصهيوني، قبل قيام دولته وبعدها، كما قدّم رؤية نقدية حيال عملية إعادة تشكُّل الهوية الدرزية في سياق الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
أما مفهوم “الغفلة” في العنوان، فيعبّر من خلاله المؤلف عن حالة التيه أو التغريب التاريخي والسياسي التي حدثت للطائفة الدرزية في فلسطين منذ عام 1948.
هذا التوصيف لحالة “التغريب” والوقوع في “أسر سرديات الآخر، الصهيوني”، يشير إلى فترة تاريخية اتسمت بغياب الوعي الجمعي الكافي أو القدرة اللازمة لمقاومة التلاعب بالهوية، فقد أغرت إسرائيل دروز فلسطين بحقوق متساوية “شكليًا فقط”، وعملت على إثارة التنافس بينهم، مستغلة غياب طبقة وطنية متعلّمة بين قادتهم في فلسطين، على عكس دروز لبنان وسوريا، الذين صمدوا بعروبتهم ولم ينصهِروا، لأسباب كثيرة.
هذا الغياب للرؤية الواضحة أو القدرة على استيعاب المفاهيم الوطنية والقومية، أدى إلى نوعٍ من “الغفلة”، حيث تم إعادة تشكيل هوية الطائفة من قبل قوى استيطانية إحلالية، منذ عام 1948، دون إدراك عواقب بعيدة المدى، نراها الآن.
السياق التاريخي والتحولات الدرزية
قبل النكبة عام 1948، لم تكن هناك مشكلة في انتماء الدروز لهويتهم العربية بمعناها الأوسع، وارتباطها ببلاد الشام، ومنها فلسطين. فقد كانوا جزءًا فاعلًا من الحركة الوطنية الفلسطينية، وشاركوا في مقاومة الاحتلال البريطاني إلى جانب المسلمين والمسيحيين، دون أن يلعب الانتماء المذهبي والعقدي دورًا في عزلهم أو تمييزهم، أو حتى في إهمالهم الدفاع عن أرضهم، أرض العرب بجميع أديانهم ومذاهبهم، كما كان متفقًا عليه، بل كانت “الهوية الدرزية” في ذلك الوقت مجرد تعبير عن خصوصية دينية ليس أكثر، شأنها شأن الطوائف الأخرى ضمن النسيج العربي/الفلسطيني الأوسع.
فقد شاركوا، كما يذكر فرّو، في الثورة العربية عام 1936، وقاموا بقتال العصابات الصهيونية التي كانت قد بدأت في التشكُّل والعمل المُسلح تحت رعاية الانتداب البريطاني على أرض فلسطين.
لكن، بعد حرب 1947–1948 وقيام دولة إسرائيل، وجد الدروز الذين بقوا في الجزء الجغرافي الذي قامت على أرضه حدود دولة إسرائيل، والتي تُعرف بمناطق الـ48، أنفسهم معزولين عن بقية مجتمعهم في جبال لبنان وسوريا. وعلى عكس مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، لم يتم تهجير غالبية الدروز من مناطقهم، فقد تراجعت الحركة الصهيونية عن خططها لتهجيرهم في ثلاثينيات القرن الماضي، فيما سمّاه فرّو “تجميد الترانسفير” (ص113).
كما استغلت، وبذكاء شديد، خصوصيتهم من حيث المكونات الثقافية والدينية، من حيث النسب والعادات والترابط الجغرافي، فأدركت الصهيونية أن وجودهم سيكون “أكثر فائدة لمشروعهم”، من خلال الاستفراد بهم، واستغلال هذه الخصوصية، وأهمّها فلسفتهم في البقاء كمكوّن درزي “طهراني” لا تمسّه مكوناتٌ أُخرى، بالاحتواء لا بالعنف المباشر، ما يُنمّي عندهم الشعور بالانتماء إلى جانب الخضوع للقوانين الجديدة التابعة للدولة الإسرائيلية حديثة النشأة.
التجنيد الإجباري (1957/1956): نقطة تحول محورية
في عام 1957، اعترفت الحكومة الإسرائيلية بالدروز كطائفة دينية مستقلة، بناءً على طلب قادتهم من شيوخ العقل. ومن ثم، في العام نفسه، فُرض عليهم التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي، فيما استُبعد العرب المسلمون والمسيحيون أيضًا من هذا القرار، كخطوة محورية وأساسية في سياسات إسرائيل لتفتيت المجتمعات الأصلية، وإعادة هندستها وهندسة مواقع وجودها وانتمائها للمؤسسات الإسرائيلية، أهمها الجيش، وهي المؤسسة التي قامت عليها الدولة لخدمة مشروعها الاستيطاني. فيما أصبح الدروز، منذ ذلك القرار، أقلية ذات “غالبية نخبوية وشعبوية موالية” للمشروع الصهيوني.
إن فرض التجنيد الإجباري لم يكن مجرد إجراء عسكري يهدف إلى ضم أفراد من الطائفة الدرزية إلى صفوف الجيش الإسرائيلي من أجل تجنيد أعداد جديدة فحسب، بل كان حجر الزاوية في مشروع دولة أوسع وأكثر تعقيدًا يهدف إلى إعادة تشكُّل الهوية الدرزية.
رافق قرار التجنيد مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية التي استهدفت إعادة صياغة الوعي الجمعي للدروز. من أبرزها كان تغيير خانة القومية في بطاقات الهوية من “عربي” إلى “درزي”، وإنشاء بلديات محلية مستقلة للدروز، وتطوير مناهج تعليمية خاصة بهم لا ترتبط بالهوية العربية/الفلسطينية.
هذا التحول في المناهج التعليمية، الذي بدأ تدريجيًا منتصف السبعينيات، كان يهدف، حسب فرّو، إلى “غرس الوعي الإسرائيلي–الدرزي” (ص355)، وتركيزها على العلاقة بين الدروز واليهود، وتراثهم الخاص، مع فصلها التام عن المنهاج الثقافي العربي.
هذا المسار، من التجنيد إلى التغييرات القانونية والتعليمية، يوضح أن الهدف لم يكن مجرد الحصول على جنود جُدد، بل كان عملية هندسة اجتماعية شاملة تهدف إلى فصل الدروز عن نسيجهم العربي الفلسطيني، وخلق هوية “إسرائيلية–درزية” تعتمد على سرديات تاريخية ودينية هجينة ومتوترة، بل ومحل شكٍ تاريخي كبير، ما يكشف عمق الاستراتيجية الصهيونية التي لم تقتصر على الاستيلاء على الأرض فحسب، بل امتدت لتشمل التلاعب بالهوية والوعي كأداة للسيطرة والتفتيت داخل مجتمع السكان الأصليين.
توظيف مفهوم “حلف الدم”
“حلف الدم”، هذا المفهوم الشهير، الذي يراه فرّو داعمًا أساسيًا، بما أنه يعتمد على موروث ديني صلب في علاقة الدروز والإسرائيليين مع بعضهما، وهو مفهوم يُزعم أنه يعود إلى لقاء النبي موسى بصهره النبي شعيب (المقدّس لدى الدروز)، لتعزيز هذا الارتباط بين اليهود والدروز.
إن “حلف الدم” يعتمد على أصل الدم ذاته، في نظرهم كما تقول سرديتهم. من بعدها، ومع مرور العقود، ترسّخ هذا المفهوم لدى العقل الجمعي لكثير من أبناء الطائفة، ما ساعد في تبرير فرض التجنيد الإجباري وأعطاه شرعية روحية وسياسية على العلاقة، على الرغم من أنه أيضًا لقي معارضة واسعة داخل المجتمع الدرزي حينها.
كان ديفيد بن غوريون، كما هو مهندس الدولة الجديدة، كان أيضًا مهندس مفاهيم الدم وقوانين التجنيد في عامي 1956 و1957. لكن، هذا المفهوم لم يمنع المشروع الصهيوني من تطبيق الانتقائية، فلم يكن مبنيًا على شراكة متساوية، بل كان أداة سياسية لإنشاء رابط فريد ومُبرَّر ظاهريًا مع الدروز.
وبالتوازي مع شرعنة التجنيد الأيديولوجي لدى الطائفة، وجدت الطائفة نفسها أيضًا “متميزة” داخل المجتمع العربي، كونها تُعامَل بشكل مختلف، بشكل غير مستعمَر وغير أصيل أيضًا، كي تُصبح أداة في مشروع السيطرة وإذابة أي سُبل للمقاومة.
كما خلق هذا المفهوم اختلافًا في السرديات التاريخية والدينية من حيث كيفية تفسيرها وتوظيفها بشكل انتقائي من قبل قوى المشروع الصهيوني، وبعض من مشايخ عقل الدروز، بهدف تحقيق مكاسب سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية، عبر تحويل تنوّعات التراث الثقافي إلى أداة لهندسة المكانة الاجتماعية.
من المحراث إلى البندقية
يحلل فرّو التأثير العميق لانتقال المجتمع الدرزي الفلسطيني من الاعتماد على العمل الزراعي إلى الانخراط في القطاع العام الإسرائيلي بمؤسساته المختلفة. هذا التحول اتضح في سلوك الأفراد الدروز المجنَّدين، وعلى بعض النخب التي تبنّت خطابًا “ارتزاقيًا” في مطالبتها بالمساواة في الحقوق، مما يعكس تبعية اقتصادية وسياسية، وسعيًا حثيثًا إلى الاندماج في نموذج الاقتصاد الجديد في الدولة، والابتعاد عن النموذج التقليدي القائم على الفلاحة.
هذا التحول الاقتصادي لم يكن مجرد تطور طبيعي أو تطورًا سعى إليه الدروز من أنفسهم، بل كان نتيجة مباشرة لسياسات إسرائيلية ممنهجة. فقد نفذت إسرائيل برنامجًا قاسيًا للاستيلاء على الأراضي بدعم من جهاز قانوني متطور، طال المسلمين والمسيحيين والدروز على حد سواء، ما أدى إلى إفراز بروليتاريا عربية، عمالة فقيرة تضطر أن تكون تابعة للاقتصاد الرأسمالي اليهودي.
في ظل هذا التهميش الاقتصادي، أصبحت القطاعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية تُمثّل، بالنسبة للكثير من الشباب الدروز، المسار الوحيد المتاح للاستقرار الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي، كأي تحول من الريف إلى الحضر في مجتمع عادي، فماذا لو كان مجتمعًا استعماريًا وعنصريًا؟ (ص325)
هذه التبعية الاقتصادية تحوّلت إلى أداة استخدمتها الدولة الإسرائيلية لفرض التجنيد وإعادة تشكيل الهوية الدرزية، رابطةً بذلك سبل عيشهم باندماجهم ضمن مقومات النظام الإسرائيلي الجديد. فكانت السياسات الاقتصادية تدفع نحو التحول الاجتماعي، وبالتالي، تدريجيًا، تنازلوا عن مفاهيم كانت متواجدة لديهم، مثل مقاطعة السردية الصهيونية ودولتها الناشئة. فلم يعد الانكفاء الذاتي للطائفة أمرًا متاحًا، بل كان الاندماج، من أجل مواكبة متطلبات الحياة، فَرضًا عليهم.
سياسات “فرق تسد” الإسرائيلية
يُركّز المؤلف على الاستراتيجيات المتعددة التي اعتمدتها إسرائيل لتفكيك الهوية العربية الجماعية وتقويض تماسكها الداخلي، في تطبيق واضح لسياسة “فرّق تسد”. من أبرز هذه السياسات، تغيير خانة القومية في بطاقات الهوية من “عربي” إلى “درزي”، وإنشاء مجالس محلية منفصلة للدروز عن العرب، وتطوير مناهج تعليمية خاصة بهم لا ترتبط بالهوية العربية الفلسطينية، بل تُركّز على علاقة الدروز باليهود وتراثهم الخاص في التاريخ والحاضر والمستقبل.
عُدّ الجهاز التعليمي، حسب قيس ماضي، ساحة معركة حاسمة لتشكيل الهوية، إذ تم استغلال النظام التعليمي في منتصف السبعينيات لـ”غرس الوعي الإسرائيلي–الدرزي”، من خلال إقامة منهاج تعليمي درزي منفصل تمامًا عن المنهاج العربي، يُركّز على “التراث الدرزي” والعلاقة بين الدروز واليهود، من خلال مفاهيم مثل المصاهرة بين النبي شعيب والنبي موسى.
هذا التغيير الممنهج، من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، نجح في إعادة تشكيل الوعي الجمعي للأجيال الجديدة، فنادرًا ما تجد شابًا درزيًا فلسطينيًا يرفض التجنيد الإجباري والانصهار ضمن المشروع الصهيوني.
كما حرّضت المناهج على قطيعة السرديات الثقافية والتاريخية التي تربط الدروز بالنسيج الفلسطيني والعربي الأوسع. هذا ما جعل من التعليم أدواتِ عنفٍ رمزية، بوصف المفكر الفرنسي ألتوسير، والتي تسيطر من خلالها الدولة على هويات الأقليات، مُبيّنًا كيف يمكن استخدامه ليس فقط لنقل المعرفة، بل لتفكيك وبناء الانتماءات الوطنية والثقافية.
الدروز.. منهم من قاوم المشروع الصهيوني
غالبًا ما تُصوِّر السرديات الصهيونية الدروز ككيان موحّد ومتجانس، وموالٍ بشكل كامل للحركة الصهيونية، فيما يدّعي فرّو أن هذه السرديات تتجاهل التنوع الفكري والمواقف السياسية المختلفة داخل المجتمع الدرزي تجاه المشروع الصهيوني.
ويُسلّط الضوء على شخصيات مثل الشاعر سميح القاسم كنموذج للمقاومة الفكرية، حيث عمل سميح القاسم لسنوات كمثقف وشاعر، وفي العمل السياسي للحزب الشيوعي الفلسطيني، مع كثير من الأفراد والتنظيمات المقاومة، فلم يخلُ مسار حياته من مقاومة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، ولم يقبل أن يكون مثقفًا مُتصهينًا يقول الشعر مديحًا للدولة الإسرائيلية وحقّها في الدفاع عن نفسها، مثلما يفعل الشاعر الدرزي سليمان دغش، الذي يتباكى على قتلى جنود إسرائيل، ومنهم حفيده، بيد المقاومة في غزة.
على النقيض من الصورة النمطية، لم يكن المجتمع الدرزي كتلة واحدة، بل شهد تيارات مختلفة، من قادة تقليديين سعوا للحماية الخارجية، إلى من رأوا فرصة لتحقيق طموحاتهم بالتحالف مع الصهاينة، أُطلق عليهم “القوى الإيجابية”، ومنهم الشيخ سلمان طريف، الذي رأى أن انضمام شباب الطائفة إلى التجنيد في الجيش الإسرائيلي ليس عيبًا، ودعا إلى الاستجابة وعدم التمرّد.
على عكس الشيخ أمين طريف، الذي عارض التجنيد الإجباري، قائلًا: “إنه يجلب الأخلاق السيئة إلى أبنائنا، ويلطّخ اسم الطائفة في البلاد العربية”، ما جعله ينتمي إلى ما يُسمّى “القوى السلبية” التي عارضت السياسات الإسرائيلية. (ص273) وحول هذا، يُفنّد فرّو فكرة أن الدروز خانوا الجيش العربي في 1948، مؤكدًا أن ما حدث في هذا المشهد كان أكثر تعقيدًا من ذلك.
حتى بعد إعلان “حلف الدم” عام 1956، الذي أدى إلى الولاء شبه المطلق للدولة اليهودية ومشروعها الصهيوني، لازالت الهوية الدرزية العربية موقعًا للتنازع الداخلي، وإن كانت تندثر مع العقود، حيث كانت هناك قوى “مشيخية” دعت إلى الحياد، وأخرى رأت في التعاون مع الصهيونية فرصة، بينما قاومت فئات أخرى، وبشدة، بعد نداءات القائد العربي سلطان باشا الأطرش لهم برفض التجنيد، ورفض خدمة المشروع الصهيوني، والاتجاه نحو العودة إلى الوحدة العربية. ومن بعد ذلك، تعالت أيضًا أصوات كثيرة تردّد نداءات الرفض.
كما أن البيانات التي قدّمها قيس ماضي تُظهر أن نسبة الرافضين للتجنيد بين الشبان الدروز كانت مرتفعة في بدايات فرض القانون، أي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، على الرغم من سياسات القمع والإجبار على الالتحاق، لكن بدأت النسب تقل مع توالي العقود، بفعل انصهار الوعي العربي الدرزي ضمن سرديات الصهيونية، إلى أن وصلت إلى أقصاها بعد حرب الإبادة على غزة، فلن نجد أي مقاومة درزية، سواء من المجنّدين في الجيش أو من مشايخ الطائفة في فلسطين، بل وُجد تماهٍ تام مع سردية إسرائيل في حقّها الدفاع عن نفسها، عبر قتل وتجويع فلسطينيي غزة.
لكن، أيضًا في عام 2014، أطلقت شابّاتٌ وشبّانٌ دروز حراكًا وطنيًا عابرًا للطوائف، رفضًا للتجنيد الإجباري، تحت شعار “ارفُض شعبك بيحميك”، والتي قالت منسّقته ميسان حمدان، تعريفًا للحركة، إنها عبارة عن “إطلاق فرق الدعم للحراك الموجودة في الضفة الغربية المحتلة، والأردن، ولبنان. انبثقت هذه الفرق وتشكلت بعد جلسات الحوار واللقاء التي انعقدت في شهر آب/أغسطس 2016 في العاصمة الأردنية عمّان. ونحن نعتقد أن عملنا ضد التجنيد الإجباري يساهم في التصدّي لمحاولات تشرذمنا، كما يصب في إعادة صياغة هوية جمعية لنا كشعب، بغض النظر عن مواقع تواجدنا”.
إعادة السرديات التاريخية لفهم الحاضر
دراسة فرّو أعطت إنتاجًا هامًا للمعرفة البديلة والنقدية، إذ قدَّم معلومات تاريخية تفصيلية وقام بتحليلها دون مبالغة أو تقليل، بعيدًا عن أي تحيّزات لروايات منتصرة أو مهزومة أو تُرضي أي طرف من الأطراف. إن منهجية فرّو، التي لا تتردد في نقد السرديات الإسرائيلية والفلسطينية معًا، تُظهر شجاعة فكرية قوية، بسبب أن دراسة مثل هذه قد تعرّضه لكثير من النقد والترهيب، سواء من القوة الاستعمارية الإسرائيلية أو حتى من الطائفة الدرزية، بما أنها لن تُعجب كثيرًا من الدروز وشيوخهم تحديدًا، سواء في فلسطين أو حتى في لبنان وسوريا، بما أن شيوخ العقل يمتلكون قداسة وسط مجتمعاتهم، ولا يجوز مسّهم أو نقاشهم، بشكل مُتشكّك، في أمور تخص الدين، بما أن الفلسفة الدينية وتعاليمها التي تُعرف بـ”رسائل الحكمة” مُخبّأة، ولا يطّلع عليها أحد من العوام، أي “الجُهّال” كما يسمّونهم.
ختامًا.. مرّت الهوية الدرزية، تحديدًا دروز فلسطين، بتصدّعات وتغيرات كثيرة، وقد تم استلابها من أصولها العربية، بحكم الفعل لا اللغة، بل تم عزلهم عن أبناء طائفتهم في لبنان وسوريا بالموقف الرسمي السياسي والديني، لا بالتقارب والنَسب، والأهم: الذاكرة، واحتوائهم من قبل الصهاينة، ما أدى إلى شعور عميق بـ”المصيبة” أو الكارثة، التي أحدثتها استراتيجيات الصهيونية.
فلم يعد دروز لبنان أو سوريا، الذين لا يزالون محافظين على هويتهم العربية، قادرين على التآخي، كما كان قديمًا، مع درزي “عربي” آخر يقتل الفلسطينيين، بل ربما يقتل اللبنانيين والسوريين ذاتهم، كونه مُجنّدًا في الجيش الإسرائيلي، إذ يُميّز الجيش الإسرائيلي الجنود الدروز لما يمتلكون من أهمية في معرفة اللغة والعادات الثقافية للفلسطينيين والعرب عامةً، سواء في القتال أو التحقيق أو التجسس أو غير ذلك من استراتيجيات تساعد الصهيونية في تثبيت مشروعها.
كما أن الهرمية الدينية والسياسية داخل المجتمع الدرزي، أعطت مساحات متعددة من تباين المواقف والآراء، فكما انصهر دروز فلسطين مع سردية الاحتلال، ولو وُجدت مقاومة نسبية، لكن لم ينصهر دروز لبنان أو سوريا، بغالبية طائفتها وموقفها الرسمي، في التخلي عن عروبتهم وأرضهم مقابل أي امتيازات قد يقدّمها أطراف خارجية صهيونية أو غيرها، لما امتلكته لبنان من قيادة تاريخية درزية سياسية وفكرية ودينية مقاومة وغير قابلة للتصهين، مثل شكيب أرسلان، وكمال جنبلاط الذي قاتل مع الفلسطينيين، وشيخ العقل الحالي للطائفة في لبنان، سامي أبي المنى، الذي رفض تمامًا التماهي مع نظيره في فلسطين، موفق طريف، الموالي تمامًا للمشروع الإسرائيلي.
بينما دروز سوريا دائمًا ما يصدحون بعروبتهم ورفضهم للتدخل الإسرائيلي الذي يحاول تفكيك المجتمع السوري واللعب على أوتار “حلف الدم”، حتى وإن كانت هناك أصوات، غير أكثرية، تُهاجم من قبل أبناء طائفتها، تحاول تقليد النموذج الدرزي الفلسطيني في التماهي والتبعية للمشروع الصهيوني.