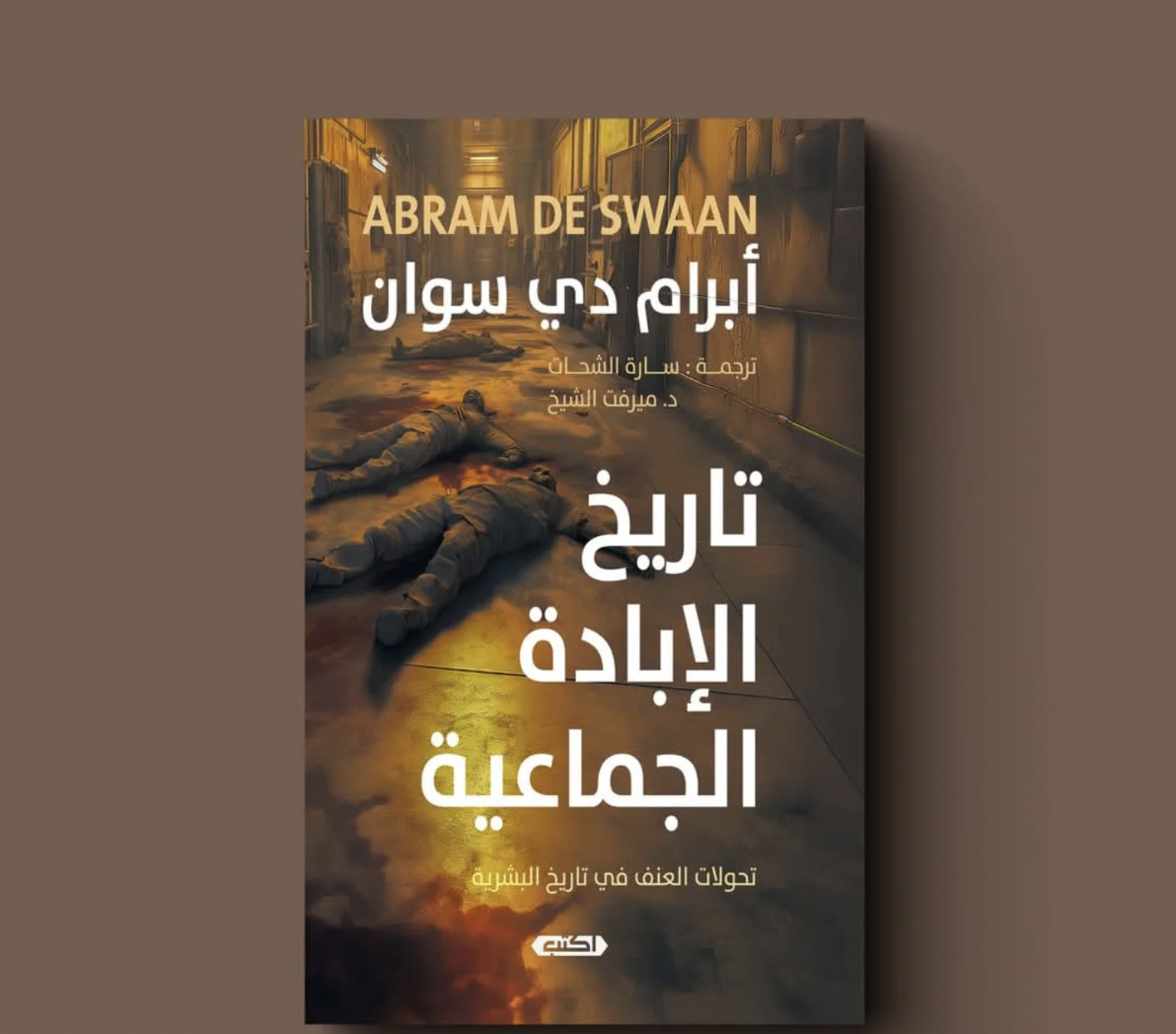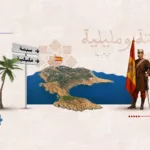في فترةٍ اقتربت من عامين تقريبًا، قتلت “إسرائيل” أكثر من ستين ألف فلسطيني ضمن حرب غير متكافئة تحولت إلى إبادة كاملة، للكبير والصغير، الصحفي والطبيب، لم يسلم منها حتى الحجر. إبادة كاملة تسعى بعض دول العالم وصحافته إلى الاستمرار في اعتبارها غير ذلك.
قبل أشهر قليلة، صدر كتاب “تاريخ الإبادة الجماعية.. تحولات العنف في تاريخ البشرية”، للأنثروبولوجي إبرام دي سوان، ويتساءل فيه الكاتب: “كيف يمكن أن يحدث مثل هذا الدمار الشامل في العالم المعاصر، وحتى في المجتمعات “الحديثة” و”المتحضرة” ظاهريًّا؟ هل هو دليل على انهيار الحضارة إلى الفوضى والعنف؟ أم أن المجتمع الحديث والحضارة نفسها بربرية في جوهرها، مغطاة فقط بقشرة ضعيفة من الكياسة؟.
يعود الكتاب، من خلال سؤاله الأساسي وتحليله، بشكل غير مباشر لتأصيل ما يحدث في غزة اليوم على اعتباره إبادة صريحة، ويثبت ذلك من خلال عرض اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948، التي تسعى إلى تشجيع القوى الخارجية على التدخل المبكر من أجل منع أو وقف عمليات القتل الجماعي وتقديم الجناة إلى العدالة، إذ كانت معظم حالات الإبادة الجماعية هي أيضًا حالات تدمير جماعي غير مشروط.
كما يؤكد بنماذج أخرى متعددة اعتبار ما يحدث قياسيًا إبادة كاملة؛ إذ يمكن النظر إلى ما حدث قديمًا في رواندا أو بنجلاديش أو الأرمن أو حتى الهولوكوست – الأشهر جميعها – كحالات تكاد تتطابق مع ما يحدث اليوم في فلسطين.
على سبيل المثال، يمكن إثبات “نية النظام في التدمير” أو “قتل الضحايا بسبب قناعاتهم السياسية أو خلفيتهم الطبقية بدلًا من الانتماء إلى مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية”، وهو ما يجعل الحرب الإسرائيلية على غزة تحديدًا إبادة لا جدال فيها. تلك الإبادة التي يذكرها أبو عبيدة، متحدث المقاومة، كل مرة أمام العالم، حتى قبل أيام.
ثم ينتقل الكاتب سريعًا ليفكك التعريفات اللغوية التي يستخدمها الناس أحيانًا بدلًا من “الإبادة”، فعلى سبيل المثال: الإفناء الجماعي، والتدمير الجماعي، والقتل الجماعي، هي في معظم النواحي مصطلحات أوضح من “الإبادة الجماعية”، التي تمت صياغتها من أجل القانون الدولي.
أُناس عاديون، ليسوا حيوانات!
يظلّ الكتاب في أغلب أجزائه تحت تأثير محاولات مضنية لفهم الجناة ووجهة نظرهم التي تدفعهم نحو القتل العشوائي، لا لمجرد إدانتهم على ذلك فقط، فيقول الكاتب إنه “من الضروري تعليق تعاطف المرء مع الضحايا، وبذل جهد صادق للنظر إلى الأحداث من وجهة نظر الجاني”.
بشكل عام، تكاد تكون النقطة المهمة في أطروحة الكاتب هي الاعتقاد أن الناس، في بعض الأحيان، يواجهون خيارات أخلاقية، ربما لا يكونون على وعي بذلك في اللحظة نفسها، لكنهم يملكون قرارًا أخلاقيًا يتعيّن عليهم اتخاذه. ربما هم فعلًا أُناس عاديون، لكنهم لا يملكون قناعة واضحة تجاه تجنّب الشر، إذ يمكنهم ببساطة التنازل عن “عاديتهم” ليصبحوا جناة إذا طلبت منهم السلطة ذلك.
يعتقد الكاتب أن الدولة الحديثة لم تجلب السلام فقط، بل إنها تحتوي أيضًا في صميمها على إمكانية الدمار القاتل، ويدلّل على ذلك بأن دولة ألمانيا وقت الهولوكست كانت من بين أكثر المجتمعات حداثة
ينقل الكاتب، عن طريق مصادر عدّة، أن هناك إجماعًا واسعًا وقويًّا في العلوم الاجتماعية بخصوص السمات الشخصية التي تميّز مرتكبي الإبادة الجماعية عن غيرهم من البشر، فوفق ما يعتقد المؤلف إبرام دي سوان: “لا يوجد شيء مميز، ومع ذلك فقد أجد أنهم يشتركون في درجات عالية من سمات معينة، ليست مرضية في حد ذاتها: الطموح العالي، والثقة الزائدة، والأسلوب المحيط في حل المشكلات. وعلى عكس المجرمين العاديين، الذين يعملون خارج التيار الرئيسي للمجتمع، في السر، أو بمفردهم، أو مع عدد قليل من المتواطئين، يعمل القتلة الجماعيون دائمًا في فرق كبيرة، بمعرفة كاملة من السلطات، وبأوامرهم”.
ويستكمل قائلًا إن “أولئك الذين يعيشون في ظل نظام الإبادة يعدّون أن الجماعات المعادية موجودة، وأن أفرادًا معيّنين ينتمون إلى أحد الأطراف وليس إلى الطرف الآخر. الإبادة الجماعية، هنا، هي انفجار للعنف الجماعي. ومثلما كانت هناك نزعة ساذجة لاعتبار الجناة وحوشًا مضطربة عقليًا، كانت هناك أيضًا نظرة تبسيطية مماثلة لأنظمة الإبادة الجماعية، باعتبارها ارتدادًا إلى الأزمنة البربرية السابقة”.
يفرّق الباحث هنا بين وقوع الإبادة ذاتها – وإدانتها بالطبع – وبين محاولة فهم الأشخاص الذين يشاركون في حدوثها، الذين يعتقد الكاتب نفسه أن أغلبهم أُناس عاديون تمامًا، يعيشون في ظل الحداثة بشكل طبيعي، لكنهم “ضحايا الدولة الحديثة”.
جُناة “عاديون” تمامًا
يعتقد الكاتب أن الدولة الحديثة لم تجلب السلام فقط، بل إنها تحتوي أيضًا في صميمها على إمكانية الدمار القاتل، ويدلّل على ذلك بأن دولة ألمانيا وقت الهولوكست كانت من بين أكثر المجتمعات حداثة، فوفق الباحث زيجمونت باومان، مثلًا، “تأسّس العصر الحديث كله على الإبادة الجماعية”.
ورغم إدانة الكاتب لنموذج الدولة الحديثة، التي تفتقد غالبًا إلى مشاعر قوية، فإنه يمرّر ملاحظة شعورية وحيدة تُنقذ فكرة الدولة الحديثة التي يدينها في أغلب الأحيان، فعلى مدار الكتاب، يظل الكاتب تحت تأثير تصوّر فلسفي يحرّكه أن “الناس قديمًا كانوا يخافون من الغرباء، بينما مع الوقت أصبح لدينا مشاعر خلّاقة تجاههم، تمامًا مثل تلك التي تحدث في أوقات الإبادة لبلد بعيد”، وربما يجد ذلك الأمر نفسه متحققًا اليوم، مع تعاطف العالم كلّه، من الشرق والغرب، مع الفلسطينيين في غزة، مقابل إدانة الإبادة الإسرائيلية.
بدت تلك مشاعر إنسانية خالصة، لا تحمل أدنى أدلجة أو توجّه، يشعر بها المرء تجاه غرباء، فيدين بها “إسرائيل” في كل سياق، ويعترف بالإبادة التي لا تُهدد الفلسطيني وحده، بل تمثّل خطرًا على إنسانية الجميع، إذ إن استمرار الإبادة يعني هلاك كل ما هو إنساني.
يرى الكاتب أن ميل البشر إلى إلحاق الأذى ببعضهم بعضًا قديم قِدم الإنسان ذاته، فمنذ العصور التوراتية، مرورًا بالعصور القديمة والوسطى، وصولًا إلى الوقت الحاضر، وهناك أمثلة لا حصر لها على المذابح الجماعية التي نفّذها الغزاة المتعطشون
كما يرى الكاتب، مثلًا، أن عدم تناسق القوة هو ما يميّز إراقة الدماء هذه عن غيرها من أشكال العنف الجماعي، كحال القتل واسع النطاق الذي يحدث في الحروب بين مقاتلين مسلحين ومنظّمين على الجانبين، فخلال الحرب الباردة بين القارات، منحت الصواريخ الباليستية ذات الرؤوس النووية لمُشغّليها قدرة على قتل عشرات الملايين على بُعد ستة آلاف ميل، وبدقة مرعبة، بينما لا يرى المتخصصون في غرف العمليات سوى الخرائط والبيانات.
يخلق هذا الوضع نوعًا من الإبادة غير المؤثرة عاطفيًّا على فاعلها، لذا ينصبّ تركيز خلاصة كتاب “الإبادة الجماعية” على فهم نفسية الجناة “العاديين”، الذين يكونون على اتصال مباشر بضحاياهم، فيحاول الكاتب شرح أفعالهم أولًا ضمن السياق الذي يجد فيه الجناة والضحايا أنفسهم على طرفي نقيض، فلا أحد منهما قادر فعلًا على فهم دوافع الآخر الحقيقية للاستمرار.
يتجاوز الكاتب كذلك مفهوم “المواطن العادي” هنا، ليرى أنه في أغلب الحالات، لا تستمر الإبادة الجماعية إلا بوجود نظام مصمَّم على تنفيذها، ولا يمكن فهم هذه الإبادة إلا من خلال النظر في تأثير ذلك النظام الحاكم، الذي يتفرّد بالرغبة في الفناء.
ومع مرور النصف الأول من الكتاب، الذي يقع في نحو 424 صفحة من القطع المتوسط، ينتقل الكاتب إلى مناقشة فكرة الشر في ذاتها، تلك التي تُنتج مفاهيم مثل الإبادة، فيقول في أحد المواضع: “في هذه الأيام، عندما يفكّر الناس في الشر، فإنهم لا يربطونه كثيرًا بالتمرد على الله: كالردة، أو البدعة، أو عبادة الأصنام والخرافات”.
ورغم ذلك، يرى الكاتب أن ميل البشر إلى إلحاق الأذى ببعضهم بعضًا قديم قِدم الإنسان ذاته، فمنذ العصور التوراتية، مرورًا بالعصور القديمة والوسطى، وصولًا إلى الوقت الحاضر، وهناك أمثلة لا حصر لها على المذابح الجماعية التي نفّذها الغزاة المتعطشون أو الحكّام المتجذرون ضد الشعوب ووثّقوا هذه المجازر التي ارتكبوها بحق الشعوب المهزومة، بكل فخر.
في القصة الملحمية حصان طروادة، يترك هوميروس لأغاممنون أن يقول لمينلاوس عن الطرواديين المهزومين: “لن نترك واحدًا منهم على قيد الحياة، لا حتى الأطفال في أرحام أمهاتهم. لا يجب أن يعيشوا. يجب أن يُمحى هذا الشعب كله من الوجود، فلا يبقى أحد ليبكيهم أو يذكرهم”، وربما بهذا الشكل تمامًا، يتحرّك عقل من يفكّر في الإبادة.
كتابات مختلفة تعيد تعريف المأساة
إلى جانب كتاب الإبادة الجماعية الذي نحاول من خلاله تحليل ما يحدث اليوم، شهدت الأشهر القليلة الماضية صدور عدة دراسات أكاديمية موسّعة تتناول القضية ذاتها، فعلى سبيل المثال، صدر كتاب جماعي بعنوان: “غزة… حرب استعمارية”، عن دار أكت سود–سندباد ومؤسسة الدراسات الفلسطينية، تناول أبعاد الحرب الإسرائيلية على غزة من خلال تساؤل أصيل: هل يمكن وصف ما يحدث بأنه حرب إبادة جماعية أم إبادة ثقافية؟ وهل هناك منطق حقيقي يحكم العمليات العسكرية الإسرائيلية؟.
كذلك، ضمن سلسلة “ترجمان”، صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب “كوابيس الإبادة: سرديات التوجس ومنطق الفظائع الجماعية”، لمجموعة من الباحثين، ترجمه وحرّره عبد الوهاب الأفندي وبدر الدين حامد الهاشمي، وناقش ظواهر العنف المكثّف والمتعاظم، محاولًا فهم دوافع الأفراد “العاديين” للمشاركة في أعمال العنف المتطرف.
يكشف المسح العام لكل هذه الدراسات المستقلة، عن أسوأ حالات الإبادة الجماعية في القرن الماضي، عن مجموعة من الأحداث التي أدّت في كثير منها إلى سقوط ملايين، بل عشرات الملايين من الضحايا، ويتساءل الجميع عن التسمية الدقيقة لما جرى – وما يجري – ومنها الحالة في غزة، عبر المقارنة اللغوية والحقوقية بالوقائع المماثلة عالميًا. بالتحديد، تبرز مقاربة لا يمكن تجاهلها عند تحليل تلك الكتابات وفهمها في سياق ما يحدث اليوم، بل ربما يمكن اعتبار بعضها قد كُتب أصلًا كإدانة أكاديمية صريحة للصهيونية.
كل تلك الكتابات، التي صدرت في الشهر ذاته تقريبًا، تؤصّل منهجيًا للتأكيد على الإبادة التي تمارسها “إسرائيل”، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن ما يُميز كتاب الإبادة الجماعية عن غيره من الكتب الأخرى، هو تركيزه الكثيف على “المواطن العادي الذي يتحوّل إلى مُنفّذ للإرهاب نتيجة تأهيله وتكيّفه مع نظامٍ مجرم”.
يمتد كتاب الإبادة الجماعية على مدى تسعة فصول، لمناقشة هذا التحوّل ونمذجته في عدة دول وفي ظروف تاريخية مختلفة، ليصبح معنيًا بذلك بشكل مباشر، وعلى الرغم من تواضع الترجمة في بعض تفصيلاته، يظل الكتاب وثيقة بالغة الأهمية والدلالة، تسجّل لحظة إبادة ينتظر العالم كلّه أن يستفيق من صمته ليوقفها بأي شكلٍ ممكن. يمثّل الكتاب، رغم كل شيء، إدانة جاءت في توقيتٍ مثالي.