شهدت الأشهر الأخيرة سلسلة انتكاسات لإيران، ما بين مقتل جيل من قادة الحرس الثوري وعددٍ من العلماء النوويين، وتراجع قدرات حزب الله، وسقوط نظام الأسد، بالتزامن مع تصاعد الجهود في العراق ولبنان للحد من نفوذ الميليشيات المرتبطة بطهران. وعلى الصعيد الداخلي، جاءت حرب يونيو/حزيران 2025 مع إسرائيل لتزيد من حدّة الضغوط على النظام الإيراني بشكلٍ غير مسبوق.
وفي ظلّ غموضٍ يكتنف مصير الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، وتراجع فاعلية وكلاء إيران في المنطقة، تواجه طهران أزمةً استراتيجيةً عميقة، يراها كثير من المراقبين لحظةً فاصلةً قد تعيد رسم مستقبل الجمهورية الإسلامية لعقودٍ قادمة.
في خضمّ هذا التحول، يستعرض نون بوست ملامح الاستراتيجية الإيرانية وتطوّرها على مدى العقود الأربعة والنصف الماضية، من خلال قراءةٍ لكتاب “استراتيجية إيران الكبرى: تاريخ سياسي” للمفكر والأكاديمي ولي نصر، باعتباره أبرز الإسهامات المعاصرة في تحليل توجهات طهران الجيوسياسية وفهم منطقها الاستراتيجي.
يتمتع ولي نصر بخبرةٍ طويلةٍ في تقديم المشورة لصنّاع القرار في واشنطن، ويشغل حاليًا مدير مبادرة “إعادة التفكير في إيران” بجامعة جونز هوبكنز، ولا يقدّم في كتابه الصادر عن جامعة برينستون منتصف 2025 مجرد تأريخٍ لسلوك إيران الخارجي، بل يغوص في البنية العميقة لصناعة القرار الاستراتيجي الإيراني.
ينطلق نصر من سؤالٍ محوري: هل تتبع إيران استراتيجيةً كبرى واعيةً ومتماسكةً، أم أن قراراتها محكومةٌ بالأيديولوجيا وردود الأفعال؟ ويعتمد في تحليله على مصادر أرشيفية، ومقابلات مع مسؤولين إيرانيين، وتحليل خطابات القادة وسلوك النظام في محطاتٍ مفصلية.
يذكر نصر أنه سعى في كتابه لتجاوز القراءات التبسيطية التي اختزلت الاستراتيجية الإيرانية في الأيديولوجيا والدين، متجاهلةً الأبعاد البراغماتية والعقلانية التي توجّه سلوك طهران. ومن هذا المنطلق، حلّل نصر الاستراتيجية الإيرانية بوصفها نتاجًا لتفاعلٍ معقدٍ بين طموحاتٍ توسعيةٍ وهواجس أمنية، تغذيها مخاوف مستمرة من التهديدات الخارجية، ويقابلها في الوقت نفسه نهجٌ براغماتيٌّ يهدف إلى حماية الداخل وضمان استمرارية النفوذ الإقليمي في آنٍ معًا.
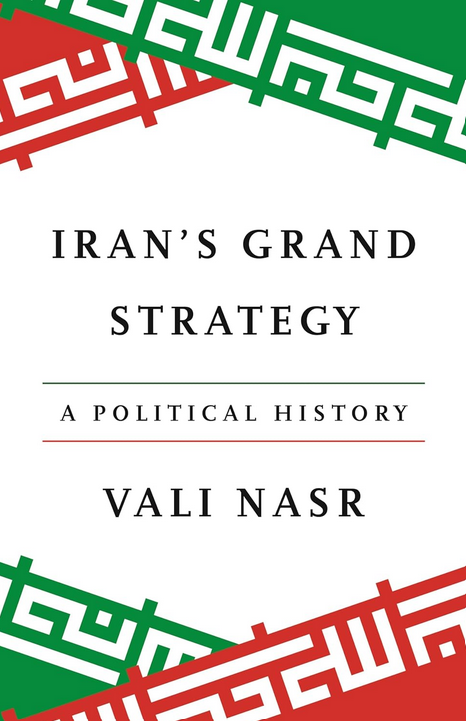
جغرافيا التطويق وذاكرة الإذلال
يرى نصر أن شعور إيران بالتفرّد والتهديد يعود إلى جذور هويتها الفارسية الشيعية التي تبلورت منذ العصر الصفوي (1501–1722)، حيث كرّس هذا الإرث تمايزها عن محيطها السني، ممّا غذّى طموحاتها التوسعية، لكنه في الوقت نفسه عمّق شعورها بالعزلة والقلق الجيوسياسي، وهو ما ترك أثرًا بالغًا في تشكيل رؤيتها الحالية للأمن القومي.
ويتعزّز شعور إيران بأنها محاصَرة، حسب نصر، بوعيٍ تاريخيٍّ تجاه التدخلات الأجنبية التي عانت منها البلاد خلال القرنين الماضيين، بدءًا من الهزائم أمام روسيا في القرن التاسع عشر، ومرورًا بالاحتلال البريطاني-السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية، وانتهاءً بالانقلاب على حكومة مصدق عام 1953.
هذه التجارب المتراكمة رسّخت في الوعي الجمعي للنخبة الإيرانية شعورًا دائمًا بالتهديد، وأسّست لنزعةٍ سياديةٍ تسعى إلى الاستقلال السياسي والاقتصادي والأيديولوجي، وجدت تعبيرها الأقصى في ثورة 1979.

فمن هذا السياق التاريخي المتراكم، جاءت ثورة 1979 كردٍّ جذريٍّ على عقودٍ من النفوذ الغربي كما يوضح نصر، إذ أعادت هذه الثورة صياغة مفهوم الاستقلال بوصفه مشروعًا شاملًا للتحرر من الهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية، خاصةً الأمريكية.
فعندما اندلعت الثورة الإيرانية، برز آية الله الخميني بوصفه الشخصية المحورية والمؤسسة لها، وفي تلك الأثناء، توجّه زعيم المعارضة العلماني “كريم سنجابي” إلى مقر إقامة الخميني في باريس في أكتوبر/تشرين الأول 1978، سعيًا لتنسيق تحالفٍ مشتركٍ ضد نظام الشاه.
كان الرجلان من أبرز معارضي النظام الملكي منذ ستينيات القرن الماضي، وقد بادر الزعيم العلماني بصياغة بيانٍ يحدّد أهداف الثورة متوقّعًا أن يحظى بموافقة الخميني، وتضمّن البيان مبدأين أساسيين، وهما أن الحكومة الإيرانية المستقبلية سترتكز على الديمقراطية والإسلام. غير أن الخميني، بعد قراءته، أضاف بيده مبدأً ثالثًا اعتبره الأهم، وهو الاستقلال الذي رأى فيه جوهر الثورة وروحها.
وصرّح الخميني عقب انتصار الثورة في فبراير/شباط 1979 بأن الشاه جعل إيران رهينةً للغرب إلى حدٍّ كبير، وأن إصلاح هذا الوضع سيتطلب سنوات، مؤكدًا أن الاستقلال الحقيقي يقتضي إزالة كل أشكال النفوذ الأمريكي، سواء كانت اقتصادية أو عسكرية أو سياسية أو ثقافية.
وكما خطّ الخميني بيده كلمة “الاستقلال” ضمن إعلان مبادئ الثورة، عاد ليؤكّد على المعنى ذاته في وصيته الأخيرة وهو على فراش الموت، مشددًا على أن الاستقلال يُعدّ الركيزة الأساسية للجمهورية الإسلامية، داعيًا الشعب الإيراني إلى التمسّك به والدفاع عنه.
وحتى اليوم، لا يزال قادة الثورة الإيرانية يفتخرون – سواء كان هذا دقيقًا تاريخيًا أم لا – بأنهم أول من منح إيران استقلالًا حقيقيًا منذ قرون، إذ يرون أن نظامهم هو أول حكومةٍ إيرانيةٍ تتمتع بالسيادة الكاملة. ومن هذا المنطلق، غدا مفهوم الاستقلال، منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، ركيزةً مركزيةً في هوية الدولة واستراتيجيتها الرسمية، متغذّيًا على الذاكرة الجمعية المثقلة بالتدخلات الخارجية والشعور المزمن بالتهديد.
وبهذا، يفسّر نصر الاستراتيجية الإيرانية منذ عام 1979 بوصفها استجابةً لتاريخٍ حافلٍ بالغزوات والهزائم والإهانات طوال القرنين التاسع عشر والعشرين، لا مجرد انعكاسٍ لشعاراتٍ أيديولوجية، فالمحرّك الأساسي للاستراتيجية الإيرانية هو الخوف من الهيمنة الخارجية والتفكك الداخلي.
من الدفاع المقدّس إلى الدفاع الأمامي
“نحن المضطهدون على مرّ التاريخ.. لا نملك إلا الاعتصام بالله، ولا نجد أمامنا سوى طريقين، الشهادة أو النصر، وكلاهما في عقيدتنا نصر”. -الخميني-
مثّلت الحرب الإيرانية العراقية (1980–1988) واحدةً من أطولِ وأكثرِ الحروبِ شراسةً في القرن العشرين، إذ شهدت أكبرَ حربِ خنادقَ منذ الحرب العالمية الأولى، وأضخمَ معاركِ دباباتٍ منذ الحرب العالمية الثانية، إلى جانب استخدامِ الأسلحةِ الكيميائية.
تكبّدت إيران ثمنًا فادحًا لهذا الصراع، إذ قُتل ما بين 200–250 ألف إيراني، وأُصيب ما بين 300–400 ألف، وشُرّد قرابةُ مليوني شخص، وكانت إيران تخصّص في عام 1988 ثلثي دخلها القومي لتمويل المجهود الحربي، ما يعكس حجم الاستنزاف الاقتصادي العميق الذي خلّفته هذه الحرب.

يؤكّد نصر أن الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي كانت الحدثَ الأكثر تأثيرًا في تشكيل الاستراتيجية الإيرانية الحالية، متجاوزةً في أثرها ثورة 1979، فقد مثّلت تلك الحرب صراعًا وجوديًا أعاد تشكيل بنية الدولة وأولوياتها الأمنية، وأسس لمنظومةٍ فكريةٍ وعسكريةٍ جديدة.
يرى نصر أن الحرب مع العراق لم تكن مجرد صراعٍ عسكري، بل لحظةً تأسيسيةً أعادت تشكيل بنية الدولة الإيرانية ومفاهيمها الاستراتيجية، إذ أفرزت مؤسساتٍ أمنيةً وعسكريةً جديدة، أبرزها الحرس الثوري الذي أصبح قوةً موازيةً للدولة سياسيًا واقتصاديًا، إلى جانب قوات الباسيج كأداةٍ تعبئةٍ شعبية، وشبكات الرعاية التي استخدمتها الدولة لضمان الولاء الشعبي.
وفي السياق نفسه، بلورت الحرب عقيدة “الدفاع المقدّس” التي أعادت تعريف الثورة، ليس فقط كمشروعٍ أيديولوجي، بل كعقيدةٍ للبقاء والمقاومة طويلة الأمد، لتصبح إحدى الركائز الرمزية والسياسية للنظام. ويؤكّد نصر على مركزية هذه العقيدة من خلال تكرارها أكثر من مئة مرة في كتابه، باعتبارها عنصرًا محوريًا في صياغة التفكير الاستراتيجي الإيراني.
ويُبرز نصر كيف استخدمت الجمهورية الإسلامية الأيديولوجيا الشيعية كأداةٍ استراتيجيةٍ للتعبئة والتماسك الداخلي خلال الحرب مع العراق، حيث ساهمت في ترسيخ ثقافة المقاومة وتحفيز المجتمع على الصمود والتضحية. بكلمات خامنئي: “إن أبرز ما علّمتْنا إياه تجربة الدفاع المقدّس هو أن السبيل الوحيد لضمان الأمن القومي يكمن في المقاومة”.
وهذا الالتزام بالدفاع المقدّس لم يقتصر على الخطاب الديني، بل تلاقى مع المشاعر القومية الإيرانية، ممّا خلق هويةً متماسكةً ومتجذّرة، وتؤكّد المؤرخة “فيروزة كاشاني” أن النظام نجح في تشكيل “ثقافةٍ إيرانيةٍ بديلة” جعلت من الأصولية الدينية تعبيرًا معززًا للهوية القومية، بما وسّع من قاعدة الدعم الشعبي خارج الأطر الدينية الصرفة.
رغم الخسائر البشرية والمادية الفادحة التي تكبّدتها إيران خلال الحرب، فإن النظام اعتبر الصمود بوجه الغزو العراقي إنجازًا بحدّ ذاته، وأعاد صياغة الهزيمة العسكرية في قالبِ نصرٍ رمزيٍّ وسياسي.
وفي سبيل ترسيخ هذا الإرث، بادرت الجمهورية الإسلامية إلى إنشاء شبكةٍ من متاحف “الدفاع المقدّس” في أنحاء البلاد، وسعت إلى ترسيخ رواية المقاومة والتضحية من خلال منظومةٍ متكاملةٍ تشمل المناهج الدراسية، التعليم الجامعي، الإعلام الرسمي، والمؤسسات الثقافية التابعة للحرس الثوري.
وقد أصبحت هذه الرواية جزءًا راسخًا من الثقافة الشعبية، عبر تمجيد الاستشهاد والبطولة، كما يظهر في الجداريات المنتشرة في عموم إيران، والتي تُخلّد ذكريات المعارك الكبرى مثل تحرير خرمشهر وحصار البصرة.
وازدهر هذا التوجّه منذ عام 2011 مع تزايد الحاجة إلى تأطير التدخل الإيراني في سوريا ضمن “روح الدفاع المقدّس”، وقد أسهمت مراكز توثيق مثل مركز وثائق الدفاع المقدّس ومركز وثائق الجمهورية الإسلامية، إلى جانب دور نشرٍ مدعومةٍ من الحرس الثوري، في إنتاج أعمالٍ أدبيةٍ وفنيةٍ تشمل الروايات، المجلات، الوثائقيات، والمسلسلات التلفزيونية.
ويشير نصر إلى أن الحرب مع العراق دفعت الجمهورية الإسلامية إلى إعادة تعريف ذاتها، من مشروعٍ ثوريٍّ يسعى لتصدير أيديولوجيّته، إلى دولةٍ تضع البقاء وتعزيز الأمن القومي في مقدّمة أهدافها. وقد تجلّى هذا التحول في قرار الخميني عام 1988 بقبول وقف إطلاق النار، وهو ما اعتبره نصر تعبيرًا عن وعيٍ استراتيجيٍّ بعدم إمكانية تحقيق نصرٍ عسكريٍّ حاسم.
من هذا المنطلق، وبعد فترةٍ وجيزةٍ من انتهاء الحرب مع العراق، وفي أعقاب الانتصار الساحق للولايات المتحدة في حرب الخليج الأولى، أصدرت إيران عام 1992 أول استراتيجيةٍ رسميةٍ لها، مدركةً حجم التحديات التي تواجهها.
فالدولة كانت معزولةً، مرهقةً اقتصاديًا وبشريًا، وفشلت في تحقيق نصرٍ حاسمٍ في حربها الطويلة، كما شاهدت بأمِّ عينها كيف دمّرت واشنطن الجيش العراقي خلال أيام. في ضوء ذلك، تبنّت إيران نهجًا عسكريًا غير تقليديٍّ سيُعرف باسم “الدفاع الأمامي”، يقوم على نقل خطوط الاشتباك إلى خارج الحدود، إلى جانب تطوير القدرات الصاروخية والسيبرانية، بدلًا من التسليح التقليدي.
ترتكز هذه الاستراتيجية على تحييد التهديدات قبل أن تَبلغ الداخل الإيراني، عبر إنشاء مناطق نفوذٍ عازلةٍ، وتشكيل شبكاتٍ من الوكلاء الإقليميين. فإيران ترى أن أمنها يتحقق بشكلٍ أكثر فاعلية عندما تبسط نفوذها داخل العالم العربي، ليس من خلال الغزو أو الاحتلال المباشر، بل عبر أدوات الحرب بالوكالة. وعلى حدّ تعبير وزير الخارجية السابق جواد ظريف: “تفضيل ساحة المعركة على الدبلوماسية”.
وتقوم هذه المقاربة على مزيجٍ من الأدوات: التعبئة الأيديولوجية، والتحالف مع قوى محليةٍ متقاربةٍ سياسيًا أو مذهبيًا، واستخدام الحرس الثوري كأداةٍ تنفيذيةٍ لتشكيل بيئةٍ إقليميةٍ مواتية، تُمكّن إيران من تعزيز أمنها القومي ورفع كلفة أيّ مواجهةٍ محتملةٍ ضدها.
وبالطبع، استفادت إيران من الانهيار والفوضى في المنطقة، لكن تدخّلها لم يكن عبثيًا أو بدافع التورط المجرد في ملفات مثل لبنان أو سوريا أو اليمن. فالرؤية الاستراتيجية الإيرانية تقوم على أن طهران تخوض صراعًا مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، ولا يُمكنها خوض هذا الصراع بالقوات الجوية والدبابات والجيوش التقليدية، لذا فإن الوسيلة الأنجع للردع هي عبر تمكين وكلائها الإقليميين، بما يضمن إضعاف خصومها وإبقاءهم منشغلين.
يؤكّد نصر أن الدفاع الأمامي يمثّل ركيزةً ثابتةً في العقيدة العسكرية والأمنية الإيرانية، وليس مجرد استراتيجيةٍ مرحليةٍ أو طرحٍ أيديولوجيٍّ صِرف، بل يعكس مزيجًا من البراغماتية والمصالح القومية والتوجّهات الثورية.
وقد رأت دوائر السياسة الخارجية الإيرانية في استراتيجية الدفاع الأمامي انعكاسًا لموقع إيران الهشّ كدولةٍ شيعيةٍ فارسيةٍ وسط منافسين عربٍ وسنّة، بلا أي تحالفاتٍ موثوقة، وتواجه احتواءً تفرضه عليها القوة العظمى في العالم.
وقد أثبت هذا النهج فاعليته في إعادة تشكيل موازين القوى، لا سيّما في العراق ولبنان، كما مكّن طهران من توسيع نفوذها مستفيدةً من تحوّلات الربيع العربي، خاصةً في سوريا واليمن.
غير أن نصر يُلفت إلى التناقض الداخلي الذي تحمله هذه الاستراتيجية، فبينما تُعدّ من منظور صنّاع القرار الإيرانيين أداةً لحماية الأمن القومي وردع الخصوم، تُقابل أحيانًا بتشكيكٍ يصعب تبريره للمواطن الإيراني العادي، بخلاف الدفاع عن الأراضي الوطنية الذي يحظى بقبولٍ شعبيٍّ أوسع. وفي حين تعدّ طهران هذه الاستراتيجية حقًا مشروعًا في إطار الدفاع عن أمنها القومي، تنظر إليها الدول العربية باعتبارها مشروعًا توسعيًا يهدّد الاستقرار الإقليمي.
وخلال العقد الممتد بين عامي 2001 و2010، تطوّر مفهوم الأمن القومي الإيراني الذي كان قد تبلور في العقد الأول بعد الثورة، ليأخذ شكل استراتيجيةٍ تشمل بُعدين رئيسيين: التوسّع الإقليمي عبر مبدأ الدفاع الأمامي، وتطوير البرنامج النووي الذي أصبح أحد أبرز بؤر التوتر بين طهران والمجتمع الدولي.
ومع أن البرنامج النووي اكتسب طابعًا استراتيجيًا في حقبة ما بعد الثورة، إلا أن جذوره تعود إلى عهد الشاه محمد رضا بهلوي، الذي دشّن مشروعًا نوويًا مدنيًا بدعمٍ من الولايات المتحدة، ضمن رؤيته لتحديث إيران وتحقيق نهضةٍ صناعيةٍ شاملة.
ورغم أن الاستخدام السلمي كان الهدف المُعلَن، فإن المشروع حمل منذ بداياته بُعدًا رمزيًا يتعلّق بالهيبة الوطنية والطموح التكنولوجي، وقد التزمت إيران حينها بعدم تطوير أسلحةٍ نووية عبر توقيعها على معاهدة حظر الانتشار.
سياق | البرنامج النووي الإيراني والجدال عليه
بعد الثورة الإسلامية عام 1979، أُعيد تأطير البرنامج النووي ضمن خطاب الأمن القومي، لا سيّما في ظلّ الحرب مع العراق، التي عمّقت في الوعي الاستراتيجي الإيراني الحاجة إلى امتلاك أدواتِ ردعٍ غير تقليدية. فقد شكّلت تجربة الحرب، خاصةً مع لجوء العراق إلى استخدام الأسلحة الكيميائية، دافعًا لترسيخ رؤيةٍ تعتبر البنية النووية وسيلةً لتعزيز السيادة في بيئةٍ إقليميةٍ تعتبرها طهران معادية.
من الدفاع الأمامي إلى الدفاع الشيعي
سعى الرئيس رفسنجاني إلى إعادة توجيه استراتيجية الدفاع الأمامي نحو مقاربةٍ أكثرَ براغماتية، إلا أن فترته ترافقت مع تحوّلاتٍ دوليةٍ كبرى، أبرزها انهيار الاتحاد السوفيتي، ما أثار قلق النخبة الإيرانية من احتمال تكرار المصير ذاته. في هذا السياق، اعتبر المرشد الأعلى علي خامنئي توجّهات رفسنجاني تهديدًا لبقاء الجمهورية الإسلامية، فعمل على عرقلتها، في حين مثّل صعود الحرس الثوري أداةً حاسمةً في ترسيخ الدفاع الأمامي.
ومع تولّي محمود أحمدي نجاد الرئاسة، اتّسع نفوذ الحرس الثوري اقتصاديًا وسياسيًا، وعزّز المرشد الأعلى علي خامنئي هذا الاتجاه، خصوصًا بعد الغزو الأمريكي للعراق واندلاع الربيع العربي، ما رسّخ المسار الأمني في قلب الاستراتيجية الإيرانية.
شكّل انهيار الدولة العراقية، وما تبعه من فراغٍ سياسيٍّ وأمنيٍّ عقب الغزو الأميركي عام 2003، فرصةً ذهبيةً لإيران لتحقيق الأهداف التي كانت تطمح إليها. ويشير نصر إلى أن إيران اعتمدت رسميًا في عام 2003 استراتيجية الدفاع الأمامي، وأوكلت مهمة تنفيذ هذه الاستراتيجية إلى فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني، الذي تولّى تنسيق شبكات النفوذ الإيرانية وتوسيع حضورها، ما جعله العقل المدبّر للتمدّد الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وهي الشبكة التي أطلق عليها المرشد الأعلى لاحقًا اسم “محور المقاومة”.
بحلول عام 2011، أعلن الرئيس أوباما سحب القوات الأمريكية من العراق، وهو ما اعتُبر نصرًا سياسيًا لإيران. وبحسب تحليل نصر، كان يُفترض أن يقود هذا التحوّل إلى مراجعةٍ إيرانيةٍ شاملةٍ لاستراتيجيتها الإقليمية، إلا أن هذه المراجعة لم تحدث، ليس فقط بسبب مقاومة فيلق القدس لأيّ تغييرٍ في النهج القائم، بل أيضًا لأن التحوّلات الإقليمية آنذاك عزّزت من قناعة طهران بفعالية استراتيجيتها.
رغم أن استراتيجية “الدفاع الأمامي” صُمّمت في الأصل لردع التهديدات خارج حدود إيران، فإنها شهدت تحوّلًا نوعيًا مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، إذ اتّسع مفهومها ليشمل الدفاع عن المجال الشيعي بأكمله في المنطقة، وحماية المراقد وشرف آل البيت، بما في ذلك لبنان وسوريا والعراق وأفغانستان.
وقد اعتُبر الدفاع عن هذه المناطق وحماية المراقد المقدّسة فيها امتدادًا مباشرًا للدفاع عن الوطن الإيراني، ممّا مثّل تحوّلًا في تعريف الأمن القومي ليأخذ بُعدًا طائفيًا وثقافيًا يتجاوز حدود الدولة. ووفقًا لنصر، فإن هذا المفهوم يستند إلى رؤيةٍ تُصوّر مجتمعًا شيعيًا عابرًا للحدود، يُعدّ الحفاظ عليه جزءًا من أمن إيران وهويّتها.
واللافت أن نصر يشير إلى أن الإيرانيين أبدوا دعمًا لحملة الحرس الثوري الهادفة لحماية المراقد الشيعية في العراق وسوريا، وهو ما شجّع الحرس على ترسيخ دوره العسكري في سوريا تحت ذريعة الدفاع عن مقام السيدة زينب في دمشق، وأسس لواء فاطميون لهذا الغرض.
أسفر التوسّع في استراتيجية الدفاع الأمامي عن تمكين إيران من ترسيخ وجودها في مناطقَ جديدة، وتعزيز نفوذها في عمق بلاد الشام، إلى جانب بناء شراكةٍ استراتيجيةٍ مع موسكو. كما نجحت في تأسيس شبكةٍ من الوكلاء في العراق وأفغانستان وباكستان، تحت إشرافٍ مباشرٍ من فيلق القدس، وقد أنجزت كل ذلك بتكلفةٍ منخفضةٍ نسبيًا، ما يعكس فعالية هذا النهج، مقارنةً بالتكاليف الباهظة التي تتحمّلها جيوش منافسيها.
ويعتقد الحرس الثوري الإيراني، والقطاع المحافظ من الطبقة السياسية، أن الدفاع الأمامي قد حلّ أخيرًا المشاكل الأمنية التي عانت منها إيران لأكثر من قرن. ويزعمون أن الدفاع الأمامي لا يقتصر على الدفاع عن إيران ضد التهديدات الإقليمية، بل يُلبّي أيضًا رغبة البلاد القديمة في التوسّع وكسب النفوذ.
لكن، كما يوضّح نصر، فإن نجاح استراتيجية “الدفاع الأمامي” بين عامي 2003–2022 لا يضمن قابليتها للاستمرار مستقبلًا، إذ إن الحفاظ عليها بالوتيرة والتكلفة ذاتها يبدو غير ممكن، وقد يكون الثمن النهائي لمواصلة هذا النهج هو الانزلاق إلى الحرب.
ورغم ما فرضته استراتيجية الدفاع الأمامي من أعباءٍ اقتصاديةٍ وسياسيةٍ على إيران، فإنها استمرّت كنهجٍ مفتوحٍ بلا أفقٍ واضح، يتطلّب توسّعًا مستمرًا للحفاظ على فعاليته. ويُشير محمد جواد ظريف إلى أن هذه الاستراتيجية لا تسهّل عمل الدبلوماسية الإيرانية، بل تُثقلها بمزيدٍ من التحديات والتعقيدات.
الانكماش والارتباك
يُشير نصر إلى أن إيران لم تكن تسعى صراحةً إلى امتلاك قنبلةٍ نووية، بل استثمرت برنامجها النووي كورقةٍ تفاوضيةٍ لرفع العقوبات وتحقيق مكاسبَ سياسيةٍ واقتصادية. ورغم أن تصاعد وتيرة التخصيب بعد عام 2011 أدّى إلى فرض عقوباتٍ غربيةٍ مشددة، فإن اتفاق عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى شكّل محطةً مفصليةً، إذ أدّى إلى تخفيف العقوبات مقابل فرض قيودٍ على البرنامج النووي.
غير أن هذا الاتفاق لم يتطرّق إلى أنشطة إيران الإقليمية، ممّا سمح لها بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية الدفاع الأمامي دون عوائقَ تُذكر. وبحلول عام 2020، كانت إيران قد تمكّنت من ترسيخ حضورها الإقليمي، رغم الضغوط المتزايدة واغتيال قاسم سليماني، الذي شكّل مقتله ضربةً مؤثرةً للنفوذ الإيراني.
يُشير نصر إلى أن استراتيجية الدفاع الأمامي واجهت اختلالاتٍ عميقةً مع تبدّل موازين القوى في سوريا، موضّحًا أن اعتماد إيران على وكلاء غير حكوميين أضعف من فاعلية هذه المقاربة وأثّر على استدامتها.
والآن، انهار الدفاع الأمامي، لأنه مع انهيار حزب الله ثم خسارة سوريا، لم يعد هناك ردعٌ ضد إسرائيل. في الواقع، تم إقصاء إيران من بلاد الشام تمامًا. ورغم هذه الانتكاسة، تعتبرها إيران مجرد محطةٍ في حربٍ طويلة.
رغم ما حققته هذه الاستراتيجية من نفوذٍ إقليميٍّ لطهران، إلا أنها أدّت إلى عواقبَ وخيمةٍ على المستوى الداخلي، مثل تصاعد العزلة الدولية، والعقوبات الاقتصادية، وازدياد التوترات الإقليمية. ومع مرور الوقت، بدأ الدعم الشعبي لهذه الاستراتيجية يتآكل، خصوصًا بين الشباب الإيراني.
يرى نصر أن استمرار إيران في تبنّي استراتيجية الدفاع الأمامي دون شرعيةٍ شعبيةٍ يجعل هذه المقاربة هشّةً وغير قابلةٍ للاستمرار على المدى البعيد. فعلى الصعيد الداخلي، تمرّ إيران بتحوّلاتٍ ديمغرافيةٍ ومجتمعيةٍ كبيرة، إذ أصبح المجتمع أقلّ ارتباطًا بالإرث الثوري والتاريخي.
ويتراوح متوسط أعمار السكان حاليًا بين 30 و37 عامًا، ويعتقد نصر أن هذا الجيل الجديد يميل إلى تفضيل الاستقرار والتنمية الاقتصادية، بدلًا من الانخراط في مغامراتٍ خارجيةٍ لا تعود عليه بفوائدَ ملموسة.
ورغم الاستياء الشعبي من الوضع الاقتصادي، يُدرك كثيرٌ من الإيرانيين مخاطرَ التغيير الجذري، ما يجعل الحفاظ على الاستقرار أولويةً لديهم، ولو ضمن نظامٍ مرفوض. هذا التوازن الدقيق بين رفض السياسات القائمة والخوف من المجهول يُعدّ أحد مصادر بقاء النظام.
وقد تزامن هذا الشعور الشعبي مع تحوّلاتٍ كبرى على صعيد السياسة الخارجية، أبرزها انهيار الاتفاق النووي بعد انسحاب إدارة ترامب منه عام 2018، واعتماد سياسة “الضغط الأقصى”، التي أعادت فرض عقوباتٍ مشددةٍ على إيران، الأمر الذي دفع طهران إلى الردّ بتصعيد برنامجها النووي، ورفع نسب التخصيب إلى ما يتجاوز 60%، في محاولةٍ لاستعادة أوراق الضغط والمناورة.
ومع تولّي إدارة جو بايدن السلطة، فشلت جهود مفاوضات الاتفاق النووي في تحقيق تقدّمٍ حاسم. وفي ظلّ استمرار الضغوط الغربية، كثّفت إيران تعاونها مع روسيا والصين، لكن نصر يُشدّد على أن هذه الشراكات لا توفّر بديلًا شاملًا، ما يُبقي باب التفاوض مع الغرب مفتوحًا.
واليوم، تُواجه إيران تحدّياتٍ متراكمة، فقد أثقلت العقوبات الدولية كاهل الاقتصاد، كما تكرّرت الهجمات المباشرة على منشآتٍ حيوية، كالمواقع النووية، وصولًا إلى الهجوم الأمريكي الأخير، الذي شكّل أول استهدافٍ عسكريٍّ مباشرٍ للبرنامج النووي من واشنطن. ووفق تحليل نصر، فقد مثّل هذا التطور نقطةَ تحوّلٍ في ميزان الردع، إذ خلق انطباعًا داخليًا وخارجيًا بأن قدرة إيران على الردّ باتت محدودة.

ورغم تعرّض البنية النووية الإيرانية مؤخرًا لضرباتٍ متكرّرة، إلا أن قدرتها على التعافي لا تزال قائمة، ممّا يعزّز قناعةً داخل القيادة الإيرانية بأن الضربات العسكرية وحدها لن توقف الطموحات النووية على المدى الطويل. وقد دفعت تجربة الحرب الأخيرة مع إسرائيل إلى ترسيخ قناعةٍ لدى بعض تيارات النظام بأن امتلاك رادعٍ نوويٍّ بات ضرورةً استراتيجية، خاصةً مع محدودية الدفاعات التقليدية.
في الواقع، أثارت الضربات الجديدة تساؤلاتٍ حول ما إذا كانت إيران ستُسرّع خطواتها نحو امتلاك قنبلةٍ نووية. غير أن نصر يرى أنه لا تزال هناك فجوةٌ تقنيةٌ ولوجستيةٌ تحول دون التحوّل الفوري إلى سلاحٍ نوويٍّ كامل، ما يجعل الوصول إلى الردع النووي الكامل هدفًا بعيد المدى، رغم استمرار الجهود في هذا الاتجاه.
في المحصّلة، يرى نصر أن تمسّك إيران بحقّ التخصيب لا ينبع من رغبةٍ في امتلاك قنبلةٍ نووية، بل من حرصها على تعزيز استقلالها الاستراتيجي ومكانتها التفاوضية. ويؤكّد نصر أن البرنامج النووي ظلّ في جوهره أداةً تفاوضية، لا مشروعَ تسليحٍ مباشر. فإيران، وفقًا لنصر، سعت إلى الحفاظ على هامشِ مناورةٍ بين التخصيب والشفافية، دون تجاوز العتبة النووية بشكلٍ صريح.
بين الاستمرارية والتكيف: أين تتجه إيران؟
منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979، تبنّت إيران مفهومًا خاصًا للنصر، يقوم على الصمود والبقاء بدلًا من الحسم العسكري المباشر، مستندةً إلى عناصر داخلية، كمساحتها الواسعة وكثافتها السكانية، ممّا يمنحها قدرةً عاليةً على امتصاص الضغوط. وقد صُمّم هيكلها العسكري وفق عقيدةٍ ترتكز على الصبر الاستراتيجي والقدرة على التكيّف مع التحديات طويلة الأمد.
ويوضّح نصر لماذا تنظر إيران إلى مواجهتها الأخيرة مع إسرائيل بوصفها انتصارًا بحدّ ذاته، إذ ترى أنها تخوض مواجهةً مع اثنين من أقوى جيوش العالم تسليحًا وتنظيمًا، وفي صراعٍ مع دولتين نوويتين. ومن هذا المنطلق، تختلف معاييرها في تقييم النصر أو الهزيمة عن المفاهيم العسكرية التقليدية، فالنصر في نظرها لا يُقاس بالحسم الميداني، بل بالقدرة على الصمود والاستمرار.
يرى نصر أن الجمهورية الإسلامية تقف اليوم عند مفترق طرق، حيث تواجه أزمةً استراتيجيةً تتقاطع فيها الضغوط الداخلية والخارجية. فخسارة عددٍ من قادة الحرس الثوري البارزين، وتقدّم المرشد الأعلى علي خامنئي في السن، أطلقا نقاشًا داخليًا حول مستقبل النظام، في ظلّ غيابِ خليفةٍ واضحٍ يتمتّع بشرعيةٍ دينيةٍ وسياسيةٍ كافية.
علاوةً على ذلك، لم تَعد إيران تمتلك قاعدةً شبابيةً كافيةً لخوض حروبٍ تقليديةٍ واسعةِ النطاق، وهو ما يدفع نصر إلى الاعتقاد بأن طهران ستواصل الاستثمار بكثافةٍ في قدراتها غير التقليدية، مثل الصواريخ والطائرات المسيّرة، مع ترجيح حاجتها في المستقبل إلى امتلاك قدرةِ ردعٍ نوويٍّ لتعويض هذا النقص وتعزيز موقعها الاستراتيجي.
ورغم أن البنية العميقة للنظام الإيراني لا تستند إلى مركزيةٍ ثيوقراطيةٍ فقط، بل إلى منظومةِ أمنٍ قوميٍّ معقّدةٍ تتوزّع فيها مراكزُ القوة والمصالح، يوضّح نصر أن القرارات تُصاغ ضمن توازناتٍ حساسةٍ تتجاوز البُعد الأيديولوجي.
في ظلّ هذا الغموض، تتوالى التساؤلات داخل دوائر صنع القرار في طهران: هل تمضي إيران قدمًا في برنامجها النووي، أم تفتح باب التفاوض بشروطٍ جديدة؟ هل تواصل الاستثمار في مشروعها الإقليمي رغم تراجع نفوذ وكلائها؟ أم تعيد ضبط أولوياتها بما يتناسب مع قدراتها المتآكلة داخليًا وخارجيًا؟
ويرى نصر أن هذا النقاش يتّسع ليشمل مصير ما بعد خامنئي، ويُبرز في هذا الإطار شخصية “مجتبى خامنئي” البالغ من العمر 56 عامًا، والابن الثاني للمرشد، والذي يتمتّع برصيدٍ رمزيٍّ داخل المؤسسة العسكرية والسياسية بسبب مشاركته في الحرب الإيرانية العراقية ضمن كتيبة “حبيب بن مظاهر”، ممّا يجعله مرشّحًا محتملًا لخلافة والده، وإن بقي الأمر غير محسوم. ووفقًا لنصر، فإن مجتبى يرغب في إدامة استراتيجية الدفاع الأمامي.
يؤكّد نصر أن إيران أظهرت مرونةً تكتيكيةً في إدارتها للأزمات، فهي تستفيد من الانفتاح الدبلوماسي عند الحاجة، كما في المصالحة مع السعودية، أو تعزيز العلاقات مع روسيا والصين، دون التخلي عن ثوابتها الاستراتيجية. غير أن هذا النهج لم يُوفّر حلولًا اقتصاديةً أو أمنيةً شاملة، ما يُبقي خيار التفاوض مع الغرب مطروحًا كأداةٍ لتخفيف الضغط وتحقيق التوازن.
ويختتم نصر رؤيته بأن بقاء الجمهورية الإسلامية مرهونٌ بقدرتها على التكيّف، لا بالقوة وحدها، بل من خلال مراجعةٍ استراتيجيةٍ جذريةٍ تجمع بين الإصلاح الداخلي وترشيد الطموح الإقليمي. فالمواجهة المستمرة دون إصلاحٍ حقيقيٍّ قد تُفضي إلى تقويض أُسس النظام نفسه. بعبارةِ نصر: إيران تحتاج أن تُظهر “مرونةَ الثعلب”.










