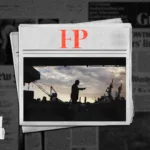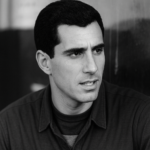تمهيد..
الروح المتجذرة للمقاومة الشعبية في الوعي المصري..
يتسم تاريخ مصر الحديث بأمثلة، تحدث بشكل دوري، تجسّد المقاومة الشعبية ضد الظلم، سواء كان داخليًا أو خارجيًا. هذه المقاومة تتجلى غالبًا في أفعال فردية أو جماعية محدودة، تنبع من إحساس عميق بالكرامة والعدالة والدور الإنساني، وتتحول إلى رموز ملهمة للأجيال فيما بعد، إنها تعكس رفضًا متأصلًا للاستسلام والخضوع.
تُعد حادثة الفلاح المصري سعد حلاوة في فبراير 1980 نقطة تحول رمزية في تاريخ الرفض الشعبي للتطبيع مع “إسرائيل”، إذ قام بفعل احتجاجي مسلح فريد، تحدى به سياسات الرئيس أنور السادات بشكل مباشر، في وقت كانت فيه الأمة العربية تمر بمرحلة جديدة وصعبة، فقد فعله صرخة مدوية في وجه سياسة رسمية كانت تسعى لتغيير مسار العروبة، وأظهر أن الكرامة الوطنية لا تزال حية في قلوب كثير من المصريين.
بعد عقود، وفي سياق متباين ومُتداخل مع حدث حلاوة التاريخي، قام بضعة شباب مصري بـ “اقتحام” قسم المعصرة بحلوان، في يوليو 2025، واحتجاز رجال القسم لساعات. هذه الحادثة، وإن كانت محاطة بالغموض والنفي الرسمي، تشير إلى استمرارية الروح المعارضة في ظل تحديات جديدة، وتؤكد أن جذور الرفض لا تزال عميقة في التربة المصرية، وأن الشباب المعاصر يجد طرقًا جديدة للتعبير عن غضبه.
نحاول من خلال الحدثين، طرح رؤية معمقة ومقارنة بينهما، مبرزًا كيف تتطور أشكال الاحتجاج الشعبي في مصر من المواجهة الفردية المسلحة إلى التعبير الرقمي الرمزي؟ وما هي السياقات والدوافع التي حركت هذه الأفعال، لا سيما فيما يتعلق بالسيادة الوطنية والتضامن الإقليمي، وخاصة القضية الفلسطينية، التي ظلت ثابتة كعناصر محفزة للغضب الشعبي عبر الأجيال. كما ما استراتيجيات الدولة المتغيرة في التعامل مع هذه الأفعال، وكيف تتنافس السرديات الرسمية والشعبية على تشكيل الذاكرة التاريخية لهذه الأحداث؟
عهد السادات وسياقات التحدي
بعد الانتصار المصري الجزئي في حرب أكتوبر 1973، بدأ السادات في رسم مسار جديد للسياسة الخارجية المصرية، بهدف استعادة الأراضي المحتلة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبعد الحرب بأربعة أعوام، جاءت زيارة السادات التاريخية للقدس عام 1977، والتي أدهشت العالم، كأول خطوة رسمية وأمام العالم، لاتجاه مصر نحو التطبيع والسلام، وحل جميع القضايا العربية العالقة مع إسرائيل، بما فيها القضية الفلسطينية.
توجت هذه الجهود بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر و”إسرائيل” في عام 1979، ورغم أنها أدت إلى استعادة كامل سيناء فيما بعد، إلا أنها أثارت جدلاً واسعًا وغضبًا شعبيًا وعربيًا كبيرًا، إذ كان التطبيع مع “العدو الصهيوني” أمرًا مرفوضا في الوعي الجمعي المصري والعربي بعد عقود من الصراع والدم، فقد اعتبر كثير من أبناء الأمة العربية أن هذه الخطوة بمثابة خيانة للمبادئ القومية العربية والقضية الفلسطينية، مما خلق بيئة من السخط الشعبي.
بالتوازي مع التحول السياسي الخارجي، تبنى السادات سياسة “الانفتاح الاقتصادي”، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتحرير الاقتصاد، والتي تضمنت السماح بالملكية الأجنبية لبعض القطاعات، ووقف سياسات الحماية الاجتماعية، مما أدى إلى تراجع دور الدولة وتصاعد دور القطاع الخاص. كانت لهذه السياسات تأثيرات سلبية عميقة على صغار المزارعين والقرى المصرية، كما سعت الحكومات المتعاقبة إلى خلق “قطب زراعي جديد أكثر ربحية” يركز الملكيات في أيدي الشركات الخاصة الكبرى والجيش، بعيدًا عن الكتلة الزراعية الأصلية.
من أبرز التشريعات التي أثرت سلبًا على الفلاحين كان القانون رقم 69 لسنة 1974، الذي ألغى وصاية الدولة على الأراضي الزراعية ورفع الحراسات عن الأراضي التي صادرتها هيئة الإصلاح الزراعي في عهد عبد الناصر، ما أدى إلى تسليم الأراضي لورثة كبار الملاك بعد إخلائها من المزارعين، وقد تسبب في فقدان مئات الآلاف من صغار المزارعين لأراضيهم. تفاقمت الأوضاع مع صدور قانون الأراضي الصحراوية عام 1981، الذي زاد الحد الأقصى للملكية الفردية، وفتح الباب لتركيز الأراضي في أيدي رجال الأعمال، مما أدى إلى تهميش الفلاحين الصغار.
عكست الإحصائيات هذا التدهور، حيث انخفضت مساحة الأراضي التي يحوزها صغار المزارعين (90% من إجمالي الحائزين) من 57.1% عام 1965 إلى 53% عام 1981 كما كانت استفادة الفلاحين من قوانين الإصلاح الزراعي محدودة للغاية في عهد السادات، حيث لم تتجاوز مساحة الأراضي الموزعة 35,343 فدانًا فقط بين عامي 1970 و1981، أي حوالي 0.5% من إجمالي مساحة الأرض الزراعية، مما أثر على 44,836 أسرة فقط.
أدت هذه السياسات إلى معاناة الفلاحين من السوق السوداء وتجار الاحتكار، وتدهور الإنتاج الزراعي والاعتماد على الاستيراد، وعادت مشاهد الفقر والمرض والجهل كي تتصدر الصورة، مما ألقى بظلاله على حياة الفلاحين وجعلهم يعيشون “حياة بائسة”.
كانت انتفاضة الخبز، في يناير 1977، خير دليل على السخط الاقتصادي والاجتماعي بسبب سياسات السُلطة، والتي اندلعت في المدن الكبرى بسبب خفض الدعم الحكومي عن السلع الأساسية، فاتجهت المظاهرات نحو أقسام الشرطة والهتافات الساخطة حيال رموز الدولة، وشارك فيها الطلاب بشكل كبير، على الرغم من وصف الحكومة للمتظاهرين بـ “العناصر الشيوعية المنظمة”، إلا أن طبيعتها العفوية أجبرت الحكومة على التراجع الفوري عن القرارات، وقد قتلت قوات الأمن قرابى أسفرت الانتفاضة عن مقتل حوالي 80 شخصًا وأصابت أكثر من 550 واعتقلت حوالي 1200.
سعد حلاوة: صرخة الرفض الفردانية
سعى السادات إلى إبرام سلام مع “إسرائيل”، معتبرًا إياه ضرورة استراتيجية. خطوته بزيارة الكنيست في القدس عام 1977 أذهلت العالم، وتلقتها “إسرائيل” بحذر. كان يظن أن “إسرائيل” ستصدم وتدفع لحل جميع القضايا، لكنها لم تفعل، توج هذا المسار بتوقيع معاهدة السلام في عام 1979، التي أدت إلى عزلة مصر عربيًا وسخط شعبي عميق.
بعد أقل من عام على توقيع الاتفاقية، جاءت لحظة “إلياهو بن أليسار” لتقديم أوراق اعتماده كأول سفير لـ”إسرائيل” في القاهرة، وكانت ذات حساسية رمزية بالغة في الوعي الشعبي، جاء ذلك في فبراير 1980، مما جعلها حدثًا يرمز إلى تحول عميق في السياسة المصرية تجاه إسرائيل، وهو ما لم يتقبله قطاع واسع من الشعب.
من هو سعد حلاوة؟
ولد سعد إدريس حلاوة في 2 مارس 1947 بقرية أجهور الكبرى، مركز طوخ، محافظة القليوبية. نشأ في أسرة ريفية متوسطة، تمتلك أراضي زراعية. كان سعد واحدًا من ستة أبناء، أكمل جميع إخوته تعليمهم العالي وتولوا وظائف حكومية، بينما اكتفى سعد بالمرحلة الثانوية واتجه لمساعدة والده في زراعة الأرض، ما يعكس اختياره، ربما، ارتباطه العميق بالأرض والفلاحين الذين اشتدت معاناتهم سنة تلو الأُخرى.
كل من عرف سعد، وصفه أنه شخصًا هادئًا ومثقفًا لا يكف عن القراءة، ولم يكن منتميًا لأي حزب سياسي، بل كان مواطنًا عاديًا عاصر الأحداث السياسية المأساوية التي عصفت بمصر والوطن العربي، فقد تربى وترعرع شبابه وسط تتابع الأحداث والنكبات، حرب فلسطين 1948، والعدوان الثلاثي 1956، ونكسة 1967 وحرب الاستنزاف، ورأى جرائم الحرب الصهيونية، ثم عاصر حرب أكتوبر 1973 وانتصار الجيش المصري.
كل هذه الأحداث زرعت في قلبه إدراكًا واضحًا للعدو من الصديق، وقد شعر سعد بالخيانة من الخطوة الرسمية نحو التطبيع، خاصة وسط الغضب العربي، وأنه كان يرى أن ما يحدث في القصر الجمهوري لا يجب أن يمر مرور الكرام، وأن واجبه القومي يحتّم عليه الاعتراض بطريقة مختلفة، في زمن وصفه البعض بـ “زمن الاستسلام والخضوع”، حيث “المجنون هو الذي لا يزال عنده كرامة، ومن بعدها خطط ونفذ حادثته الشهيرة.
حادثة الاحتجاز
صباح يوم الثلاثاء 26 فبراير 1980، خرج حلاوة من منزله، بعد أن قرأ الصحف واتخذ قراره، قبل أن يجهز حقيبته، التي احتوت على بندقية رشاشة (مرخصة لحماية أملاكه)، ومكبر صوت، ومسجل صغير، وبعض المأكولات، قبل أن يتوجه إلى الوحدة المحلية، صلى ركعتين في مسجد القرية، فقد كان يعلم أن صوته يجب أن يصل ليس فقط إلى السادات، بل إلى العالم كله.
وصل سعد إلى مبنى الوحدة المحلية، ودخل بشكل طبيعي حاملاً حقيبته. في الداخل، كان هناك سبعة موظفين، فطلب من أحدهم مساعدته في حمل الحقيبة إلى الدور الثاني، ثم أخرج بندقيته الرشاشة ووجهها نحو الموظفين بهدوء قائلاً: “أنتم مخطوفون”، ومن ثم أكد لهم أنهم لن يصابوا بأذى، وأن هدفه هو إيصال رسالة إلى الرئيس السادات مفادها أن هناك من يرفض سياساته.
بعد ذلك، فتح سعد نافذة الوحدة المحلية وأعلن عبر مكبر الصوت بيانه الأول، الذي سمعه الجميع، بمن فيهم عمدة القرية “نور حلاوة” الذي كان عم سعد. كانت رسالته واضحة: “الموظفون مخطوفون حتى يتم طرد السفير الإسرائيلي من مصر”، فقد خيَّر السادات بين الحفاظ على أرواح الرهائن أو طرد السفير الإسرائيلي فورًا، كما قام بتشغيل أغاني وطنية لعبد الحليم حافظ وخطابات لجمال عبد الناصر من المسجل الصغير.
سريعا، وصل الخبر إلى عمدة القرية، الذي هرول إلى الوحدة المحلية محاولاً إقناع سعد بالتراجع، لكن أبلغ الثاني بما يريده من الرئيس السادات، فاتصل الأول بمأمور المركز، الذي أبلغ مدير الأمن، ومن ثم تم إبلاغ وزير الداخلية حينذاك نبوي إسماعيل، وبدوره، ولشدة حساسية الموقف، شعر أبلغ السادات شخصيًا بما يحدث. غضب السادات جدا، ووصف حلاوة بـ “المجرم”، وأصدر أوامره الفورية للوزير بسرعة التصرف، فاتجه وزير الداخلية إلى الوحدة، وطلب من سعد تسليم نفسه مقابل عدم تقديمه للمحاكمة. لكن، رفض سعد ما عُرض عليه، ومن بدء في انفعال عبر مكبر الصوت واتهم السادات بالخيانة.
في محاولة يائسة، قرر الوزير استخدام والدة سعد كورقة ضغط، وهى عادة قديمة لدى عقلية الأمن المصري، تهديد الأشخاص بالقبض على ذويهم. جاءت الأم، وتحدثت إلى سعد عبر الميكروفون، بينما كانت تبكي وتتوسل إليه كي يسلم نفسه. لكن، الصدمة كانت في رد سعد الذي رفض طلب أمه، وطلب منها أن تقرأ الفاتحة على روحه، قائلاً لها أن تعتبره “المرحوم سعد حلاوة” من اليوم، متمسكًا بموقفه حتى النهاية، حينها، تأثر الموظفون المختطفون، وقد أبدوا تعاطفهم مع سعد، وشعروا أنه يقول ما كانوا يريدون قوله، لكن، كان هو أشجع منهم.
بعد أن فشلت المفاوضات، أصدر وزير الداخلية أوامر بإطلاق زخات من الرصاص لتخويف من في الداخل، فانبطح الجميع على الأرض بعد توقف الرصاص، أشار العمدة نور حلاوة لأحد الضباط بأنه يرى سعد من خلال النافذة، ومن ثم أطلق ضابط قناص رصاصة واحدة أدت إلى مقتل سعد، بينما لم يصب أي من الرهائن بأذى.
تحكي الرواية الشعبية، أن أول إصابة أصيب بها سعد كانت في عينه اليسرى. رغم إصابته، لم يفكر في الاطمئنان على نفسه، بل أخرج كشافًا من جيبه وبدأ ينظر إلى الرهائن ليطمئن عليهم. بعدها، بدأ يغمس إصبعه في الدم النازف من عينه ويكتب رسالته على الحائط. ظل يكتب حتى فاضت روحه من جسده، ولم يكمل الحرف الأخير من كلمة “حرة” في جملته “اطردوا السفير عاشت مصر حرة” . تم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى طوخ ومن هناك تم دفنه في المقابر مباشرة.
انتشر خبر مقتله بسرعة، وغطت أخباره على الخبر المرتبط بتقديم أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي في مصر، مما أزعج السادات نفسه. وقد أصبح سعد حلاوة رمزًا شعبيًا للرفض، ورثاه كبار الشعراء مثل نزار قباني الذي وصفه بـ “مجنون مصر الجميل الذي كان أجمل منا جميعًا”، وأنه “أطلق الرصاص على العقل العربي المتنحس الجلد البارد الدم، العاطل عن العمل”، وأن القدر أرسله ليقول جملة واحدة قبل أن يموت، “هذه ليست مصر”.
حادثة قسم المعصرة: احتجاج العصر الرقمي..
في الوقت الحالي، تعاني مصر حاليًا من ضغوط اقتصادية كبيرة، تتجلى في ارتفاع معدلات الفقر، وتدهور الأوضاع المعيشية، يضاف إلى ذلك حالة من القمع السياسي المستمر، واعتقال عشرات الآلاف من المعارضين، ومنهم المئات بسبب التضامن مع فلسطين ضد الإبادة الجارية في غزة، مما يضيق الخناق على أي شكل من أشكال التعبير عن الرأي. هذه الظروف تخلق حالة من الغضب المكبوت.
تتفاعل الأوضاع الداخلية مع التطورات الإقليمية، وتحديدًا ما يحدث في قطاع غزة، إذ يشعر الشعب المصري بغضب شديد تجاه ما يحدث في غزة من إبادة جماعية ومعاناة إنسانية، كما يتزايد الإحساس بالإحباط من الموقف الحكومي تجاه القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بإغلاق المعبر والصمت الرسمي، ومؤخرا اتفاقية الغاز الجديدة البالغ قيمتها 35 مليار دولار حتى عام 2040.
بعد عقود من حادثة سعد حلاوة، وفي سياق مصري متباين ومُتداخل أيضا، برزت حادثة قسم المعصرة بحلوان كنموذج معاصر لأشكال الاحتجاج، التي أثارت جدلاً واسعًا وشغلت الرأي العام، رغم النفي الرسمي.
تضمنت الحادثة قيام شابين، يُدعى أحدهما أحمد الشريف والآخر ابن خاله محسن مصطفى، باقتحام مقر أمن الدولة في الطابق الرابع بقسمِ شرطة المعصرة بحلوان، حيث كانا يتابعان هناك، ضمن ما يعرف بالمتابعة لدى الأمن الوطني، ومن ثم انتشر فيديو للحادثة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه الشابان وهما يحتجزان عددًا من رجال قسم الشرطة داخل غرفة الحجز، ويرفعان شعارات سياسية.
كانت الدوافع المعلنة للشباب هي نصرة لغزة، ورفض إغلاق المعبر، والصمت الحكومي تجاه ما يحدث هناك، أيضا، وفق إصدار صوتي منسوب للشاب أحمد عبد الوهاب، كانت خطتهم تهدف إلى حبس الضباط والطاقم الأمني، وتصوير أماكن التعذيب، والإفراج عن المعتقلين، والضغط على النظام، وكذلك الضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية في غزة. في أحد الفيديوهات، ظهر الشاب محسن مصطفى مصابًا، ومن رأسه ينزف الدم، ويعبر عن قلقه على مصيره، ويشير الإصدار الصوتي لأحمد عبد الوهاب إلى أن سماع هذا الإصدار يعني أن العملية لم تتم كما خططوا لها، مما يوحي باحتمال مقتلهم على يد قوات الأمن.
بعد انتشار مقاطع الفيديو بشكل واسع، في بلدان كثيرة، نفت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها صحة الفيديو المتداول، ووصفته بأنه “مفبرك”، على يد أنصار الجماعة الإرهابية. لكن، بعض المصادر ذكرت أن الفيديو نُشر على قناة “طوفان الأمة” على تليجرام، وادعى البعض أنه يعود لهروب أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي عام 2021، لكن وجود لافتات مكتوبة بالعامية، وشبَّه المبنى بمباني أمن الدولة في مصر نفى هذه الادعاءات، وقد قامت بعض المصادر الخاصة بالتحقق من الأخبار، بتأكيد صحة مقطع الفيديو.
تزامنًا مع هذه الأحداث، قامت قوات الأمن بشن حملة اعتقالات شرسة، وذكرت مصادر أن الشابين أحمد الشريف ومحسن مصطفى، قد تم نقلهما إلى مقار الأمن الوطني بالعباسية عقب اعتقالهما قبل أن يخرجا من القسم، وأنهما قد تعرضا للقتل، أي “التصفية الجسدية”، في ظل غياب أي تواصل معهما أو توثيق حقيقي بشأن ما حدث لهم حتى وقتنا الحالي.
تُبرز حادثة قسم المعصرة التحول الجذري في أشكال الاحتجاج الشعبي في مصر، فبينما اعتمد سعد حلاوة على السلاح والمواجهة المادية المباشرة، استخدم مقتحمو المعصرة الكاميرا والهواتف الذكية كأدوات رئيسية لاحتجاجهم، إذ هم يعرفون أن أي مواجهة مسلحة مع قوات الأمن هم فيها الخاسرون لفرق القدرات بينهما، لذا، اعتمدوا أن تكون منصات التواصل الاجتماعي، ومقطع الفيديو، هو ذاته محرّكًا للجماهير المصرية للضغط على النظام المصري أو حتى إسقاطه باحتجاجات ضخمة ومتفجرة في الشوارع.
لم يكن الهدف المواجهة المباشرة مع السلطة فحسب، بل نشر الرسالة على أوسع نطاق ممكن عبر المنصات الرقمية لخلق ضغط عام وتضامن. الفيديو الذي انتشر بسرعة، رغم نفيه، أحدث صدى واسعًا وأثار نقاشات، مما يجعله نموذجًا لـ “الاحتجاج الرمزي الجماعي عبر الفيديو الرقمي”
بين حادثتين
على الرغم من الفارق الزمني الكبير الذي يقارب الخمسة وأربعين عامًا بين حادثة سعد حلاوة (1980)، وحادثة قسم المعصرة (2025)، إلا أنه يوجد أوجه تشابه واختلاف جوهرية في الدوافع والأساليب وردود الفعل والأثر.
كلا الحادثتين كانتا مدفوعتين بإحساس عميق بالكرامة الوطنية ورفض للظلم أو الخيانة، وترك الشعب الفلسطيني وحده. كان سعد حلاوة يشعر بالخيانة من خطوة التطبيع، بينما شعر شباب قسم المعصرة بالغضب من الصمت الحكومي تجاه الإبادة الجارية في غزة، ما يوضح مدى الارتباط القوي بالقضية الفلسطينية ورفض الوجود أو السياسات الإسرائيلية كدافع رئيسي مشترك، كما أن كلا الطرفين شعرا بأن أصواتهم غير مسموعة عبر القنوات الرسمية، فأحبّا أن يصرخوا بكل ما فيهم من إرادة وفعل ومقدرة.
بينما كان احتجاج سعد حلاوة موجهًا بشكل أساسي ضد التطبيع مع “إسرائيل” كسياسة خارجية، فإن احتجاج شباب المعصرة كان له أبعاد أوسع، فبالإضافة إلى تضامنهم مع غزة، كان احتجاجهم يعكس أيضًا غضبًا من القمع الداخلي والأوضاع الاقتصادية الصعبة في مصر، فهم قد تحدثوا عن قضايا المعتقلين في مصر، ومنهم أصدقائهم، سواء بسبب معارضة النظام أو التضامن مع فلسطين.
أيضا، الحادثتين تضمنتا مواجهة مباشرة مع سلطة الدولة أو رموزها، سعد حلاوة استهدف الوحدة المحلية، بينما استهدف شباب المعصرة قسم الشرطة، بشكل مباشر، كما أن كلا الواقعتين تضمنتا “احتجاز” أو “حبس” لمسؤولين.
أيضا، كان رد فعل السُلطات بعد قرابة 5 عقود بذات العقلية الأمنية، إذ تعاملت السلطة مع حلاوة بسخرية في البداية، ووصفه السادات بـ “المجرم”، ثم تم وصفه بـ “المجنون”، ومن ثم قتلوه بشكل مباشر، كذلك شباب المعصرة، وعلى الرغم من النفي الرسمي لوزارة الداخلية بالواقعة من الأساس، غلَّا أن التعامل الأمني المباشر، إذ تم تصفية الشباب جسديا، على الأغلب، بعد اعتقالهم داخل القسم..
نهاية، يُعد حلاوة رمزًا تأسيسيًا للرفض الفردي المسلح للتطبيع، وقد كشفت تضحيته عن عمق المعارضة الشعبية لسياسات السادات، وظل رمزا وجدانيا لدى الشعب المصري رغم محاولات الأنظمة مسح سيرته تماما. كذلك، كانت محاولات شباب المعصرة أقل زخما، إذ اعتمد زخمها على منصات التواصل الاجتماعي التي سرعان ما ينسى جمهورها الحدث، إذ يتعامل الجمهور على السوشيال ميديا وفقا لمفهوم “الترند”، فيمكث الخبر مع الجمهور يوم أو يومين، سواء كان الخبر موت أو قتل أو عملية مسلحة أو غير ذلك، ثم يذهب الخبر ويأتي ترند آخر بعده، وهكذا.
أيضا، تُسلط كلتا الحادثتين الضوء على التحديات المستمرة بين السرديات الرسمية والشعبية في تشكيل الذاكرة التاريخية، فالدولة غالبًا ما تسعى إلى نزع الشرعية عن هذه الأفعال، سواء بوصف مرتكبيها بـ “المجانين” أو “المجرمين” في الماضي، أو بـ “فبركة” الأحداث ونفيها في الحاضر. في المقابل، يتبنى الوعي الشعبي هذه الأفعال ويرفعها إلى مصاف الرموز البطولية، حتى ولو لفترة مؤقته، مما يضمن استمراريتها في الذاكرة الجمعية وتأثيرها على الأجيال اللاحقة، فيما يزيد عصرنا الرقمي من تعقيد هذه المعركة السردية، حيث يصبح من الصعب على أي طرف التحكم الكامل في تدفق المعلومات.
تقدَّم هذه الأحداث دروسًا قيمة حول طبيعة الاحتجاج الشعبي في سياقات القمع، كما أنها تُظهر مرونة المقاومة الشعبية وقدرتها على التكيف حتى في ظل الظروف القمعية الشديدة. عندما تُغلق القنوات التقليدية للتعبير، يجد الأفراد والجماعات وسائل بديلة للتعبير عن مظالمهم وتحدي السلطة، بغض النظر عن النجاح التكتيكي الفوري لهذه الأفعال، فإنها تعمل كبيانات رمزية قوية، تتردد أصداؤها عبر الأجيال، وتؤكد أن جذوة الرفض لا تنطفئ وأن الكرامة الوطنية تظل محركًا دائمًا للعمل الشعبي.