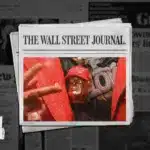تشهد سوريا واحدة من أكثر التحديات المعيشية والاقتصادية تعقيدًا، نتيجة التراجع الحاد في الموارد المائية السطحية والجوفية، وتزايد الضغوط المناخية والبشرية على البنية التحتية الهشّة، فمن انحسار الأنهار الكبرى كالفُرات، إلى تراجع معدلات الهطل المطري، مرورًا بضعف الاستثمار في مشاريع الري، تتكشّف ملامح أزمة تهدّد الأمن المائي والغذائي، وتنعكس مباشرة على قطاعات الزراعة والصناعة والسكن.
تشهد دمشق وريفها أزمة مياه شرب غير مسبوقة، تُعدّ الأخطر منذ عام 1958، حيث تتكرر الانقطاعات في ضخ المياه نتيجة انخفاض منسوب الموارد المائية، ونقص الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المضخّات، فضلًا عن الأعطال المتكررة في الشبكات القديمة، التي باتت تمثل نموذجًا صارخًا لانعكاسات الشحّ المائي في سوريا، وسط تحديات مناخية وبنيوية متراكمة.
وفي إطار التحرّك الرسمي لمعالجة الأزمة، عقد معاون وزير الطاقة للموارد المائية، المهندس أسامة أبو زيد، اجتماعًا مع وفد من الخبراء السعوديين المتخصصين في تحلية المياه والطاقة المتجددة. واستعرض الجانب السعودي تجربته الرائدة في تحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تصل إلى 12 مليون متر مكعب يوميًا، كنموذج عالمي يمكن لسوريا الاستفادة منه في حال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة. وقد اختُتم الاجتماع بالاتفاق على إعداد مسودة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة، بما يسهم في دعم الأمن المائي السوري وتوفير حلول مستدامة لمواجهة الأزمة.
لكن المواطن السوري يحتاج اليوم إلى حلول عاجلة تضمن له الحد الأدنى من الأمن المائي، ومن هنا تبرز مجموعة من التساؤلات الملحّة: هل ثمة إجراءات إسعافية موازية يجري العمل عليها لتخفيف وطأة العطش قبل دخول الاستثمارات حيّز التنفيذ؟ وما هي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة؟ وكيف يمكن التعامل مع أزمة مركّبة تمسّ جوهر الأمن المائي والغذائي؟ ثم ما الحلول الممكنة، وما التحديات التي قد تعترضها؟
في هذا التقرير نسلّط الضوء على ملامح الأزمة المائية المتفاقمة في سوريا، ولا سيما في دمشق وريفها، ونستعرض أبرز المقترحات والحلول المطروحة على لسان نخبة من الخبراء وأصحاب الاختصاص.
تداعيات اقتصادية واجتماعية
انعكست أزمة المياه على مجمل مفاصل الحياة لدى المواطن السوري، فقد أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن إطلاق برنامج جديد لتقنين المياه، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة واستمرار شحّ الأمطار.
وبحسب البرنامج، بلغت ساعات التقنين في ضاحية قدسيا 90 ساعة، مقابل 12 ساعة فقط من التزويد بالمياه خلال فترة امتدت لـ15 يومًا. وفي حيّ الورود، سُجّل نفس عدد ساعات التقنين (90 ساعة)، بينما ارتفعت ساعات التزويد إلى 17 ساعة فقط. أما في جبل الرز ووادي المشاريع، فقد أشار البرنامج إلى أن التزويد يتم ثلاثة أيام في الأسبوع، ولمدة لا تتجاوز أربع ساعات يوميًا. وفي مناطق أخرى مثل أوتستراد المزة، الفيلات الشرقية، شارع المدارس، العدوي، شرقي التجارة، الزبلطاني، وشارع بغداد، اقتصر التزويد على ستة أيام أسبوعيًا، بمدة تتراوح بين ست إلى تسع ساعات يوميًا، وفقًا لطبيعة كل منطقة.
جفاف غير مسبوق يضرب #سوريا منذ 36 عامًا.. إنتاج القمح يتراجع 40٪ وثلاثة ملايين سوري يواجهون خطر الجوع الحاد. فهل تتحول الأزمة إلى فرصة لبناء تنمية خضراء؟ pic.twitter.com/7bNKMB4HZi
— نون سوريا (@NoonPostSY) August 22, 2025
في ريف دمشق، امتد تقنين المياه في بعض المناطق إلى أكثر من عشرة أيام متواصلة، وذلك تبعًا لطبيعة الآبار المغذية لكل بلدة أو تجمع سكني. هذا الانقطاع الطويل دفع العديد من المواطنين إلى اللجوء لشراء المياه من الصهاريج المتنقلة، بأسعار وصلت إلى نحو 100 ألف ليرة سورية للصهريج الواحد، في ظل غياب البدائل المستدامة.
وتزامنًا مع ارتفاع الطلب، شهدت أسعار خزّانات المياه المنزلية زيادة بنسبة 20%، حيث بلغ سعر الخزّان بسعة 1000 ليتر نحو مليون و100 ألف ليرة. كما ارتفعت أسعار المضخّات المائية، المعروفة محليًا باسم “حرامي المياه”، نتيجة الإقبال المتزايد عليها. إلا أن الظاهرة الأكثر إثارة للقلق تمثّلت في تسجيل حالات سرقة مياه من أسطح المنازل، في مشهد يعكس حجم الأزمة وتداعياتها الاجتماعية.
الأزمة لم تقتصر على الاستخدام المنزلي، بل امتدت لتطال القطاع الزراعي، حيث تراجع ريّ المحاصيل بشكل ملحوظ مع جفاف الآبار، وفي ظل غياب محطات معالجة مياه الصرف الصحي. وقد ضبطت الجهات المعنية خلال العام الماضي 114 مخالفة تتعلق بريّ المزروعات بمياه صرف صحي غير معالجة، شملت محاصيل مثل البقدونس، الملوخية، والباذنجان، وغيرها. كما تم تنظيم 10 ضبوط إضافية مؤخرًا في مناطق متفرقة من ريف دمشق.
سببان لأزمة المياه في دمشق وريفها
أوضح مدير عام مؤسسة مياه دمشق وريفها، المهندس أحمد درويش لـ”نون بوست” أن العاصمة السورية ومحيطها تعتمد في تغذيتها المائية على عدة مصادر رئيسية، أبرزها نبع الفيجة الذي يشكّل ما نسبته 70% من المياه الواردة في الظروف الطبيعية، وترتفع النسبة إلى 100% في حالات الفيضان. وإلى جانب الفيجة، تُضاف مصادر أخرى مثل نبعي بردى وحاروش، وآبار بسيمة، فضلًا عن مجموعة من الآبار المنتشرة داخل مدينة دمشق وفي ريفها المحيط.
هذه المصادر، وفقًا لـ درويش، تُغذّي المدينة عبر شبكة تمتد لعشرات الكيلومترات، وصولًا إلى خزّانات رئيسية في جبل قاسيون، ومنها إلى خزّانات فرعية موزّعة في أنحاء العاصمة. كما توجد آبار داخل المدينة تضخّ المياه مباشرة إلى الشبكة، وتُستخدم لدعم مياه الفيجة قبل دخولها إلى منظومة التوزيع.
وأشار إلى أن الاحتياج اليومي لمدينة دمشق يبلغ نحو 560 ألف متر مكعب، وهو رقم مشابه لما يحتاجه الريف المحيط. إلا أن هذا الرقم شهد انخفاضًا كبيرًا خلال العام الحالي، نتيجة تراجع كميات المياه الواردة من الآبار والينابيع، ما انعكس بشكل مباشر على المواطنين الذين باتوا يشعرون بوضوح بشحّ المياه، واضطر كثير منهم إلى شراء خزّانات إضافية لتخزين المياه تحسّبًا لانقطاعها.
وعن أسباب الأزمة، بيّن درويش أنها تعود إلى عاملين رئيسيين: الأول مناخي، والثاني تقني. فالمناخ لعب دورًا حاسمًا في انخفاض معدلات الهطل المطري والثلجي على الأحواض المغذية، حيث لم تتجاوز نسبة الهطل 33% على حوض الفيجة، و24% على حوض دمشق، ما أدى إلى تراجع كبير في كميات المياه المتدفقة من المصادر الطبيعية.
أما السبب التقني، فيتمثل في خروج عدد كبير من الآبار والمضخات عن الخدمة نتيجة التهالك، والتخريب، والسرقة، والإهمال. كما تعاني الشبكات من ضعف في إيصال المياه، بسبب قدمها وتعرّضها للقصف والتخريب في سنوات سابقة، إضافة إلى التعديات والسرقات، والحفر العشوائي للآبار، مما أثّر سلبًا على كفاءة التغذية المائية. يُضاف إلى ذلك الهدر الكبير والاستجرار غير المشروع، ما فاقم من حجم الأزمة.
وفيما يتعلق بالحلول، أكّد درويش أن المؤسسة تعمل على إدخال أكبر عدد ممكن من المصادر المائية إلى الخدمة، والبحث عن مصدر أكثر استدامة لتغذية دمشق وريفها، بما في ذلك إمكانية استجرار المياه من مناطق أخرى أو اللجوء إلى تحلية مياه البحر.
كما أطلقت المؤسسة حملات توعية للمواطنين حول أهمية ترشيد استخدام المياه، إلى جانب حملات لإزالة التعديات على الشبكات، والمضخّات غير المرخصة، وتنفيذ إصلاحات طارئة للأعطال. وختم درويش بالتأكيد على أن المياه حق للجميع، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع المؤسسة، والامتناع عن أي استجرار غير مشروع يضر بالصالح العام.
تحوّلات تستدعي استجابة استراتيجية عاجلة
ذكر شادي جاويش، رئيس مركز التنبؤ في المديرية العامة للأرصاد الجوية، لـ”نون بوست”، أن سوريا شهدت هذا العام معدلات هطول مطري هي الأدنى منذ ثلاثة عقود على الأقل، وفي بعض المناطق، سُجّلت مستويات غير مسبوقة من الانخفاض. ووفقًا للبيانات، كانت منطقة الجزيرة الأكثر تأثّرًا، حيث لم تتجاوز نسبة الهطولات 20% من المعدل السنوي المعتاد، تلتها المنطقة الشرقية بأقل من 25%، ثم دمشق والمنطقة الجنوبية بنسبة تقل عن 30%. أما المنطقة الشمالية والوسطى، فقد بلغت فيها الهطولات نحو 45%، في حين لم تتجاوز النسبة في المنطقة الساحلية، المعروفة بغزارة أمطارها، 65%.
هذا التراجع الحاد في الهطولات، لا سيما الثلجية منها، انعكس بشكل مباشر على مستويات المياه الجوفية، وفقًا لما أكده جاويش، خصوصًا في دمشق والمنطقة الجنوبية التي تعتمد بشكل رئيسي على مياه الينابيع المتغذية من تراكم الثلوج الشتوية. في المقابل، تعتمد المناطق الشمالية ومنطقة الجزيرة على مياه نهر الفرات كمصدر رئيسي للمياه، ما يجعلها أكثر عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية العابرة للحدود.
وقال أيضًا: “يُعد تأثير التغير المناخي على المنطقة أمرًا واقعًا لا يمكن تجاهله، إذ باتت بلاد الشام تشهد مؤشرات واضحة على التحوّلات المناخية، من بينها ازدياد حالات الجفاف، وتكرار الهطولات الغزيرة في مناطق محدودة، والتي تُعرف بظاهرة “الفيصانات”، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على المستويين المحلي والعالمي. هذه التحوّلات تستدعي استجابة استراتيجية عاجلة لضمان الأمن المائي والغذائي في ظل التحديات المناخية المتسارعة”.
انخفاض المساحات وتراجع الإنتاج الزراعي
المهندس عبد الرحمن قرنفلة، الخبير بالشؤون الزراعية، أوضح لـ”نون بوست” أن سوريا تشهد، كما العديد من دول المنطقة، آثارًا متسارعة للتبدلات المناخية أدت إلى زيادة تواتر موجات الجفاف، وانحسار معدلات الهطول المطري، وتراجع حجم الموارد المائية العذبة، سواء السطحية أو الجوفية، المتاحة للاستهلاك، فالأحواض المائية السورية تواجه منذ عقود ضغوطًا متصاعدة، إذ ترافقت موجات الجفاف التي بدأت منذ منتصف الثمانينيات مع استنزاف كبير للموارد المائية، لا سيما في القطاع الزراعي، الذي يُعد المستهلك الأكبر للمياه المتجددة بنسبة تصل إلى 92% من إجمالي الوارد المائي.
وقد ساهم حفر واستثمار عدد كبير من الآبار غير المرخصة في دمشق وريفها، دون رقابة على أعماقها أو حجم الاستجرار منها، في تفاقم الأزمة، خاصة في ظل اعتماد أساليب ريّ تقليدية تهدر كميات كبيرة من المياه، أو استخدام تقنيات حديثة منخفضة الكفاءة نتيجة غياب الصيانة الدورية.
قرنفلة ذكر أن الشتاء الماضي كان من بين المواسم التي شهدت انخفاضًا حادًا في الوارد المائي، بالتزامن مع ارتفاع كبير في عدد السكان المستهلكين للمياه في دمشق وريفها، والتي تضم أكثر من 40% من إجمالي سكان البلاد، وهذا التفاوت بين حجم المياه المتجددة وحجم الاستهلاك الفعلي خلق فجوة مائية خطيرة، انعكست على مختلف القطاعات الحيوية، من مياه الشرب إلى الزراعة والصناعة والسياحة والاستخدام المنزلي. وفي ظل استمرار الهدر المائي، وعدم ضبط الاستجرار، تلوح في الأفق مخاطر حقيقية بتحوّل بعض المدن الكبرى في الشرق الأوسط إلى مناطق شبه مهجورة، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإدارة الموارد المائية بكفاءة، وتعزيز التكيّف مع التغيرات المناخية المتسارعة.
ولا شك أن أزمة المياه وتراجع كميات الري المخصصة للزراعة تركت آثارًا عميقة على القطاع الزراعي في سوريا، حيث سجّلت بعض المحافظات انخفاضًا في المساحات المزروعة بنسبة وصلت إلى 90%. كما انحسرت الزراعة البعلية المعتمدة على مياه الأمطار، ما أدى إلى تراجع كبير في حجم المعروض من المنتجات الزراعية في الأسواق.
كما شهد محصول القمح، الذي يُعدّ الركيزة الأساسية للأمن الغذائي في سوريا، تراجعًا حادًا خلال موسم 2025 نتيجة موجة الجفاف التي ضربت البلاد. وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج انخفض إلى ما دون النصف مقارنة بالأعوام السابقة، حيث لم يتجاوز 38 ألف طن، في حين كان الإنتاج المعتاد يقارب 100 ألف طن. هذا الانخفاض الكبير لا يغطي سوى بضعة أشهر من احتياجات المواطنين من مادة الخبز،
حلول استراتيجية لمعالجة أزمة المياه
بالنظر إلى تفاقم أزمة المياه وتزايد آثار الجفاف، تبرز مجموعة من الحلول الاستراتيجية التي يمكن أن تسهم في التخفيف من حدّة الأزمة وتحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية، بحسب قرنفلة، وتتمثل فيما يلي:
- صياغة رؤية وطنية طويلة الأمد لإدارة الموارد المائية، تقوم على ترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات، وتأخذ في الحسبان التغيرات المناخية المحتملة، إلى جانب إنشاء منصة متخصصة لرصد حالات الجفاف والتنبؤ بها مبكرًا.
- التحول الزراعي نحو محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر قدرة على التكيّف مع ظروف الشح، بما يضمن استمرارية الإنتاج الزراعي دون استنزاف الموارد.
- إعادة تفعيل مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي لاستخدامها في الري كمصدر بديل، يخفف الضغط على المياه العذبة.
التطبيق الإلزامي لأنظمة الري الحديثة، مع تدريب كوادر فنية متخصصة للإشراف على تشغيلها وصيانتها، بما يرفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة. - تأسيس جمعيات لمستخدمي المياه لتعزيز الإدارة التشاركية للموارد وتقليل الهدر عبر آليات جماعية فعالة.
تفعيل دور الإعلام في نشر ثقافة الترشيد، وإبراز التكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة لتأمين المياه، بما يعزز حسّ المسؤولية لدى المواطنين. - منع الحفر العشوائي للآبار وردم المخالف منها، مع تركيب عدّادات على فوهاتها لضبط الكميات المسموح بها وفق الحاجة والمساحة المزروعة، أسوة بتجارب دول الجوار.
- تقنين استخدام المياه والبحث عن مصادر إضافية، بما يحقق الاستخدام المستدام، ويرفع الكفاءة الاقتصادية، ويضمن العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.
يمكن القول، إن أزمة المياه في سوريا، ودمشق على وجه الخصوص، تُعتبر كواحدة من أخطر التحديات التي تهدد الأمن المعيشي والغذائي، وتضع البلاد أمام استحقاقات مصيرية لا تحتمل التأجيل، فالتراجع الحاد في الموارد المائية، وتفاقم آثار التغير المناخي، وتدهور البنية التحتية، كلها عوامل متشابكة تُنذر بمستقبل مائي قاتم إن لم تُبادر الجهات المعنية إلى تبني سياسات جريئة واستراتيجيات مستدامة.