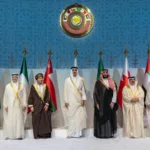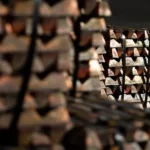في بيئة إقليمية متوترة تتسم بتشابك الأزمات وتعدد اللاعبين الإقليميين والدوليين، برزت تركيا خلال الأسابيع الأخيرة كفاعل رئيسي يعيد صياغة أولوياته الدفاعية والأمنية، إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على القوة الناعمة أو الخطابات السياسية التحذيرية أو المناورات الدبلوماسية التي اعتادت أنقرة استخدامها لإدارة صراعاتها الإقليمية في فترات سابقة، بل انتقلت إلى مسرح آخر عنوانه بناء أدوات ردع صلبة يمكن أن تصمد في مواجهة سيناريوهات قصوى.
كشفت تطورات الأيام الماضية عن سلسلة من الخطوات العملية التي اتخذتها القيادة التركية، ممثلة في الحكومة والقوات المسلحة، استعدادًا لمواجهة محتملة مع “إسرائيل” حذَّر منها تقرير استخباراتي تركي داخلي استند في جانب كبير منه إلى دراسة الحرب التي اندلعت قبل فترة قصيرة بين طهران وتل أبيب، واستمرت 12 يومًا، التي هزّت المنطقة، وأعادت رسم معادلاتها.
هذه الخطوات متعددة الأبعاد ترافقت مع نقاش واسع في الأوساط السياسية والعسكرية التركية حول طبيعة التهديد الإسرائيلي، وفتحت الباب أمام تساؤلات جوهرية حول طبيعة التهديد الإسرائيلي، والتوجهات الاستراتيجية التركية، وما إذا كان ما يجري مجرد تحرك ظرفي اقتضته التطورات الإقليمية الراهنة، أم أنه يمثل تحوّلاً استراتيجيًا بعيد المدى يرسم ملامح عقيدة ردع تركية جديدة تضعها في مواجهة مباشرة مع تل أبيب، وتعيد ترتيب موازين القوى في المنطقة؟
ثلاثية الإجراءات التركية
“إن تحليل أسوأ السيناريوهات المحتملة للتطورات المتعلقة بإيران ضمن مقاربة متعددة الأبعاد يمثل ركيزة أساسية لتعزيز المكاسب الاستراتيجية لتركيا، وفي هذا السياق، من الضروري أن تتخذ تركيا تدابير استباقية وفعالة للتقليل من المخاطر المحتملة”.
هذه العبارة جزء من دراسة حديثة نشرتها الأكاديمية الوطنية للاستخبارات التركية، التابعة لجهاز الاستخبارات، واعتُبرت في الأوساط التركية من بين أكثر الدراسات شمولاً خلال الأعوام الأخيرة، وأوصت بضرورة أن تبادر أنقرة باتخاذ 3 خطوات استباقية وعملية استعدادًا لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع “إسرائيل”، وتشمل تلك الخطوات ما يلي:
تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية
لم يمض وقت طويل على نشر هذه الدراسة التي حملت عنوان “حرب الـ 12 يومًا: دروس لتركيا”، حتى أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أقل من شهر، استلام الجيش التركي لمشروع “القبة الفولاذية”، وهو أول منظومة دفاع جوي متكاملة من إنتاج محلي، بدأ العمل عليها قبل 7 سنوات ضمن خطة تركية لمواجهة التهديدات الإقليمية المتزايدة، وتهدف إلى حماية الأجواء التركية، ومواجهة التحديات الجديدة، وربما أبرزها التهديد الإسرائيلي.
شركة “أسيلسان” التركية التي قادت عمليات التصميم والإنتاج جعلت المنظومة تشمل عدة أنظمة رئيسية مترابطة من بينها 47 مركبة مخصصة للدفاع الجوي، وتبلغ قيمتها 500 مليار دولار، ونظام المدفعية المضادة “كوركوت” المزود بإنذار مبكر، وصواريخ “حصار” للدفاع الجوي القصير والمتوسط، إلى جانب نظام الدفاع الجوي “سيبر” للحماية من التهديدات الجوية، فضلاً عن أنظمة الحرب الإلكترونية “إخطار”، وشبكة رادارات متطورة قادرة على تتبع المئات من الأهداف في وقت واحد.
يمثل المشروع ما يشبه “نظام الأنظمة” بفضل تكاملها وتطورها، فهي أداة استراتيجية مخصصة لحماية المجال الجوي التركي وتحصين بنيته الدفاعية أمام تحديات متصاعدة، وعلى رأسها هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة التي أصبحت سلاحًا رئيسيًا في أي مواجهة إقليمية، وقد تشكل جزءًا من أي مواجهة محتملة مع “إسرائيل”.
من الناحية التقنية، يشكل المشروع نقلة نوعية في التفكير العسكري التركي، فهو لا يقتصر على كونه محاولة لتكرار النسخة الإسرائيلية من “القبة الحديدية”، بل يسعى إلى تقديم بديل وطني قادر على موازنة القوى، ويمثل حلم أردوغان الذي بات واقعًا، فالرئيس التركي قالها في السابق بكل وضوح “إذا لم تستطع دولة تطوير نظام دفاعها الجوي الخاص، فلا يمكن أن تنظر إلى مستقبلها بثقة”.
في الوقت نفسه، يمثل المشروع رسالة سياسية واضحة مفادها أن أنقرة لم تعد ترغب في الاعتماد المفرط على المظلة الغربية، في ظل علاقتها المتذبذبة مع واشنطن وبروكسل، وانفتاحها المحسوب على روسيا والصين، بل تضع لنفسها طريقًا مستقلاً يجعلها أقرب إلى دولة مكتفية ذاتيًا في المجال الدفاعي.
عسكريًا، يعزز ذلك قدرة الجيش التركي على الصمود أمام ضربات مفاجئة، ويقلّص الفجوة التكنولوجية مع “إسرائيل”، حيث تبدو المقارنة المباشرة مع “القبة الحديدية” الإسرائيلية حاضرة، ما يجعل هذه النقلة تحمل بين طياتها أيضًا بعدًا تنافسيًا مع “إسرائيل” التي لطالما اعتبرت أن تفوقها التكنولوجي في مجال الدفاع الجوي أحد أعمدة أمنها القومي.
ورغم من أن العمل على هذا المشروع بدأ رسميًا عام 2018، إلا أن توقيت الكشف عنه يحمل رسالة واضحة إلى تل أبيب، مفادها أن القيادة التركية استوعبت بعمق الدروس المستفادة من التحديات ونقاط الضعف التي واجهت الأطراف المعنية في سياقات سابقة، وتعمل بشكل حثيث على سد أي ثغرات محتملة في قدراتها الدفاعية.
كما حظي تطوير القدرات الهجومية بحصة في الخطط التركية، بعد إعلان شركة “روكستان” عن الصاروخ فرط الصوتي “تايفون بلوك 4″، الذي يصل طوله لـ10 أمتار، ويزن أكثر من 7 أطنان، ليُوصف بأنه عنصر ردع رئيسي في أي معركة قادمة.

كما نجحت تركيا أخيرًا في حسم صفقة تُقدر قيمتها بنحو 5.6 مليار دولار لشراء 40 طائرة من طراز “يوروفايتر” من ألمانيا لتعويض خسارتها مشروع الطائرات الأمريكية “إف-35″، ما سيمنحها قوة إضافية في سلاح الجو، وهو ما أثار انتقادات لحكومة نتنياهو لفشلها في منع إبرام صفقة أكملت بها تركيا القطعة الناقصة في أسطولها من المقاتلات.
📌 الصحافة العبرية: “أصبحت #تركيا أقوى دولة مسلمة في المنطقة”، وأشارت إلى قلق “إسرائيل” من تزايد القوة العسكرية والدبلوماسية لأنقرة.
📌 أستاذ في جامعة تل أبيب: “تركيا المجهزة بطائرات F-35 تمثل تحدياً كبيراً لـ “إسرائيل”. حتى #اليونان منزعجة من ذلك”.
📌 قالت صحيفة “معاريف”: “… pic.twitter.com/KiWRWApD28
— نون بوست (@NoonPost) July 7, 2025
بناء الملاجئ النووية
على خلاف ما كان سائدًا سابقًا، لم تعد التحصينات العسكرية وحدها كافية، لذلك تعمل تركيا على بناء شبكة من الملاجئ المتطورة والمجهزة بشكل جيد للحروب الحديثة، والقادرة على الصمود أمام تهديدات غير تقليدية، بما في ذلك الأسلحة النووية أو الكيماوية.
كلَّفت الحكومة التركية شركة “توكي” ببناء ملاجئ حديثة في جميع الولايات، وهي شركة تمتلك خبرة في تصميم الأبنية المضادة للزلازل، وبرهنت على ذلك خلال الزلزال الشهير الذي ضرب الولايات الجنوبية عام 2023.
تشمل الخطة بناء هذه الملاجئ في 81 ولاية على مراحل، بدءًا من المدن الكبرى ثم إلى بقية الولايات، مع إمكانية الاستفادة من محطات المترو، بالإضافة إلى وإعادة تأهيل الملاجئ القديمة، ما يمثل نقلة نوعية في العقيدة الأمنية التركية.
يُنظر إلى توصية تقرير أكاديمية الاستخبارات بضرورة هذه الخطوة، والتي تترجمها سياسات الحكومة التركية هذه الأيام عمليًا ، على أنها أبعد من أي سيناريو عسكري تقليدي، وتعكس رغبة في تعزيز صمود المجتمع المدني وتحويله إلى عنصر قوة وليس عبئًا في أوقات الأزمات.
ومن المعروف أن تركيا ليست في مرمى تهديد نووي مباشر في الوقت الراهن، لكن تفكيرها في هذا النوع من التحصينات يكشف عن أمرين أساسيين:
أولهما أن أنقرة بدأت تدرك أن التهديدات غير التقليدية أصبحت جزءًا من معادلة الأمن الإقليمي، سواء عبر الأسلحة الكيماوية أو عبر احتمالية انزلاق المواجهات إلى مستويات قصوى غير متوقعة.
وثانيهما أن القيادة التركية لا تفكر فقط في جبهاتها الخارجية، بل تسعى لإعطاء مواطنيها شعورًا بأن الدولة تفكر في أمنهم وحمايتهم من الانهيار في حال اندلاع مواجهة واسعة على المدى الطويل، بما يرفع الروح المعنوية ويعزز الثقة في المؤسسات في حال اندلاع أي صراع.
وفي هذا المعنى، لا يقل البعد النفسي أهمية عن البعد المادي، فالملاجئ ليست مجرد جدران إسمنتية، بل هي أيضًا رسائل تطمينية بأن الدولة تستعد لكل الاحتمالات، ما يرفع منسوب الثقة بالدولة ويعزز صلابة الجبهة الداخلية.
تحصين الجبهة الداخلية
يظهر البُعد الثالث للتحركات التركية في مسألة تفكيك مصادر التهديد الداخلي وملاحقة البؤر غير المستقرة، سواء كانت شبكات مرتبطة بالاستخبارات الأجنبية أو تنظيمات معارضة قد تستغل الفوضى، خاصة بعدما كشفته حرب الـ12 يومًا من تغلغل إسرائيلي وتجسس في الداخل الإيراني.
وأثبتت التجارب الحديثة أن الحرب لا تُخاض فقط على الجبهات العسكرية، بل في عمق المجتمعات، حتى “إسرائيل” نفسها تعثرت في بعض المواجهات بسبب ضربات استهدفت جبهتها الداخلية أو أثرت على معنويات مواطنيها.
ومن هنا، جاء التركيز التركي على تحصين الداخل من أي محاولات لاختراقه، ومحاربة الخلايا النائمة، ومراقبة التهديدات السيبرانية، وإغلاق أي ثغرات يمكن أن تُستغل لزعزعة استقرارها من الداخل في حال اندلاع صراع مفتوح.
الأمر الذي دفع السلطات التركية لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني، وتنفيذ حملة أمنية واسعة لتعقب بؤر التهديد، وطالت مدير شركة “أسان” للصناعات الدفاعية، إذ يواجه اتهامات تتعلق بالتجسس العسكري.
دروس حرب الـ12 يومًا
اللافت أن هذه الخطوات لم تأتِ من فراغ بل من مجموعة من الدروس التي استوعبتها أنقرة بعد المتابعة الدقيقة لحرب الأيام الـ12، وبدا واضحًا أن أنقرة لم تنظر إلى هذه الحرب على أنها مواجهة بين خصمين بعيدين عنها لم تكتفِ بمشاهدة تفاصيل المواجهة بين طهران وتل أبيب، بل حاولت تكييفها مع واقعها، والتقطت منها إشارات عميقة يمكن أن ترسم ملامح استراتيجيتها المقبلة، فتعاملت معها باعتبارها “مختبرًا استراتيجيًا” يقدم دروسًا قابلة للتطبيق، أهمها:
أولًا، أولوية الدبلوماسية: أظهرت التجربة الإيرانية أن غياب الحضور الدبلوماسي القوي قبيل الحرب جعل طهران في وضع هش أمام خصومها الغربيين، فالرفض الأوروبي والأمريكي للبرنامج النووي الإيراني فتح المجال أمام اصطفاف كامل مع الموقف الإسرائيلي الداعي إلى الضربة الاستباقية.
تركيا بدت متنبهة لذلك، إذ تذكِّرها الدراسة بأنها نجحت قبل سنوات في إعادة صياغة علاقاتها مع محيطها العربي، فاستعادت جسور التواصل مع السعودية والإمارات ومصر بعد قطيعة طويلة، وتسير اليوم في المسار ذاته مع أرمينيا واليونان لتجاوز إرث الخلافات، وبناء شبكة دبلوماسية تتيح لها تجنب العزلة التي أضعفت الموقف الإيراني.
ثانيًا، قوة التحالفات الموثوقة: كشفت الحرب أن السند الحقيقي في لحظات الصراع ليس الشعارات بل التحالفات العملية، فقد حظيت “إسرائيل” بدعم استخباراتي ولوجستي وعسكري واسع من الغرب، بينما بدت تحالفات طهران مع روسيا والصين شكلية، لا تملك آليات دفاعية فاعلة، حتى تكتل “البريكس” أثبت محدوديته في حماية أعضائه عند التعرض لضغط خارجي.
في المقابل، ترى الدراسة أن تركيا مطالبة بترسيخ تحالفاتها مع شركاء مثل قطر وباكستان وأذربيجان وسوريا، مع عدم إغفال تثبيت حضورها داخل حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ما يمنحها مجالاً أوسع للمناورة وتقلل احتمالية انكشافها.
ثالثًا، كثافة النيران هي كلمة السر: أربكت قدرة إيران على إطلاق مئات الصواريخ دفعة واحدة على المدن والمنشآت الإسرائيلية “القبة الحديدية”، وأظهرت أن أي منظومة دفاعية مهما بلغت قوتها لا تستطيع أن تصمد أمام ضربات متواصلة ومنظمة، ما جعل تركيا تفكر في بناء دفاع متعدد الطبقات وليس منظومة واحدة.
رابعًا، حماية النخب المؤثرة: أحد أهم دروس الحرب كان نجاح “إسرائيل” في شل القيادة الإيرانية عبر استهداف مباشر لكبار قادتها العسكريين والعلماء النوويين في الساعات الأولى، فقد خسرت طهران رئيس أركانها وعددًا من أبرز قيادات الحرس الثوري، إضافة إلى مجموعة من العقول العلمية، ما انعكس بشكل مباشر على قدرتها في إدارة المعركة.
هذا السيناريو يضع تركيا أمام ضرورة تحصين نخبها العسكرية والمدنية، باعتبارهم العمود الفقري لأي مواجهة محتملة مع أي قوة خارجية، وأي اختراق في صفوفهم قد يعني انهيار البنية القيادية في لحظات حرجة.
خامسًا، أولوية الدفاع المدني: برهنت تجربة “إسرائيل” على أن الدفاع المدني يشكل خط الدفاع الأول عن المجتمعات، فأنظمة الإنذار المبكر والملاجئ المنظمة والوعي الشعبي قللت من خسائرها البشرية رغم كثافة الهجمات الإيرانية، من هذا المنطلق، بات على تركيا ضرورة بناء شبكة إنذار متطورة وتوسيع رقعة الملاجئ القابلة للاستخدام في المدن الكبرى، إلى جانب تحصين شبكات الاتصالات.
سادسًا، التنسيق الأمني الشامل: أحد الثغرات الكبرى التي عانت منها إيران تمثلت في ضعف التنسيق بين أجهزتها الأمنية، ما جعلها عرضة لاختراقات إسرائيلية متكررة، لذلك تدعو الدراسة أنقرة إلى بناء شبكة أمنية مترابطة تبدأ من المستويات القاعدية، كحرَّاس القرى والأحياء، وتمتد إلى قمة الهرم الاستخباراتي بهدف خلق عمق أمني متماسك يجعل من الصعب على أي قوة خارجية التعامل مع الداخل التركي وكأنه كتاب مفتوح.
سابعًا، الاستقلال التكنولوجي: لم تكن المعركة عسكرية بحتة، بل رافقها هجوم سيبراني على البنى التحتية، ودعاية إعلامية مؤثرة، ولعبت التكنولوجيا دورًا حاسمًا في اختراق المجتمع الإيراني، إذ تمكنت “إسرائيل” من استغلال أدوات وتقنيات مرتبطة بشركات عالمية لها صلات وثيقة بها.
لذلك، أصبح من الضروري لتركيا السعي للاستعداد لهذه الجبهات عبر تعزيز وحدات الأمن السيبراني والإعلام الموجّه، والمضي بخطوات أسرع نحو بناء بدائل محلية تقلل من الارتهان للتكنولوجيا الأجنبية.
وظهرت بالفعل بوادر هذا التوجه من خلال إعلان رئيس هيئة الأركان العامة سلجوق بيرقدار عن منصة “Next Sosyal” للتواصل الاجتماعي مطورة الصنع، إضافة إلى جهود تطوير نظام تحديد مواقع بديل عن الـ”GPS”، لكن التحدي الأكبر يبقى في ضمان تحصين الشركات الدفاعية والتكنولوجية ضد أي محاولات تجسس، من خلال برامج أمن سيبراني فعّالة ومستمرة.
ما وراء البعد العسكري
لم تعد “إسرائيل” الطرف الوحيد الذي يمتلك اليد الطولى، ولم تعد إيران الخصم الوحيد القادر على تحديها، فدخول تركيا على هذا الخط يضيف طبقة جديدة من التعقيد، لكنه يمنحها فرصة لملء فراغ في ميزان القوى عبر تقديم نفسها كقوة قادرة على مجابهة تل أبيب، أو على الأقل ردعها.
دوليًا، تستثمر تركيا في التحولات التي يشهدها النظام العالمي في ظل تراجع الهيمنة الأميركية الأحادية وصعود التعددية القطبية، ومن خلال تعزيز استقلاليتها الدفاعية، توجّه رسالة للغرب بأنها لم تعد مجرد تابع للناتو، بل لاعب مستقل يفرض أولوياته، ما يمنحها موقعًا تفاوضيًا أقوى، ويتيح لها هامش مناورة أوسع بين موسكو وبكين والعواصم الغربية.
المسألة إذًا لا تقف عند حدود الإجراءات العسكرية أو الأمنية فقط، بل تمتد إلى البعد السياسي والدبلوماسي، إذ تسعى تركيا من خلال هذه الخطوات – التي تعكس مزيجًا من الطموح السياسي والواقعية الاستراتيجية – إلى إعادة صياغة معادلات القوة في المنطقة عبر بناء منظومات دفاعية وهياكل داخلية قادرة على الصمود.
هذا التموضع يشير إلى أن أنقرة لم تعد تكتفي بدور المراقب في التفاعلات الإقليمية، ويفتح أمام أنقرة هامش مناورة مع الفاعلين العرب الذين ينظرون بقلق إلى الهيمنة الإسرائيلية، لكن يتطلب بالضرورة مواجهة النفوذ الإسرائيلي الذي تصاعد في السنوات الأخيرة، سواء عبر التطبيع مع عدد من الدول العربية أو عبر الشراكات الأمنية والعسكرية مع الغرب.
بدأت هذه المواجهة مؤخرًا بقطع تركيا علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دولة الاحتلال نتيجة استمرارها في ارتكاب المجازر الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وأعلنت عن تدابير عقابية اتخذتها تركيا ضد دولة الاحتلال، أبرزها قطع العلاقات التجارية وإغلاق الموانئ التركية أمام سفن الاحتلال، وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات التابعة للاحتلال، ومنع سفن الحاويات المحملة بالأسلحة والذخائر إلى “إسرائيل” من دخول الموانئ التركية.
بالنسبة لأنقرة، فإن تجاهل هذا التمدد يعني قبول دور ثانوي في معادلة الشرق الأوسط، وهو ما لا يتوافق مع طموحات القيادة التركية الحالية التي تريد أن ترسخ مكانة أنقرة كقوة إقليمية لا يمكن تجاوزها، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: هل هذه التحركات تمثل سياسة ردع طويلة الأمد، أم أنها مجرد رد فعل على التصعيد الراهن؟
بين الاستجابة الظرفية والعقيدة الممتدة
القراءة المتأنية تشير إلى مزيج بين الأمرين، فمن جهة، يتطلب بناء منظومات دفاعية وملاجئ نووية استثمارات ضخمة لا يمكن اختزالها في مجرد استجابة آنية لاحتمالية صدام مع “إسرائيل”، ومن جهة أخرى، يكشف التمعن في تفاصيل وسياقات الخطوات التركية أنها ليست مجرد تفاصيل تقنية، بل هي أدوات في مشروع أكبر عنوانه ترسيخ مكانة تركيا في معادلة الشرق الأوسط، وجزء من رؤية ممتدة تتجاوز الظرف الراهن.
بعبارة أخرى، يمكن القول إن أنقرة – التي عرفت كيف تستثمر التحولات الدولية والإقليمية لصالحها – كانت تعمل على هذه المشاريع منذ فترة، لكن الظروف الراهنة، خاصة تصاعد التوتر مع “إسرائيل”، سرّع من الإعلان عنها، وأظهرها للرأي العام المحلي والدولي، ومنحها زخمًا إعلاميًا وسياسيًا أكبر.
مع ذلك، لا يمكن إنكار أن الطريق أمام أنقرة ليس مفروشًا بالورود، وإن بدت اليوم أكثر تصميمًا على رسم مسارها الخاص، فـ”إسرائيل” ما زالت تمتلك تفوقًا نوعيًا في مجالات حيوية مثل الاستخبارات والتكنولوجيا العسكرية المدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا.
كما أن العامل النووي – كأداة ابتزاز سياسي محتملة – يبقى سلاحًا غير متكافئ لا تستطيع تركيا مجاراته في المدى المنظور سوى بتسريع بناء الملاجئ المتطورة، وبالتالي، فإن الردع التركي المحتمل سيظل جزئيًا، قادرًا ربما على منع “إسرائيل” من التفكير في مواجهة مباشرة لكنه غير كافٍ لقلب ميزان القوى بالكامل.
في هذا الإطار، قد يكون هدف أنقرة الواقعي هو خلق “توازن خوف” وليس توازن قوة كامل، أي أن تجعل أي هجوم إسرائيلي محتمل مكلفًا بما يكفي لردعه، دون الحاجة إلى الدخول في سباق تسلح غير محسوب. ويعتمد هذا النوع من الردع على إظهار القدرة على الصمود أكثر من إظهار القدرة على التفوق، وهو ما تركز عليه تركيا من خلال بناء منظومات دفاعية وتحصين جبهتها الداخلية.
لكن يبقى السؤال مفتوحًا: هل سيسمح لها النظام الدولي المتشابك بفرض معادلة جديدة في مواجهة “إسرائيل”، أم أن الضغوط الدولية ستكبح مسارها قبل أن يكتمل؟ مهما كانت الإجابة، فإن ما هو مؤكد أن الشرق الأوسط يقف على أعتاب مرحلة جديدة ستكون تركيا لاعبًا رئيسيًا فيها، ليس فقط عبر قوتها الناعمة أو نفوذها الدبلوماسي، بل أيضًا عبر قدراتها الدفاعية وأجهزتها الأمنية التي تتأهب لسيناريوهات لم يكن أحد يتصورها قبل سنوات قليلة.