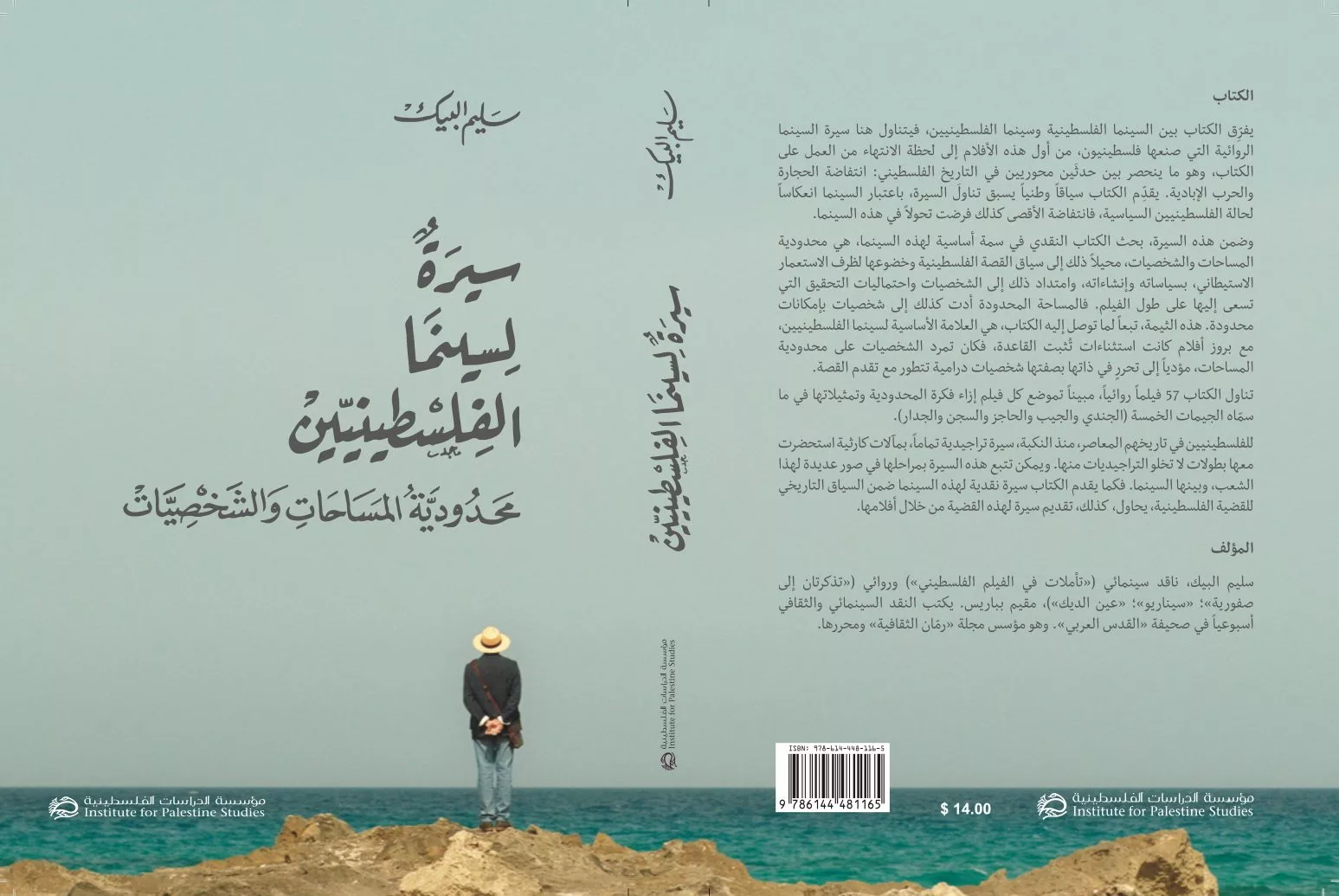لأن الشاشة جبهة قتال رمزية تقدم السردية الفلسطينية أمام رواية العدو على الساحة العالمية، نجد أنفسنا هذه الأيام إزاء فيلمين روائيين يتزامن عرضهما الأول في مهرجانين سينمائيين كبيرين مع حرب الإبادة المستمرة على فلسطين؛ الفيلم الأول هو “صوت هند رجب” للمخرجة التونسية كوثر بن هنية والذي عُرض في مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى (27 أغسطس- 6 سبتمبر) ولاقى حفاوة كبيرة حتى فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى.
الفيلم يدور عن الطفلة الفلسطينية التي استهدفها جنود الاحتلال بوحشية في قطاع غزة ومنعوا عنها الإسعاف حتى لفظت أنفاسها. وقد انضم للفيلم النجمان براد بيت وخواكين فينيكس كمنتجين منفذين بما أكسبه زخمًا فوق الزخم.
حصد فيلم “صوت هند رجب” جائزة “الأسد الفضي” في الدورة 82 لمهرجان البندقية السينمائي، والذي كان يحكى قصة الطفلة الغزّية التي فقدت حياتها مع عائلتها في هجوم إسرائيلي.
شهد العرض الأول للفيلم دموعًا وتصفيقًا حارًا استمر أكثر من 22 دقيقة من قبل الحاضرين، وتعالت هتافات “فلسطين حرة” مع… pic.twitter.com/isC0fh1bmM
— نون بوست (@NoonPost) September 7, 2025
الفيلم الثاني هو “فلسطين36” بطولة النجم ظافر العابدين ويُعرض في مهرجان تورنتو السينمائي (4-14 سبتمبر)، ويعتبر الفيلم هو الرابع في مسيرة الفيلم الروائي الفلسطيني للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر بعد “ملح هذا البحر” (2008) و”لما شفتك” (2012) و”واجب” (2017). لا يدور “فلسطين 36” عن طوفان الأقصى ولا حرب الإبادة بل يرجع إلى جذور القضية الفلسطينية إبان الاحتلال البريطاني وقمعه للثورة الفلسطينية الكبرى التي استمرت ثلاث سنوات منذ عام 1936 وحتى 1939 ضد الاحتلال وضد الهجرة الجماعية لليهود.

ذاكرة الشاشة
منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية يندر وجود أفلام فلسطينية تتناول أحداثًا سابقة لزمان صناعتها، فالرهان دومًا على آنية القضية وتطوراتها اللحظية. يقول سليم البيك، الكاتب والناقد السينمائي الفلسطيني، في كتابه الأحدث “سيرة لسينما الفلسطينيين: محدودية المساحات والشخصيات” (مؤسسة الدراسات الفلسطينية: 2025): “الابتعاد في الزمان وتمحور القصة حول مرحلة تاريخية معينة للفلسطينيين، ليسا مفضلين عند المخرجين الفلسطينيين الذين يتكئون بصورة عامة على راهنية القصة زمانًا ومكانًا”، لكن الظرف الراهن المتمثل في حرب الإبادة يدفعنا للنظر في الأصول وعرضها على العالم لتذكيره بجذور القضية ودور القوى العظمى فيها. وحتى من قبله، عاد بنا فيلم “ملح هذا البحر” خارقًا الحاجز بين طرفي فلسطين المحتلة منذ عام 1948 ومنذ 1967، وكذلك “فرحة” (2021) لدارين سلام التي عادت لجذور المشكلة وهي النكبة.
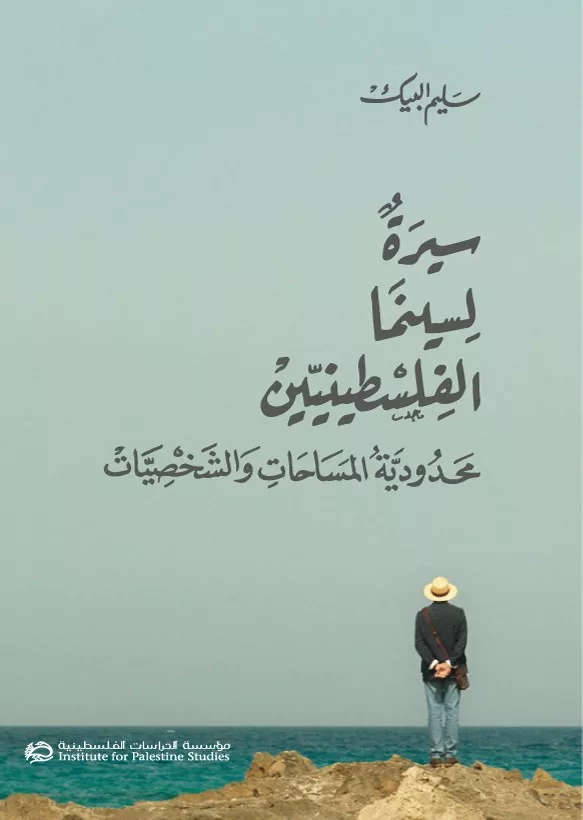
والسينما في الحالة الفلسطينية تتجاوز حدود المتعة البصرية منذ انطلاقها لتغدو أداة مقاومة فهي ذاكرة حية تحفظ الهوية وتتصدى لمحاولات الطمس والاقتلاع. في شهر مارس الماضي، صدر للبيك مرجع مهم في توثيق ونقد السينما الفلسطينية يرصد الأفلام المنتجة في الفترة بين حدثين مفصلين هما الانتفاضة الثانية وحتى طوفان الأقصى أي حوالي ربع قرن، حتى أنه يمكن، في نظره، تقسيم سينما الفلسطينيين إلى طور ما قبل الانتفاضة وطور ما بعدها بما فيه عقد الثورات والحروب (2010-2024)، ليعقبهما الطور الثالث: مرحلة الإبادة.
يضيء البيك في كتابه المدعوم من الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) على 57 فيلمًا روائيًا طويلًا صدروا في الفترة الزمنية المختارة على سبيل الحصر، ومع ذلك لا يغفل سينما الفلسطينيين في الثمانينيات والتسعينيات التي يؤصل لها في الثلث الأول من الكتاب تقريبًا لنرى البدايات ونقف على المحطات وشكل التطور الذي لحق بالصناعة. يقدم الكاتب في كتابه الثاني عن السينما الفلسطينية، بعد “تأملات في الفيلم الفلسطيني” مقاربة للسياقين الوطني السياسي ثم السينمائي متعرضًا للأعمال بالنقد والتحليل في محاولة لشرح الظروف التي هيأت وأثرت على خروج كل فيلم بفكرته، وذلك باعتبار السينما الفلسطينية سيرة جمعية للفلسطينيين. ويتوقف الكتاب عند الإبادة الجماعية في غزة التي لا شك ستشكل فصلًا جديدًا مهمًا في سيرة سينما الفلسطينيين ما زالت تجري كتابته.
من الثورية إلى “الجيمات الخمسة”
يقدم الكتاب تأريخًا سينمائيًا لسينما الفلسطينيين وبدايتها الثورية على يد منظمة التحرير الفلسطينية في أواخر الستينيات والسبعينيات كسينما وثائقية تتتبع النكبة والنكسة والتهجير والمخيمات وتركز على صورة الفدائي. لاحقًا انطلقت الأفلام الروائية في الثمانينيات بعد الخروج الفلسطيني من لبنان وكانت البداية بـ”عرس الجليل” للمخرج ميشيل خليفي (شاهده كاملًا هنا) الذي حصل على جائزة الصدفة الذهبية أعلى جوائز مهرجان سان سيباستيان السينمائي. ويمثل عرس الجليل نموذج الفيلم الانتقالي بين مرحلتين هما سينما الثورة وسينما أوسلو.
يُحسب لخليفي أنه أحيا السينما بعد انقطاع هذا الخروج وهو يعرف كيف يصنع فيلمًا جيدًا بموارد قليلة. يعتبره الكاتب مؤسس السينما الفلسطينية لهذا السبب، كما يعتبره واحدًا من ثلاثة مخرجين هم “مؤسسي سينما الفلسطينيين” إلى جانب رشيد مشهراوي وإيليا سليمان. ذهب ثلاثتهم بالفيلم الفلسطيني إلى مهرجانات سينمائية دولية مثل كان وفينيسيا، حاملين القرية الجليلية عند خليفي، والمخيم الغزّي عند مشهراوي، ثم المدينة (الجيتو) عند سليمان. يقتصر الحديث في الكتاب على صناعة الفلسطينيين لسينما القضية عبر الأفلام الروائية والدعم الغربي لهذه السينما ماليًا وتقنيًا، بعد أن بدأت السينما الفلسطينية التي تتناول القضية على أيدي مخرجين عرب في السبعينيات، وبذلك أيضًا هو يستبعد الأعمال التي أخرجها فلسطينيون ولا تمت للسينما الفلسطينية بصلة.
يذكر الكتاب عدة منعطفات ومحطات مرت بها السينما الفلسطينية وفقًا لتطورات القضية التي تتماشى معها، فقد تلا الخروج من لبنان اتفاق أوسلو الذي أقام سلطة في ظل الاحتلال في مقابل الاعتراف به والتنازل عن المقاومة المسلحة. وتحولت القضية إلى عقيدة أمنية بديلة عن المقاومة تتضمن التنسيق الأمني مع “إسرائيل” وطغت الفردانية على سينما هذه الفترة بعد ضرب الكتلة الجمعية. وجاءت انتفاضة الأقصى عام 2000 لتعيد الزخم السياسي إلى القضية وترسم مسارًا جديدًا للسينما الفلسطينية وتحولها إلى سينما سياسية بالدرجة الأولى “ما جعل من الشخصيات موضوعًا لا ذاتًا” تنحصر فيها “فردانية الشخصية الفلسطينية لمصلحة تنميطها وجعلها نموذجًا لجماعة”.
وقد حملت هذه المرحلة أسماء جديدة برزت فيها مثل آن ماري جاسر وهاني أبو أسعد ونجوى نجار ومها حاج وآخرين، ثم جاء الاقتتال الداخلي بين حماس وفتح في أعقاب فوز الحركة الإسلامية في انتخابات شرعية أُجريت تحت إشراف دولي. وتأسست بعض الأعمال على موضوعات سياسية إخبارية راهنة مثل “الجنة الآن” (2005) لهاني أبو أسعد الذي صور تخطي رجلين فلسطينيين للأسلاك الشائكة لتنفيذ عملية فدائية كنوع من المقاومة للاحتلال. ويُعتبَر أبو أسعد أحد أكثر المخرجين الفلسطينيين إنتاجًا أو إخراجًا. وقد جاء هذا الفيلم بتمويل أوروبي وفشل في كسب تمويل من صندوق الفيلم الإسرائيلي بعد أن قوبل الطلب بالرفض لأسباب سياسية.

في معرض تحليله لسينما الفلسطينيين، يضع الكاتب أداة نقدية يسميها “الجيمات الخمسة” ليرى من نظارتها سينما الانتفاضة التي تتجلى في أعمال هذه الفترة. والجيمات الخمسة هي عناصر بصرية إسرائيلية تتمثل في الجندي والجِيب (العسكري) والحاجز وجدار الفصل والسجن وهي السمات الحاضرة في عموم الأفلام الفلسطينية المنتجة في هذه المرحلة بداية من “يد إلهية” (2002) لإيليا سليمان. ويعتبر البيك فيلم سليمان فيلمًا تأسيسيًا لتلك المرحلة وهو أول أفلام ذلك العقد، كما أنه أول فيلم فلسطيني يصل إلى مهرجان كان السينمائي.
الخاصية الغالبة على هذه الأفلام هي محدودية المساحات والشخصيات كما يأتي في عنوان الكتاب. وتظل السينما الفلسطينية مليئة بالرمزيات المعبرة عن هذا الضيق وأكبر أيقوناتها الحاجز بما يمثله من تقطيع للطريق وعزل الشخصيات على جانبيه مقيِّدًا حركتها، وفاصل للزمن الفلسطيني، كما المكان، بما قبل الحاجز وما بعده. ويظهر امتداد حالة الإغلاقات وضيق الحيز المكاني الناجم عن تقطيع الاحتلال للجغرافيا الفلسطينية في أفلام عديدة مثل “عرس رنا” (2002) لهاني أبو أسعد الذي جاء تمويله عربيًا في معظمه من جهات رسمية فلسطينية وخليجية. تأتي هذه الأفلام للتذكير بأن المساحة الفلسطينية مقيدة مهما تكثر الخطوات ضمن المسموح به. وفي سينما رشيد مشهراوي تبرز المخيمات وأبناؤها من البسطاء بقوة. يسميها الناقد سينما “المغلوبين على أمرهم المهزومين المتآلفين مع الوضع القائم”.
تحدث أيضًا مقاربة بين الفلسطينيين كسكان أصليين لأرض فلسطين وبين شعب الموهاك كسكان أصليين أمريكا الشمالية في فيلم “جمود” (2013) لمجدي العمري. وتبدو الهجرة إلى الخارج، من الضيق إلى السعة، مآلًا أخيرًا للتحرر من الاحتلال على مستوى فردي بعد العجز عن التحرر الجماعي. وتظهر الناصرة كثيرًا كلما أراد المخرجون الفلسطينيون تصوير الداخل أو أراضي 48 كما في “زنديق” (2009) لميشيل خليفي و”إن شئت كما في السماء” (2019) لإيليا سليمان. وقد تكرس حضور الناصرة باعتبارها الداخل الفلسطيني في أكثر من فيلم إذ تحضر مع الضفة في السينما الفلسطينية في مقابل تهميش غزة والشتات كذلك.

وتفرض موضوعات أخرى نفسها على الواقع الفلسطيني غير الاحتلال مثل فساد السلطة في الضفة الغربية كما في فيلم “عيد ميلاد ليلى” (2008) لمشهراوي، و”ديجراديه” (2015) للأخوين ناصر عن الاقتتال بين فتح وحماس و”كتابة على الثلج” (2016) لمشهراوي الذي يعكس الانقسام السياسي بين الفلسطينيين. ويتمثل الضيق هنا في حالة الانقسام في الشارع الفلسطيني نفسه بعيدًا عن المحتل.
غزة والنسوية والتطبيع
تكاد تنحصر الأفلام التي تجري أحداثها في قطاع غزة في أفلام الأخوين ناصر ورشيد مشهراوي (وثلاثتهم من غزة) بسبب الحصار المفروض منذ عام 2007 الذي يعرقل الإنتاج، إلا أننا شهدنا خلال العقد الحالي وقبل حرب الإبادة فيلمًا لمخرج رابع هو باسل خليل بعنوان “أسبوع غزاوي” (2022) وإن غلب عليه الطابع الكوميدي. والكوميديا إحدى التصنيفات أو الأنواع “الجونر” التي اقتحمتها بعض أفلام الفلسطينيين في السنوات الأخيرة إلى جانب التشويق والرعب كما ظهر في أفلام مؤيد عليان مثل “التقارير حول سارة وسليم” و”بيت في القدس” و”الحب والسرقة ومشاكل أخرى” و”تل أبيب ع نار” لسامح زعبي. شخصيًا، لم أستسغ أفلام الرعب عن فلسطين كفيلم بيت في القدس والذي عرضته منصة نتفليكس.
وفي العقد الماضي الذي طغت عليه الثورات والحروب، صار عموم الإنتاج السينمائي الفلسطيني نسائيًا بالدرجة الأولى بامتياز واضح لمخرجات أبرزهن مها حاج وآن ماري جاسر ونجوى نجار. يقول البيك: “يشهد النصف الثاني من هذا العقد (العقد الفائت) تقدمًا واضحًا للأفلام النسائية في الإخراج والنسوية في المقاربة، وحضورًا قويًا للمخرجات النساء بدأ مع سنة 2000، بعد أن كانت السينما الروائية ذكورية في إخراجها وواقعية في تصوير تقليدي للنساء كشخصيات سالبة، تتأثر ولا تؤثر”. وتباينت المقاربات النسوية بين الاندماج في خطاب الاحتلال أو مواجهته.
وبعد أن كانت صورة الفلسطيني في السينما هي صورة الفدائي ثم البائس بالاحتلال، ظهر كمقاوم مع الانتفاضة الثانية في أفلام مثل “لما شفتك” (2012) لآن ماري جاسر الذي جاء بتمويل عربي ويقدم الفدائيين كموضوع رئيسي. أيضًا في “عيون الحرامية” (2012) لنجوى نجار الذي يدور حول قناص فلسطيني وهو مبني على أحداث حقيقية.
في المقابل، تآلف بعض المخرجين مع الوجود المجتمعي للمحتل بما يتضمن تطبيع العمل السينمائي الفلسطيني مع التمويل الإسرائيلي. لا يخلو الكتاب من رصد أفلام التطبيع مثل “موسم الزيتون” (2003) الذي يميل إلى خيار السلام مع الاحتلال، أو يُكرّس للتعايش والتآلف مع المحتل ويُغيّب الصراع عن العمل السينمائي كما في “تناثر” (2011)، أو يعزز روح الانهزامية والخروج النهائي كحل وخلاص كما في “جيرافادا” (2013)، بينما يخلص الناقد إلى أن أفلام مشهراوي التزمت الجانب الاجتماعي في تغييب للجانب السياسي المباشِر، أي المواجَهة مع الاحتلال، قدر الإمكان “فلا غايات مقاوَمة بالمعنى المسلح في أفلام مشهراوي”.
ويرصد الكاتب على سبيل الاستثناء عن المتعارف الظهور الحديث لأفلام مثل “حمى البحر المتوسط” (2022) لمها حاج تصور الفلسطيني كإنسان في المقام الأول بأحلامه وطموحاته وانكساراته وهزائمه.
تغيب الخصوصية الفلسطينية عن بعض الأعمال وتتفاوت أهمية الأفلام التي يعرضها البيك في كتابه بين أفلام رسمت مسار السينما الفلسطينية وشكلت ثيماتها، وأخرى متواضعة لم يكن لها أي دور، لكنه رأى أهمية ذكرها على سبيل الحصر والتوثيق لكي يقدم سيرة شاملة عن السينما الفلسطينية، فـ”الثقافة مجال تحريري للفلسطينيين، جوهري وحيوي، لا حدود له ولا محدودية فيه” كما يختم الناقد السينمائي الفلسطيني كتابه.