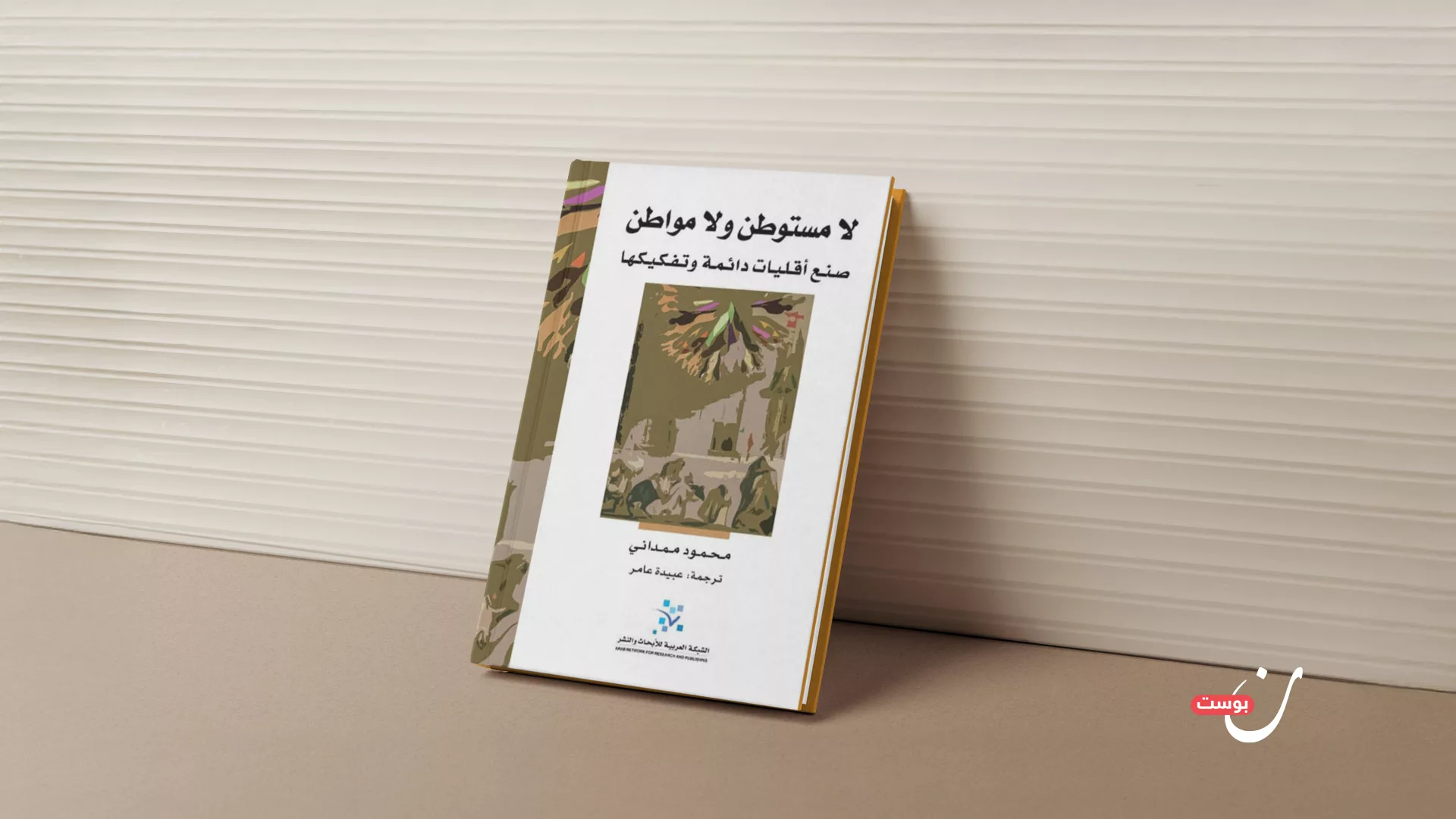يقدم الأكاديمي والباحث الأوغندي محمود ممداني في كتابه “لا مستوطن ولا مواطن: صنع أقليات دائمة وتفكيكها”، الذي صدر بالإنجليزية عام 2020، والذي نقلته الشبكة العربية للأبحاث والنشر (بيروت، عام 2023) إلى العربية بواسطة الباحث والمترجم السوري عبيدة عامر، أطروحة فكرية رائدة تتجاوز الفهم التقليدي للعلاقة بين الدولة القومية والاستعمار.
يرى ممداني أن هذه الأطروحة ضرورية لفهم جذور العنف السياسي في مجتمعات ما بعد الاستعمار، وللخروج من الجمود الفكري الذي يسيطر على كثير من الصراعات المعاصرة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
يركز الكتاب، الذي يدرس حالات متعددة من الولايات المتحدة إلى جنوب أفريقيا والسودان وألمانيا، وصولًا إلى فلسطين، على كيفية إنتاج الدولة القومية والدولة الاستعمارية لبعضهما البعض، وكيف قامتا معًا بصناعة “أقليات دائمة” لا يمكن دمجها أو استيعابها في المجتمع السياسي.
الدولة القومية والاستعمار: وجهان لعملة واحدة!
يسائل ممداني الفرضية السائدة التي تفصل بين القومية والاستعمار، حيث تُعتبر الأولى قوة إيجابية تحررية، بينما تُصنّف الثانية كقوة سلبية كانت مستعمِرة للأولى التي حلّت مكانها، إذ يرى أن القومية والاستعمار وُلدا معًا في عام 1492، ويمثلان وجهين لعملة واحدة في بضعة سياقات، حيث كان هذا العام، الذي يمثل ولادة الدولة القومية في أيبيريا، هو نفسه الذي شهد عمليات التطهير العرقي للأقليات، وفي الوقت ذاته، غزو الأميركيتين. هذا الترابط يوضح أن العنف ليس مجرد نتيجة للاستعمار الخارجي، بل هو نتاج طبيعي لعملية تأسيس الدول القومية التي تسعى إلى تحقيق نقاء عرقي أو ثقافي.
كما يرى، برأيه، أن “الحداثة السياسية” هي التي قامت بتسييس الفروقات الثقافية والدينية، وتحويلها إلى حدود سياسية وقومية متصارعة، ففي حالة السودان، على سبيل المثال، يوضح كيف أن السلطات الاستعمارية البريطانية، من خلال نظام “الحكم غير المباشر”، لم تخترع الفروقات الثقافية بين المجموعات السكانية، بل أعادت تشكيلها وأعطتها معنى سياسيًا جديدًا.
هذا التحول من “الاختلافات الثقافية” إلى “الحدود العرقية” أدى إلى انقسامات حادة استمرت وتفاقمت بعد الاستقلال، ما مهّد الطريق لصراعاتٍ مسلحة أدت في النهاية إلى انفصال جنوب السودان. وهذه العملية، في جوهرها، تهدف إلى “تفكيك المجتمع السياسي” من خلال ترسيخ الانقسامات وجعلها أساسًا للحكم، وهو ما يفسر استمرار العنف في المجتمعات ما بعد الاستعمارية التي ورثت هذه البنية.
نقد العدالة الجنائية: من نورنبرغ إلى جنوب أفريقيا
يتوجه ممداني بالنقد إلى الحلول الجنائية للعنف السياسي، مستخدمًا محاكمات نورنبرغ كنموذج رئيسي. يجادل بأن هذه المحاكمات فشلت لأنها ركزت على “الأفعال الجنائية الفردية” للنازيين، وتجاهلت “المشروع السياسي” الأوسع الذي أنتج تلك الجرائم. لذا، كانت النتيجة أن البنية الفكرية والسياسية التي أدت إلى العنف ظلّت قائمة، ما مهّد الطريق لولادة دولتين “مطهّرتين” عرقيًا بعد الحرب العالمية الثانية: “ألمانيا بلا يهود، وإسرائيل بلا فلسطينيين”.
فيما بدا أن حل الدولتين، الذي يُنظر إليه غالبًا على أنه حل معتدل، هو في الواقع امتداد منطقي لنفس هذا المنطق، حيث يسعى إلى تطهير الدولة القومية من أقلياتها بدلًا من دمجها في مجتمع سياسي واحد. في المقابل، يقدم ممداني النموذج الجنوب أفريقي كبديل واعد، على الرغم من أوجه قصوره. لكنه يستخلص منه ثلاثة دروس أساسية، يرى أنها ذات أهمية بالغة:
أولًا، انتصار النضال المناهض للفصل العنصري عندما تحوّل من صراع عسكري إلى صراع سياسي.
ثانيًا، إدراك القوى المناهضة للنظام أن مفتاح النجاح هو توحيد الصفوف وتجاوز التقسيمات التي فرضها النظام العنصري.
وثالثًا، توسيع التحالفات لتشمل حتى البيض المناهضين للفصل العنصري، ما يؤكد أن الحل الحقيقي هو في إعادة تشكيل المجتمع السياسي بأكمله ليشمل الضحايا والجناة والمستفيدين في كيان واحد.
فلسطين في مرآة ممداني: المستوطن والمواطن
يطبق ممداني إطاره النظري على الحالة الفلسطينية من خلال تمييز حاسم بين “المهاجر” و”المستوطن”، فيرى أن اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين قبل الصهيونية كانوا “مهاجرين” غير مسلحين، اختاروا الانتماء إلى جماعة محلية كانت موجودة بالفعل. في المقابل، يرى أن المستوطنين الصهاينة قد قدموا “مسلحين” ضمن برنامج قومي لإنشاء دولتهم الخاصة، وهو ما يميز الصهيونية عن الوجود اليهودي المبكر في فلسطين.
وحيال الحل المستقبلي، دعا إلى “تفكيك الصهيونية” كأيديولوجيا سياسية، إذ يوضح أن الأمن طويل الأمد لليهود في فلسطين التاريخية يكمن في “تفكيك الدولة اليهودية”، وليس الحفاظ عليها، لتحقيق “دولة لجميع مواطنيها”، على غرار النموذج الجنوب أفريقي.
يقوم هذا المفهوم على فرضية أن “المستوطن والأصلي هما جزء لا يتجزأ من بعضهما البعض”، وأن مصير كل منهما مرتبط بالآخر، وأنه لا يمكن لأحدهما أن يوجد بمعزل عن الآخر. وهذا الترابط الجدلي يفتح الباب أمام رؤية جديدة للصراع، تتجاوز ثنائية الضحية/الجلاد، وتدعو إلى دمج الوجودين في مجتمع سياسي واحد بدلًا من فصلهما.
على الرغم من أهمية أطروحة ممداني، إلا أن النظر إليها يتوجّب عليه بعض المراجعات، من حيث قراءته غير الدقيقة للسرديات التاريخية، مثل تحديد بداية المشروع الصهيوني في أوائل القرن العشرين بدلًا من جيل سابق، أو تحديد دوافع بلفور لدعم الصهيونية بأنها سياسية وليست بسبب معاداة السامية في أوروبا. كما يرى بعض النقاد أن الكتاب يغفل أصواتًا رئيسية، مثل أصوات الفلسطينيين أنفسهم من مثقفين وكُتّاب، ويقدم القليل من التفاصيل عن مجموعات معينة مثل اليهود الإثيوبيين.
ومن الجوانب المثيرة للاهتمام في كتاب ممداني، نقده لحركة المقاطعة (BDS)، على الرغم من دعمه لها، فإنه يرى أن الحركة، على الرغم من أهميتها، تعاني من قيود جوهرية، حيث يجادل بأنها لا تعمل بشكل منهجي مع القوى المناهضة للصهيونية داخل “إسرائيل”، ولا تقدم رؤية مستقبلية “قابلة للعيش” لليهود الإسرائيليين تتجاوز منطق الدولة القومية. هذا النقد ليس رفضًا للحركة، بل هو دعوة لتطويرها لتصبح نضالًا سياسيًا أكثر شمولية، يهدف إلى إعادة تشكيل المجتمع بأكمله، وليس فقط فرض العقوبات من الخارج. وهذا يتسق مع أطروحته التي تؤكد أن الحلول يجب أن تكون سياسية وشاملة للجميع.
صناعة الأقليات على الأرض
تُعد السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة تطبيقًا عمليًا لأطروحة ممداني حول بناء الأقليات الدائمة، فمنذ احتلال عام 1967، قامت “إسرائيل” بتبني سياسات ممنهجة تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني ومنع إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة.
تتجلى هذه السياسات في الاستيلاء على الأراضي، وبناء المستوطنات غير الشرعية، خاصة في المنطقة “ج” ومناطق استراتيجية مثل “E1” التي تُعد الجسر البري الوحيد الذي يربط التجمعات السكانية الفلسطينية في الجنوب والشمال. وهذا المخطط يهدف إلى إحباط أي فرصة لوجود دولة فلسطينية قابلة للحياة، من خلال منع التواصل الإقليمي.
كما تستخدم “إسرائيل” آليات قانونية وإدارية لترسيخ هذا التفكيك، مثل نظام التصاريح المقيّد للحركة، والعقاب الجماعي، والقيود الاقتصادية على الاستثمار والزراعة، والسيطرة على الموارد.
هذه الممارسات تحوّل المجتمع الفلسطيني إلى سلسلة من الجيوب المعزولة والمفككة، ما يمنعه من تشكيل مجتمع سياسي متكامل،
وهذا يفسر استخدام منظمات دولية مصطلحات مثل “الفصل العنصري” و”التطهير العرقي” لوصف هذه السياسات التي تهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وضمان هيمنة الأغلبية اليهودية، مع عزل الفلسطينيين في جيوب غير متصلة.
هذه الممارسات تُعد تطبيقًا مباشرًا لمنطق “الحكم غير المباشر” الذي تحدث عنه ممداني، والذي يرسّخ التقسيمات القومية والعرقية، ويحوّل الفروقات إلى حدود سياسية. فمثلًا، يهدف الاستيطان وبناء جدار الفصل إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني جغرافيًا، وإقامة جيوب معزولة لا يمكنها تشكيل كيان متصل، ما يرسّخ وضع “الأقلية الفلسطينية الدائمة”.

أما نظام التصاريح والقيود على الحركة، فيعمل على فصل الفلسطينيين عن بعضهم البعض، وتقسيمهم إلى نطاقات إدارية وقانونية مختلفة، ما يمنع الوحدة السياسية.
ويُعد العقاب الجماعي أداة لترسيخ الهيمنة وتدمير البنية التحتية، وهو ما يتماشى مع منطق يُعامل السكان كجماعات، وليس كأفراد لهم حقوق، فضلًا عن القيود الاقتصادية والسيطرة على الموارد، التي تهدف إلى منع التطور الاقتصادي الذاتي، وتكريس التبعية لـ”إسرائيل”، مما يضعف قدرة المجتمع على تشكيل كيان سياسي مستقل.
وهذا ما يتماشى مع استراتيجية “إسرائيل” مع سوريا، تاريخيًا وفي الحاضر، إذ مثّلت حالة الدروز في الجولان المحتل والسويداء بسوريا مثالًا آخر على أطروحة ممداني حول التفكيك السياسي. ففي الجولان، يرفض معظم الدروز الجنسية الإسرائيلية ويتمسكون بهويتهم السورية، ما يضعهم في تناقض مع أبناء طائفتهم في “إسرائيل” الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي.
كذلك تعمل “إسرائيل” على طمس هويتهم من خلال سياسات الاحتلال، وتنشأ من حين لآخر مواجهات معهم، كما حدث في قضية توربينات الهواء منذ سنوات. هذا الموقف يُعد تمسكًا بالهوية الوطنية في مواجهة محاولات التفكيك التي يفرضها الاحتلال، كما هو في الحاضر، في حالة دروز السويداء ومسألة انفصالهم عن سوريا.

ويمكن تلخيص التناقض بين الحالتين في أن دروز الجولان يرفضون الانفصال ويتمسكون بهويتهم السورية في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، بينما يميل بعض من دروز السويداء إلى الانفصال. ففي هاتين الحالتين، يظهر أن تفكك الدولة المركزية يمكن أن يصبح أداة جديدة لخلق أقليات دائمة تحت سيطرة أطراف مختلفة، ما يزيد من تفتيت النسيج الاجتماعي والسياسي، وهذا يوضح أن الحل ليس بالضرورة في الانفصال، بل في “إنهاء استعمار المجتمع السياسي” وإرساء نظام جديد يضمن حقوق جميع مكوناته.
View this post on Instagram
نهاية، يقدم كتاب ممداني “لا مستوطن ولا مواطن” إطارًا تحليليًا عميقًا لفهم الصراعات المعاصرة التي تبدو عصية على الحل، فمن خلال إثبات أن الدولة القومية والاستعمار ليسا نقيضين بل متلازمين، في أحايين كثيرة، وأن العنف الذي تشهده المجتمعات ليس انحرافًا، بل هو نتاج طبيعي لعملية “التطهير” التي تسعى إليها الدولة القومية، في أحايين أُخرى أيضًا.
كما أن الحلول التقليدية، مثل محاكمات نورنبرغ أو حل الدولتين، قد تكون غير كافية لأنها تترك البنية السياسية التي أنتجت العنف سليمة. وبدلًا من ذلك، يقترح ممداني تجاوز الثنائيات الجامدة، مثل “مستوطن/أصلي” أو “ضحية/جلاد”، والدعوة إلى حلول سياسية شاملة تستوعب جميع الأطراف في مجتمع سياسي واحد.
تُثبت سياسات التفكيك الإسرائيلية في فلسطين، ولا سيما بعد السابع من أكتوبر 2023، التي تحوّل الضفة الغربية وغزة إلى جيوب معزولة أو مهجّرة، وكذلك ديناميكيات الانقسام في مجتمعات دروز سوريا، أن أطروحة ممداني ليست مجرد نظرية أكاديمية، بل هي أداة قوية لفهم ما يحدث على الأرض، فهذه الممارسات لا تهدف فقط إلى السيطرة على الأرض، بل إلى تفكيك المجتمعات ذاتها، مما يضمن استمرار حالة “الأقلية الدائمة”.