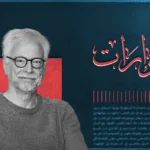لغة القانون معقدة، رصينة، مليئة بالمصطلحات الغامضة التي تحمل ما لا يُحتمل، وتؤول على غير سياقاتها، لكنها بالنسبة للعالم أجمع تكتسب قيمة حمائية باعتبارها جزءًا من العدالة الدنيوية، يبحث عنها الضحية ليتأكد أن الظلم مدفوع الثمن، ويهابها الجاني حتى تردع طغيانه وبطشه.
في الحقيقة، لم يعد هذا واقع الحال بعد السابع من أكتوبر. يعبر عن هذا الواقع الباحث خالد الحروب بقوله: “هذا شيء استثنائي في التاريخ، كل إبادة نعرفها حصلت ومن ثم اكتشفناها، اكتشفها الباحثون والسياسيون لاحقًا وبدأوا في جمع الأدلة عن مقدار وعمق الجريمة، لكن الإبادة الراهنة في غزة اليوم تتم ببثٍ حي ومباشر، ونستطيع مراقبتها من الأجهزة المحمولة، ونرى عائلات أصدقاء نعرفهم يقتلون أو تندلع خلفهم الانفجارات أو يذهبون للحصول على المساعدات ثم يقتلون”.
يكمل الحروب قوله: “في المحاضرات التي كنت أدرسها في الجامعة عن مساق فلسطين، أعترف أنني كنت سطحيًا عندما كنت أقول لطلابي إنّ نكبة 1948 حصلت في ظل غياب المنظومة العدلية والقانون الدولي والتغطية الإعلامية التي يتميز بها القرن الـ21، بمعنى أن النكبة حصلت لأن العالم كان في غفلة، وجرت أحداثها خلف ظهر العالم. اليوم اكتشفت أنا وآخرون كثر معي أنه تحليل ساذج، وأن الكل يندد لكن الكل مؤيد، وغير المؤيد لا يستطيع أن يفعل شيئًا”.
أذرع قانونية وحقوقية معطلة
تحظى المنظومة الدولية بآليات متعددة للتقصي والمساءلة والتحقيق، تتداخل معًا وتتيح توفير أكبر قدر من العدالة الاستقصائية والإجرائية، فمن المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، التي تتابع الانتهاكات وتصدر بيانات والتوصيات، وتقوم ببعثات استقصائية أو تُكلّف لجان تحقيق بجمع المعلومات الموثقة لتقديمها في تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق (Commission of Inquiry)، التي تُنشأ وفقًا لقرارات مجلس حقوق الإنسان، وتُمنح تفويضًا مرنًا للتحقيق في الانتهاكات في مناطق النزاع، حيث تعد تقارير شاملة تستند إلى مقابلات وأدلة ميدانية ومستندات، وتملك صلاحية إصدار إحالات قضائية أو تدابير إصلاحية.
ثم هناك آليات التخصص (مثل الممثل الخاص للجمعية العامة أو مجلس الأمن أو لجان الخبراء) التي تركز في تحقيقاتها على قضايا محددة مثل العنف الجنسي في النزاع، وتقوم على سد جزء من ثغرات التقارير العامة، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية (ICC) التي بإمكانها توجيه لائحة اتهام تقاضي من خلالها الأفراد حول تورطهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وأخيرًا التحقيقات الصحفية والحقوقية المستقلة، التي تتم عبر مؤسسات إعلامية ومنظمات غير حكومية وباحثين مستقلين ويتم من خلالها إجراء تحقيقات ميدانية وتحليلية ونشر الأدلة والشهادات لإثارة وتحريك الرأي العام، أو المحافل الدولية والقانونية.
تنوع الأذرع وولايتها القضائية وحدود صلاحياتها لا يعني قدرة كلية على تحقيق العدالة، فالمفوضية تُعاني -غالبًا- من رفض الدول التعاون معها وتعطيل وصولها إلى مواقع الحوادث أو توثيقها للجرائم، وهو ما يعيق لجنة الأمم المتحدة التي بإمكان الدول المعنية رفض دخولها واتهامها بالتحيز، أما ممثل الجمعية العامة أو مجلس الأمن فنادرًا ما يتم منحهم صلاحيات تنفيذية حقيقية، بينما بإمكان الضغوط والابتزاز الدولي وألاعيب السياسة أن تحول أداء المحكمة الجنائية الدولية إلى مجرد استعراض، وهو ما ينطبق -ويا للغرابة- على التحقيقات الصحفية التي قد يتم منع نشرها أو اتهامها بالتشهير، رغم قدرتها الفائقة على الوصول إلى حقائق قد تعجز الأذرع الرسمية عن الوصول إليها.
هذه الأذرع جميعًا فُعلت واستهلكت منذ اللحظة الأولى للسابع من أكتوبر، إما نتيجة سعي إسرائيلي لاستغلالها في الحشد الدولي والعسكري لدعم وتمويل الحرب، أو نتيجة محاولات الفلسطينيين المتواصلة الوصول إلى مخرجٍ من جحيم الحرب، يتجاوز التواطؤ الدولي والتخاذل العربي ورغبة جميع الأطراف في تحويل الحرب إلى درسٍ يتعلمه الفلسطينيون والعرب والعالم أجمع عن نتائج تحدي “إسرائيل” واستفزاز أمنها.
مزاعم وحقائق
سويعات فقط فصلت بين اندلاع السابع من أكتوبر وبين دعاية إسرائيلية تتعلق بعنف جنسي ومزاعم اغتصاب واعتداء جماعي وقطع رؤوس رضع وحرقهم، نفذتها المقاومة الفلسطينية خلال اقتحامها المعسكرات والمستوطنات المحيطة بغلاف غزة، وبينما غابت الصور والحقائق والأدلة، ظهرت التصريحات الإسرائيلية والغربية السياسية والإعلامية التي تؤكد وجود “أسس معقولة للاعتقاد” بوجود عنف جنسي خلال الطوفان.
ورغم أن التقارير المتواترة لم تكن قضائية ولا استقصائية، ولم تعتمد جمع الأدلة أو تقييمها، ولم تحدد نسبة الضحايا بدقة أو مدى انتشار العنف، إلا أن المؤسسات الدولية ومنها بعثة الأمم المتحدة الخاصة لتمثيل الأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في النزاع، ومنظمة Human Rights Watch والمفوضية قد نشرت سلسلة تقارير تعتمد على الرواية الإسرائيلية، متماشية مع تبني الإعلام الدولي (BBC، The Guardian).
في الوقت نفسه جمعت اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية و”إسرائيل” أكثر من 7 آلاف قطعة من الأدلة لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن لم يتم التوصل عبر أيٍ منها لوجود “الأسس المعقولة إياها” لعنف جنسي فلسطيني بحق الإسرائيليين.
لاحقًا، ونتيجة توسع الحرب وتوحشها، بات من الصعب الاستمرار في التباكي الإسرائيلي في مقابل حمى الإبادة، خاصة عندما بادرت عدة أذرع حقوقية بإطلاق لجان تحقيق فيما وصفته بـ “الانتهاكات من جميع الأطراف” منذ 7 أكتوبر 2023، منها لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ما نتج عنه سلسلة تقارير تتطرق لاحتمال ارتكاب “إسرائيل” جرائم إبادة، وتحمل قادتها مسؤولية جرائم حرب، بينما لم تصدر اللجنة تقريرها النهائي لأنها لا تزال تعمل في جمع الأدلة والنشر وصياغة التوصيات!
تزامن ذلك مع جهد حقوقي من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق الإنسان، أسفر عن استمرار في رصد الانتهاكات وإصدار تقارير عن هجمات على مستشفيات ومدنيين ومدارس واستخدام أسلحة فتاكة، وعدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين وقضايا التجويع والتهجير القسري، دون أن يسفر ذلك أيضًا عن أي تقدم سوى مواصلة جمع الأدلة.
من الجهود القانونية الأخرى، تقارير لمفوضية حقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة تستنتج وجود عنف جنسي وتحرش وعري قسري استُخدمت ضد الفلسطينيين كجزء من العنف المنهجي في سياق الاحتلال والصراع، ورغم أن الدول والهيئات الأممية بإمكانها استخدام تقارير الأمم المتحدة كأسانيد قانونية وسياسية للدفع بمسائلة الاحتلال ومحاسبته، إلا أن رفض الاحتلال للتعاون واستخدم ألاعيب السياسة الدولية وحُجج معاداة السامية للتهرب من استحقاقات العدالة.
لا تتوقف التحقيقات عند جرائم معينة، فهناك لجان التحقيق الأوروبية والأممية في جريمة استهداف الطفلة هند رجب وعائلتها في التاسع والعشرين من يناير 2024، والتي وثقت باتصال هاتفي للطفلة تطلب فيه النجدة من الهلال الأحمر قبل استهدافها وقصف طاقم الإسعاف الذي حاول الوصول إليها.
التحقيق الذي بدأ صحفيًا وتقنيًا وقامت به Forensic Architecture بالتعاون مع جهات إعلامية، توصل إلى أن سيارة هند وعائلتها تعرضت لإطلاق نار كثيف، تجاوز 335 طلقة من دبابة إسرائيلية تتبع الفرقة 162، وتبعد مسافة تتراوح ما بين 13-23 مترًا عنها، وأن سيارة الإسعاف التي مُنحت تنسيقًا وإذنًا للوصول وإغاثة الطفلة تعرضت للقصف على بُعد أمتار من السيارة وقبل وصولها إليها.
هذه النتيجة تلقفها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليصدر بيانًا يُشير فيه إلى أن مقتل هند وعائلتها والمسعفين “قد” يشكل جريمة حرب بناء على المعطيات المتوفرة، لتقوم الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية برفض التقرير لاحقًا وإطلاق لجان تحقيق خاصة بهما بدون نتيجة تُذكر.
لاحقًا رُفعت شكوى إلى محكمة العدل الدولية (ICC)، من قبل مؤسسة “هند رجب”، تطالب بفتح تحقيق في مسؤولية الضباط الإسرائيليين، وحددت الضابط بني أهارون كقائد الوحدة الذي يُزعم أنه كان وراء الأمر، وحتى اليوم لم ينطلق تحقيق قضائي كامل في القضية أو يصدر أي أمر رسمي بالقبض على المشتبه بهم، والحُجة كانت أن فتح مثل هذه القضايا أمام الـ “ICC” يأخذ وقتًا طويلاً بسبب التحقق من الاختصاص وجمع الأدلة ومرافعة الأطراف، واعتراضات الدول.
وهو ما دفع ناشطين وحقوقيين لمحاولة إطلاق تحقيقات وطنية، مثل تحقيق النيابة العامة الفرنسية فيما يتعلق بـ “المشاركة في إبادة جماعية” والتحريض عليها” (complicity in genocide / incitement to genocide) ضد مواطنين فرنسيين إسرائيليين يُزعم أنهم كانوا يشاركون في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، إضافة لشكاوى جنائية رفعتها منظمات حقوقية فرنسية ضد جنود فرنسيين إسرائيليين تتعلق بجرائم حرب مزعومة في غزة.
تحقيق وطني آخر في إسبانيا، عبر النائب العام الإسباني الذي أنشأ فريقًا للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة يجمع الأدلة لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما أطلقت السلطات تحقيقًا في الاعتداء على قافلة تضامنية حاولت كسر الحصار البحري والوصول إلى غزة، للتأكد مما إذا كان هناك خرق للقانون الدولي.
عمومًا، هذه التحقيقات، رغم رمزيتها، كشفت محدودية الإرادة الأوروبية في مواجهة واشنطن وتل أبيب، حيث لم تتجاوز حدود الإدانة الأخلاقية، ورفع العتب. لا يعني ذلك أبدًا جمودًا في لجان التحقيق، بل إنها تتنوع في أشكالها وجرائمها، ففي مجزرة المسعفين في مايو 2025، حين عُثر على جثث أربعة عشر من العاملين الطبيين والمسعفين في غزة، بمن فيهم عامل من الأمم المتحدة، قُتلوا بينما لا يزالون مرتدين معداتهم الطبية، تم إطلاق سلسلة تحقيقات إعلامية من قبل (BBC, AP, FT)، رد عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بفتح تحقيق داخليّ، رفضته مؤسسات الإغاثة (الهلال/الصليب الأحمر الفلسطيني) وطالبت بتحقيق دولي مستقل -لعدم كفايته- وليس نزاهته.
وفي سلسلة مجازر الطحين، خلال فبراير ومارس 2024، أطلقت مجموعة خبراء الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الحقوقية مثل الميزان وأمنستي دعوتها لتحقيق دولي مستقل، إثر سلسلة تقارير وتحقيقات إعلامية حللت الفيديوهات وبيانات المستشفيات، مع استنكار المجازر، فقط.
تكرر الفعل نفسه في استهداف موظفي المطبخ العالمي في إبريل 2024، حين دفعت تقارير إعلامية جيش الاحتلال الإسرائيلي لفتح تحقيق داخلي، عبر لجان مستقلة! -مستقلة عن من؟- بينما قدمت التقارير الإعلامية الدولية أدلة وتحليلات فيديو موثقة أجبرت المنظمات الدولية للمطالبة بتحقيقات أكثر استقلالًا.
وفي مجزرة حي الدرج ومحرقة الخيام المتكررة ما بين 2024-2025، خرجت منظمات الأمم المتحدة والهلال والصليب الأحمر وخبراء الأمم المتحدة ببيانات استهجان ودعوات لتحقيقات مستقلة، والحال نفسه مع مجزرة المشفى المعمداني، وقصف المدارس والجامعات والمشافي، واستهداف عائلات بأكملها، واستخدام الذكاء الاصطناعي في القتل، والاستعانة بقنابل طن ونصف طن في تنفيذ المجازر، وجميعها تُحاط ببيانات استنكار ودعوات للجان تحقيق مستقل، رغم أنه ليس من الواضح حتى الآن أن هناك تحقيقًا جنائيًا دوليًا عامًّا أسفر عن محاسبة محددة في هذه المجزرة أو تلك، بعيدًا عن التقارير الإعلامية والحقوقية.
ما نسيناه سريعًا أو تجاهلناه
في السادس عشر من سبتمبر المنصرم، خلُصت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق إلى أن “إسرائيل”: “ارتكبت ولا تزال ترتكب أربعة من الأفعال الممنوعة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948” (القتل، وإلحاق ضرر جسدي أو نفسي، وفرض ظروف حياة محسوبة لتدمير المجموعة جزئيًا أو كليًا، وفرض تدابير لمنع الولادات)؛ وقد اعتبرت أن التصريحات الصادرة عن قيادات إسرائيلية وأفعال قواتها تُشير إلى نية إبادة واضحة.
وفي ديسمبر 2024 أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا تؤكد فيه أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وتطالب مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بإضافة تهم الإبادة إلى لائحة التحقيقات، ليتبعه إصدار المحكمة الدولية (ICJ) أمرًا مؤقتًا يُلزم “إسرائيل” باتخاذ خطوات لمنع الإبادة، وهو أمر يُعدّ قانونيًا ملزمًا، رغم محدوديته في التنفيذ الفعلي.
وحتى على مستوى الأدلة الملموسة، ففي يناير 2025 أقر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في يناير 2025، بأن “إسرائيل” لم تقُم بأي جهد حقيقي للتحقيق في ادعاءات جرائم غزة، معتبرًا أن صدور أوامر الاعتقال لنتنياهو وغالانت هو خيار أخير بعد فشل المسارات الوطنية، لتُصدر المحكمة أمرَ مذكرتي توقيف ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ما اعتُبر تطورًا رمزيًا مهمًا على مستوى المساءلة الدولية.
هذه التفاعلات، التي كان يمكن أن تحظى بتأثير، ربما في كوكبٍ آخر، لا تصنف إلا باعتبارها خاملة عندما ترتبط بدولة الاحتلال، فالإعلام انتقل بسببها من خانة متابعة التقارير الحقوقية إلى عد القتلى والجرحى، بل وتجاوز هوائية التساؤل في كل مرة عن أهمية القرارات ولجان التحقيق في وقت الإبادة، مع إدراكه أن الأهمية مفقودة.
بينما وجدت الدول الغربية في هذا النمط الحقوقي السطحي ميدانًا للمجادلة والتفاوض والتداول بدلًا من التعاطي الجاد، بل وسحبت من الأمم المتحدة آليات التنفيذ الحقيقية، واستُبدل الاهتمام الإنساني بنتائج التحقيقات والمحاكم بدلًا من إعادة الإعمار ووقف الحرب والإغاثة وإدخال المساعدات الإنسانية والأدوية، حتى غدا أن الأولوية هي للقرارات الدولية على حساب الحياة الحقيقية التي تُباد في غزة.
ثم أجمع المجتمع الدولي على تهميش القانون، ريثما أتى ترامب وفتته بالضربة القاضية، وهو ما حول العدالة الدولية لمكونٍ هش لا يمكن اعتماده على مستوى سياسي بعد اليوم، بهذا تحولت النتائج والتحقيقات القانونية إلى ملامح باهتة يُستدل من خلالها على أن “القانون الدولي مرّ من هنا” ليس إلا.
بعد اليوم، لم يعد ممكنًا اعتبار القانون الدولي أداة تغيير، أو النظر إلى التحقيقات بوصفها تنصف الضحية، بل باعتبارها ورقة مساومة تُستخدم لتجاهل الحقائق، تمامًا كما تبتز “إسرائيل” السلطة الفلسطينية عند كل منعطفٍ قانوني، لسحب كلمتها مقابل القليل من أموال المقاصة.
عمومًا، بإمكاننا التأكد اليوم أن فيتو مجلس الأمن يتفوق على أي عدالة، وأن المساومات السياسية والضغط الاقتصادي أقوى من كل لجان تحقيق، وأن الضحية تبقى وحدها في خانة الذكرى والشكوى بينما يواصل الجاني مراكمة هيمنته وطغيانه بلا خوف، وهو ما يؤذن بسقوط قادم لا محالة -رمزي أو فعلي- للقانون والمجتمع الدولي وآلياته وأذرعه بشكلها الحالي، ربما حتى يُصار إلى صياغة فعلية للعدالة الدولية، بصفتها سيفًا للحق لا أرشيفًا يُستدعى للضغط والمكايدة.
هذا ما استنتجه الفلسطينيون ومن ثم العالم بأكمله، فهُناك الكثير من الجرائم التي يفضل العالم نسيانها سريعًا، وإتاحة المجال لجرائم أخرى، لكن ذلك لا يغير من حقيقة الجريمة، بل يكشف أن المجتمع الدولي قوي في إنكار العدالة، وضعيف في إنشائها والدفاع عنها، وأن سرعة نسيان الجرائم لا تمحوها من ذاكرة الضحايا، لكنها تمحو العدالة من ذاكرة العالم، فتتحول العدالة إلى ذكرى باردة، لا إلى فعل رادع.
لاحقًا لا تصدقوا العدالة الدولية، صدقوا الدماء التي لا تُمحى على الجدران، ومسننات الدبابة التي تمر فوق الحقول والآمال والأرواح، والصور القديمة لعائلات لم يبق منها سوى الظلال، وصدقوا الثائر حين يخط عدالته بسكينٍ أو رصاص، ويترك نصره أو أشلائه في المكان، وصدقوا الحكايا والآلام، ففي الألم يقين لا تبصره العدالة العمياء ولا تأتي به قوانين الدول الكبرى ومصالحها.