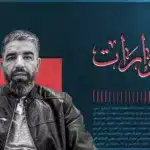في أواخر الأربعينيات، وبينما كانت الولايات المتحدة تعيد رسم خرائط النفوذ العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، أعدّ البنتاغون بين عامي 1944 و1946 وثائق عُرفت باسم “خطة الظهران”، نصّت على الاستعداد لاحتلال السعودية والسيطرة على حقول النفط في الظهران إذا ما تعرّضت المصالح الأميركية لأيّ تهديد ألماني أو سوفييتي أو وطنيّ محلّي. كانت هذه الخطة ثمرةً مباشرة لتحوّل النفط إلى سلاح إستراتيجي في بناء النظام الدولي الجديد، وجزءًا من مشروع أوسع لترسيخ الهيمنة الأميركية على الخليج بعد انحسار النفوذ البريطاني والفرنسي. ومع أنها وُضعت في سياق الحرب الباردة، فإنها سرعان ما أصبحت حجر الأساس لعقيدة الأمن الأميركي في المنطقة.
فقد تجسّدت آثار الخطة في إنشاء قاعدة الظهران الجوية عام 1945، ثم في التوسّع العسكري الأميركي بعد حرب 1967، وصولًا إلى حرب أكتوبر 1973 التي أعادت تعريف العلاقة بين النفط والسياسة والحرب. حينها، ومع استخدام العرب لسلاح النفط، أعادت واشنطن إحياء روح الخطة القديمة، إذ ناقشت إدارة نيكسون وكيسنجر إمكانية احتلال الحقول النفطية السعودية والكويتية إذا استمرّ الحظر النفطي.
انطلاقًا من هذا الإرث، يسعى المقال إلى تفكيك البنية السياسية والفكرية لخطة الظهران من خلال ثلاثة محاور: الجذور الجيوسياسية للمشروع الأميركي في الخليج، وتحول استراتيجيته من الاحتلال الصلب إلى السيطرة الناعمة عبر الحماية، ثم أثر ذلك على مفهوم السيادة الوطنية، وعلاقة النفط بالحماية والهيمنة في العالم العربي.
صياغة المشروع الأميركي في الخليج (1940–1946)
بدأ المشروع الأميركي في الخليج قبل وقتٍ قصير من انتهاء الحرب العالمية الثانية، متزامنًا مع تآكل النفوذ الإمبراطوري البريطاني. كانت الخطوة الأولى نحو دمج المملكة العربية السعودية في الإطار الاستراتيجي الأميركي هي ضمّها إلى برنامج الإعارة والتأجير في عام 1943، وهو البرنامج الذي يسمح للرئيس بنقل الخدمات العسكرية والإمدادات إلى الدول الحيوية للأمن القومي الأميركي. وقد تم في هذا الإطار الإعلان رسميًا عن أن الدفاع عن السعودية هو “أمر حيوي للدفاع عن الولايات المتحدة”.
تبع ذلك السعي لإنشاء موطئ قدم عسكري دائم. ففي عام 1944، قدّمت وزارة الحرب الأميركية طلبًا رسميًا لبناء قاعدة جوية بالقرب من الظهران. وقد واجه هذا الطلب تحدّيات مباشرة، أبرزها الاعتراض البريطاني الأولي على منح الولايات المتحدة الإذن بالبناء. لكن واشنطن نجحت في تجاوز هذا الاعتراض بحجّة الضرورة العسكرية الملحّة لاستكمال الحرب في المحيط الهادئ، مشيرةً إلى أن القاعدة الجديدة ستُقصّر المسار اللوجستي بين القاهرة وكراتشي بنحو 200 ميل، ما يوفّر الوقود وساعات الطيران.
وفي عام 1945، تم الحصول على موافقة الملك عبد العزيز، لكنها جاءت بشروط سيادية صارمة: أن يكون الاستخدام مؤقتًا لثلاث سنوات بعد نهاية الأعمال العدائية، وأن تنتقل ملكية المنشآت الثابتة إلى الحكومة السعودية.
في تناقضٍ صارخ مع الطبيعة “المؤقتة” و”السيادية” لاتفاقية القاعدة المُعلنة، كانت الولايات المتحدة تطوّر خططًا سرية لضمان السيطرة الدائمة على النفط. كشفت الوثائق أن البنتاغون أعدّ “خططًا خاصة” (Special Plans)، وهو مصطلح كان يُستخدم كتعمية لوصف خطط الحرب والاحتلال.
هذه الخطة، التي عُرفت بـ”خطة الظهران”، نصّت صراحةً على الاستعداد لاحتلال حقول النفط السعودية والسيطرة عليها.
كانت خطة الاحتلال مصمَّمة للتعامل مع ثلاثة سيناريوهات تهديد رئيسية: التهديد الألماني، التهديد السوفييتي، أو “تهديد وطني محلي يهدّد المصالح الأميركية”. هذا السيناريو الأخير يشير تحديدًا إلى الحركات القومية أو الثورية التي قد تسعى لتأميم النفط أو استخدامه كسلاح ضد الغرب. وقد كشفت الوثائق تفاصيل مقلقة حول نية الولايات المتحدة تعطيل البنية التحتية النفطية في حال تعذّر السيطرة المباشرة (استراتيجية الإنكار).
وقد تميّزت الخطة بدمج القطاع الخاص، حيث ساعدت شركة النفط الأميركية (أرامكو) وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في تدريب موظفيها لتنفيذ خطط التعطيل المادي في حقول السعودية والكويت والبحرين وقطر.
وجود خطط لتدمير الأصول بواسطة موظفي الشركة نفسها يكشف أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لتدمير الأصل إذا لم تستطع السيطرة عليه بشكل مباشر، مما يؤكد أن المنطق وراء الخطة كان قسريًا ودائمًا، ويتجاوز بكثير الالتزامات الدبلوماسية المؤقتة.
تطوّر الاستراتيجية من الاحتلال الصريح إلى السيطرة الناعمة (1967–1980)
شهدت الفترة ما بين حرب 1967 وحرب أكتوبر 1973 تحوّلًا حاسمًا في ميزان القوى النفطية. فبعد أن فقدت الولايات المتحدة قدرتها الاحتياطية على الإنتاج، أصبح الغرب يعتمد بشكل متزايد وحاسم على النفط الخليجي. وعندما لجأت الدول العربية إلى سلاح النفط في أكتوبر 1973، مُستخدمة الحظر ضد الدول الداعمة لـ”إسرائيل”، أثبت هذا السلاح فعاليته وتسبّب في صدمة اقتصادية غير مسبوقة.
دفعت هذه الأزمة إدارتي نيكسون وكيسنجر إلى إحياء روح خطة الظهران القديمة، حيث نوقشت بجدية خطط الاحتلال العسكري لحقول النفط السعودية والكويتية إذا استمرّ الحظر. وقد كشفت الوثائق عن مناقشات بين وزير الدفاع جيمس شليزنجر والمسؤولين البريطانيين حول إمكانية استخدام القوة. وتؤكّد هذه النقاشات استمرار الفكر الإمبريالي الكامن، فوزير الخارجية هنري كيسنجر صرّح في أحد الاجتماعات الخاصة بأن “من المضحك أن يتم تعطيل العالم المتحضّر من قبل 8 ملايين من الهمج”، ما يؤكد أن الأساس الفكري لخطة الظهران (تجاهل السيادة المحلية عند تهديد المصالح الحيوية) ظل عقيدةً مهيمنة.
أدركت واشنطن أن تكاليف الاحتلال المباشر غير مستدامة سياسيًا وعسكريًا. لذا، تم اتخاذ قرار بتحويل الاستراتيجية من القسر المباشر إلى “الهيمنة الهيكلية” عبر تعميق الاعتماد الأمني والمالي، حيث التزمت الولايات المتحدة بإدارة برنامج ضخم للإنشاءات العسكرية بمليارات الدولارات.
وشمل التعاون تزويد وتدريب القوات السعودية، بما في ذلك تزويد لواءين من الجيش بالدبابات وناقلات الجند الحديثة (مثل M60 وM113). كما التزمت واشنطن بتطوير سلاح البحرية السعودي، من خلال توفير 18 سفينة وإنشاء قاعدتين بحريتين. واستمرّت بعثة التدريب العسكري الأميركية (USMTM)، التي تأسست في عام 1949، في عملها من مقرها في الظهران، ما رسّخ النفوذ العسكري والتدريبي الأميركي.
بالتوازي مع التعاون الأمني، كانت الركيزة المالية حاضرة، إذ تم التوقيع على اتفاقيات هامّة، أبرزها “البيان المشترك للتعاون” في يونيو/ حزيران 1974. أدّت هذه الاتفاقيات إلى إنشاء نظام البترودولار، الذي يضمن تسعير النفط العالمي بالدولار الأميركي.
هذا النظام لم يضمن فقط تدفّق النفط، بل ضمن أيضًا قيام الدول المنتجة بإعادة تدوير عائداتها الضخمة (البترودولارات) إلى النظام المالي الأميركي، خاصة عبر شراء سندات الخزانة والاستثمار. وقد سمح هذا الأمر للولايات المتحدة بالحفاظ على هيمنتها المالية العالمية، وتمويل عجزها دون ضغوط تضخمية كبيرة.
لكن، شهد عام 1980 التكريس العلني والمؤسسي لروح خطة الظهران، عبر “مذهب كارتر” الذي أعلنه الرئيس جيمي كارتر. جاء هذا المذهب كردّ فعل على صدمة حرب 1973، وسقوط نظام الشاه في إيران، والغزو السوفييتي لأفغانستان. أعلن كارتر أن: “أيّ محاولة من قبل أيّ قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج، سيتم اعتبارها اعتداءً على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأميركية، وسيتم ردّ هذا الاعتداء بأي وسيلة ضرورية، بما في ذلك القوة العسكرية”.
لقد أخذ مذهب كارتر التهديد السرّي الذي تضمنته خطة الظهران (ضمان الوصول بالرد العسكري)، وحوّله إلى سياسة خارجية علنية. وترجمةً لهذا التعهّد، تم تأسيس قوة الانتشار السريع (RDF) في مارس/ آذار 1980، والتي تطوّرت لاحقًا لتصبح القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM).
وبذلك، أصبحت القيادة المركزية الآلية الدائمة التي تضمن تطبيق العقيدة الأمنية المؤسسة على أساس حقّ الولايات المتحدة في الدفاع عن النفط، وهو الهدف الذي قامت عليه خطة الظهران في المقام الأول.
انعكاسات الخطة على السيادة الوطنية ومفهوم الحماية والهيمنة
خلال أربعة عقود، وفّرت المظلّة الأمنية الغربية (التي ترسّخت في عقيدة الظهران المتطوّرة) الحماية الضرورية للأنظمة الملكية في الخليج ضد الاضطرابات الداخلية والإقليمية، وخاصة موجات القومية العربية. وقد سمح هذا الاستقرار الأمني للدول الخليجية بتحقيق سيادتها الاقتصادية، خاصةً من خلال تأميم صناعة النفط في السبعينيات. لكن، هذه الحماية كانت مقايضة استراتيجية. فمقابل أمن الأنظمة واستقرارها، فُرضت “تبعية أمنية” عميقة.
هذه التبعية قيّدت بشكل كبير الخيارات السياسية الخارجية لتلك الدول، وجعلت استمرارية النظام في الخليج مرتبطًا بالالتزام بالحفاظ على الشراكة الحيوية مع الولايات المتحدة.
ويمكن تحليل مكوّنات نسيج (النفط–الأمن–السيادة)، الذي أرسى نموذج الهيمنة الهيكلية بعد عام 1974، عبر ثلاثة أبعاد استراتيجية متكاملة.
في البعد العسكري/الأمني، مثّلت الإدارة الشاملة للجيش والتدريب والمشتريات (مثل برنامج الإنشاءات العسكرية وبعثة التدريب العسكري الأميركية) آلية الهيمنة الأميركية، ونتج عنها تبعية أمنية عميقة هدفت إلى ضمان أمن الأنظمة ضد التهديدات الخارجية والداخلية، مما أدّى إلى نشوء “سيادة تابعة” (Subordinated Sovereignty).
أما في البعد المالي/الاقتصادي، فقد قام نظام البترودولار على ضمان استثمار العائدات النفطية الضخمة في الأصول الأميركية، وهو ما منح الدول الخليجية استقرارًا ماليًا واقتصاديًا مقابل الالتزام بآليات تداول العملة العالمية، مما أدّى إلى نشوء “سيادة مالية مقيّدة” (Constrained Financial Sovereignty).
وأخيرًا، في البعد السيادي/الداخلي، عملت واشنطن على دعم استقرار الأنظمة الحاكمة في وجه الحركات القومية والراديكالية، مما سمح لدول الخليج بتحقيق سيادة الموارد (التأميم) مقابل تقبّل النفوذ السياسي الأميركي. وبهذا التفاعل المعقّد، نُسجت خيوط ما يمكن تسميته بـ”السيادة المُدارة” (Managed Sovereignty).
في العصر الحديث، تجسّدت استمرارية عقيدة الظهران في البعد المالي من خلال نظام البترودولار. لقد مكّن هذا النظام الولايات المتحدة من استخدام الدولار كـ”سلاح مالي”، حيث ضمِنَ الهيمنة الأميركية في الاقتصاد السياسي العالمي، وجعل الدول المنتجة للنفط عرضةً للقيود المالية الأميركية، مما يحدّ من قدرتها على اتخاذ قرارات سيادية تتعارض مع المصالح الأميركية.
كما يشير التحليل، فإنّ محاولات دول مثل العراق وليبيا وإيران لتحدّي تسعير النفط بالدولار، وما أعقبها من صراعات وتغييرات أنظمة، تؤكّد أن البعد المالي أصبح ساحةً جديدة لتطبيق “روح الظهران” العسكرية، ولكن بأدوات اقتصادية هذه المرّة. فالتهديد بالقوة العسكرية، الذي تجسّده (CENTCOM)، يتم دعمه الآن بالتهديد بالعقوبات المالية، وكلاهما يهدف إلى حماية الهيمنة الأميركية على الطاقة والنظام المالي.
إنّ سعي الدول الخليجية، وعلى رأسها السعودية، إلى تعزيز سيادتها الوطنية في العقدين الماضيين، يمثّل استمرارًا للصراع الذي بدأ بشروط الملك عبد العزيز على القاعدة في عام 1945. هذا السعي يتجلّى اليوم في برامج التنويع الاقتصادي، ومحاولات تقليل التبعية الأمنية، وكذلك في التركيز الحديث على قضايا “سيادة البيانات” كأصل وطني حيوي يجب حمايته، تمامًا كما كانت حقول النفط أصولًا حيوية تتطلب الحماية في الأربعينيات.
نهايةً، لقد أثبتت “خطة الظهران” أنها لم تكن مجرّد خطة عملياتية عسكرية عابرة، بل كانت الأساس الفكري الذي أرسى العقيدة الأميركية الدائمة تجاه الخليج.
تمحورت هذه العقيدة حول ضمان “الوصول المطلق” للنفط، متجاوزةً حدود السيادة المحلية عبر استراتيجية مزدوجة، حيث جمعت بين التهديد بالقسر العسكري (الاحتلال المحتمل كما نوقش في عام 1973) والسيطرة الهيكلية التي تكرّست بعد عام 1974. تمثّلت هذه السيطرة في منظومة التبعية الأمنية الموسّعة، ونظام البترودولار المالي، وكلاهما أدّى إلى مأسسة الهيمنة الأميركية من خلال مذهب كارتر وتأسيس القيادة المركزية (CENTCOM).
وفي المحصّلة، أدّت هذه الديناميكيات إلى إرساء مفهوم “السيادة المُدارة” في دول الخليج، حيث ضمِنَت الحماية الإقليمية مقابل قبول القيود العسكرية والمالية على الخيارات السيادية الوطنية.