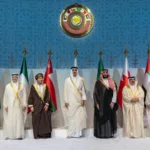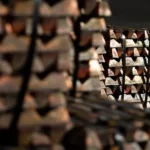تتصاعد ملامح حضور تركي متزايد في الملف الفلسطيني، يتجاوز حدود الدعم الدبلوماسي والإنساني إلى انخراط فعلي في صياغة المشهد الميداني والسياسي في قطاع غزة، وسط تحولات إقليمية متسارعة تُعيد رسم موازين القوة بعد عامين من الحرب.
وبينما تُحاول “إسرائيل” احتكار مسار “اليوم التالي” وفرض تسوية تُفكك بنية المقاومة وتُعيد هندسة القطاع سياسيًا وأمنيًا، تجد نفسها أمام عودة تركية قوية مدفوعة بتحالف وثيق مع واشنطن، وصل إلى حدّ التنسيق المباشر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما جعل من أنقرة أحد أبرز مهندسي مرحلة ما بعد الحرب.
هذا التمدد التركي، الذي بدأ من موقع الدعم عن بُعد، وصولًا للوساطة، واتخذ شكلًا أكثر رسوخًا في الأشهر الأخيرة، يثير قلقًا إسرائيليًا متزايدًا، إذ ترى فيه تل أبيب تهديدًا مزدوجًا: فمن جهة، يمنح حركة حماس غطاءً سياسيًا مشروعًا بعد محاولات نزع شرعيتها، ومن جهة أخرى، يُعيد أنقرة إلى قلب النظام الإقليمي كقوة لا يمكن تجاوزها في أي تسوية تتعلّق بغزة أو بملفات المنطقة عمومًا.
حضور أوضح وانخراط أكبر
كشفت الأشهر الأخيرة عن تحوّل نوعي في الانخراط التركي، لم يعد مقتصرًا على الإسناد السياسي أو الإغاثي، بل تعدّاه إلى التماس المباشر مع خطوط التفاوض ومحاولات تثبيت وقف إطلاق النار، بل والمشاركة في هندسة ملامح المرحلة التالية للحرب.
في هذا السياق، لعب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان دورًا نشطًا في المسار التفاوضي، تحديدًا فيما يتعلّق بالتعديلات التي طلبتها المقاومة على “إطار ويتكوف”، وهو الإطار الذي انهار لاحقًا بقرار أمريكي–إسرائيلي، لكنه مثّل أول حضور تركي مؤثّر على طاولة المفاوضات بخصوص قطاع غزة، بعد ممانعة إسرائيلية منذ بداية الحرب.
لاحقًا، ومع لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة ثماني دول عربية وإسلامية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، برزت أنقرة كأحد أهم الأطراف المنخرطة في جهود الوساطة.
فالرئيس رجب طيب أردوغان، الذي جلس على رأس طاولة الاجتماع، بدا واثقًا من إمكانية الوصول إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار، مؤكدًا بعد لقاءٍ ثنائي مع ترامب أنه “تم التفاهم على آليات تحقيق سلام دائم في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية”.
وبحسب مصادر دبلوماسية مطّلعة تحدثت لـ”نون بوست”، فإن قنوات الاتصال التركية مع قيادة حركة حماس بقيت مفتوحة على مدار الساعة لمعالجة أي عقبات قد تحول دون التوصل لاتفاق، فيما أبدى الدبلوماسيون الأتراك حرصًا واضحًا على دفع الحركة للموافقة على المرحلة الأولى من الاتفاق، التي تشمل صفقة تبادل الأسرى، بما يضمن تجاوبًا إيجابيًا من الطرف الأمريكي.
تجلّى الانخراط التركي أكثر خلال محادثات شرم الشيخ، حيث شارك وفد تركي رسمي في النقاشات الفنية الخاصة بالمرحلة الأولى من الاتفاق، في حضور وزراء خارجية مصر وقطر ومبعوثي الولايات المتحدة، ليُعلن رسميًا عن انضمام تركيا إلى فريق الوساطة الدولي.
وبذلك، تحوّل الدور التركي من داعمٍ سياسي إلى شريك مباشر في ترتيبات وقف إطلاق النار، في ترجمة عملية للتصريحات التي أطلقها أردوغان قبل عام، حين أبدى استعداد بلاده لتحمّل مسؤولية أكبر في مسار الحل.

إلا أن هذا الحضور لم يكن موضع ترحيب من جانب الاحتلال الإسرائيلي، فوسائل الإعلام العبرية نقلت امتعاضًا واسعًا من انخراط أنقرة، بالنظر إلى حدة المواقف التركية التي تصاعدت منذ “طوفان الأقصى”، بدءًا من وصف أردوغان لنتنياهو بـ”هتلر العصر”، ومرورًا بقرارات المقاطعة الاقتصادية، وصولًا إلى وقف العلاقات التجارية مع “إسرائيل”.
ومؤخرًا، كشفت بعض التقارير أن أردوغان هدّد بالانسحاب من قمة شرم الشيخ إن شارك نتنياهو فيها، قبل أن تعود طائرته إلى مسارها بعد إعلان الأخير انسحابه بدعوى احترام “عيد العُرش” اليهودي.
الكاتب الإسرائيلي ليئور بن آري لخّص الموقف الإسرائيلي بقوله إن “إسرائيل، منذ هجوم السابع من أكتوبر، حاولت بكل الطرق استبعاد تركيا عن المفاوضات، مفضّلة الاعتماد على مصر وقطر، لكنها فشلت في ذلك”، مضيفًا أن “تركيا أصبحت لاعبًا لا يمكن تجاوزه، بل كانت العامل الحاسم في تمرير اتفاق وقف إطلاق النار بضغطٍ مباشر من أردوغان نفسه”.
عمليًا، تُدرك “إسرائيل” أن الانخراط التركي في ملف غزة لم يعد تفصيلًا سياسيًا، بل تحوّل إلى معطى استراتيجي يُعيد رسم توازنات الإقليم ويُعيد لأنقرة موقعها في قلب القضية الفلسطينية، وهو ما يُفسّر حالة التوجس الإسرائيلية المتصاعدة من الدور التركي، خصوصًا أن أنقرة تتحرك على قاعدة الانفتاح على المقاومة وتثبيت حقها السياسي، لا على قاعدة تفكيكها أو تجريدها من شرعيتها.
العلاقة التركية مع حركة حماس
بالرغم من احتفاظ تركيا بعلاقات متينة مع “إسرائيل”، سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا على امتداد العقود الماضية، وكانت أول دولة إسلامية تعترف رسميًا بها بعد إعلانها في منتصف القرن العشرين، إلا أن هذه العلاقات لم تدم بسمتها الإيجابية التي حكمت سنواتها الأولى.
مع صعود رجب طيب أردوغان إلى الحكم عام 2002، بدأت تلك العلاقة تشهد تصدعات متتالية، تزامنت مع انفتاح تركي متزايد على حركة حماس، التي كانت في تلك الفترة تخطو نحو قمة المشهد السياسي الفلسطيني بقوة عقب فوزها في انتخابات 2006.
وجاءت دعوة أنقرة لرئيس المكتب السياسي للحركة آنذاك خالد مشعل لزيارة تركيا، رغم تصنيف واشنطن والاتحاد الأوروبي للحركة كـ”منظمة إرهابية”، لتُؤشّر إلى تحوّل استراتيجي في الرؤية التركية تجاه المقاومة الفلسطينية، وتكسر حاجز العزلة الدبلوماسية التي حاولت “إسرائيل” فرضها على حماس.
تفاقم التوتر بين أنقرة وتل أبيب بعد حادثة دافوس عام 2009، حين انسحب أردوغان غاضبًا من المنتدى الاقتصادي العالمي عقب سجالٍ حادّ مع الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز بسبب العدوان على غزة، معلنًا أنه “لن يعود إلى دافوس أبدًا”، وهو وعد التزم به حتى اليوم.
بعد عامٍ واحد فقط، كانت سفينة مافي مرمرة عنوانًا للمواجهة الكبرى، فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية السفينة التركية التي كانت في طريقها إلى غزة لكسر الحصار، وقتلت عشرة متضامنين أتراك في المياه الدولية. وقد مثّل الحدث نقطة الانهيار في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ورسّخ في الوعي التركي أن القضية الفلسطينية لم تعد قضية تضامن، بل قضية كرامة وطنية.
منذ ذلك الحين، لم تتوقف “إسرائيل” عن إبداء امتعاضها من المساحة السياسية الواسعة التي منحتها أنقرة لحركة حماس. فقد أصدر جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” عام 2018 تقريرًا اتّهم فيه تركيا بتسهيل عمل كيانات اقتصادية يُزعم أنها تقدّم مساعدات مالية ولوجستية لحماس، وتتيح لقادتها حضور معارض أسلحة داخل تركيا. كما اتّهم الشاباك الحركة بإدارة عمليات غسيل أموال في إسطنبول، بتسهيلات تركية ضمنية، وبأنها تُسيّر جزءًا من أنشطتها الأمنية من هناك.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، عاد جهاز الشين بيت لاتهام أنقرة صراحة، زاعمًا أن الهجوم الذي نفّذه فدائي فلسطيني في تل أبيب في أغسطس من العام نفسه تم التخطيط له تحت إشراف “مقر حماس في تركيا”، في محاولة جديدة لتصوير العلاقة التركية مع الحركة كتهديد مباشر للأمن الإسرائيلي.
ورغم هذه الحملات، حافظت تركيا على موقف ثابت تجاه حماس، حتى بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبعه من حملة دولية غير مسبوقة لتشويه الحركة وشيطنتها، إذ رفض أردوغان بشدة وصفها بالإرهاب، مؤكدًا أنها “حركة تحرر وطني” تشبه نضال الأتراك من أجل الاستقلال عقب انهيار الدولة العثمانية، وقال بوضوح: “من الخطأ إلقاء اللوم على حماس وحدها؛ لا يمكن تجاهل أفعال نتنياهو”.
كما التقى بعدة قيادات من الحركة في إسطنبول، بينهم إسماعيل هنية، الذي اغتيل لاحقًا في طهران في يوليو/تموز 2024، في لقاءٍ اعتبرته “إسرائيل” تحديًا رمزيًا لكسر الحصار السياسي المفروض على الحركة.
تصريحات أردوغان المتكرّرة على المنابر الدولية، وآخرها حديثه لقناة فوكس نيوز، عبّرت عن موقف تركي صلب في مواجهة الرواية الإسرائيلية، حين وصف ما يجري في غزة بأنه “إبادة مكتملة الأركان”، محمّلًا نتنياهو شخصيًا المسؤولية عنها، ومعلنًا أن تركيا نقلت آلاف الجرحى من غزة لتلقي العلاج داخل أراضيها.
هذه المواقف الصريحة، المقترنة بالاحتضان السياسي لقيادة حماس، جعلت من أنقرة إحدى العواصم القليلة التي لم تنكسر أمام موجة الضغوط الدولية، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديدًا سياسيًا لاستراتيجيتها في شيطنة ومحاصرة المقاومة الفلسطينية.
تحالف الزعيمين الذي يقلق تل أبيب
من بين أكثر ما يثير الارتباك داخل تل أبيب في المرحلة الراهنة، هو حجم التقارب الشخصي والسياسي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وتأثير هذا التقارب المباشر على مسار الحرب في غزة ومستقبل الدور التركي في الإقليم.
فبالنسبة لـ”إسرائيل”، لم يعد الأمر مرتبطًا فقط بالعلاقة المتوترة تاريخيًا مع أنقرة، بل بات يتجاوز ذلك إلى خشية حقيقية من أن تتحوّل العلاقة الخاصة بين الزعيمين إلى قناة نفوذ جديدة تُعيد رسم أولويات واشنطن في الشرق الأوسط، على حساب المصالح الإسرائيلية.
وبحسب تقرير نشره موقع “واينت” العبري، فإن الرئيس الأمريكي هو من بادر إلى إشراك أنقرة في المفاوضات التي أفضت إلى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بل واعتبرها طرفًا مركزيًا مارس ضغوطًا حاسمة لإنجاح الاتفاق.
وقد ظهر ذلك جليًا خلال قمة شرم الشيخ، حين جلس أردوغان إلى جانب ترامب، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتوقيع الاتفاق، في مشهدٍ رأت فيه وسائل الإعلام العبرية ترسيمًا علنيًا لدور تركي جديد في غزة.
ولم يتوقف ذلك عند الجانب السياسي، إذ أعلنت أنقرة استعدادها للمشاركة في قوة المهام الدولية المكلّفة بالمساعدة في العثور على جثث الأسرى الإسرائيليين، حيث أكّد مسؤول تركي رفيع لوكالة “فرانس برس” أن فريقًا مكوّنًا من 81 منقذًا ينتظر الضوء الأخضر من تل أبيب لدخول القطاع.
ويرى متابعون إسرائيليون أن ترامب، الذي يُفضّل إدارة الشرق الأوسط عبر “علاقات الزعماء الأقوياء”، منح أردوغان ما كان يطمح إليه منذ أكثر من عقدٍ، بالعودة الشرعية إلى غزة لاعبًا أساسيًا بعد عزلة ما بعد أزمة “مافي مرمرة” عام 2010.
وفي هذا السياق، تشير الباحثة الإسرائيلية غاليا ليندنشتراوس من معهد دراسات الأمن القومي إلى أن أنقرة تنظر إلى تدخلها في غزة بوصفه “فرصة تاريخية لاستعادة مكانتها الإقليمية بعد سنواتٍ من العزلة”، وأنها تسعى من خلاله إلى استعادة مكانها الطبيعي في القضايا العربية الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي استثمرت فيها سياسيًا ودبلوماسيًا على مدار عقدين.
أما الباحث رامي دانيال، فاعتبر دخول تركيا على خط التفاوض “تحوّلًا حاسمًا”، مشيرًا إلى أن أنقرة، رغم غيابها عن مرحلة الوساطة الأولى، أصرّت على أن تكون طرفًا مقرّرًا في النهاية، ونجحت في ذلك بفضل علاقات أردوغان المتينة مع ترامب.
ويُضيف دانيال أن “أنقرة ضخّت خلال السنوات الماضية كمياتٍ كبيرة من المساعدات إلى غزة، وراهنت على خطاب أردوغان المناهض لإسرائيل لقيادة محورٍ داعم للفلسطينيين، لكنها لم تنجح بتحويل هذا الحضور إلى نفوذٍ فعلي إلا في هذه اللحظة، حين فتحت خطة ترامب الباب أمامها لتثبيت دورٍ سياسي واضح داخل القطاع”.
ويرى أن الرئيس التركي “وجد في الخطة فرصة ذهبية لإعادة تموضعه الإقليمي”، في وقتٍ تدفع فيه إسرائيل ثمن هذا التغيير في قواعد اللعبة، لأن أردوغان، برغم التقارب مع واشنطن، لم يُبدّل موقفه من حماس، بل يسعى لتثبيت شرعيتها السياسية، وهو ما يجعل المضي في المرحلة الثانية من الاتفاق أكثر تعقيدًا بالنسبة لتل أبيب.
هذا التقارب بين الزعيمين لم يقتصر على الملف الفلسطيني فحسب، فمنذ تجربة التعاون في سوريا، وصولًا إلى مؤتمرات القمم الأخيرة، حرص ترامب على الإشادة المتكرّرة بنفوذ أردوغان الإقليمي، مؤكدًا خلال مؤتمرٍ صحفي مشترك معه أن “أردوغان يتمتع بنفوذٍ واسع في الشرق الأوسط، وأن التعاون معه سيكون محوريًا لتحقيق الاستقرار”، مضيفًا: “سنعمل معًا لإيجاد حلولٍ مستدامة لتحقيق السلام”.
صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بدورها حذّرت صراحة من “تنامي الحضور التركي في شرايين البيت الأبيض”، معتبرة أن ما يجري “ينذر بتآكل النفوذ الإسرائيلي داخل الإدارة الأمريكية”.
وقالت الصحيفة إنّ “ترامب سمح لتركيا بالانضمام إلى نادي وسطاء وقف إطلاق النار، لكنّ حكومة أنقرة تستغل هذا الهامش لاختراق إسرائيل من حديقتها الخلفية الإقليمية”، مشيرة إلى أن الصورة التي جمعت ترامب وأردوغان في نيويورك، خلال اجتماع حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، “تلخّص المشهد الجديد”، حيث جلس الزعيمان جنبًا إلى جنب، في مقابل الجميع.
ووفق الصحيفة، فإنّ طموحات تركيا في غزة لا تتوقف عند الجانب السياسي، بل تشمل أيضًا البُعد الجيوستراتيجي، إذ تسعى أنقرة إلى الحصول على موطئ قدم في الميناء البحري ضمن رؤيتها للسيطرة على شرق المتوسط ومحاصرة قبرص واليونان.
وترى الصحيفة أن هذا التموضع التركي في جنوب إسرائيل لا يختلف كثيرًا عن وجودها في الشمال السوري، ما يعني أن إسرائيل باتت محاطة فعليًا بنفوذٍ تركي مزدوج الجبهات.
إلى جانب ذلك، تشير تحليلات إسرائيلية إلى أن الخشية الكبرى تكمن في فقدان تل أبيب احتكارها لقناة التأثير على الرئيس الأمريكي. فانخراط تركيا الواسع في غزة سيجعل من أنقرة مصدرًا مهمًا لتغذية ترامب بالمعلومات والتقديرات حول الملف الفلسطيني، وهو ما قد ينعكس في نهاية المطاف على مواقف أمريكية أكثر توازنًا، أو حتى متعارضة مع الرؤية الإسرائيلية لمستقبل غزة، ولمعادلة الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي ككل.
تغيّر المعادلة الإقليمية عكس الرغبة الإسرائيلية
رغم اعتقاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن موجة الحروب المتلاحقة في الإقليم، من غزة إلى لبنان واليمن وإيران، قد أعادت هندسة الشرق الأوسط بما يضمن تفوّق إسرائيل وهيمنتها على المعادلات السياسية والأمنية في المنطقة، فإن الواقع بدأ يتشكّل في اتجاهٍ مغاير تمامًا.
ففي مقابل الانكشاف الإسرائيلي المتزايد، برزت قوى إقليمية جديدة تُعيد التموضع وتفرض حضورها في الملفات الحساسة، وعلى رأسها تركيا، التي لم تعد مجرد وسيطٍ عابر أو لاعب هامشي، بل طرفٌ فاعل في صياغة ملامح النظام الإقليمي الجديد.
هذا التوصيف عبّر عنه عوديد عيلام، الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في الموساد، حين قال إن “تركيا لم تعد وسيطًا مؤقتًا، بل أصبحت لاعبًا رئيسيًا وأحد مهندسي النظام الجديد”.
وبينما ينظر كثير من المحللين الإسرائيليين إلى الدور التركي في غزة كأزمة ظرفية، فإنّ مراكز التفكير الإسرائيلية الكبرى تُحذّر من أن الأمر أعمق بكثير، ويتصل بإعادة توزيع موازين القوة في المنطقة، وتراجع القدرة الإسرائيلية على التحكم في شكل التفاعلات الإقليمية.
القلق الإسرائيلي لم يعد محصورًا بغزة. فبحسب الباحثة ليندنشتراوس، فإن تركيا، التي كانت تركز في السابق على شمال سوريا، أصبحت تنظر إلى المشهد الإقليمي بعينٍ أوسع، وتتعامل مع إسرائيل كعقبةٍ محتملة أمام تمدّد نفوذها، سواء في سوريا أو في شرق المتوسط أو في غزة.
ويرى مراقبون إسرائيليون أن الحكومة التركية تستخدم ملف غزة لترميم صورتها في الشارعين العربي والإسلامي، ولتعزيز موقعها كقوةٍ إقليمية متوازنة قادرة على الجمع بين العلاقة مع واشنطن والدفاع عن القضايا العربية المركزية.
وفي المقابل، ترى إسرائيل أن هذه السياسة تحمل وجهين: وجهٌ يُقدّم تركيا كشريكٍ للولايات المتحدة في جهود “السلام”، ووجهٌ آخر يُبقيها خصمًا سياسيًا صلبًا يهاجم إسرائيل في خطاباته العلنية، ويواصل احتضان حركة حماس سياسيًا وإعلاميًا.
ويعتقد باحثون إسرائيليون أن أنقرة ستسعى إلى تثبيت وجودها في قطاع غزة عبر المشاركة في فرق المراقبة أو في مشاريع إعادة الإعمار، ما سيمنحها نفوذًا طويل الأمد داخل القطاع لا يمكن لإسرائيل القبول به بسهولة.
الرئيس التركي أردوغان ردًا على هتاف “خذنا إلى غزة”: “سأذهب أنا إلى قطاع غزة أولًا، ثم أنتم تذهبون بعدي.” pic.twitter.com/n6cR94zzgT
— نون بوست (@NoonPost) October 12, 2025
وحذّرت ليندنشتراوس من أن “أي احتكاك ميداني بين الجيشين التركي والإسرائيلي داخل غزة، مهما كان محدودًا، قد يتحوّل إلى أزمة دبلوماسية واسعة”، في إشارةٍ إلى هشاشة المعادلة الجديدة التي لم تألفها تل أبيب من قبل.
المخاوف الإسرائيلية عبّرت عنها أيضًا نوا لازيمي، الخبيرة في معهد “ميسغاف” للأمن القومي، التي قالت إن “إشراك تركيا في اتفاق غزة يعني الاعتراف بها كقوةٍ سنية مؤثّرة، والإقرار بأنه لا يمكن الوصول إلى ترتيباتٍ إقليمية شاملة، وخصوصًا في القضية الفلسطينية، دون مشاركة أنقرة”.
ويمكن الجزم بأن توسّع الدور التركي في غزة سيخلق معضلةً استراتيجية مزدوجة أمام الاحتلال: فمن جهة، لا تستطيع إسرائيل التصرف تجاه تركيا كما تفعل مع إيران أو حلفائها، لأن أنقرة عضو في حلف الناتو، وحليف رسمي للولايات المتحدة، ممّا يُقيّد خيارات الرد العدائي المباشر.
ومن جهةٍ أخرى، فإن توسّع الدور التركي يفتح الباب أمام تحالفات جديدة تُعيد تعريف خطوط التأثير في المنطقة، وتحدّ من قدرة “إسرائيل” على الانفراد بإدارة الملفات الفلسطينية والإقليمية، إذ تدرك حكومة الاحتلال أن هذا التحوّل لم يكن ليحدث لولا إعادة التموضع التركي في علاقاتها الإقليمية، خاصةً بعد تحسن العلاقات مع القاهرة، واستمرار الشراكة الوثيقة مع قطر.
وقد مكّن هذا الانفتاح أنقرة من الدخول بثقلها إلى ملفات المنطقة، وخصوصًا غزة، كما ساعد في الوقت نفسه على تعزيز الدور المصري الإقليمي الرافض لمشروع التهجير الإسرائيلي، والساعي لتثبيت معادلة “وقف الحرب دون تنازل عن الحقوق الفلسطينية”.
وهكذا، تتشكّل أمام “إسرائيل” معادلة جديدة أكثر تعقيدًا، تُقوّض قدرتها على التحكم بتفاعلات الشرق الأوسط، وتحدّ من طموحات اليمين الصهيوني في فرض هيمنته على المنطقة. فموازين القوى لم تعد تميل باتجاه تل أبيب وحدها، إذ تتحرك أطرافٌ إقليمية فاعلة لخلق مساراتٍ سياسية جديدة يصعب تجاوزها، فيما تُعدّ تركيا اللاعب الأكثر محورية وتأثيرًا في هذه المعادلة الآخذة بالتشكّل.