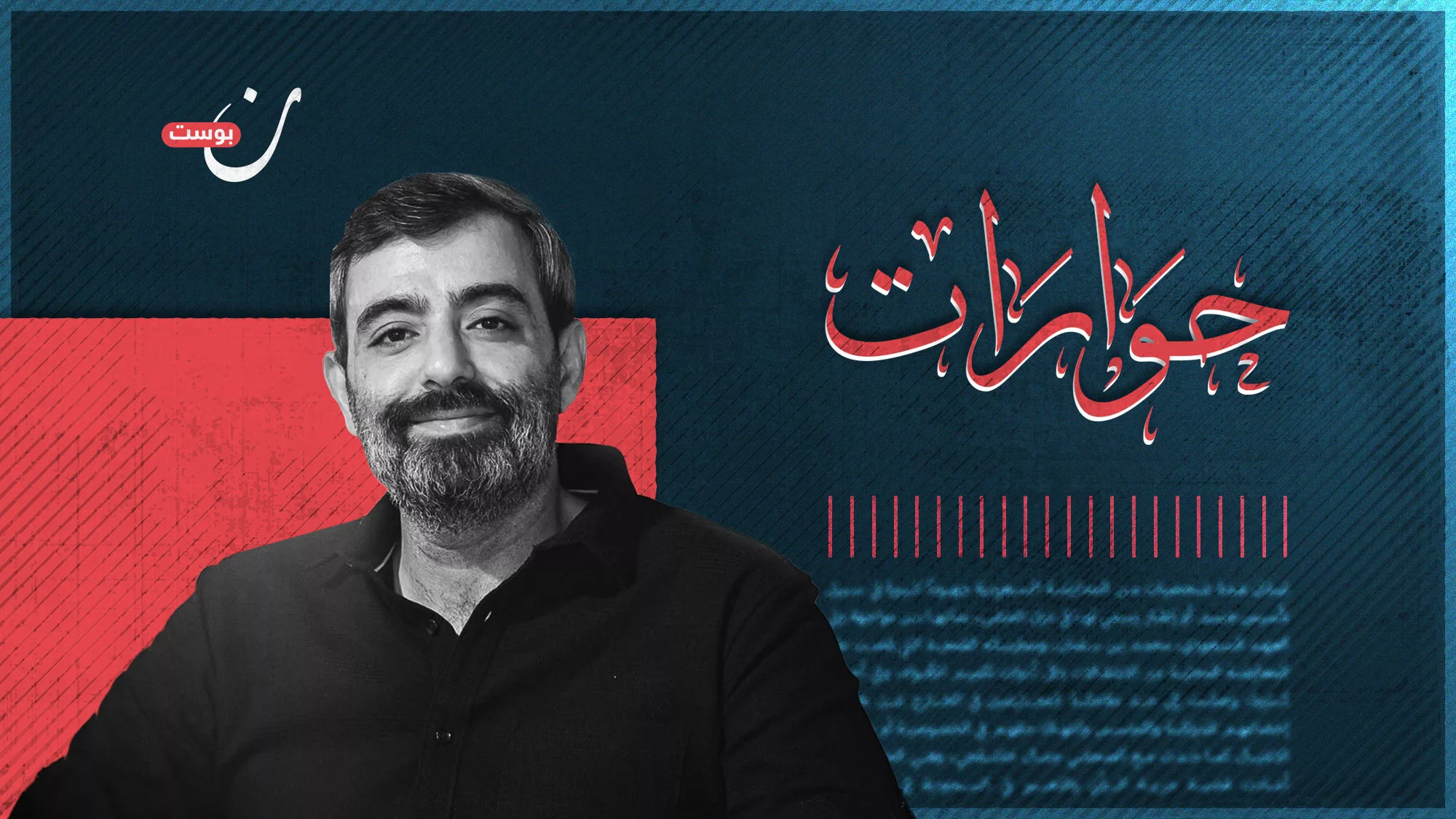يُعدّ حذيفة العرجي واحدًا من أبرز الأصوات الشعرية السورية التي رافقت الثورة منذ شرارتها الأولى حتى فجر النصر. شاعرٌ صاغ في قصيدته تداخُل الذات بالوطن، وجعل من إحساسه امتدادًا لنبض شعب مثخن بالوجع والحنين، فكتب تجربته الشعرية بصدق لا يهادن، فجاء شعره مرآةً للثورة بدمها وأحلامها، وبحثها المستمر عن معنى الكرامة والحرية. قصيدته لا تكتفي بالتأمل، بل تمضي إلى الفعل، تُقاوم بالبيان كما يُقاوم بالسلاح، وتجعل من اللغة جسرًا بين الألم والأمل، ثابت لا ينقطع.
في هذا الحوار الخاص مع “نون بوست”، يتحدث العرجي عن علاقته بالشعر الذي اختاره قبل أن يختاره هو، ويروي كيف رافق شعرُه الثورة منذ لحظتها الأولى حتى إعلان النصر، وكيف كتب “قصيدة النصر” كتتويج لمسار طويل حمل فيه الشعر همّ الناس، ووجع المعتقلات، وحنين المنافي. ويتوقف عند تحوّل اللغة السورية بعد الثورة، وعن دور الشعر في إعادة بناء الوعي الجمعي، وقدرته على جمع السوريين تحت راية واحدة.
ما الذي دفعك لاختيار الشعر بالذات وسيلة للتعبير؟ متى شعرت أنه قدرك؟ وهل كانت البدايات تعبيرًا عن ذاتك الشخصية، أم كنت ترى من بين السطور التي تكتبها وخلفها شيئًا من الهمّ الجمعي؟
الشعر هو اللغة الوحيدة التي لم تخن ضعفي.. وما اخترته، لكنه اختارني، فكان له السبق، وعليّ الوفاء.. ولذلك أحببته، وتعلّقتُ به تعلُّق الغريق بقشّةٍ في عرَض البحر، لأنه ساعدني بكلّ ما أُوتيَ من بيان لأن أُنقذ ما تبقّى من كبريائي المطعون.. وعلمت أنّه قدري، حين اكتشفت أنّ ما أقوله منطلقًا به من همّي الذاتيّ.. كان، بشكل أو بآخر، يُلامس معاناة إنسانية مشتركة مع الكثير من الناس. كنت أظنني أكتب عني، لكنني، ودون أن أدري، كنت أكتب عن كل الذين فقدوا أصواتهم، وضلّوا الطريقَ إلى ذواتهم.
تكررت في قصائدك صورة “الجراح” و”الخذلان”، لكنها جاءت دائمًا مترافقة مع البحث عن معنى ونجاة. كيف ترى العلاقة بين الألم والإبداع في شعرك؟
الإبداع عندي ليس احتفاءً بالعتمة، بل تمرُّدٌ عليها.. والحياة كما يراها كلّ عاقل، نَزَقٌ مُستمر، وخُسرٌ ما استُثنيَ منه أحد، إلا من استثناه ربنا سبحانه وتعالى.. ولستُ أعرفُ حافزًا للكتابة مثل الحزن – أعاذنا الله منه، وأستعيذُ منه على ضرورته للمبدع – لشدّة ما لاقيتُ منه. وسبق أن قلت في إحدى قصائدي:
وأقبلُ كلَّ حُزنٍ لا خضوعًا
ولكن بعدَهُ يأتي القصيدُ!
في “ما لم يقله المتنبي” نسمع نبرة المنفى والخذلان:
لا شيءَ إلا أمانينا تُصبّرُنا،
الحمد لله.. لا أهلٌ ولا وطنُ!
كيف استطعت تحويل هذا الألم إلى شعر يملك صوتًا جمعيًّا يعبر عن حالة ملايين السوريين في تلك اللحظة؟
السر في صدق العاطفة، ولستُ إلا رجلًا من قومي، عبرتُ ذلكَ الجسر الذي عبَروا، وشربتُ من الكأس الذي شربوا، فطَعمُ المرّ كان واحدًا.. شَعَر به حينَ تحدّثتُ عنه كلّ من تجرّعه مثلي، هكذا، ليس أكثر.
ما الفارق بين قصيدة تُكتب في دفء الوطن، وأخرى تُولد في برد المنفى؟ وهل ترى أن الغربة نزعت من شعرك بهجته، أم أنها منحت قصيدتك عمقًا لا يُنال إلا بالتيه والحرمان؟
هذا سؤال يؤدّي إلى طُرق الأسئلة التي وردت قبله، فالحزن والتيه والمنافي والوجع بكلّ صوره، تُربةٌ خصبةٌ للإبداع.. وليس ثمة فارق بين القصيدة التي تكتبها وأنت سعيد ومطمئن، والتي تكتبها وأنت ضائع وحزين، إلا لون الحِبر؛ الأولى حِبرُها أزرق، والثانية حِبرُها الدم! الأولى حِبرُها ناشف، والثانية حِبرُها نازف!
عندما منّ الله علينا بالنصر وأُسقِط الطاغية، كتبتَ “قصيدة النصر” وكأنها إعلان رسمي بلسان الشعر. إلى أي مدى ترى أن شعرك كان شهادة حيّة ختمت الثورة كما افتتحتها، وأنه روى الحكاية السورية بكلّ مآسيها وشتات أهلها وتنقّلهم، ثم عاد ليتوّجها بالنصر والعودة إلى الديار بعد أن وطِئنا العداة بأقدامنا؟
باعتراف صادق جدًّا مع نفسي ومع التاريخ، أقول إن الفضل كلّه لله وحده، أولًا وأخيرًا.
ثمّ بعد ذلك، أقول بكلّ اعتزاز أيضًا، إنّ قصائدي كانت تتويجًا لمسار شعري طويل، عايشَ الثورة منذ شرارتها الأولى، ورافقها بيتًا بيتًا، ووجعًا بوجع. لقد كتبتُ “قصيدة النصر” لا كخاتمة، بل كإعلان حيّ يُسجّل لحظةً انتظرناها بدم القلب، ويختم فصل الدم بفصل العودة، ويضع الكلمة الأخيرة في كتاب كنتُ حاضرًا فيه منذ الصفحة الأولى.
شعري لم يكن حياديًّا ولا عابرًا، بل كان شاهدًا ومُقاوِمًا، وكما قلتُ في قصيدتي “السرائر والجهر”:
تاهت عن الحقّ أقلامٌ لها أثرٌ
الحمدُ للهِ أنّي لم يَتُه حِبري
لقد شارك شِعري الناس أوجاعهم، ونقل أنين المعتقلات، وصوت المخيمات، وصمت القبور الجماعية.. كنتُ أكتب القصيدة وكأنني أكتب بيانًا للناس، أُسجّل به الحقيقة كما هي، بعيدًا عن الزيف والمواربة.. وفي كل محطة، كانت القصيدة تسبق الحدث أحيانًا، أو تُوثّقه من عمق روحه، لا من سطحه.. لقد قالت قصائدي ما عجزت عنه البيانات، ووثّقتُ بالبيت الواحد من بعضها ما عجزت عنه المؤتمرات.. كانت قصائدي، بفضل الله، بمثابة بلاغٍ شعبيّ، يترقبه الناس كما يترقّبون النشرات العاجلة.. ثم جاءت “قصيدة النصر” لا لتُغلق الكتاب، بل لتُسدِل الستار على فصل الدم، وتفتح فصل العودة والبناء، وأنا واقفٌ بين السطور، شامخٌ، لله الحمد.
واليوم، حين أُسقِط الطاغية، وارتفعت راية النصر بأيدي الأحرار، عدتُ بالكلمة نفسها التي بدأتُ بها الطريق، لا لأحتفل فقط، بل لأقول إنّ هذا الشعب يستحق الحياة، وإنّ الشعر كان وما زال سلاحنا الموازي، حاملًا ذاكرة هذا الشعب، ومُمهدًا لعودته، ومُتوّجًا كبرياءه.
أمّا “قصيدة النصر”، فليست خاتمة، بل تتويجٌ لمسار شعريّ لم ينفصل لحظةً عن نبض الثورة، ولا عن أنين المعتقلات، وصرخات الثكالى.. بدأت الحكاية بلجوء، ولكن ليس إلى منفى، بل إلى المعنى، هكذا حتى صرتُ مقاتلًا في صفّ الكلمة، وها قد عُدتُ بفضل ربي على صهوة النصر، لا أحمل بندقية، بل بيتًا من الشعر، يتقدّم الصفوف.
لقد كتبتُ الثورة كما عشتُها، وها أنا ذا أكتب النصر، لا لأُغلِق الحكاية، بل لأفتح فصلها الجديد… فصل الوطن العائد من الرماد، ومعه الكلمة التي لم تُهزم.
كيف تقرأ الفرق بين لغة السوري قبل الثورة ولغته بعدها؟ هل تغيّر معجم السوريين وصورة كلماتهم بعد التجربة الدامية؟ إلى أي مدى انعكس هذا التحول على لغتك الشعرية؟
بلا شك، لغة السوري قبل الثورة ليست كما بعدها. ما جرى لم يكن حدثًا عابرًا، بل زلزالًا عميقًا هزّ البنية النفسية والوجدانية للناس، وبالتالي غيّر معجمهم بالكامل. الكلمات التي كانت تبدو بسيطةً وعادية قبل 2011، أصبحت محمّلةً بالدم والمعنى؛ صار للكرامة طَعمُ الدم، وللحرية ظلّ المقبرة، وللوطن صورة الخيمة والحدود والمنافي. تغيّرت اللغة لأن التجربة كانت جارحة، صادمة، وجودية.
هذا الحال انعكس عليّ كشاعر بالضرورة. لم أعد أكتب بالكلمات ذاتها، ولا بالنبرة ذاتها. القصيدة نفسها تغيّرت، فأصبحت القصيدة أكثر توترًا، أكثر صدقًا، وأقلّ تزيينًا. انكسر الشموخ فيها مرّات كثيرة، لينقل انكسار الإنسان، وارتفعت حرارة المفردة لتوازي ما في الداخل من غضب وحزن واحتراق.
أمّا بعد الثورة، فصار الشاعر مُطالَبًا بالصدق إلى الحدّ الذي يُعرّيه! لم يعُد باستطاعته أن يُزيّن شيئًا من المشهد، بل صار مُلزَمًا أن يفضحه، أو أن يُرمّمه بالكلمة التي ما زالت قادرةً على أن تُواسي، أو تُقاوم، أو تبني ما تهدّم.
كيف يمكن للشاعر أن يبقى صوتًا حرًّا، لا مرهونًا بسلطة، ولا ممولًا، ولا محسوبًا على تيار؟
عليه فقط أن ينحاز إلى الحق الذي يعتقده، والحق ليس حكرًا على جهة واحدة، فالسُّلطة ليست مذمومة بالمطلق، والشعب ليس ممدوحًا بالمطلق، لذلك على الشاعر أن يكون واعيًا جدًّا بمآلات الأمور، وما تؤدي إليه الطُّرق، وأن يستقلّ الطريق المستقيم وإن كان طويلًا، على الطُّرق الملتوية وإن كانت مختصرة.
هل يمكن للشعر أن يجمع السوريين تحت راية واحدة؟ كيف يقدر النص أن يتجاوز الاصطفافات السياسية والطائفية ويُعيد صياغة فكرة الوطن الكامل؟ ما هو الخطاب الجمعي اللازم تصديره الآن في ظل ما يحدث؟
نعم، أؤمن أن الشعر قادرٌ على جمع السوريين تحت راية واحدة، لا لأنه فوق السياسة، بل لأنه أعمق منها. الشعر الحقيقي لا يُخاطب المذهب ولا الطائفة، بل يُخاطب الإنسان، ويدخل إلى قلبه من أوسع أبواب الألم المشترك، والحنين المشترك، والكرامة الجريحة التي يعرفها الجميع، مهما اختلفت انتماءاتهم.
النص القادر على تجاوز الاصطفافات هو النص الصادق، الذي لا يستدرّ العاطفة، ولا يُهادن في الحق، بل ينحاز بوضوح إلى فكرة الإنسان والحرية والعدالة.. وحين يرتفع الخطاب الشعري إلى هذا المستوى، يصبح الوطن معنًى جامعًا، لا جغرافيا ممزّقة، ولا رايات متنازعة.
أمّا الخطاب الجمعي الذي نحتاج إلى تصديره الآن، فهو خطاب الالتقاء لا الإلغاء، خطاب يُعيد تعريف “نحن” السورية الجامعة.. والشعر في لحظات كهذه لا يُزيّن المشهد، بل يُعيد صياغته.
تقول إنّ التاريخ يعيد نفسه في كل زمان ومكان. كيف يمكن للشعر أن يكسر هذه الحلقة المفرغة؟ وهل الشاعر محكوم بالتاريخ أم قادرٌ أن يكتب تاريخًا مغايرًا بكلماته؟
الشاعر محكومٌ بتاريخه، ولا يستطيع هو ولا غيره أن يصنع تاريخًا آخر، إنّه قَدر، وليس بوسع الإنسان مواجهة قَدره.. أمّا الشعر، فليس مُلزَمًا بكسر هذه الحلقة المُفرغة، بل عليه التأقلم معها، والانتفاع بها قدر ما يستطيع.