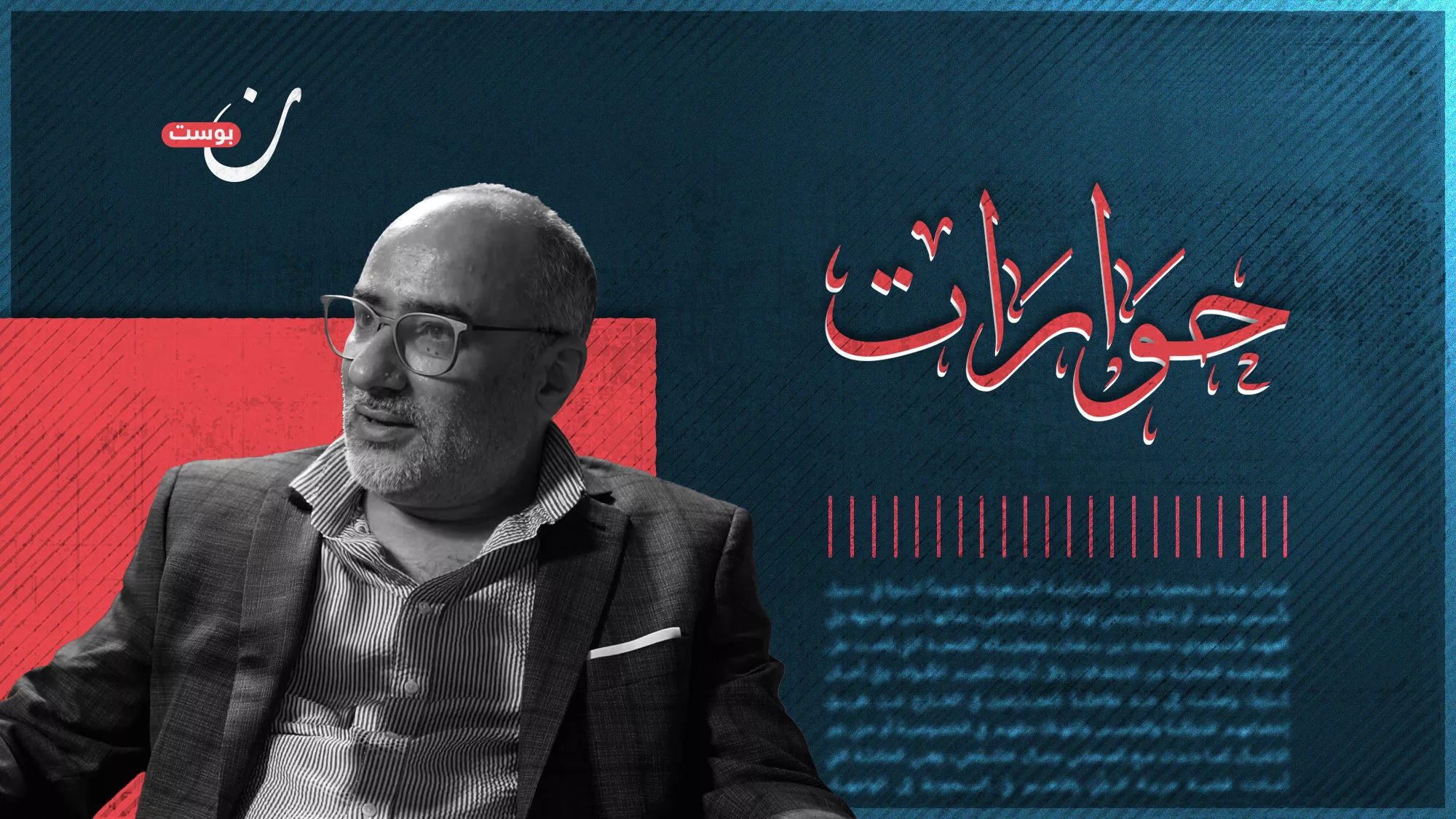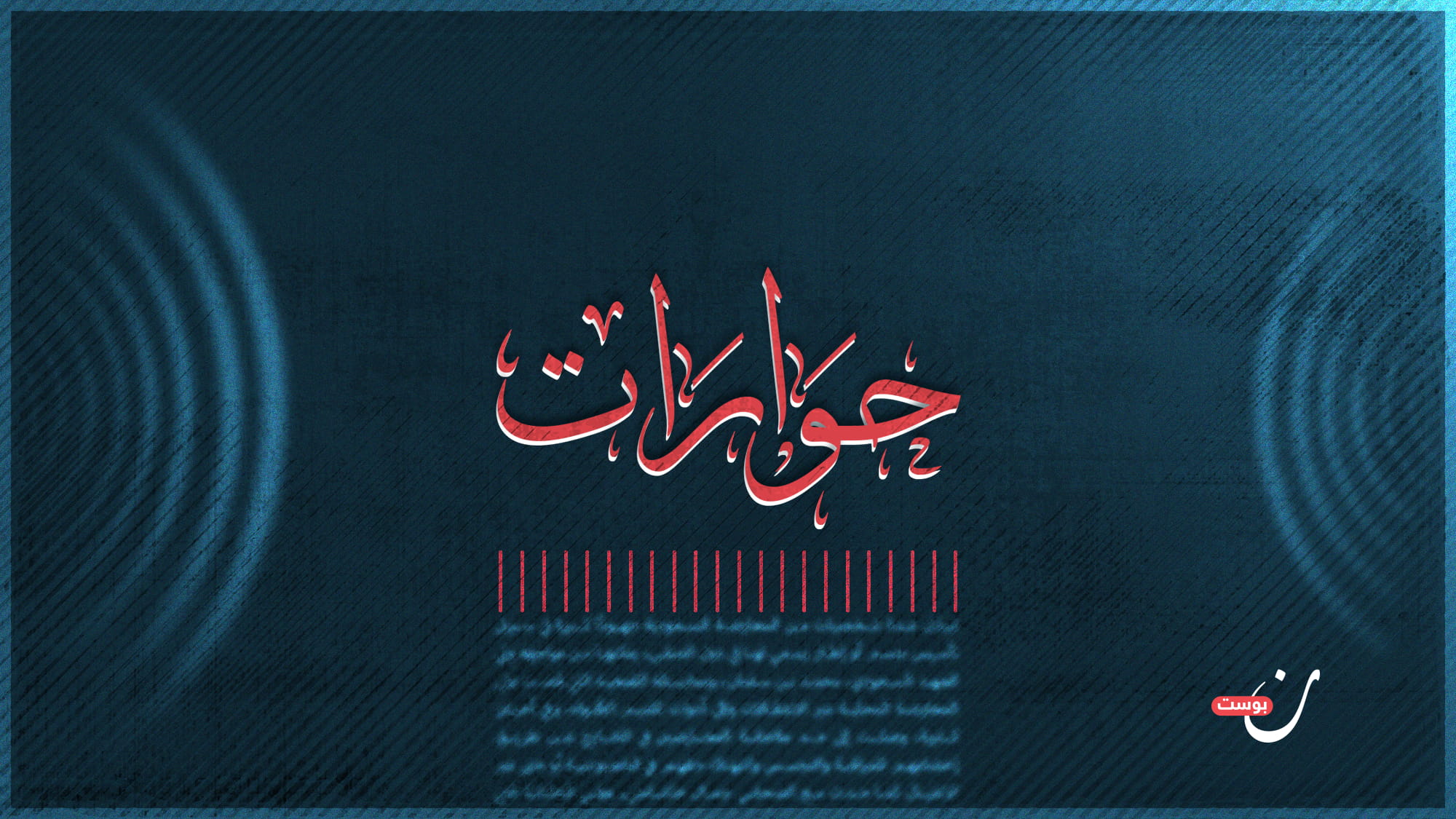في خضمّ الموجة الاحتجاجية التي شهدها المغرب خلال الأسابيع الماضية، والتي انطلقت من فضاءات رقمية افتراضية قبل أن تنتقل إلى الشارع، يجد المراقب نفسه أمام ظاهرة شبابية غير مسبوقة في الشكل والمضمونK فخلف دعوات “جيل زد”، التي بدأت من غرف نقاشٍ في منصة “ديسكورد”، تتقاطع مطالب اجتماعية واقتصادية مع أسئلة سياسية وحقوقية، حيث لم تعُد القضايا مقتصرة على الصحة والتعليم، بل امتدّت إلى ملفات الفساد والريع، وسوء تدبير السياسات العمومية، والتفاوتات المجالية، في ظلّ سياق اقتصادي متأزّم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. ومع اتساع رقعة الغضب الشعبي، برزت تساؤلات حول جدوى المقاربة الأمنية في مواجهة جيلٍ مختلفٍ في وعيه وأدواته.
في حوارٍ خاص مع “نون بوست”، يُقدّم الدكتور خالد البكاري، الأكاديمي والناشط الحقوقي المغربي، قراءةً تحليلية للتجربة الاحتجاجية لـ”جيل زد” في المغرب، متوقفًا عند أسباب اندلاعها، وكيف تم التعامل معها من قِبل السلطات، وعند إمكانية استعادة ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية في البلد، ثم عند العوامل التي أدّت إلى المطالبة بإسقاط حكومة عزيز أخنوش.
كيف تفسّر انطلاق موجة الاحتجاجات التي يشهدها المغرب؟ هل ترى أنها تعبير عن أزمة ظرفية مرتبطة بقطاع الصحة والخدمات أم هي نتيجة تراكم اختلالات اجتماعية واقتصادية أعمق تمتدّ لعقود؟
موجة الاحتجاجات الحالية، التي انطلقت بدعوات من شبابٍ يُقيم غرفَ نقاشٍ في منصة “ديسكورد”، ليست مرتبطةً حصرًا بالاختلالات المُسجَّلة في قطاعي الصحة والتعليم، فتطوّر الخطاب الاحتجاجي لما سُمّي بـ”جيل زد” عرف انتقالًا نحو طرح قضايا الفساد والريع، وسوء تدبير السياسات العمومية، وإشكالية الثقة في المؤسسات. ثم، بعد سلسلة الاعتقالات التي طالت العديد من المحتجين، بدأت قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير كذلك تعاود الظهور.
وبالتالي، يمكن اعتبار رفع مطلبي الصحة والتعليم في البداية كان ذا بُعد “ذرائعي”، لاكتساب شرعية الاحتجاج، ونوع من مقبولية ذلك وسط المجتمع، وهو ما نجحت فيه حركة الاحتجاج الحالية، التي فرضت نفسها حتى على الفاعلين الرسميين والمؤسسيين والحزبيين، وأجبرتهم على الاعتراف بمشروعية هذه الاحتجاجات.
وهي احتجاجات تندرج ضمن سيرورة متواصلة من الاحتجاج السلمي المدني في المغرب، المستمرة منذ أكثر من عقد، وتظهر كل مرة بصيغة جديدة: فمرّة تكون بصبغة مجالية (نموذج حراك الريف، احتجاجات الماء بفجيج، مسيرات العطش بعدة قرى…)، ومرّة بصبغة فئوية (نموذج احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، الطلبة الأطباء، المحامون…)، وهذه المرة بصيغة جيلية شبابية، سواء على مستوى التعبئة أو الحضور الميداني.
وأعتقد أن الأمر يتداخل فيه مُعطيان: الأول محليٌّ خالص، مرتبط بتدهور الخدمات العمومية الأساسية في المغرب (الصحة، التعليم، التشغيل…)، والمرتبطة أساسًا بتفضيل الدولة تفويت هذه الخدمات للقطاع الخاص تدريجيًّا، ومرتبط كذلك بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار المرتبط بالاحتكار والتضخُّم، مع استحضار معطى تكلفة المساهمة في تنظيم كأس العالم 2030، والتي من نتائجها تعميق الفوارق المجالية.
والمُعطى الثاني خارجي، يتجلّى في التأثر بموجة الاحتجاجات المتوالية في الكثير من دول العالم، وخصوصًا في أوروبا وأمريكا، والتي من سماتها المساهمة الشبابية الملحوظة، وطرحها لإشكاليات هيمنة النخب المالية والشركات العابرة للقارات، وتراجع دور الدولة في الخدمات العمومية، دون أن ننسى تأثير مشاهد الاحتجاجات المسانِدة للفلسطينيين، والتي تتحوّل إلى صدامات مع الدولة على المستوى الخطابي، ومع القوات العمومية على المستوى الميداني. وبالتالي، تُصبح تلك المشاهد – بسبب انتقالها السريع على منصات التواصل الاجتماعي – بمثابة عامل تعبئةٍ عابرٍ للثقافات والدول والسياقات.
شهدنا تحوّلًا في ردّ فعل السلطات المغربية في تعاملها مع الاحتجاجات، حيث حاولت منعها في البداية بذريعة أنها غير مرخصة، ثم عادت بعد اندلاع أحداث العنف إلى السماح بها. كيف قرأتَ هذا التحوّل؟
أعتقد أن تفعيل المقاربة الأمنية في الأيام الأولى للاحتجاجات كان الهدف منه مزدوجًا: الأول يتمثل في توقيف عدد كبير من المحتجين، بغاية تكوين بنك معطيات يمكن أن يُساعد في الوصول إلى ما تعتبره السلطات الأمنية والاستخبارية “العقول المدبّرة” لهذه الدينامية. والثاني إحداث نوع من الترهيب يمكن أن يؤدي إلى وأد الاحتجاجات في بداياتها.
وأعتقد أن الدولة وعَت مبكرًا خطأ المبالغة في التدخلات الأمنية العنيفة أثناء الاحتجاجات، لأنها تحوّلت إلى مادةٍ للتعبئة وزيادة التعاطف الشعبي مع المحتجين. ولذلك، سمحت بعد ذلك بتنظيم الوقفات دون الاحتكاك بالمحتجين.
مع ملاحظة أن أحداث العنف التي سُجّلت في الأيام الأولى للاحتجاجات، لم تحدث في الأمكنة التي دعت الحركة الاحتجاجية للتظاهر فيها، بل في مناطق لم يكن مُبرمجًا فيها أي احتجاج، وفي أوقات متأخرة من الليل، مع تسجيل تورط قاصرين وجانحين فيها. والسؤال الذي يُطرح هو: كيف اندلعت تلك الأحداث؟ وكيف توقّفت فجأة؟
مما يجعل المطالبة بفتح تحقيقٍ نزيه وجديّ ومحايد ضرورةً لاستجلاء الحقيقة، خصوصًا مع وجود حالات وفاة. وللأسف، فإن تسريع وتيرة المحاكمات وإصدار الأحكام الابتدائية بسرعةٍ قياسية بخصوص هذه الأحداث لا يُساعد لا في توفير ضمانات المحاكمة العادلة، ولا في استجلاء الحقيقة والوصول إلى خيوط التخطيط والتعبئة والتنفيذ لمثل هذه الأفعال المُدانة.
مع العلم أننا لا ننفي فرضية أن الأوضاع الاجتماعية المقلقة بتلك المناطق قد تكون هي الدافع للانسياق نحو العنف، في ظلّ الانفلات الأمني الذي سُجّل تلك الأيام بسبب انشغال القوات العمومية في تأمين الأماكن التي دعا المتظاهرون لتنظيم وقفات سلمية بها.
هل هذا يعني فشل المقاربة الأمنية في التعامل مع جيل جديد بخصوصيات مختلفة عن الأجيال السابقة؟
المقاربة الأمنية وحدها، هي بطبيعتها، فاشلة في التعامل مع أي ظاهرة كيفما كانت، وليست الاحتجاجات وحدها. لنأخذ مثال الظاهرة الإرهابية، فرغم النجاحات التي حققتها المؤسسة الأمنية المغربية في محاصرة وتفكيك الخلايا الإرهابية – وهي العمليات التي يتم التسويق لها وطنيًا ودوليًا – إلا أن ذلك لم يؤدِّ إلى القضاء على الفكر الإرهابي والمتطرف. والدليل هو استمرار الأجهزة الأمنية نفسها في اكتشاف خلايا جديدة كل سنة. والسبب في ذلك هو ضعف التأطير الديني والثقافي، وفشل المنظومة التعليمية، ورداءة المشهد الإعلامي، واستمرار مظاهر الفقر والإقصاء.
ولذلك، فإن الاكتفاء بالمقاربة الأمنية لن يُفلح في وقف الاحتجاجات، بدليل استمرارها رغم كل مظاهر القمع والمحاكمات غير العادلة. بل إنّ تأثير ذلك على المدى البعيد سيضرّ بمؤسستي الأمن والقضاء، اللتين سيُنظر إليهما كأدوات للتسلط والضبط، وخدمة مصالح المستفيدين من وضعٍ يهيمن عليه الاحتكار والريع والفساد، وتَحكُّم الأقلية الريعية.
وبخصوص الاحتجاجات الحالية، فإن المقاربة الأمنية لم تتراجع، رغم السماح بتنظيم الوقفات، إذ تشتغل بأدوات أخرى، منها: الاعتقالات المستمرة حتى اللحظة، المحاكمات السريعة، وعودة كتائب التضليل الإلكترونية بمحاولة تشويه هذه الدينامية، عبر الإيهام بتدخل جهات خارجية في توجيهها.
وهذا يعني أنه لم يتغيّر أي شيء في استراتيجية مواجهة الديناميات الاحتجاجية، إذ يتم الاعتماد على التدخلات الأمنية المصحوبة باعتقالات، ثم دفع هذه الدينامية إلى الإنهاك والتفكك الذاتي، عبر المراهنة على طول الزمن الاحتجاجي دون نتائج ملموسة، والمفضي للإنهاك، وخلق صدامات داخلية، وتحويل التناقضات الثانوية إلى تناقضات رئيسية، ومحاولة العزل الجماهيري عبر التضليل ونشر الإشاعات، والتي أصبح الذكاء الاصطناعي يساعد كثيرًا في ذلك، في ظلّ أمية رقمية تجعل المتلقين للصور والفيديوهات لا يُميّزون المفبرك من الصحيح، وصولًا إلى الالتفاف على المطالب، عن طريق حزمة وعود لا تتضمن أي ضمانات يمكن الوثوق بها.
منذ الاستقلال، شهد المغرب احتجاجات وانتفاضات عديدة. ما الذي يُميّز احتجاجات هذا الجيل عن سابقيه، من حيث المطالب ومن حيث تعامل السلطات المغربية، خاصةً أن هناك من يرى أن سقف المطالب انخفض مقارنةً بما كان عليه خلال 2011؟
في رأيي، إن المسألة لا تتعلق بالجيل، أكثر مما تتعلق بالسياقات، إذ إن الاحتجاجات السابقة، في أغلبها، كان للشباب الدور المركزي فيها، بما فيها حتى الاحتجاجات التي كانت زمن الاستعمار.
وإذا أردنا الحديث عن التحوّلات، يمكن الحديث عن التحول من الاحتجاج العنيف، الذي استمر إلى حدود بداية التسعينيات (14 دجنبر 1990)، حيث كان مطبوعًا بالاصطدام العنيف مع القوات العمومية (نموذج احتجاجات 1981 و1984)، إلى الاحتجاج السلمي المدني، الذي انطلق بالخصوص مع حركة المعطّلين حاملي الشهادات الجامعية منتصف التسعينيات، واستمر مع احتجاجات حركة 20 فبراير 2011، وحراك الريف 2016/2017، ولازمَ مجمل الاحتجاجات الفئوية والنقابية والمجالية (جرادة، أيت بوكماز، أمانديس بطنجة…)، وكذا مسيرات التضامن مع الشعب الفلسطيني.
غير أن هذا لا يعني نهاية الاحتجاج العنيف، إذ يمكن أن نشهد عودةً له، بتضافر عاملَي تعميق الفوارق الطبقية والمجالية – ما يعني انتقال الاحتجاج من الطبقة المتوسطة أساسًا إلى المحرومين والمقصيّين والمهمّشين – خصوصًا أمام تراجع إمكانيات وصولهم إلى الحدّ الأدنى من العيش الكريم، بفعل تحوّلات في تدبير المجال الحضري، أساسًا اقتصاديًا وعقاريًا.
وكذلك عامل عودة الاحتجاج العنيف عالميًّا؛ فلا يجب أن ننسى أن التركيز على مصطلح “السلمية” في الاحتجاجات، كان متأثرًا بسياقٍ كونيٍّ مرتبط بموجة الاحتجاجات التي رافقت انهيار دول المعسكر الشرقي في أوروبا.
التحول الثاني في الاحتجاجات مرتبط بالسياق الرقمي، إذ أصبحت وسائط التواصل الاجتماعي أدوات فاعلة في التعبئة، والتحريض، والتوثيق، والنقاش العمومي. فيما التحوّل الثالث مرتبط بتصاعد الحركات الاجتماعية الجديدة، البعيدة عن التأطير النقابي والحزبي. وهذا التحوّل الأخير – وإن كان يسمح للاحتجاجات بالوصول إلى فئات مختلفة، وبالانفلات من محاولات الضبط المؤسّساتي الحزبي والنقابي – إلا أنه يحدّ من إمكانياتها التفاوضية، وبالتالي يسهل على الحكومات والسلطات الالتفاف على مطالبها. وهذا يطرح إشكال التوفر على تعبيرٍ سياسيّ يُمكّن من ترصيد الحركة الاحتجاجية وتحصين مكتسباتها.
كيف تُقيّم الطابع اللامركزي والرّقمي لهذه الاحتجاجات؟ هل يُمثّل هذا الشكل من التنظيم بدايةً لنموذج احتجاجي جديد في المغرب؟
ليست هذه أول مرة تكون فيها الاحتجاجات في المغرب لا مركزية، فقد عشنا ذلك في احتجاجات حركة 20 فبراير، واحتجاجات حركة المعطّلين حاملي الشهادات الجامعية، بل حتى احتجاجات 1984 كانت لها امتدادات في مدن تتوزع بين الشمال والوسط والجنوب. لكن هذا لا ينفي أننا أمام نموذج جديد للفعل الاحتجاجي، غير أنه نموذج يعيش التحوّل في ظلّ الاستمرارية، وليس قطيعةً نهائية. وبالتالي، أُفضّل الحديث عن “تطوّر من داخل النسق الاحتجاجي” فرضه تغيّر السياق، بدلًا من الحديث عن قطيعة.
وهو تطوّر في آليات التشبيك التي أصبحت رقمية، وفي آليات اتخاذ القرار والمصادقة عليه، والتي أصبحت تتسم بالسرعة والحسم، وفي آليات التعبئة الرقمية أساسًا. فإذا كنا قبل احتجاجات 20 فبراير بإزاء براديغم ميداني أساسًا (المقرات والشارع)، فمع 20 فبراير انتقلنا إلى براديغم ميداني (جموع عامة لاتخاذ القرار)–افتراضي (للتعبئة)–ثم العودة للميداني (الاحتجاج في الشارع)، فإننا اليوم مع براديغمٍ معكوس: افتراضي لاتخاذ القرار، ثم ميداني للاحتجاج، ثم العودة إلى الافتراضي من أجل التقييم.
وقد يكون هذا مقدّمةً إلى زمن عالمي قادم، بحيث يُصبح كل الاحتجاج رقميًا، وليس فقط التعبئة واتخاذ القرار، بل قد يتحوّل مثلًا العصيان المدني من الاعتصام في المؤسسات والامتناع عن العمل، إلى تعطيلها رقميًّا.
يرى البعض في لجوء الشباب إلى الشارع فشلًا لمؤسسات الوساطة، خاصةً الأحزاب والنقابات. برأيك، ما الشروط الضرورية لاستعادة الثقة بين الشباب والأحزاب السياسية؟
سأكون مختصرًا، لم أعُد أرى أي إمكانية لاستعادة ثقة المواطنين، وليس الشباب فقط، في الأحزاب القائمة، رغم وجود أحزاب قليلة مبدئية تحاول الاشتغال مع الجماهير، وتنحاز لنفس مصفوفة المطالب موضوع الاحتجاجات، لكنها تعيش أزمات التشرذم، والنزيف التنظيمي، وقلّة الإمكانيات اللوجيستية، وتحكُّم قيادات لم تخرج بعد من آليات في التفكير والتحليل والتحرك لم تعُد قادرة على مسايرة التحوّلات القيمية والثقافية السائدة، بفعل التحولات الرقمية.
لكن هذا لا يجب أن يكون عامل اطمئنان، لا للدولة، ولا للمعارضات المختلفة، إذ لا يمكن تصوّر ديمقراطية – على الأقل في الشروط الحالية – دون أحزاب قوية، ودون سُلطٍ مضادّة مؤسساتية.
وأعتقد أن سيرورة تطوّر الفعل الاحتجاجي، ونمو الحركات الاجتماعية الجديدة، سواء ذات النفس الاجتماعي أو الهويّاتي أو الجيلي أو غيره، قد يُفضي إلى طرح سؤال “الحامل السياسي”، مما قد يُسهم في ظهور تعبيرات سياسية جديدة، قد تُفضي بدورها إلى تأسيس تنظيمات حزبية ونقابية مغايرة للسائد.
وهذا أمر حصل في الماضي مع حركات اليسار الجديد، التي كانت نتاج تآكُل الوسائط الكلاسيكية للحركات الاشتراكية التقليدية، وحصل اليوم في تجارب بالبرازيل، وبوليفيا، وإسبانيا، وفرنسا، وجنوب أفريقيا، من تحوُّل تعبيرات لحركات اجتماعية إلى تعبيرات سياسية مهيكلة.
عبّر هذا الجيل عن رفضه القاطع للحوار مع الحكومة، وطالب بإسقاطها، هل يمكن اعتبار ذلك نتيجة حتمية لشبهات الفساد وتضارب المصالح التي لاحقتها منذ بدايتها؟
رفض الحوار مع الحكومة فيه عاملان برأيي: الأول أن هذه الحكومة تجسيد عملي لزواج المال والسلطة، وبالتالي فهي أكثر حكومة دفاعًا عن مصالح الأوليغارشيات الريعية، وأكثر حكومة تقف خلفها أغلبية برلمانية تضم العديد من المتابعين والمدانين في قضايا نهب المال العام، والفساد الانتخابي، والتهرب الضريبي، والتهريب الدولي للمخدرات وغيرها.
والثاني مرتبط بالاقتناع أن مركز السلطة الحقيقي هو بيد المؤسسة الملكية، وبالتالي يجب مخاطبة الملك أساسًا، وانتظار تدخّله لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
قلتَ في إحدى لقاءاتك الإعلامية إن أخنوش هو الأضعف بين رؤساء الحكومات الذين عاصرتَهم في المغرب، أين يتجلّى هذا الضعف من وجهة نظرك؟
تحدثت عن ضعفه التواصلي والكاريزماتي، ففي كل خرجاته والمعدة مسبقًا، يظهر بوضوح ضعفه التواصلي وتواضعه من حيث المعرفة السياسية، وبالتالي قد يكون رجل أعمال ناجحًا، لكنه فاشل سياسيًا، وفشله بنيوي، إذ لا يمتلك تجربة في العمل السياسي القاعدي. وحتى الفريق الذي يشتغل معه على هذا الجانب (نظير الناطق الرسمي باسم الحكومة) بدوره ضعيف مقارنة مع الذين اشتغلوا مع رؤساء حكومات أو وزراء أولين سابقين.
لكن هذا لا ينفي نجاحه على مستويين: الأول، تحويله لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى مقاولة سياسية تابعة له، يقودها حاليًا في الأغلب من يشتغلون معه في المجلس الإداري للهولدينغ المالي الذي يقوده. والثاني، قدرته على أن يصبح الممثل للباطرونا المالية والريعية بالمغرب، إذ كلها تقريبًا ملتفة حوله، ومراهنة على استمراره رئيسًا للحكومة لولاية ثانية، وهذا يوفر له قاعدة مالية صلبة.
أعلن المجلس الوزاري المنعقد الأسبوع الماضي، برئاسة الملك محمد السادس، عن رفع ميزانية الصحة والتعليم إلى أزيد من 140 مليار درهم في 2026. برأيك، هل هذا الإجراء كافٍ لإصلاح هذين القطاعين؟
هو غير كافٍ، وحتى الحكومة لا أعتقد أنها تقول بأنه كافٍ، فقد قال وزير التربية الوطنية إن رفع الميزانية من حوالي 85 مليار درهم إلى حوالي 97 مليار درهم لن يمكن من حل كل المشاكل المرتبطة بالقطاع، بما فيها قضايا ما زالت مطروحة على طاولة الحوار القطاعي مع النقابات.
ولكن دعنا نكن صريحين، فالقول برفع الميزانية في قطاعَي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم مجتمعين، هو يشبه ما تقوم به بعض الشركات حين تتحدث عن تخفيضات في الأسعار، ليكتشف الزبناء بعد ذلك أن تلك التخفيضات تتضمن نوعًا من التضليل.
إذ الحقيقة أن الرفع لم يتجاوز 20 مليار درهم في القطاعين معًا مقارنة بالسنة الماضية، وستلتهم كتلة الأجور جزءًا كبيرًا من هذه الميزانية بسبب الزيادة في الأجور التي عرفتها السنتان الأخيرتان، وتوظيف حوالي 27 ألف موظف جديد. كما أن عددًا من المشاريع التي تم الحديث على أنها ستموّل من ميزانية 2026 هي أصلًا مرحلة من المشاريع المموّلة بميزانية 2025 أو قبل، من مثل بعض المراكز الاستشفائية الجامعية.
كما أن الرصيد المرصود للرعاية الاجتماعية ضمن “أمو تضامن”، والذي يفوق 10 مليارات درهم، يذهب إلى المصحات الخاصة، وكان من الأجدى الإبقاء على نظام راميد الذي لم يكن يكلف سوى 2 مليار درهم في أحسن الحالات، وتوجيه الباقي إلى الاستثمار في بناء وإصلاح المستشفيات والتوظيف، نظرًا للخصاص الكبير في الأطباء، خصوصًا في التخصصات التي تتوقف عليها العمليات الجراحية: التخدير، الإنعاش…
فقط أود أن أشير إلى مسألة التوظيف في قطاع التعليم، إذ يتم الحديث عن انتقال من حوالي 15 ألف منصب إلى 19 ألف منصب، والحقيقة أن هذا الرقم هو فقط عودة إلى ما كان عليه قبل 3 سنوات فقط، حيث كانت المناصب تتعدى 22 ألف منصب بحسبان الأساتذة المتعاقدين حينها، مع العلم أننا مقبلون على موجة من التقاعد في قطاع التعليم ستصل إلى حوالي 30 ألف موظف بحلول سنة 2028، أي بمعدل 10 آلاف متقاعد في السنة.