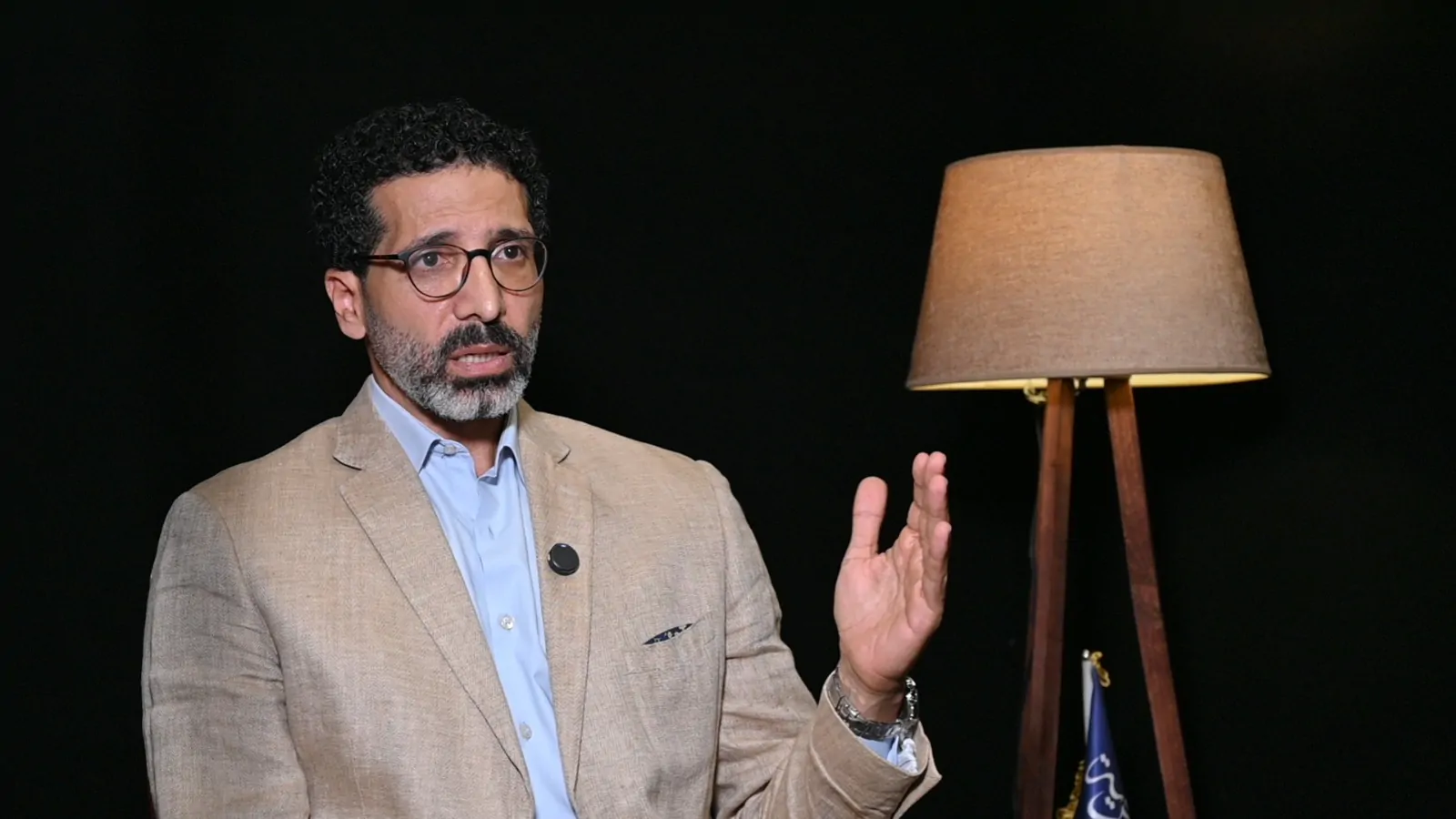أثار استبعاد البرلماني الأسبق هيثم الحريري من الترشح لانتخابات مجلس النواب المصري، المقررة في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وفي الداخل يومي 10 و11 من الشهر ذاته، حالة واسعة من الجدل داخل الشارع المصري، وسط مخاوف من انعكاسات هذا القرار على المشهد السياسي الداخلي واتجاهاته المستقبلية.
وجاء القرار بعد أن أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برفض الطعن الذي تقدم به الحريري على قرار استبعاده، على خلفية استثنائه من أداء الخدمة العسكرية، وقد وصف الحريري هذا القرار بأنه يمثل “اغتيالاً سياسياً” له ولأسرته، معتبرًا أنه يستهدف إقصاءه من الحياة العامة بشكل متعمد.
ورغم تأكيد المحامي خالد علي سلامة الموقف القانوني للحريري، موضحًا أن الأخير وضع نفسه تحت تصرف القوات المسلحة وأن استثناءه من الخدمة لم يكن بإرادته بل بقرار رسمي من الجهات المختصة، ما يجعله قانونًا في حكم من أُعفي من التجنيد، وبالتالي لا يجوز حرمانه من حق الترشح، فإن الإدارية العليا رفضت تلك الدفوع كافة، وأصرت على تأييد قرار استبعاده.
وأشار علي إلى أن استبعاد مرشح صدر بشأنه قرار رسمي بالإعفاء يعد “افتئاتًا على سلطة المشرّع” ويتنافى مع روح العدالة الدستورية، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذه الأسانيد.
لم يكن الحريري الحالة الوحيدة في هذا السياق، فالمشهد السياسي المصري يشهد موجة جديدة من الإقصاء والتضييق على المعارضة، في ظل مناخ يكرّس لما يمكن وصفه بـ”استراتيجية الصوت الواحد”، ويُنظر إلى ما يجري على أنه امتداد لنهج السيطرة المطلقة على المجال العام، لا يقتصر على الإعلام فقط، بل يمتد إلى البرلمان والحياة السياسية برمتها.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الأجواء تُعيد إلى الأذهان ملامح عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي عبّر الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة عن إعجابه بتجربته الإعلامية، في وقت يبدو فيه أن الدولة تسعى إلى استنساخ تلك التجربة على المستويين السياسي والإعلامي معًا.
ازدواجية مُريبة
عند التوقف أمام قضية استبعاد هيثم الحريري من الترشح للانتخابات البرلمانية، تبرز مفارقات وازدواجية تثير الكثير من التساؤلات، فالمحكمة برّرت قرارها باستثنائه من أداء الخدمة العسكرية، رغم أن هذا الإجراء لم يكن بإرادته أو نتيجة تهرب منه، بل جاء بقرار رسمي صادر عن وزير الدفاع.
فوفقًا لما هو موثق، تقدم الحريري بنفسه إلى منطقة التجنيد بالإسكندرية بعد تخرجه مباشرة لاستكمال إجراءات خدمته الإلزامية، لكنه فوجئ باستثنائه من التجنيد، دون أن يكون له أي دور في ذلك القرار.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الاستثناءات غالبًا ما ترتبط باعتبارات سياسية أكثر منها قانونية، خصوصًا حين يتعلق الأمر بشخصيات تنتمي إلى تيارات معارضة أو ذات خلفيات سياسية لا تنسجم مع توجهات السلطة. وفي حالة الحريري، يُعتقد أن الاعتبار السياسي لعب دورًا واضحًا، لاسيما أن والده، المعارض الراحل أبو العز الحريري، كان من أبرز الأصوات اليسارية المعارضة في الحياة النيابية، وهو ما قد يكون قد انعكس على موقف الجهات المعنية من نجله.
من الناحية القانونية، لا يُعد الاستثناء من الخدمة العسكرية تهربًا، ولا يترتب عليه إسقاط الحق في الترشح أو تولي المناصب العامة، فهذه قاعدة مستقرة في القانون المصري منذ عقود، وقد شُهدت حالات مشابهة لمرشحين من تيارات سياسية ودينية متنوعة تمكنوا من خوض الانتخابات والفوز بمقاعد برلمانية رغم إعفائهم أو استثنائهم من الخدمة.
ويُضاف إلى ذلك أن الحريري نفسه خاض انتخابات 2015 ونجح في دخول البرلمان بالمستندات ذاتها التي يقدمها اليوم، كما تم قبول ترشحه في انتخابات 2020 دون أي اعتراض قانوني، وإن لم يوفق في الفوز، من هنا، فإن رفض ترشحه اليوم بالاستناد إلى مبررات كانت مقبولة في السابق يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول خلفيات القرار وأبعاده السياسية.
فالازدواجية في تطبيق المعايير، وتغير تفسير القانون من دورة انتخابية إلى أخرى، يثيران الشكوك حول مدى حياد العملية الانتخابية واستقلال قراراتها عن الاعتبارات السياسية، كما يعززان الانطباع بأن استبعاد الحريري لا يستند فقط إلى تقديرات قانونية، بل يدخل ضمن سياق أوسع من إعادة هندسة المشهد السياسي باتجاه تضييق هامش المعارضة وإقصاء الأصوات المستقلة.
قرار سياسي في المقام الأول
من خلال تتبع مجريات استبعاد الحريري من الترشح للانتخابات البرلمانية، يتضح أن القرار يحمل في جوهره طابعًا سياسيًا أكثر منه قانونيًا، فالمسألة لم تعد مرتبطة بتطبيق نصوص الدستور أو أحكام القانون بقدر ما تخضع لرؤية السلطة في إدارة المجال العام وفق ما يمكن وصفه بـ استراتيجية الصوت الواحد، حيث لا مكان للأصوات المستقلة أو المعارضة مهما التزمت بالأطر القانونية.
لقد تجاوزت الدولة في تعاملها مع المعارضة مرحلة التضييق التقليدي إلى مرحلة الإقصاء الكامل، بحرمان رموز سياسية من حقوقهم الدستورية في الترشح والمشاركة، وهو ما لا يقتصر على حالة الحريري وحده، بل امتد إلى شخصيات أخرى أبرزها أحمد الطنطاوي، الذي جرى استبعاده من الانتخابات الرئاسية ثم لاحقًا من السباق البرلماني، في ما يبدو أنه توجّه منسّق لإخراج التيار المعارض المدني من المعادلة السياسية كليًا.
وفي تفسيره لما جرى، قال الحريري في حوار مع موقع “مدى مصر” إنه يرى فرقًا واضحًا بين ما حدث له في انتخابات 2020 وما يجري الآن، ففي انتخابات 2020، بحسب قوله، كان التدخل الأمني المباشر وراء سقوطه، خاصة في الجولة الثانية، بعد أن مُنع عدد كبير من الناخبين من التصويت في دائرة محرم بك التي كان يتصدر نتائجها، وهي نفسها الدائرة التي فاز بها في انتخابات 2015.
أما في الوضع الحالي، فيرى الحريري أن الأمر لم يعد مرتبطًا بتدخلات أمنية، بل أصبح قرارًا مؤسسيًا موجّهًا لإقصائه سياسيًا بالكامل، إذ يقول: “لو العزل السياسي ما اتطبقش على الحزب الوطني ورموزه قبل الثورة، فالهيئة الوطنية للانتخابات دلوقتي بتنفّذ فيا إعدام سياسي، لمجرد إن والدي كان شخصية معارضة معروفة، رغم إن الدولة نفسها كرّمته في حياته وبتُثمّن دوره بعد وفاته.”
ويضرب الحريري مثالًا ساخرًا يوضح مقدار التناقض في تفسير القوانين بقوله: “لو شخص استُثني من الخدمة العسكرية لأنه متزوج من سورية، زوجته بعد سنتين من الزواج هتحصل على الجنسية، وبعد خمس سنين من حقها تترشح وفقًا لقانون منح الجنسية، لكن زوجها، بسبب التفسير الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات، هيُحرم طول حياته من الترشح لأي انتخابات، حتى لو كانت انتخابات نادي أو نقابة.”
هذا المنطق، كما يرى متابعون، يكشف عن تحوّل خطير في فلسفة إدارة العملية السياسية، من محاولة السيطرة على نتائج الانتخابات إلى إقصاء المنافسين من أصل العملية الانتخابية نفسها، وهو ما يشير إلى أن الدولة لم تعد تكتفي بتقييد المجال العام، بل تتجه نحو إعادة هندسة الحياة السياسية بالكامل بما يضمن خلوها من أي معارضة فعلية أو حتى رمزية.
الإقصاء المبكر.. استراتيجية جديدة
لا يمكن النظر إلى استبعاد نجل المعارض السابق بوصفه واقعة معزولة، بل باعتبارها حلقة جديدة في سلسلة طويلة من السياسات الممنهجة لإقصاء المعارضين من المجال السياسي، فالنظام المصري، على ما يبدو، رسّخ خلال الأعوام الأخيرة استراتيجية جديدة تقوم على “الاستبعاد المسبق” بدلًا من المنافسة داخل الصندوق، وهو ما بدأ بشكل واضح خلال الانتخابات الرئاسية الماضية عندما مُنع السياسي أحمد الطنطاوي من استكمال مسار ترشحه بعد تعطيل عملية جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لمنافسة الرئيس الحالي.
القضية لم تتوقف عند ذلك الحد، إذ صدرت ضد الطنطاوي أحكام قضائية وقرارات اعتبرها مراقبون منحازة سياسيًا، خاصة بعدما أصرت المحكمة على تحديد أن المنع يخص الانتخابات البرلمانية تحديدًا وليس أي انتخابات أخرى، في خطوة تعكس اتجاهًا واضحًا نحو تسييس القضاء الانتخابي وتحويله إلى أداة لفرز المشهد السياسي وفق رؤية السلطة.
وما يزيد المشهد التباسًا أن دائرة التضييق لم تطل المرشحين فقط، بل امتدت إلى محيطهم المباشر، فقد فوجئ مدير حملة الطنطاوي، محمد أبو الديار، في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحذف اسمه من قاعدة بيانات الناخبين، ما حرمه من حقه في الترشح للانتخابات البرلمانية، رغم أنه لم تصدر بحقه أي أحكام قضائية، والمفارقة أن بعض أعضاء حملة الطنطاوي الآخرين، الذين أُدينوا في قضية التوكيلات الشعبية، لم يُحرموا من حقوقهم السياسية، وهو ما يعزز فرضية أن الإقصاء انتقائي بطبيعته، وليس قانونيًا أو موضوعيًا.
هذا النمط المتكرر من الاستبعاد -سواء في حالة الحريري أو الطنطاوي أو أبو الديار- يشير إلى أن الأمر يتجاوز مجرد قرارات فردية أو تقديرات قانونية، ليعكس توجهًا سياسيًا متكاملًا هدفه تنقية الساحة الانتخابية من الأصوات المستقلة التي يمكن أن تشكّل بديلًا حقيقيًا داخل البرلمان أو تطرح خطابًا مغايرًا للرؤية الرسمية.
فالرسالة واضحة: النظام لا يريد مجرد تقليص هامش المعارضة، بل يسعى إلى إلغاء وجودها من الأساس، إذ يُنظر إلى هذه الشخصيات باعتبارها أصواتًا “لا تناسب المرحلة المقبلة” لأنها ترفع شعار المساءلة وتنتقد الأداء الرسمي من داخل الإطار القانوني نفسه.
ومن ثمّ، فإن الإقصاء المبكر يصبح أداة استباقية لتجنّب أي مواجهة انتخابية غير محسوبة داخل صناديق الاقتراع، في مشهد يُعيد رسم الحياة السياسية على مقاس السلطة وحدها.
هندسة على الطريقة الناصرية
منذ توليه السلطة عام 2014، لم يُخفِ الرئيس عبد الفتاح السيسي إعجابه المتكرر بتجربة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، خاصة في ما يتعلق بسيطرته المحكمة على الإعلام، الذي كان في عهده صوت الدولة الوحيد. وقد عبّر السيسي أكثر من مرة عن أمنيته في أن يمتلك إعلامًا يشبه إعلام عبد الناصر، «يتحدث بصوت واحد» ويعمل تحت مظلة ما يُسمّى بـ الوطنية، وفق الشعار الشهير في ستينيات القرن الماضي: «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة».
هذا الإعجاب، الذي بدا في بدايته حنينًا رمزيًا إلى حقبة القوة والانضباط السياسي، تجاوز في السنوات الأخيرة البعد الإعلامي، ليأخذ شكل محاولة لاستنساخ التجربة الناصرية برمّتها — سياسيًا وبرلمانيًا، فكما كان الحال في عهد عبد الناصر، حيث أُجريت الانتخابات البرلمانية ضمن إطار نظام الحزب الواحد ممثلًا في الاتحاد الاشتراكي العربي، يسير المشهد الحالي في اتجاه مشابه، تُختزل فيه التعددية الحزبية إلى مجرد واجهة شكلية، ويُقصى منه كل صوت مستقل أو معارض.
تشير معطيات المشهد الانتخابي الراهن -بدءًا من استبعاد هيثم الحريري ووصولًا إلى منع أحمد الطنطاوي من خوض الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية- إلى أن مصر تتجه نحو نموذج برلماني أقرب إلى الاتحاد الاشتراكي من حيث الشكل، وإن اختلفت الدوافع، فبينما كانت انتخابات الخمسينيات والستينيات تتم تحت شعارات الوحدة القومية، تجري انتخابات اليوم في ظل إعادة هندسة المجال العام لضمان برلمان بلا معارضة، وإعلام بلا صوت ناقد.
ولعل العودة إلى انتخابات 1957 تُظهر هذا النمط بوضوح، فقد كانت أول انتخابات بعد ثورة يوليو، أُجريت على أساس غير حزبي، وتأجلت عدة مرات بسبب أزمة السويس، ومع ذلك رفضت السلطات العسكرية آنذاك قرابة نصف المرشحين باعتبارهم “غير مرغوب فيهم”، واليوم، بعد ما يقرب من سبعة عقود، تتكرر الصورة وإن بأدوات جديدة: استبعاد إداري وقضائي وسياسي ممنهج، يحقق النتيجة ذاتها — إقصاء كل من لا يتماهى مع خطاب الدولة الرسمي.
محصلة لما سبق يمكن القول إن ما جرى مع هيثم الحريري ليس مجرد حالة فردية، بل مرآة لصورة أوسع للمشهد السياسي المصري الحالي، حيث تتحوّل العملية الانتخابية من أداة للتعبير الشعبي إلى آلية لإدارة النتائج مسبقًا.
فالإقصاء المبكر للمعارضين وإعادة تفسير القوانين بشكل انتقائي يعكسان استراتيجية السيطرة المطلقة على البرلمان والمجال العام، بما يضمن استمرار ما يمكن وصفه بـ “البرلمان الصامت” وغياب أي رقابة سياسية فعلية على السلطة التنفيذية.
ومن خلال مقارنة هذا النهج بالنموذج الناصري، يتضح أن السلطة الحالية تسعى إلى استنساخ الشكل دون المضمون: استعادة الانضباط والسيطرة على المؤسسات، مع غياب المشروع الوطني الشامل أو الأيديولوجية الجماهيرية التي كانت تمنح الشرعية للنفوذ الناصري.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى الاستبعاد السياسي والاستبعاد القضائي والإداري كأدوات متكاملة لإعادة هندسة الحياة السياسية على مقاس السلطة وحدها، تاركة المعارضة خارج اللعبة، والمواطنين أمام واقع انتخابي محدود الخيارات، حيث يصبح الصوت المستقل خارج المعادلة، وتتحول الديمقراطية إلى مجرد واجهة شكلية.