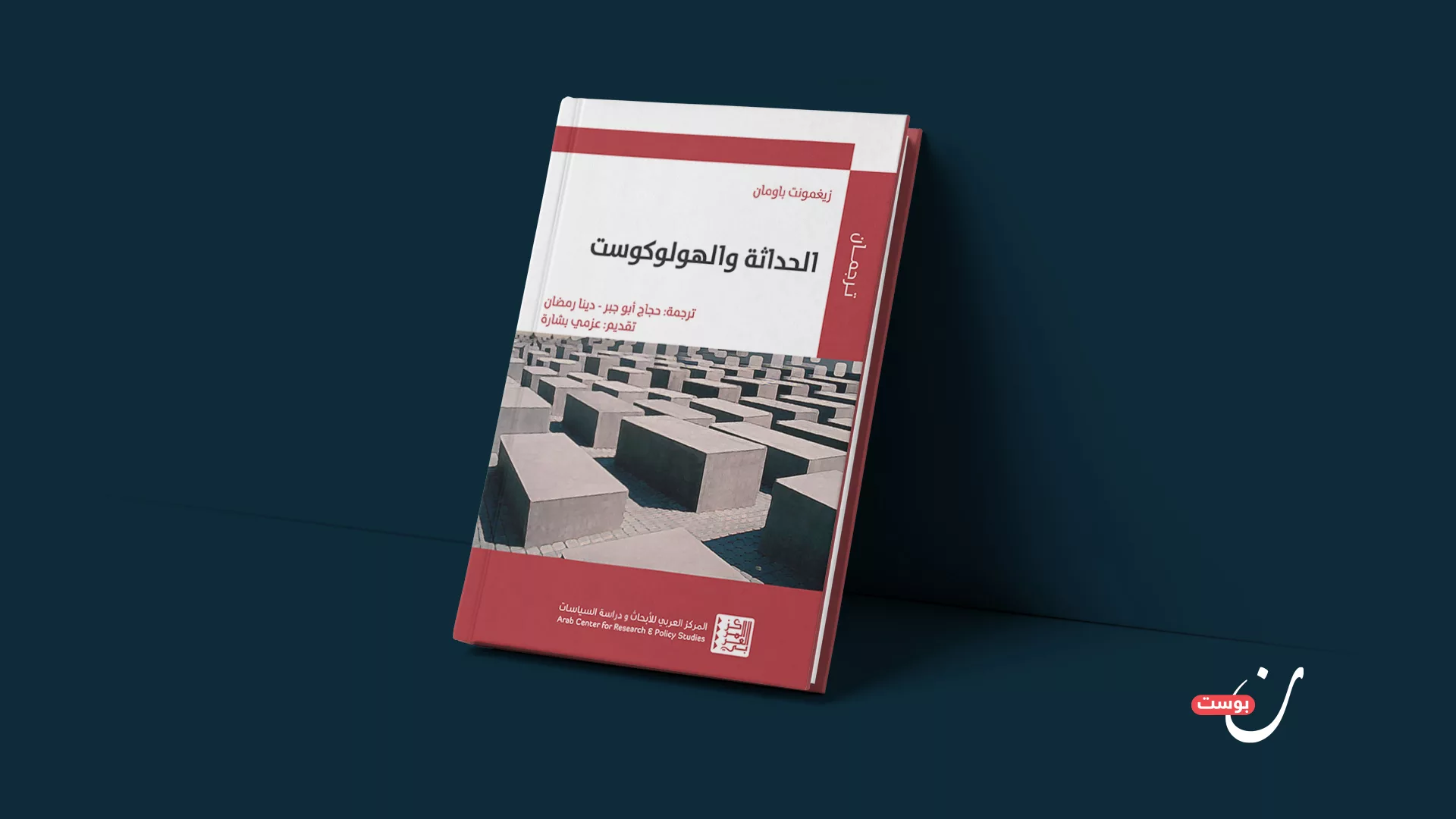تعد أطروحة زيغمونت باومان في كتابه المؤسس “الحداثة والهولوكوست” (Modernity and the Holocaust) واحدةً من أكثر التحليلات السوسيولوجية والفلسفية إثارةً للجدل، فهي لا تقتصر على دراسة حدث تاريخي معزول، بل تتجاوزه لتقديم نقد جذري للحداثة الغربية ذاتها. لقد تحدى باومان الرؤية التقليدية التي اعتبرت الهولوكوست “نوبة جنون” أو “انحرافًا” عن مسار التمدّن الحضاري. بدلًا من ذلك، أكد أن الإبادة كانت إمكانيةً كامنةً، بل هي “وجهٌ من وجوه الحداثة” نتج عن تضافر عناصرها البنيوية: العقلانية الأداتية، التكنولوجيا، والبيروقراطية الكفؤة.
إن العودة إلى تحليل باومان، اليوم، في ضوء الحرب الإبادية الجارية في غزة، ليست مجرد استدعاء تاريخي، بل هي ضرورة نقدية تطرح أسئلةً ملحة حول استمرار منطق الإقصاء الممنهج، ودور الأدوات الحديثة، وخاصةً البيروقراطية العسكرية الرقمية، في تحييد الأخلاق وتفتيت المسؤولية عن العنف الجماعي. في هذا المقال، نحاول إعادة قراءة باومان في ضوء اللحظة الراهنة، متسائلين: ما العلاقة بين البيروقراطية والعنف المُؤسّس في الحروب الحديثة؟ وكيف تُستخدم مفاهيم الأمن والعقل والعلم لتبرير الإبادة الجماعية؟ وهل فشلت الحداثة في تجاوز نزعتها الإقصائية والعنصرية، أم أن ما يجري في غزة يكشف عن جوهرها الحقيقي؟
الإبادة كـ “احتمال كامن” في صلب الحداثة
لم يكن الهدف من مقاربة باومان هو تبرئة الأيديولوجيا النازية، بل نزع الحصانة عن الحداثة كإطارٍ فكري واجتماعي، إذ يصر باومان، في أطروحته، على أن الإبادة لم تكن لتحدث إلا في مجتمع الحداثة العقلاني التنويري المسلح بالعلم والتكنولوجيا، فالهولوكوست كان، في جوهره، اختبارًا قاسيًا لـ “سيرورة التهذيب الحضاري” الغربي، وكشف عن إنتاج الحداثة لـ “اللامبالاة الأخلاقية” و”العمى الأخلاقي” كعواقب بنيوية.
يكمن الخطر الأول في تحول العقل التنويري نفسه إلى عقل أداتي. في الأصل، وعد التنوير بالتحرر، لكنه تحول إلى أداةٍ للسيطرة على الطبيعة، ثم السيطرة على الإنسان، وهذا الاختزال في المعرفة التقنية واستبعاد القيم الجمالية والأخلاقية والفلسفية، جعل من الممكن تنفيذ أفظع الجرائم بكفاءة لا تشوبها شائبة، فالكفاءة والمنطق التقني هما اللذان وفّرا الإطار الإبستمولوجي (المعرفي) اللازم للتنفيذ البيروقراطي للإبادة.
ويتجسّد هذا المنطق الإقصائي في مفهوم “الدولة البُستانية” (Gardening State)، فالحداثة، بسعيها لبناء الدولة القومية “الصلبة” وتحديد القواعد واليقين المادي، تنزع نحو “البستنة”، إذ البستاني لا يرى سوى التصميم المثالي الذي يسعى لتحقيقه، ويجب عليه إزالة الأعشاب الضارّة التي تهدد نقاء الحديقة. هذه النزعة الإقصائية، التي تسعى للتطهير الاجتماعي وتصميم مجتمعٍ مثاليٍّ، هي الدافع العميق وراء استخدام العنف غير المتناسب.
في سياق حرب الإبادة على غزة، يتجلّى هذا المنطق في النظر إلى المجتمع المستهدف بأكمله، بما في ذلك بنيته التحتية وذاكرته، على أنه “بنية تهديد” تحتاج إلى إزالة شاملة وتطهيرٍ جذريٍّ. هنا، يتجلى الدرس الأساسي الذي يقدّمه باومان، وهو أن أبشع الجرائم في تاريخ الإنسان لم تنشأ من كسر النظام، بل “عن اتباع النظام بشدة وبلا أخطاء”.
البيروقراطية والمسافة الأخلاقية
إن الشرط السوسيولوجي للإبادة الحديثة هو وجود بيروقراطية كفؤة، مدعومة بسلطة مركزية قوية. وفي ظلّ حالة طوارئ، تعمل البيروقراطية كآلية لتفريغ الأخلاق وتحييد المسؤولية. حسب باومان، لم يكن الهولوكوست جريمةً ارتكبتها مجموعة من الغوغاء، بل نفذتها “مجموعة محترمة ومنظمة ترتدي زيًّا رسميًّا وتتبع القانون، بل وتتحرى الدقة في تعليماتها”. هذا الترتيب المؤسسي هو ما يولّد الشرّ الممنهج، أو الشرّ التافه، حسب وصف الفيلسوفة الألمانية حنّة آرنت.
أيضًا، كانت السمة المميزة للبيروقراطية العقلانية الحديثة هي الجمع بين السلطة الهرمية وتقسيم العمل الوظيفي، بما يساعد في تفتيت الفعل الإجرامي الكبير إلى مهام تقنية صغيرة ومجزّأة، لا تتطلب قرارًا أخلاقيًّا شاملًا من أيّ منفّذ فردي، فكل موظف أو جندي يركّز فقط على واجبه العقلاني تجاه النظام، مستبدلًا القيم الأخلاقية الأساسية بالطاعة لسلطة المؤسسة، وهذا هو المفتاح لـ “التكوين الاجتماعي للموظف” (Sodogenesis) الذي يصبح مجرّد منفّذ تقنيٍّ للحل النهائي.
ويعتمد باومان على تجارب ميلغرام لتأكيد “أخلاقيات الطاعة”، حيث تُظهر التجارب كيف يمكن للأفراد العاديين، ضمن سياق سلطة هرمية، أن يرتكبوا أعمالًا قاسية، ليس لأنهم ساديّون بطبيعتهم، بل لأن المنظومة البيروقراطية تعمل على تمييع المسؤولية، وتزيل عن الفرد عبء القرار الأخلاقي. كما أن الشرط الأهم لتمكين الإبادة هو خلق المسافة الأخلاقية (Moral Distance)، لتكون بمثابة تباعد جسديٍّ وروحيٍّ عن الضحية، وهي ضروريةٌ لتمكين القتل الممنهج دون الشعور بالندم أو صراع الضمير. وهذا يتمّ عبر عزل الضحايا وتجريدهم من إنسانيتهم، ما يتناقض بشكلٍ مفارقٍ مع ادعاءات الحداثة الغربية بالتهذيب والتمدّن.
في السياق الحديث، لم تقتصر آليات تفتيت المسؤولية على الهياكل الإدارية التقليدية، بل تطوّرت لتشمل هياكل تكنولوجيةً متقدّمةً تعمل على تحويل العمل الإجرامي إلى مهامّ تقنية صغيرة ومجرّدة. ويتجسّد ذلك في الفصل بين مطوّري خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ومحلّلي البيانات، ومنفّذي الضربات، ما يخلق “مصنع إنتاج للأهداف”. هذا الفصل يعمّق المسافة الأخلاقية، حيث يركّز كل طرف على واجبه الوظيفي العقلاني دون تحمّل المسؤولية الكلية عن نتائج الفعل الإبادي. كما أن التجريد من الإنسانية يتمّ عبر القتل عن بعد باستخدام الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي، وتحويل الضحية إلى بياناتٍ رقمية مجرّدة، بينما يتمّ ضمان الامتثال داخل المنظومة من خلال الطاعة العمياء لـ “قوائم الأهداف” التي تنتجها الآلة، واعتبار القرار الآلي محايدًا ومبرَّرًا دون الحاجة للتحقّق البشري المستقل.
عقلنة الإقصاء في غزة
تجد مفاهيم باومان صدىً مباشرًا في حرب الإبادة على غزة، حيث يبرَّر العنف المؤسسي الممنهج بغطاء العقلانية والأمن، وتُستخدم التكنولوجيا الحديثة لتعميق المسافة الأخلاقية إلى مستويات غير مسبوقة، فهي تحوّل ممارسات العنف الإبادية في غزة إلى “سياسة دولة” ضرورية و”عقلانية” تحت غطاء “الأمن القومي” وحماية الذات (“دولة إسرائيل، وشعبها اليهودي”) من الهلاك. هذا الخطاب الممنهج يُوظّف مفاهيم “العقل” و”العلم” و”الاستباقية” لتوفير شرعيةٍ للقتل الجماعي. فالنزعة الاستباقية، التي تُبرّر تدمير البنية التحتية والاجتماعية بأكملها، تتماهى مع منطق الدولة البُستانية الإقصائي.
إنّ التحليلات القانونية المعاصرة تُعزّز هذه القراءة؛ إذ خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة، في تقريرها، إلى وجود “النية الخاصة بالإبادة الجماعية” في غزة، ما أكّد أن الأفعال ليست عشوائية، بل هي جزءٌ من نمطِ سلوكٍ ممنهجٍ يتسم بقصد تدمير جماعة الفلسطينيين كليًّا أو جزئيًّا. هذا القصد هو التجسيد الحديث للنزعة الإقصائية التي نبّه إليها باومان في جوهر الحداثة.
وإذا كانت البيروقراطية النازية قد اعتمدت على تفتيت العمل الورقي واللوجستي، فإنّ الإبادة الحديثة تعتمد على البيروقراطية العسكرية الرقمية، التي تبلغ ذروتها في أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI). فلم يعُد الجنود يواجهون الضحايا مباشرة، بل يتعاملون معهم كـ “أهداف” رقميةٍ مُصنّفة. ويلعب الإعلام دورًا جوهريًّا في هذه العملية، حيث يعمل على أدلجة الخبر والصورة، وتضخيم المحتوى الضار، وتصنيف الفلسطينيين كـ “أعداء” أو “مشتبه بهم”، ما يُسهّل تجريدهم من الإنسانية.
كما أنّ استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل “لافندر” (Lavender) و”غوسبل” (The Gospel) يُمثّل التطور النوعي الأخير في خلق المسافة الأخلاقية وأتمتة الإبادة، إذ يعمل نظام “لافندر” على تحديد وترشيح الأهداف البشرية للاغتيال، بعد تحليل أنماط سلوك الأفراد وبيانات المراقبة المتعلقة بكل فردٍ تقريبًا في غزة، حيث يقوم النظام بتصنيف الفلسطينيين بمؤشر لاحتمالية أن يكونوا نشطين عسكريًّا. وهذا يُمثّل التجريد الأقصى: يُختزل الإنسان إلى مجموعةٍ من البيانات والأنماط، ويُصبح “نموذج خطر” إحصائي. أمّا نظام “غوسبل”، فيعمل على أتمتة عملية تحديد المباني والهياكل كأهداف محتملةٍ للضربات العسكرية، حيث يمكنه إنتاج عددٍ كبيرٍ من الأهداف يوميًّا، مُحوّلًا التخطيط العسكري والتدمير إلى عمليةٍ صناعيةٍ تقنيةٍ فائقة السرعة.
النقطة الأكثر دلالة هي أن “لافندر” يُحدّد الأهداف “من دون أيّ تدخّلٍ بشريٍّ تقريبًا”، ويُصبح الشخص المصنّف كـ “مسلّح” هدفًا للقصف دون الحاجة إلى التحقّق المستقل. هذا النقل لعملية اتخاذ القرار إلى الآلة يضع طبقةً عازلةً كاملةً بين الجندي وعواقب فعله، ما يجعل المسافة الأخلاقية إنجازًا تكنولوجيًّا. إنّ هذه “البيروقراطية الخوارزمية” تُزيل آخر فرصةٍ للندم أو التساؤل الأخلاقي لدى المنفّذ البشري. فالجندي يتسلّم “قائمة أهداف أنشأها الحاسوب ولا يعرف بالضرورة على أيّ أساسٍ تمّ وضعها”. ما يضمن، أي الجهل المُريح، تفتيت المسؤولية بشكلٍ كامل: القرار نابعٌ من الآلة (التي يُفترض أنها عقلانية ومحايدة)، والمنفّذ يطيع واجبه تجاه مخرجات النظام التقني، نظام دولته الحضارية.
تبرز هنا المفارقة التي تؤكّد أطروحة باومان عن العقلانية الأداتية. فرغم الترويج للذكاء الاصطناعي كأداةٍ “ذكية” و”جراحية” عالية الدقة، فإنّ الكفاءة العقلانية المفرطة تؤدّي إلى التدمير العشوائي الأعمى. فالنظام يرتكب “أخطاء قاتلة” نتيجةً لتحيّز الخوارزميات، أو الاشتباه في المدنيين لمجرّد تشابه الأنماط الاتصالية. هذه الأخطاء، المقترنة باستخدام قوّةٍ تدميريةٍ غير متناسبة، تجعل هذه الآلات “عمياء بدلًا من كونها ذكية”، وهدفها “التدمير الشامل وليس انتقاء الأهداف بدقةٍ عالية”. هنا، تتجلّى قمة نقد باومان: إنّ القتل الممنهج في العصر الحديث ليس خروجًا عن العقلانية، بل هو النتيجة النهائية لتطبيق هذه العقلانية بكفاءةٍ قصوى في غياب الضوابط الأخلاقية والقيم الإنسانية.
خلاصات فلسفية: تحديات الأخلاق في العنف المُبرمَج
إن الأزمة التي يكشفها العنف الإبادي في غزة، في ضوء باومان، هي فشل المشروع العالمي للحداثة في تجسيد فِكره الإنسانوي على أرض الواقع، فبدلًا من أن تتحوّل الحياة الحديثة إلى نموذجٍ ليبراليٍّ “سائل”، كما وصف باومان لاحقًا، فإنّنا نرى استمرار وجود “حداثة لزجة”، أي أنّ هياكل العنف المؤسسي والبيروقراطية الأمنية تظلّ صلبةً ومُتمأسسةً على مصالح مرسلة، بينما تُذاب القيم الإنسانية.
مأساة غزة تُثبت أن الإبادة ليست مجرد شذوذ تاريخي، بل إمكانيةٌ بنيويةٌ متجددةٌ (Sodogenesis) في أيّ دولةٍ قويةٍ تملك أيديولوجيا إقصائيةً، وبيروقراطيةً كفؤةً، وغطاءً للأمن. واليوم، تتفاقم الخطورة عبر تحويل المسافة الأخلاقية إلى إنجازٍ تكنولوجيٍّ يمنح المنفّذين القدرة على القتل بالجملة دون أيّ صراعٍ عاطفيٍّ أو إدراكٍ للمسؤولية الشخصية.
وفي الختام، فإن المُهمّة السياسية والأخلاقية الحقيقية، كما أشار باومان، هي نقد عمل المؤسسات التي تبدو محايدةً ومستقلةً، بهدف رفع النقاب عن العنف والقهر الذي مُورِسا دومًا عبرها. في العصر الرقمي، يعني هذا مساءلة البيروقراطية العسكرية التي تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تقتل بـ “العمى” المُبرمج. كما أنّ القيمة النقدية لأطروحة “الحداثة والهولوكوست” تكمن في تذكيرنا بأنّ الإبادة الحديثة ليست نتاجًا لجماعات غوغائية، بل هي نتاجٌ منطقيٌّ للكفاءة والعقلانية والقدرة الإدارية للمؤسسات الحديثة على تجريد الفعل الإجرامي من محتواه الأخلاقي، عبر التقنية، والعزل، والإدارة. وهذا يضع عبئًا أخلاقيًّا ثقيلًا على كاهل كلّ من يشارك في، أو يُبرّر، أو يصمت عن العنف المؤسسي الممنهج في عصر تكنولوجيا الإبادة.