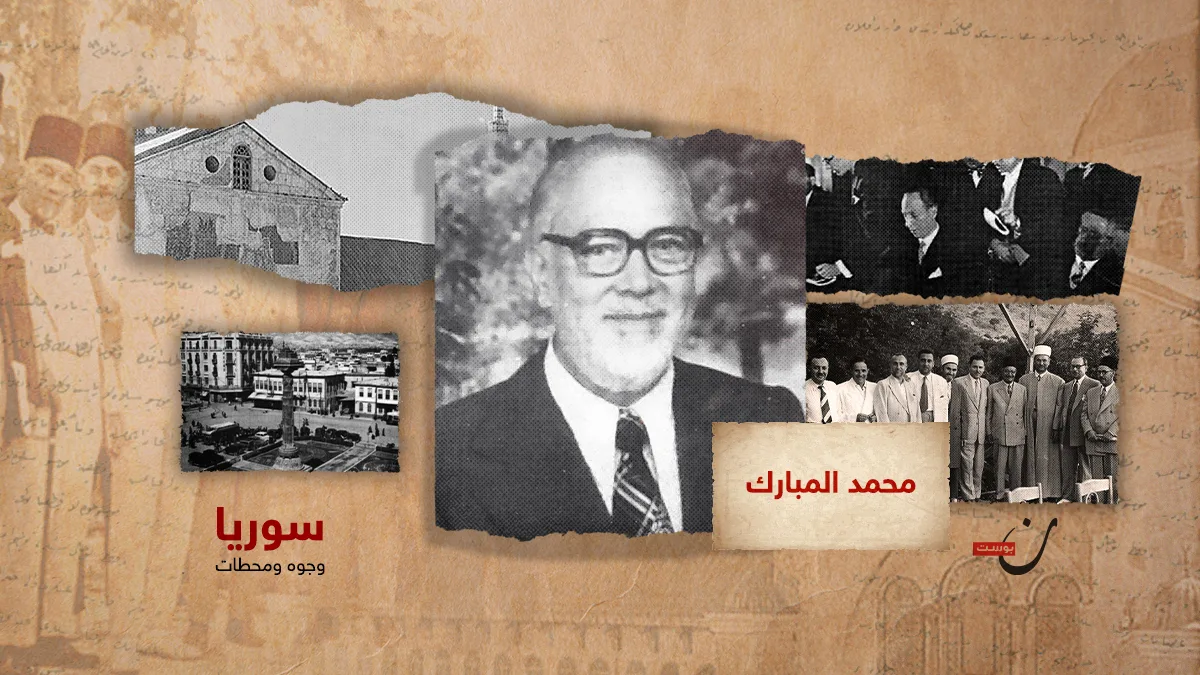منذ قرون، شكل التصوف في سوريا أحد أعمدة الحياة الروحية والاجتماعية، ضاربًا جذوره في أعماق المدن القديمة وزوايا القرى، غير أن هذا الإرث العميق لم يكن بمنأى عن العواصف التي عصفت بالبلاد، خاصة بعد عام 2011. واليوم، ومع بزوغ ملامح مرحلة ما بعد التحرير، تقف الصوفية أمام اختبارٍ جديد، هل تستطيع أن تستعيد دورها، أم ستبقى أسيرة التحولات السياسية التي كبلتها لعقود.
التصوف في التاريخ السوري
دخل التصوف بلاد الشام منذ العصور الإسلامية الأولى، لكنه ازدهر فعليًا في العهدين الزنكي والأيوبي ثم المملوكي. وفي العهد العثماني، بلغ ذروة انتشاره وتنظيمه، فبرزت في دمشق طرق الرفاعية والنقشبندية والقادرية، بينما اشتهرت حلب بالشاذلية، وتمتع مشايخ الطرق بمكانة رفيعة لدى السلطة والعامة، إذ تولوا مناصب دينية واستشارية، وأدوا أدوارًا رقابية وأخلاقية في الحياة العامة.
ومع سقوط الدولة العثمانية، تغيرت طبيعة العلاقة بين الدين والدولة، وتراجع نفوذ الطرق الصوفية أمام صعود الأفكار القومية والحركات الإصلاحية الإسلامية، كذلك لم تولِ الحكومات السورية بعد الاستقلال اهتمامًا كبيرًا بالتصوف، إذ لم يعد يشكل لها البعد الأيديولوجي ذاته الذي مثله في العهد العثماني، فتراجعت مكانة الطرق والجماعات الصوفية لصالح أطر العمل السياسي والمدني الحديثة.
لكن رغم انحسار نفوذه المؤسسي وتزايد هيمنة الدولة على المجال الديني، ظل التصوف حاضرًا كقوة روحية واجتماعية متجذرة في المجتمع السوري، فقد واصلت الزوايا الصوفية نشاطها داخل الأحياء القديمة، مما جعل التصوف جزءًا أصيلًا من الهوية السورية، وإن لم يعد يحتل الموقع المركزي الذي عرفه في العصور السابقة.
بداية الصراع مع النظام
مع وصول حافظ الأسد إلى الحكم، وجد الصوفيون أنفسهم أمام واقع جديد فرض عليهم إعادة تموضعٍ حذر، فتفاوتت مواقف الطرق الصوفية بين رفضٍ مكتومٍ وقبولٍ مشوبٍ بالحيطة، بينما اختارت بعض الطرق الحياد والسعي للتكيف مع النظام، في حين حرصت أخرى على صون استقلالها دون الانجرار إلى مواجهة مباشرة.
برزت الطريقة النقشبندية بوصفها نموذجًا للحياد، إذ التزمت الصمت خلال صراع النظام مع الإخوان المسلمين في ثمانينيات القرن الماضي، في حين انخرط بعض شيوخ الصوفية في حماة في العمل الميداني ضد النظام، وقد رد النظام على ذلك بعنف بالغ، فاستهدف شخصيات صوفية بارزة باغتيالات واعتقالات ونفي.
فقد اغتال النظام شيخ مشايخ الرفاعية في حلب ودمر عددًا من الزوايا هناك، وضيق الخناق على الطريقة الشاذلية التي تزعمها الشيخ عبد القادر عيسى الذي توفي في منفاه بالأردن. كما اغتال الشيخ الصوفي أديب الكيلاني في حماة، وحظر تداول كتب عدد من الشيوخ الصوفيين الذين عُرفوا بمواقفهم النقدية من السلطة، ومن أبرزهم الشيخ سعيد حوى.
ومن الجدير بالذكر أن فترة تسعينات القرن الماضي وبدايات الألفية الأولى شهدت صراع ناعم بين بعض المشيخات الصوفية في سوريا وإيران، اتخذ طابعًا فكريًا ودعويًا أكثر من كونه صراعًا سياسيًا مباشرًا. فقد رأت المشيخات الصوفية التقليدية، خاصة في دمشق وحلب، أن محاولات إيران التمدد عبر النشاط الثقافي والخيري تمثل تهديدًا لبنية التدين السني وللتراث الصوفي المحلي.
وفي هذا السياق، برزت مواقف عدد من العلماء الصوفيين الذين حذروا من محاولات “اختراق المجال الديني السني” تحت غطاء التقريب بين المذاهب، معتبرين أن تلك المبادرات تحمل في جوهرها مشروعًا لنشر التشيع.
ومن بين الأصوات التي عبرت بوضوح عن هذا الموقف، الشيخ محمد صهيب الشامي، الذي تحدث في مناسبات متعددة عن ضرورة “صون الهوية السورية”، وقد أشار الشامي إلى أن بعض الجمعيات والمراكز التي تلقت دعمًا إيرانيًا حاولت استقطاب الشباب في حلب وريفها.
ويمكن القول إن ذلك الصراع الناعم شكل واحدة من المحطات التي أعادت التأكيد على الوظيفة الدفاعية للتصوف السوري في حماية الهوية الدينية المحلية، قبل أن يتجدد بصيغٍ جديدة بعد عام 2011 مع تصاعد الحضور الإيراني في المشهد السوري.
علاقة مقايضة: تحالف المشيخات الصوفية مع النظام
بعد مجزرة حماة عام 1982، أعاد النظام صياغة سياسته الدينية، منتقلًا من نهج علماني صدامي إلى سياسة الاحتواء والضبط، فاستثمر في بعض اتجاهات التصوف كقوة ناعمة تمنحه شرعية في مواجهة التيارات الإسلامية السياسية، ومنذ ذلك الحين، بدأ دمج المشيخات الصوفية في مؤسسات الدولة عبر وزارتي الأوقاف والتعليم.
في هذا السياق، برز الشيخ أحمد كفتارو بوصفه النموذج الأوضح لهذا التحالف، إذ تولى مشيخة الطريقة النقشبندية الخالدية في دمشق خلفًا لوالده الشيخ محمد أمين كفتارو، وأسس مجمع أبي النور الذي تحول إلى مؤسسة ضخمة تضم مسجدًا وكليات دينية وجمعيات خيرية.
وقد وفر كفتارو للنظام غطاءً دينيًا رسميًا مقابل نفوذٍ واسعٍ له داخل المجتمع الديني، لتغدو جماعته أحد أبرز أذرع “التصوف الرسمي” في سوريا، ومع اتساع نفوذه داخل البلاد، أصبحت الكفتارية أحد أهم ركائز الخطاب الديني الموالي للسلطة.
ومع تولي بشار الأسد الحكم، استمرت هذه السياسة بصيغة أكثر مؤسساتية، حيث حصلت بعض الطرق الصوفية على دعم وتسهيلات مقابل خطابٍ يدعو إلى الاستقرار ونبذ الفتنة، وامتد هذا الاحتواء إلى الجمعيات النسائية ذات الخلفية الصوفية، مثل القبيسيات، اللاتي بلغ عددهن عشرات الآلاف، وحافظن على نفوذ اجتماعي ضمن الإطار الرسمي. كما برزت عائلات دينية ذات خلفية صوفية، مثل عائلة الفرفور في دمشق، ومشايخ نقشبنديين في حلب شغلوا مناصب حساسة كالإفتاء وإدارة الأوقاف.
لكن هذا التحالف لم يكن بلا ثمن، فقد أدى إلى تآكل مصداقية بعض المشيخات الصوفية في نظر قطاعات شعبية واسعة، حيث اعتُبر كثير من رموز التصوف جزءًا من المنظومة السلطوية، ومع ذلك، احتفظت بعض الشخصيات الصوفية بشرعيتها الشعبية، خصوصًا بين الجماهير غير المسيسة.
من جهة أخرى، لم تكن المشيخات الصوفية على درجة واحدة من الولاء للنظام، فبعضها حافظ على مسافة حذرة مع السلطة، بينما انخرط آخرون في جهاز الدولة الديني بشكل مباشر، كما برزت فروقٌ واضحة بين تصوف المدن الكبرى كدمشق وحلب، حيث تغلغل النفوذ المؤسسي، وبين الطرق الريفية التي احتفظت بشيء من الاستقلال.
كذلك تنوعت دوافع تعاون مشايخ الصوفية مع النظام، فمنهم من سعى للحفاظ على زواياه وحلقاته من البطش، ومنهم من رأى في دعم النظام وسيلة لضمان الاستقرار، بينما رغب آخرون في الاستفادة من الدعم المالي والمناصب الرسمية. وهكذا تشكلت أنماط متعددة من التحالفات، تراوحت بين تعاونٍ تكتيكي ودعمٍ صريحٍ للنظام.
يمكن توصيف العلاقة بين النظام وغالبية الطرق الصوفية بأنها علاقة مقايضة واضحة، إذ منح النظام العديد من الطرق الصوفية حرية النشاط والانتشار والمناصب الدينية، مقابل صمتها عن سياساته وتجنبها لأي خطاب نقدي.
وبينما ظل الرضا العام من السلطة هو السمة الغالبة، لم تخلُ الساحة من حالات محدودة من التوتر أو التصفية، كما حدث مع الشيخ معشوق الخزنوي الذي قُتل عام 2005 بعد مواقفه المعارضة للنظام وانتقاداته العلنية له، ليبقى اغتياله علامة فارقة في حدود ما يُسمح به داخل فضاء التصوف السوري.
أبرز الطرق الصوفية في سوريا وموقعها من النظام قبل سقوطه
| الطريقة الصوفية | الانتشار الجغرافي | ملاحظات عن الدور | موقعها من النظام |
| النقشبندية الخالدية | دمشق – حلب | أكثر الطرق نفوذًا في القرن العشرين، قادها المفتي الأسبق أحمد كفتارو، وشكلت الركيزة الأبرز للتحالف بين التصوف والنظام منذ السبعينيات. | تحالف عضوي |
| الخزنوية النقشبندية | الحسكة – القامشلي | تمتلك شبكة تعليمية واسعة (معهد العرفان) برعاية الأوقاف. | حيادية – متعاونة |
| الشاذلية | دمشق – حلب – دير الزور – الميادين – البوكمال | من أكثر الطرق نشاطًا في حلقات الذكر، كثير من رموزها معروفون بولائهم التقليدي للنظام وانخراطهم في أنشطة دينية رسمية. | موالية رسميًا |
| الرفاعية | دمشق – حماة – دير الزور – حلب | خضعت مأسستها لإشراف الأوقاف، وانقسمت مواقف مشايخها بين التعاون الإداري أو الحياد. | متعاونة إداريًا |
| السعدية | حمص | نشاط محدود | متعاونة بحذر |
| القادرية | حلب – عامودا – الجزيرة | ذات فروع متعددة، حافظت على نشاط محدود، وبعضها ارتبط رسميًا بالأوقاف. | حيادية – متعاونة |
| القبيسيات | دمشق وعدة محافظات | جماعة نسائية مغلقة ذات طابع صوفي نقشبندي علمي. | موالية رسميًا |
يقدم الجدول صورة عن المشهد الصوفي السوري قبل سقوط النظام، إذ يربط بين الطرق الصوفية الرئيسة ومواقعها الجغرافية وأدوارها السياسية والدعوية، مما يسمح بفهم البنية الهرمية للعلاقات بين التصوف والدولة.
أول ما يلفت النظر هو التركيز الجغرافي للطرق الكبرى في المدن المركزية كدمشق وحلب، ما يعكس علاقة تاريخية بين التمدن والتصوف المؤسسي، فالنقشبندية الخالدية بقيادة أحمد كفتارو، مثلت النموذج الأوضح لتأميم التصوف عبر تحويله إلى مؤسسة رسمية، وهو ما جعل علاقتها بالنظام عضوية وليست مجرد تعاون مرحلي.
بالمقابل، تكشف الطرق الريفية أو الطرفية – مثل القادرية – عن صيغة مختلفة من الولاء، تقوم على التحالف البراغماتي مقابل الحماية الإدارية القانونية. كما يُظهر الجدول أن معظم الطرق، حتى ذات الجذور العميقة كالشاذلية والرفاعية، لم تعد فاعلًا مستقلًا في الحقل الديني، بل باتت جزءًا من جهاز الضبط الديني للدولة.
يُلاحظ أيضًا تباين واضح بين الطرق الصوفية في مراكز المدن السورية ونظيراتها في الأرياف من حيث البنية والوظيفة الاجتماعية، ففي المدن الكبرى كدمشق وحلب وحماة، اتخذ التصوف طابعًا مؤسسيًا منظمًا، مرتبطًا بالمدارس والمعاهد الشرعية، وغالبًا ما اندمج في الإطار الرسمي للدولة من خلال وزارة الأوقاف.
أما في الأرياف والمناطق الطرفية، فقد احتفظ التصوف بطابعه الشعبي التقليدي، قائمًا على الولاءات الشخصية للمشايخ وعلى الروابط العائلية والقبلية، مع حضور قوي للكرامات والممارسات الشعبية الصوفية.
التحولات بعد عام 2011
مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، دخل المشهد الصوفي مرحلة مضطربة، إذ وجد مشايخ الطرق ومريدوهم أنفسهم أمام اختبار مصيري بين الحفاظ على العلاقة مع النظام الذي وفر لكثير منهم الحماية المؤسسية، وبين الاستجابة لمطالب الشارع الثائر والتحولات التي فرضها الصراع على الأرض.
في البداية التزم معظم مشايخ الطرق الكبرى الحياد أو التأيد للنظام، مبررين ذلك بالرغبة في حفظ “استقرار البلاد والعباد”، بينما فضل آخرون الصمت من دون تقديم أي موقف معلن وواضح.
في المقابل، انحاز عدد من المشايخ الصوفيين إلى صف الثورة، فخرجت مظاهرات من مساجد عُرفت بتوجهها الصوفي، مثل مسجد الرفاعي في دمشق الذي أمّه أبناء الشيخ عبد الكريم الرفاعي من الطريقة النقشبندية، وكذلك ساحة العاصي في حماة حيث شارك مريدون من الطريقة الشاذلية.
في الواقع، ظهرت شخصيات صوفية معارضة للنظام منذ الأشهر الأولى للثورة، مثل الشيخ أسامة الرفاعي وأخيه سارية الرفاعي والشيخ كريم راجح الذين اصطفوا مع مطالب الشعب وأسسا لاحقًا “المجلس الإسلامي السوري” في المنفى بتركيا ليكون مظلة دينية للمعارضة السورية، ولم يكونا وحيدين في هذا الموقف، إذ انضم إليهما مشايخ آخرون أقل شهرة من محافظات عدة.
كما وقع عدد من مشايخ الشاذلية والرفاعية والنقشبندية بيانات دعم للحراك الثوري، وشارك بعض المريدين فعليًا في التظاهرات السلمية، وشهدت مدن بانياس وحمص وحلب حراكًا قاده عدد من المشايخ الصوفيين البارزين، إذ برز الشيخ أنس عيروط في بانياس، والشيخان أسعد كحيل والسقا الشاذلي في حمص، كما يعتبر الشيخ الشاذلي محمد اليعقوبي من أبرز الأصوات الجريئة، إذ ألقى خطبة قرب قصر الرئاسة وجه فيها انتقادات علنية للنظام رغم ما انطوت عليه من مخاطر جسيمة.
ومع اتساع رقعة الحراك الشعبي، اشتدت المواجهة بين النظام وعدد من الرموز الصوفية، إذ شرع النظام في ملاحقة الشخصيات التي أبدت تعاطفًا مع الثورة أو شاركت فيها، فاعتُقل عدد منهم، من أبرزهم الشيخ أسعد كحيل الذي زُج به في سجن المزة، في حين اضطر كثيرون إلى مغادرة البلاد هربًا من الملاحقة الأمنية.
ومع تصاعد الأحداث بعد عام 2011، انخرط عدد من أتباع الطرق الصوفية في العمل المسلح، حيث ساهم بعضهم في تأسيس فصائل مقاتلة، مثل “كتيبة مصعب بن عمير” في الميادين و“الكتيبة الخضراء” في دير الزور، التي ضمت شبابًا من أتباع الطريقة القادرية، وكان لهم دور بارز في تحرير مواقع عسكرية في مدينة الميادين.
ومع مرور الوقت، أخذت الظاهرة طابعًا أوسع وأكثر تنظيمًا، إذ ظهرت كتائب تحمل أسماء رموز الطرق الصوفية، مثل “كتائب الإمام الرفاعي” في ريف دمشق، و“كتيبة عبد القادر الكيلاني” في درعا، فضلًا عن تشكيل “أحرار الصوفية” كجناح عسكري. وقد أحصت بعض التقديرات أكثر من خمسين كتيبة ذات خلفية صوفية، وهو ما يعكس محاولة لإعادة توظيف الرموز الصوفية في سياق الجهاد الشعبي ضد النظام.
لاحقًا، ومع اشتداد الحرب وصعود النفوذ الإيراني والميليشيات الطائفية، تراجع حضور الزوايا الصوفية التقليدية، إذ استغلت طهران حالة الفراغ الديني لتوسيع نفوذها المذهبي في عدد من المناطق، حتى باتت ميليشياتها صاحبة اليد العليا هناك.
كما أنشأت إيران مراكز دينية منافسة في المناطق التي خلت من العلماء والمشايخ المستقلين، وفي مواجهة هذا الواقع الجديد، حاولت بعض الزعامات الصوفية التكيف مع موازين القوى المستجدة لضمان بقائها.
أما في مناطق المعارضة شمالي سوريا، فقد استمرت الطرق الصوفية في نشاطها الديني والاجتماعي بدعم غير مباشر من جهات وشخصيات لها علاقات واسعة مع شيوخ ومريدي الطرق في مناطق النظام وتركيا.
كما انتقلت بعض الأنشطة الصوفية السورية إلى المنفى، حيث أعادت الطريقة السعدية تنظيم نفسها في ألمانيا، وأنشأ مريدوها زوايا ومجالس ذكر. كذلك مارس الشيخ مخلف العلي القادري نشاطه في مصر، مندمجًا في الأوساط الصوفية المصرية ومواصلًا التأليف والنشر، بجانب نشاطه على اليوتيوب.
وبحلول العقد الثاني من الثورة، أصبح المشهد الصوفي السوري منقسمًا إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية:
الموالون للنظام: وهم الطرق الكبرى والقيادات الرسمية التي حافظت على موقعها داخل مؤسسات الأوقاف، العديد من هؤلاء استمروا في البرامج الإعلامية والدينية الرسمية، لكن ضمن إطار ضيق يخضع للرقابة والسيطرة الأمنية.
ثم المستقلون أو المهاجرون الذين انسحبوا من الساحة أو واصلوا نشاطهم في المنفى. وأخيرًا المتأقلمون مع النفوذ الإيراني، جزء من الصوفيين اضطر لتعديل خطابه تحت ضغط تمدد المراكز الشيعية المدعومة من إيران، والتي حاولت ملء الفراغ الديني في العديد من المناطق.
وهكذا انتهى التصوف السوري إلى حالة من التشرذم والضعف بعد أن كان أحد أهم روافد التدين الشعبي في البلاد، فتراجعت زواياه التاريخية، وتفرق علماؤه بين المنافي، فيما تحولت بعض رموزه إلى أدواتٍ في صراعات السلطة.
مصير المشيخات الصوفية في ظل التحولات السياسية الراهنة
مع انطلاق المرحلة الانتقالية لسوريا الجديدة، سعى التيار الصوفي إلى التكيف مع المشهد السياسي والديني المستجد، كما سارع الرئيس أحمد الشرع إلى تعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتيًا عامًا للجمهورية، في خطوة رمزية هدفت إلى توحيد المرجعية الدينية وإعادة بناء المؤسسة الرسمية على أسس وسطية.
وقد تزامن هذا التعيين مع انعقاد مؤتمر ضم علماء من مختلف المذاهب، أُعلن خلاله عن تشكيل مجلس إفتاء أعلى برئاسة الرفاعي لتوحيد المرجعية الشرعية وتنظيم الخطاب الديني في مرحلة ما بعد الحرب، كما تولت شخصيات صوفية مناصب داخل وزارة الأوقاف وهيئات الإفتاء.
ورغم القرارات الصادرة عن وزارة الأوقاف التي تضمنت عزل عدد من المشايخ الصوفيين، من بينهم محمود علي عكام (مفتي حلب السابق)، وعبد الله محمد أديب حسون (شقيق المفتي السابق أحمد حسون) المنتمي إلى الطريقة الشاذلية، إلى جانب جمال أحمد حماش، وحسن جمال شرباتي، وأحمد نجم الدين شير، وعمار خالد دياب، ومحمد يعرب، فضلاً عن إعادة هيكلة مجلسي الأمناء والإدارة في مجمع الشيخ أحمد كفتارو.
فإن الغالبية العظمى من مشايخ الطرق الصوفية ما زالوا يواصلون نشاطهم الديني والاجتماعي، بل يشغل بعضهم مناصب مؤثرة داخل مؤسسات الدولة الجديدة، مما يعكس استمرار حضورهم ضمن المشهد الديني الرسمي رغم إجراءات التغيير الإداري.

ويُلاحظ أن الطرق الصوفية الكبرى تمكنت من الحفاظ على وجودها المؤسسي في سوريا الجديدة بفضل شبكاتها التعليمية والتنظيمية المتجذرة، مما يعني أن ما تراجع هو “التصوف المؤسسي المرتبط بالنظام السابق” أكثر من التصوف ذاته. ومع ذلك، خسرت المدارس الصوفية التقليدية التي كانت تهيمن لعقود على المشهد الديني جزءًا من شعبيتها بعد الحرب، نتيجة تآكل الثقة برموزها المقربة من النظام، وانفتاح المجال أمام تيارات أخرى.
تحولات المشهد الصوفي في سوريا: المشايخ والطرق والعلاقة مع النظام
| الشيخ / الطريقة | المنطقة | نمط العلاقة بالنظام | أبرز الأدوار/ المظاهر قبل 2011 | مصير ما بعد 2011 | الحالة الحالية |
| أحمد كفتارو (نقشبندية كفتارية) | دمشق | موالي | مفتي الجمهورية | توفي 2004، لكن إرثه استمر عبر الأبناء ومؤسسة المركز | إرث مؤسسي مستمر |
| عبد الفتاح البزم | دمشق | تحالف إداري | إدارة معهد الفتح | استمر ضمن المؤسسة الدينية الرسمية | باقٍ |
| حسام الدين فرفور | دمشق | موالي | إدارة جامعة بلاد الشام فرع مجمع الفتح الإسلامي | باقٍ في نفس الموقع الرسمي | منسحب |
| القبيسيات | دمشق | تحالف إداري | نشاط نسائي دعوي واسع | استمر | باقٍ |
| الطريقة القادرية (عامودا) | القامشلي | حيادي | نشاط محدود | استمر | باقٍ |
| الطريقة النقشبندية / إسماعيل أبو النصر | حلب | متعاون إداري | نشاط رسمي محدود | استمر | باقٍ |
| النقشبندية الخزنوية / محمد مطاع الخزنوي | تل عرفان (الحسكة) | حيادي | تأسيس مدارس صوفية، نشر التصوف | استمر | باقٍ تعليمي |
| عبد العزيز الخطيب
(الشاذلية) |
دمشق | موالي رسمي | نشاط مستمر ضمن الأوقاف | استمر | باقٍ |
| محمد جمال جوهر | حلب | موالي | من المشايخ المعروفين بخطبه في المساجد الكبرى | موالي | معزول رسميًا |
| أحمد نجم الدين شير – الخليفة العام للطريقة القادرية في سوريا | حلب | حيادي – موالي | من أبرز مشايخ القادرية | تعاون حذر | معزول رسميًا |
وكما يُظهر الجدول، فإن معظم مشايخ الطرق الذين دعموا النظام أو التزموا الحياد استمروا في نشاطهم، في حين اقتصر التهميش على عدد محدود من الشخصيات التي تراجعت شعبيتها أو تم إعفاؤها من مناصبها.
وفي هذا السياق، وجه الشيخ عبد العزيز الخطيب أحد أبرز مشايخ الطريقة الشاذلية في دمشق، رسالة إلى وزير الأوقاف عبر فيها عن استيائه من تعرض أتباعه لمضايقات أمنية ومنعهم من النشاط، مطالبًا بوقف الاعتقالات التعسفية والكف عن الخطاب الذي يصور الصوفية بصورة سلبية، مع العلم أن الشيخ عبدالعزيز كان من مؤيدي نظام الأسد بشكل صريح ومباشر، ولازال حتى اليوم يمارس أنشطته بشكل طبيعي.
الدين والمجتمع بعد الثورة السورية.. مراجعة للدور والرموز بين صوت الأمة وظلال السلطة.@NoonPostSY pic.twitter.com/CYKxkdSQY3
— نون بوست (@NoonPost) November 1, 2025
كذلك أثار خبر طرد الشيخ شريف الصواف من أحد مساجد دمشق صدى واسعًا، إذ اعتُبر مؤشرًا على التحولات الجارية داخل المشهد الديني الحالي، وتراجع نفوذ بعض الرموز الصوفية المحسوبة على النظام، فالصواف المعروف بانتمائه إلى التيار الصوفي الدمشقي التقليدي وارتباطه الوثيق بمؤسسات الأوقاف، يمثل نموذجًا لـ“التصوف الرسمي” الذي حاولت السلطة السابقة توظيفه لترسيخ خطاب ديني موجه يخدم سياساتها.
في المحصلة، يبدو أن التصوف السوري لا يتجه نحو الزوال، بل نحو إعادة التموضع، ولا تزال العديد من الطرق الصوفية السورية تحتفظ بروابط وثيقة مع نظيراتها في تركيا ومصر، سواء عبر الامتداد الروحي أو التواصل المباشر بين المشايخ والمريدين، إضافة إلى شبكة من العلاقات العابرة للحدود تتجدد عبر الزيارات المتبادلة والمشاركة في المناسبات الدينية الكبرى مثل الموالد، والتعزيات.
وبرغم ما فقده من التصوف في سوريا من رموزه ومواقعه، ما يزال يشكل أحد الأعمدة الثقافية والروحية في المجتمع السوري، وقادرًا على التكيف مع التحولات السياسية والاجتماعية، كما فعل مرارًا عبر تاريخه الطويل، وربما تمهد هذه المرحلة لولادة فصل جديد في حكاية التصوف في سوريا.