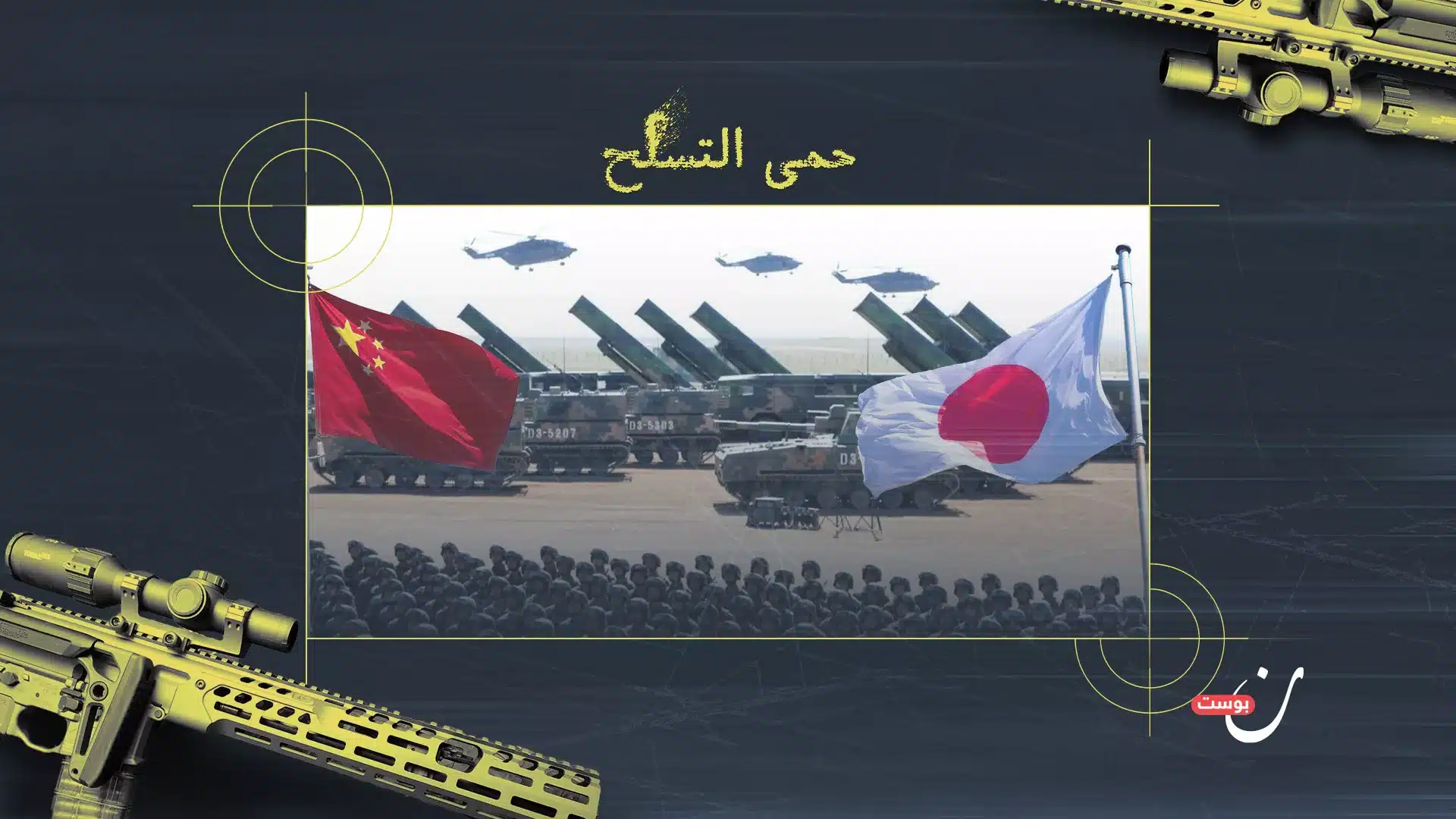شهدت الصين خلال السنوات الأخيرة استمرارًا واضحًا في مسار صعودها العسكري، وهو مسار بات معهد ستوكهولم للسلام (سيبري) يوثّقه عامًا بعد عام، ليتضح من خلال تقريره الصادر في أبريل/نيسان 2025 حجم الزيادة التي طرأت على الإنفاق الدفاعي الصيني. فقد رفعت بكين ميزانيتها العسكرية بنسبة 7% لتبلغ نحو 314 مليار دولار، محافظةً على ثلاثة عقود من النمو المتصل، وبزيادة قدرها 59% مقارنة بعقد مضى. وفي الواقع، يبدو الاقتصاد الصيني قادرًا على تحمّل هذا العبء الذي يُغذي طموح الرئيس “شي جين بينج” للزعامة العالمية، إذ لا يزال الإنفاق العسكري يشكّل نحو 1.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كان 1.8% عام 2015.
استأثرت الصين بنحو 50% من إجمالي الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، وبنسبة 12% من الإنفاق العالمي، مستثمرةً في تحديث جيشها وتوسيع قدراتها في الحرب السيبرانية وترسانتها النووية. ويقدّر معهد (سيبري) امتلاكها ما يقارب 800 رأس نووي، فيما يثير الانتباه في مسارها نحو موقع “القوة العظمى” اعتمادها المتزايد على التصنيع المحلي؛ إذ هبطت وارداتها من الأسلحة بنسبة 64% لتشكل 1.8% فقط من الإجمالي العالمي بين عامي 2020–2024، بعد أن كانت 5.1% في الفترة 2015–2019، لتخرج الصين للمرة الأولى منذ 1990–1994 من قائمة أكبر عشرة مستوردين للسلاح. وهذا التحوّل يعكس قدرةً متنامية على تصميم وإنتاج الأسلحة الرئيسية، بما يمنحها تفوقًا نوعيًا على جيرانها أو خصومها المحتملين: الهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
تطمح الصين أن تسترد إمبراطوريّتها الكاملة التي ترى أن أجزاءً كثيرةً منها أُخذت غُبنًا في سياقات عالمية مختلفة كانت فيها ضحيةً للأطماع الإمبريالية الغربية. وفي قلب هذه الاستراتيجية تبدو تايوان مكانًا مثاليًا لتفجير حرب عالمية ثالثة، بالنظر إلى ما تمثّله من رمزية سياسية وتاريخية وجغرافية بالنسبة لبكين. ومن هنا يعود ارتفاع الإنفاق الصيني بشكل كبير إلى هدفها طويل المدى المتمثل في تحديث قواتها المسلحة في جميع المجالات بحلول عام 2035. وقد كشفت الصين في عام 2024 عن عدة قدرات محسنة، بما في ذلك مقاتلات شبح جديدة وطائرات بدون طيار من طراز “يو إيه في إس” ومركبات تحت الماء غير مأهولة. كما واصلت توسيع ترسانتها النووية، وتعزيز أنواع معينة من قدرات الحرب الفضائية والحرب الإلكترونية، وأنشأت قوات فضاء وقوات فضاء إلكترونية منفصلة في عام 2024.
يبدو الحديث بتوسع عن الصين بشكل تفصيلي في هذا الباب العسكري من باب توضيح الواضحات، فالقوة الصينية من الوضوح والرسوخ بما لا حاجة لاستكشافه، كمثيلتها الأميركية. ولكن ما يهم بالنسبة لمسار التسلح في قارة آسيا–الباسيفيك، أو آسيا–أوقيانوسيا، هو كيف أثّر تراكم القوى العسكرية في الصين على السياسات العسكرية للدول المجاورة، وعلى رأسها بالطبع اليابان، التي تخلت عن نزعتها السلامية (الباسيفية) بكل وضوح بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ رأت في تلك الخطوة أن عالمًا بمنطقه الحالي بات كل شيء فيه ممكنًا.
ومن هذا المنطلق يمكن إيراد قصة قصيرة عن تاريخ اليابان تُعبّر بشكل مكثف عن انتهاء السلامية – التي كانت هشة أساسًا – وذهابها إلى غير رجعة. فاليابان التي ضُربت مثالًا استثنائيًا بعد الحرب، أدرجت في دستورها عام 1946 مادة ثورية هي المادة التاسعة، التي تنص على نبذ الحرب كحق سيادي للأمة، وشجب التهديد أو استخدام القوة كوسيلة لحل النزاعات؛ وذلك في إطار سعيّها للتخلص من ماضيها الإمبراطوري الذي جعلها قوة احتلال على جيرانها في الصين والجزيرة الكورية ومنشوريا وسنغافورة وبورما والهند الشرقية والفلبين، وقوة حرب وتهديد للإمبراطورية الروسية ثم الولايات المتحدة الأميركية.
الباسيفية.. في زمن القنبلة النووية
يبدو تاريخ اليابان مع النزعة (الباسيفية-السلامية)، تاريخًا من المناورة أكثر منه التزامًا صادقًا، ففي سياق الحرب الباردة مع اندلاع الحرب في الجزيرة الكورية، انحازت اليابان للغرب بشكل واضح، واعتبرتها الولايات المتحدة حصنًا معها ضد التهديد الشيوعي في آسيا. بعد انتصار “ماو زيدونج” ومشروعه الشيوعي على كومينتانغ شيانغ كاي شيك عام 1949، أرادت الولايات المتحدة من اليابان أن تعيد النظر في المادة التاسعة مفضلة أن تعيد اليابان تسليح نفسها للمساعدة في الحرب الكورية حينما اندلعت عام 1950، ودعمت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع دولة سُتعرف فيما بعد باسم “كوريا الجنوبية” في مقابل مشروع دولة سُتعرف باسم “الشمالية” دعمتها الصين والاتحاد السوفييتي.
في ذلك الوقت، تحجج رئيس الوزراء الياباني، يوشيدا شيغيرو، بأن الدستور يقيّد يديّه، رغم أنه ود لو أن بإمكانه مساعدة الولايات المتحدة، ولكن ضغوط إعادة الإعمار ستجعل من فكرة أي عودة للعسكرة مرفوضة. رغم ذلك، أسست اليابان عام 1954 ما يُعرف باسم “قوات الدفاع الذاتي” بغرض أن تكون قوات شرطية للضبط الداخلية، سرعان ما سترث الجيش الإمبراطوري بصفة رمادية، لتكون قوة دفاعية عن اليابان في وجه الإتحاد السوفييتي والصين وكوريا الشمالية في زمن الحرب الباردة.
بحلول أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، كما يذكر تيم مارشال في كتابه “سجناء الجغرافيا” يمكن تلمس ظهور النزعة القومية اليابانية مرة أخرى على نحو خافت. كان هناك جزء من الجيل الأكبر سنًا لم تقبل جسامة جرائم الحرب اليابانية قط، وجزء من الشباب ليس مستعدًا لقبول الذنب عن خطايا آبائهم كما أراد العديد من أطفال أرض الشمس المشرقة مكانهم الطبيعي تحت أشعة الشمس في عالم ما بعد الحرب.
أصبحت النظرة المرنة إلى الدستور هي المعيار، وتحولت قوات الدفاع الذاتي اليابانية ببطء إلى وحدة قتالية حديثة. حدث هذا عندما أصبح صعود الصين واضحًا بشكل متزايد، وبالتالي فإن الأمريكيين الذين أدركوا أنهم بحاجة إلى حلفاء عسكريين في منطقة المحيط الهادئ صاروا على استعداد لقبول اليابان المعاد تسليحها.
في عالم ما بعد الحرب الباردة، طمح السياسيون المحافظون إلى دور أكبر في السياسة الدولية، لذلك شعروا بالإهانة حينما لم يستطيعوا إرسال قوات إلى حرب الخليج عام 1991 بسبب دستورهم السلمي، ولكن في وقت لاحق، سيسمح البرلمان الياباني بمشاركة أفرادًا من قوات الدفاع الذاتي في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وداعًا للـ”سلام”
في عام 2010، أتى شينزو آبي رئيسًا للوزراء برؤية تسعى لجعل اليابان “دولة عادية”، وكانت كلمة عادية هنا تعني دولة قادرة على الدفاع عن نفسها وإرسال قوات في مهام خارجية، ضمن رؤيته المسماة “اليابان الجميلة”. وفي هذا الإطار أصدرت اليابان الوثيقة الاستراتيجية الأمنية لعام 2013، التي أسمت فيها أعداؤها المحتملين، الهند والصين، وخصت بالذكر الصين قائلة “لقد أقدمت الصين على إجراءات يمكن وصفها بأنها محاولات لتغيير الوضع الراهن بالإكراه”، حيث تطالب بمعظم بحر الصين الشرقي وجزر سينكاكو.
بلغت ميزانية الدفاع اليابانية عام 2015 رقمًا قياسيًا قدره 42 مليار دولار أمريكي، وزادت مرة أخرى في العام الذي يليه لتصل إلى 44 مليار دولار. خُصص معظم ذلك للمعدات البحرية والجوية، بما في ذلك ست غواصات جديدة وستة مقاتلات “إف 35 ستيلث” أمريكية الصنع. وفي ربيع 2015، كشفت طوكيو أيضًا عن مدمرة حاملة مروحيات كما أسمتها. ولم يتطلب الأمر خبيرًا عسكريًا لكي يلاحظ أن السفينة كانت كبيرة بحجم حاملات الطائرات اليابانية في الحرب العالمية الثانية، وهي نوع تحظره شروط الاستسلام عام 1945. هذه السفينة يمكن تكييفها لحمل الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، لكن وزير الدفاع أصدر بيانًا قال فيه إنهم “لا يفكرون في استخدامها كحاملة طائرات”. لكن النتيجة أن اليابانيين لديهم الآن حاملة طائرات.
قد كان هذا حتميًا ليجابه طموحات الصين التي بدأت في توسعة منطقة دفاعها الجوية عام 2013 لتشمل الأراضي التي تطالب بها في اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية. لذلك حاولت اليابان أن تكون تلك الأموال المُنفقة بمثابة بيان واضح النوايا، فالبنية العسكرية التي في جزيرة “أوكيناوا” والتي تحرس مدخل الجزر الرئيسية، ستسمح لليابان بقدر من المرونة للقيام بدوريات في منطقة الدفاع الجوي التي يتداخل جزء منها مع منطقة الصين.
تتصادم منطقتا الدفاع في الجزر المسماة “سينكاكو” باليابانية، أو “دياويو” بالصينية، وهي التي تسيطر عليها اليابان وتطالب بها الصين، كما أنها تشكل جزءًا من سلسلة جزر ريوكيو التي تعتبر حساسة بشكل خاص، لأن أي قوة معادية يجب أن تمر بالجزر في طريقها إلى المناطق الحيوية اليابانية، لذا تكمن أهمية تلك الجزر في منح اليابان الكثير من المساحة البحرية الإقليمية، وقد تحتوي على حقول غاز ونفط تحت الماء قابلة للاستغلال.
تعرضت الباسيفية إلى إهانة أخرى في عام 2019، في تلك المرة كانت من الحليف الأكبر، والحامي، الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اتهم دونالد ترامب في خطاب له اليابان باستغلال حماية الولايات المتحدة، ودعاها إلى إعادة عسكرة البلاد بسبب عدم عدالة الاتفاقيات الدفاعية، رغم أن هذا كان منافيًا للحقائق، فاليابان تتحمل من تكاليف القواعد الأمريكية على أراضيها أكثر من أي حلفاء آخرين للولايات المتحدة، بنسبة تصل إلى 55% من التكلفة.
إلى أن جاء الغزو الروسي لأوكرانيا ليُعزز الشعور بالتخلي عن الباسيفية، لدى اليابانيين أنفسهم أكثر من حكومتهم، ففي استبيان أجرته صحيفة “أساهي شيمبون” تبيّن أن 64% من الناخبين اليابانيين يريدون أن تعزز اليابان قدرتها الدفاعية، وللمرة الأولى منذ بدء مثل هذه الاستطلاعات في عام 2003، تجاوزت نسبة هؤلاء 60%. فعندما بدأ الاستطلاع في أعقاب غزو العراق، أيد 48% تعزيز اليابان قدراتها الدفاعية، وارتفعت النسبة إلى 57% في نهاية عام 2012 عندما كانت النزاعات الإقليمية تهدد علاقات اليابان مع الصين وكوريا الجنوبية.
عودة الجيش الإمبراطوري للعمل
وفقًا لتقرير (سيبري) 2024، تُعد اليابان هي الدولة العاشرة الأكثر إنفاقًا في العالم، بزيادة نفقاتها العسكرية خلال العقد الأخير بنسبة 49%. بدايًة ارتفع الإنفاق العسكري الياباني خلال السنة الأخيرة، بنسبة 21% ليصل إلى 55.3 مليار دولار في عام 2024، وهي أكبر زيادة سنوية منذ عام 1952، وبلغ عبء ذلك الإنفاق العسكري 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1958.
يتساوق ذلك التنامي في الإنفاق مع الاستراتيجية الدفاعية الجديدة التي كشف عنها رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عام 2022، والتي تتضمن استثمار حوالي 314 مليار دولار في القوات المسلحة على مدى السنوات الخمس 2022-2027، ورفع ميزانية الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، تريد اليابان بحلول عام 2027 أن تُزيد نفقاتها العسكرية بنسبة 60%، لتصبح ثالث أكبر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. تُركز تلك الاستراتيجية الدفاعية على قدرات الضرب بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي، وقد أنفقت اليابان في عام 2024 على تلك الأنظمة فقط 13 مليار دولار. ورغم ذلك التوجه الدفاعي، فلقد زادت اليابان من شراء أسلحة “هجومية” مثل 400 من صواريخ توماهوك الأمريكية، مما يضع استراتيجية اليابان “الدفاعية” البحتة، موضع شك وتساؤل.
كذلك تعمل اليابان على تطوير نسختها الخاصة من صواريخ تايب-12 بحيث يصل مداها من 200 كم إلى 1000 كم لتُطلق بحرًا وبرًا وجوًا لتصل إلى مناطق استراتيجية داخل الصين أو كوريا الشمالية في حالة الحرب. وتقوم أيضًا على تعديل مدمرتيّ الهيلكوبتر “إيزومو” و”كاغا” ليصبحا حاملتيّ طائرات خفيفتين قادرتيّن على تشغيل مقاتلات من طراز إف-35ب، وهذا يعطيها القدرة على إبراز القوة الجوية في البحر لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. كذلك تُعد اليابان أكبر مشترٍ طائرات الإف-35 الشبحية، حيث طلبت 147 طائرة بدأت في الحصول عليهم في عام 2025. وتشرع اليابان في بناء سفينتين جديدتين مخصصتين للدفاع الصاروخي الباليستي كبديل لنظام “أجيس أشور” الذي تم إلغاؤه لتعزيز حمايتها من الصواريخ.
كانت اليابان تفتخر بامتلاكها ثلاثة مبادئ أساسية، هي عدم امتلاك الأسلحة النووية، وعدم إنتاجها، وعدم استيرادها، وقد أصبحت هيروشيما مركزًا لمقاومة السلاح النووي في العالم، حتى أن رئيس الوزراء الياباني في عام 2023 أرسل منها رسالة إلى بوتين في قمة السبع الكبار، داعيًّا إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية. رغم ذلك، ترى بعض التقارير، أن التوجه الياباني لإعادة التسلح، قد يدفعها إلى محاولة امتلاك سلاح نووي، وخصوصًا وأن اليابان ليست من الدول المُوقعة على المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة النووية. وتمتلك اليابان بالفعل نحو 45 طنًا من البلوتونيوم، يكفي تسعة أطنان منها لصنع مئات الرؤوس النووية، مما يجعلها من الدول ذات المخزون الأكبر عالميًا.
سوق شرق آسيا.. وصائد الجوائز الأمريكي
إن النزعة التسلحيّة في شرق آسيا، لا تنحسر بين ثبات الصين في إنفاقها، وتوجه اليابان إلى الإنفاق العسكري بشراهة، ففي عام 2024 أيضًا، أنفقت كوريا الجنوبية وفقًا لتقرير (سيبري) 47.6 مليار دولار على الجيش، بزيادة قدرها 1.4% عن عام 2023 و30% عن عام 2015، وبذا، أصبحت كوريا الجنوبية تُعد كالدولة صاحبة أعلى عبء عسكري في شرق آسيا (2.6% من الناتج المحلي الإجمالي). وقد واصلت مسعاها في الحصول على أنظمة الضربة الاستباقية، مثل الصواريخ الباليستية وطائرات إف-35أ المقاتلة، ضمن برنامج الشراء واسع النطاق الذي يهدف إلى مواجهة التهديد المتزايد من كوريا الشمالية التي يُصعب من ناحيّتها رصد كم إنفاقها العسكري بسبب طبيعتها المغلقة.
وهناك في الجزيرة التايوانية، التي يُعتقد أنها ستكون مسرحًا للحرب العالمية الثالثة في أكثر السيناريوهات تشاؤمًا بشأن مستقبل العالم، زادت تايوان إنفاقها العسكري بنسبة 1.8% ليصل إلى 16.5 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 48% عن عام 2015. وتواصل تايوان شراء الأسلحة الأمريكية وتطوير الأنظمة المحلية، وكشفت تايوان في عام 2024 عن طائرات بدون طيار وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار المُصنعة محليًا، وخصصت حوالي 18% من ميزانيتها للأنظمة البحرية الأمريكية وتحديثات طائراتها المقاتلة إف-16.
سيكون جدير بالذكر أيضًا أن نُشير إلى دولة ميانمار، التي بلغ إنفاقها العسكرية 5 مليارات دولار في عام 2024، لتزيد إنفاقها بنسبة 66% ليرتفع العبء العسكري من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.8% لتصبح بذلك صاحبة أكبر زيادة سنوية في الإنفاق وأعلى عبء عسكري مسجل في آسيا وأوقيانوسيا في عام 2024.
في ذلك المناخ المشتعل في قارة آسيا، تقف الولايات المتحدة كرابح أكبر، فلقد نما تصدير الأسلحة الأمريكية بنسبة 21% بين عاميّ 2015-2019 و 2020-2024 وتزايدت حصتها في صادرات الأسلحة العالمية من 35% إلى 43%، وفي تلك الفترة، تلقت الدول في آسيا وأوقيانوسيا، نسبة 28% من صادرات الأسلحة الأمريكية، فلقد مثلت اليابان 8.8% من إجمالي صادرات الأسلحة الأمريكية، وراءها أستراليا 6.7%، ثم كوريا الجنوبية 5.3%، وكانت تايوان المستلمة الثامنة عشرة بنسبة 1.5%.
وستبدو الأرقام أكثر إدهاشًا حينما نقرأها بشكل معكوس، لنتبيّن مقدار التبعيّة في التسلح العسكري للولايات المتحدة. فلقد شكلت الولايات المتحدة 97% من واردات اليابان و86% من واردات كوريا الجنوبية من الأسلحة بين عاميّ 2020-2024، ولكن في العموم، تحاول الدولتيّن تنويع مصادر أسلحتهما مستقبلًا وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، فدولة كوريا الجنوبية مثلًا قد انخفضت وارداتها بنسبة 24% عمومًا بين عاميّ 2020-2024، وفي نفس النهج تسير تايوان التي انخفضت وارداتها من الأسلحة بنسبة 27%.
رغم المرارة، شهدت الفترة الأخيرة تقاربًا بين كوريا الجنوبية واليابان، رغم عقودًا من رفض اليابان الاعتراف بجرائم الحرب في فترة احتلالها الجزيرة الكورية، التي خلفت مرارة في حلق الكوريين، جعلت العلاقة بينهم وبين اليابانيين فيها جفوة، لكن عالمًا تنهض فيه الصين بحجمها الضخم، اقتصاديًا وبشريًا وجغرافيًا، بالتأكيد بإمكانه أن يؤجل كل شيء جانبًا ولو لفترة مؤقتة، وهنا نستشهد مرة أخرى بتيم مارشال القائل “إن لدى اليابان وكوريا الجنوبية الكثير مما يتجادلان بشأنه، لكنهما تتفقان على أن قلقهما المشترك بشأن الصين وكوريا الشمالية يتغلب على مشاكلهما الخاصة، وحتى إذا استمرتا قدمًا في حل مشكلة مثل كوريا، فإن قضية الصين ستظل قائمة، وهذا يعني أن الأسطول الأمريكي السابع سيبقى في خليج طوكيو، وأن مشاة البحرية الأمريكية سيبقون في أوكيناوا، لحراسة الممرات البحرية من وإلى المحيط الهادئ وبحر الصين. إنها المياة التي من المتوقع أن تصبح قاسية خشنًة”. وفي ظل مسرحًا منصوبًا بهذا الشكل، ومفتوحًا على كل الاحتمالات، لا يوجد مكانًا أكثر مثالية لتندلع فيه حرب تُنهي كل الحروب، والسلام.