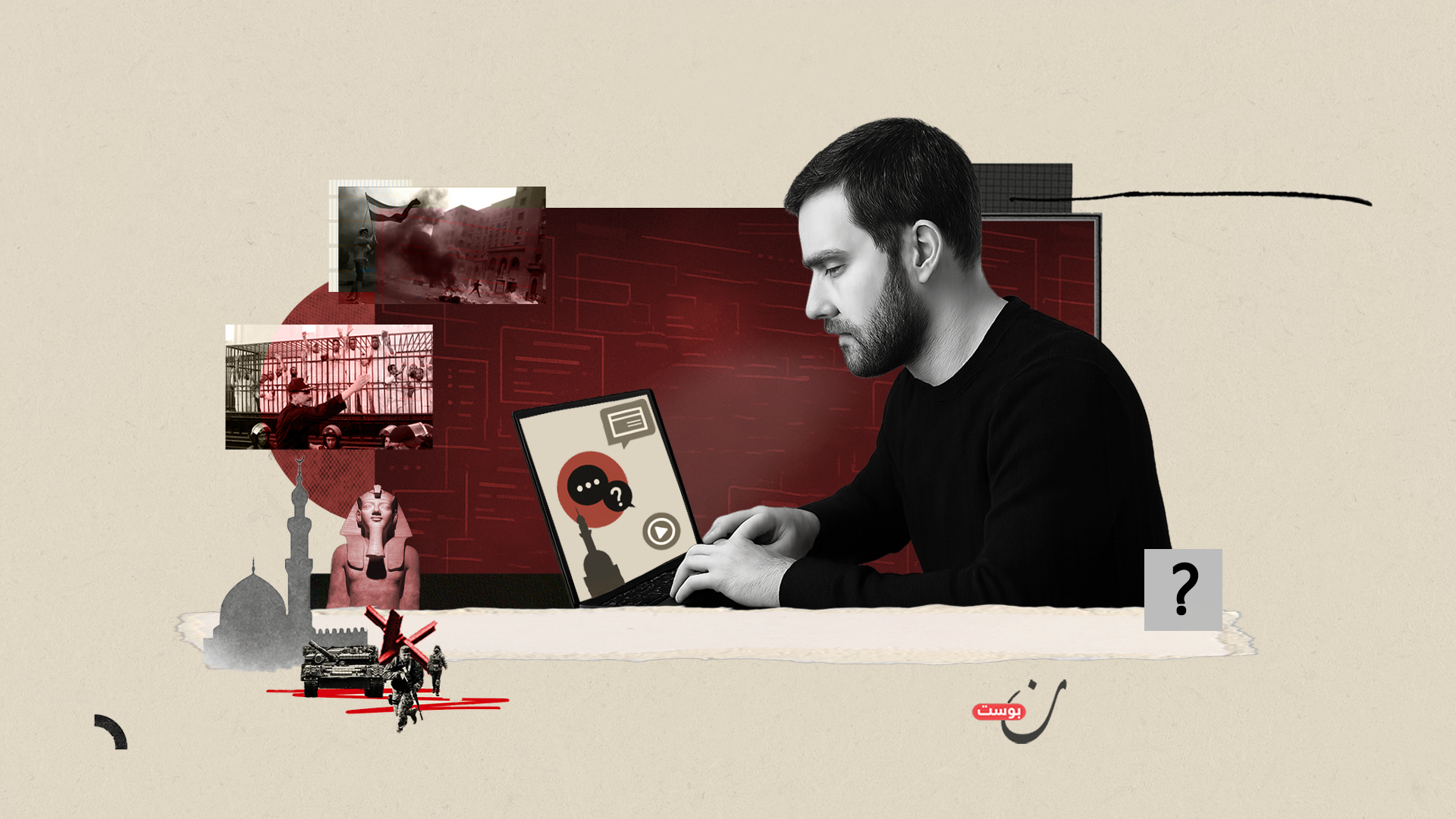في منتصف عام 2013، شهدت الحركة الإسلامية المصرية منعطفًا مفصليًا، إذ انهارت مشاريعها السياسية وتفككت بنيتها التنظيمية والفكرية التي شكلت أساس حضورها لعقود، ترافق ذلك مع حملات اعتقال واسعة استهدفت قياداتها وتشويه صورتها العامة.
لكن من قلب هذا الانهيار، بدأ يتبلور جيل جديد من الشباب الإسلامي المصري، لم يكتفِ بتجاوز آثار الهزيمة السياسية التي أصابت آبائه، بل سعى إلى إعادة تعريف علاقته بالدين والهوية من منظور ذاتي أكثر استقلالًا.
ومع انفتاحه على الفضاء الرقمي وتفاعله مع تجارب فكرية واجتماعية متنوعة، تجاوز هذا الجيل النماذج التقليدية للحركات الإسلامية المصرية، متجهًا نحو مقاربات أكثر واقعية في التعامل مع الدين والسياسة والمجتمع.
وقد تبلور وعي هذا الجيل في سياق ما بعد 3 يوليو 2013، بالتزامن مع تقدم القيادات الإسلامية القديمة في السن وتراكم إخفاقات المشروع الإسلامي السياسي، ما جعل هذا الجيل يبرز بوصفه حالة استثنائية تحمل ملامح التحول والتجديد داخل التيار الإسلامي المصري.
تكتسب دراسة هذا الجيل أهمية خاصة لكونه يمثل فضاءً جديدًا يمكن من خلاله استشراف مستقبل التيار الإسلامي واتجاهات التدين في مصر، ومن هذا المنطلق، يتناول هذا التقرير تحولات الوعي والهوية لدى الجيل الإسلامي المصري الجديد بعد عام 2013، محللًا كيف أعاد هذا الجيل صياغة فهمه لذاته ولدينه في ظل القمع وانهيار المشاريع الإسلامية التقليدية.
تفكيك الإسلاميين ومحاولة صناعة وعي بديل
بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013، دخلت البلاد مرحلة جديدة اتسمت بتغول الأجهزة الأمنية على كامل المجال الإسلامي العام. وأطلق نظام السيسي حملة واسعة استهدفت تفكيك البنى التنظيمية التي شكلت عماد الحركة الإسلامية لعقود، وتجفيف منابع النشاط الدعوي المستقل.
فتم إغلاق الجمعيات الخيرية، ومصادرة المراكز التعليمية، وتجميد أنشطة المؤسسات الدعوية الصغيرة التي كانت تشكل فضاءات حيوية للنشاط الأهلي الحر، وقد طالت الإجراءات أكثر من ألف جمعية ذات خلفية إسلامية، في خطوة هدفت لإحكام السيطرة على المجالين الديني والاجتماعي، وإعادة ترسيخ هيمنة الدولة الأمنية عليهما بشكل كامل.
وتزامنت هذه الإجراءات مع واحدة من أوسع موجات الاعتقال في التاريخ المصري الحديث، طالت قيادات الصف الأول وطلاب الجامعات والنشطاء المستقلين من مختلف التيارات الإسلامية، ما أدى إلى تفريغ المشهد الإسلامي من فاعليه التقليديين.
وحتى التيار السلفي العلمي الذي حاول التماهي مع السلطة حفاظًا على وجوده، فقد كثيرًا من قاعدته الاجتماعية بعدما اعتبره كثير من الشباب متواطئًا مع النظام، فقد تحول خطابه إلى امتداد رسمي للدولة أكثر منه تيارًا دعويًا مستقلًا كما كان قبل 2013.
في المقابل، سعى النظام منذ عام 2014 إلى ملء الفراغ الذي خلفه تراجع الحضور الإسلامي الحركي، من خلال تبني سردية “الفرعونية” كمرتكز جديد للهوية الوطنية، تجلى ذلك في الخطاب الرسمي والمشاريع الثقافية والمعمارية والمناهج التعليمية التي أعادت إحياء رموز الحضارة المصرية القديمة لترسيخ هوية بديلة في مواجهة أي سرديات إسلامية منافسة.
تحية عسكرية وموكب رئاسي.. استقبال ملوك يليق بالفراعنة 🔥
في موكب مهيب.. لحظة استقبال مومياوات ملوك وحكام مصر القدماء 🫡 #CBC pic.twitter.com/puIxzjSxXh— CBC Egypt (@CBCEgypt) October 30, 2025
لكن رغم تغييب التيار الإسلامي الحركي من المشهد منذ عام 2013، ما تزال الساحة المصرية تخلو من قوة بديلة، فقد تهاوت أغلب المبادرات الدعوية الصغيرة والمستقلة، وتراجع النشاط الإسلامي الحر حتى كاد يختفي، تاركًا مساحة واسعة خالية في الحقلين الديني والاجتماعي، وحتى الآن، لم تنجح أي مؤسسة أو تيار في ملء هذا الفراغ أو تقديم بديل مؤثر.
فالقوى الأزهرية والسلفية والصوفية عجزت عن إنتاج مشروع يمتلك الجاذبية الشعبية التي تمتع بها التيار الإسلامي الحركي لعقود، كما لم تنجح مبادرات شيخ الأزهر أحمد الطيب والمؤسسات الرسمية في بناء قاعدة اجتماعية مؤثرة كتلك التي مثلها التيار الإسلامي الحركي قبل إقصائه.
في ظل هذا الواقع، ومع تشتت قيادات الحركة الإسلامية المصرية بين المنافي والسجون، وإسكات ما تبقى منهم داخل البلاد أو إقصائهم عن أي دور عام، وجد الجيل الإسلامي الجديد نفسه بلا مرجعية تربوية أو تنظيمية تقوده، وهكذا بدأ هذا الجيل رحلة بحثٍ عن ذاته خارج الأطر التقليدية.
من التنظيم إلى الفردانية: ملامح الجيل الإسلامي بعد 2013
بعد عام 2013، دخل الوعي الإسلامي الشاب في مصر مرحلة مفصلية، إذ انهارت التنظيمات الإسلامية التقليدية وتفككت مرجعياتها الفكرية، لتجد الأجيال التي وُلد أغلب أفرادها بين منتصف التسعينيات ومنتصف العقد الثاني من الألفية نفسها أمام مشهد ديني وسياسي مغاير تمامًا لما عرفته الأجيال السابقة.
كان هؤلاء الشباب قد عاشوا طفولتهم في أواخر عهد مبارك، ثم تفتحت أعينهم على الثورة والانقلاب، فاختبروا انهيار البنى الدعوية والتنظيمية التي كانت تمثل سابقًا إطارًا جامعًا للهوية والتكوين.
في ظل غياب تلك الأطر وضمور المساحات التقليدية للتربية والتكوين، برز جيل جديد صاغ وعيه وممارساته عبر العالم الرقمي، فقد صار الفضاء الإلكتروني هو المدرسة والمجتمع والمنتدى، يحل محل المساجد والدروس الحركية والدوائر التربوية القديمة.
ومن خلاله تشكل وعي يقوم على الانتقاء والخبرة الشخصية، ويجمع بين التراث الإسلامي وأدبيات التنمية الذاتية والأفكار الاجتماعية والفلسفية الحديثة، لتظهر ملامح تدين فردي، بعيد عن الالتزام الحركي الصارم الذي ميز العقود السابقة.
وتشير ملامح هذا الجيل إلى ميلٍ متزايد لرؤية الإسلام كهوية ثقافية وروحية قبل أن يكون مشروعًا سلطويًا أو برنامجًا سياسيًا. ويتجه كثير من هذا الجيل نحو الإصلاح الاجتماعي والتربوي والعمل الفردي، بدلًا من الانخراط التنظيمي أو الصدام السياسي المباشر. ومع ذلك، يعيش هذا الجيل توترًا بين الذاكرة والقطيعة، إذ يحمل من تجارب آبائه التنظيميين إحساسًا بالخيبة والانكسار، لكنه يسعى لتجاوزها وبناء مسار جديد دون قطيعة كاملة مع جذوره.
وتبرز السمة الأوضح لهذا الجيل في “اللا تنظيمية”، فقد تراجع الانتماء الحركي لمصلحة المبادرات الفردية والمشاريع الصغيرة والمحتوى الرقمي، ما منحه حرية واسعة في التفكير وطرح الأسئلة، لكنه في المقابل خلق حالة من التشتت وغياب المشروع الجماعي المتماسك، في ظل فقدان مرجعية توحد الرؤية وتضبط المسار ضمن إطار عملي مشترك.
اجتماعيًا ونفسيًا، فقدت شرائح من الشباب الإسلامي الروابط الجماعية التي وفرتها التنظيمات سابقًا، ما ولد لدى البعض إحساسًا بالانفصال والبحث عن بدائل، وفي مواجهة هذا الفراغ، اتجه كثير منهم إلى بناء دوائر رقمية مرنة وعلاقات معرفية غير مؤسسية.
وبالتوازي مع انسداد الأفق السياسي، برز توجه واضح نحو “التمكين الفردي” عبر النجاح المهني والاقتصادي وريادة الأعمال والعمل الحر، باعتبارها مسارات لاستعادة الفاعلية دون صدام مباشر مع السلطة.
وهكذا يتبلور منذ 2013 نمط جديد داخل شريحة واسعة من الشباب الإسلامي في مصر، نمط أكثر فردانية ورقمنة ونزعة نقدية، يحاول التوفيق بين ميراث ثقيل وواقع اجتماعي وسياسي مختلف عن ما عرفته الأجيال السابقة. هذا الجيل يسعى إلى إيجاد مساحات بديلة للانتماء والتأثير خارج الأطر التنظيمية الكلاسيكية التي لم تعد متاحة أو مناسبة لتعقيدات المرحلة الراهنة.
التحولات الفكرية لجيل الإسلاميين الجدد بعد 2013
شهد العقد الذي تلا عام 2013 تحولات عميقة في وعي شريحة واسعة من الشباب الإسلامي المصري، إذ تركت أحداثه السياسية والفكرية أثرًا بالغًا على تصوراتهم للعالم ولأنفسهم، بجانب زعزعة العديد من المسلمات التي كانت راسخة في أذهان أجيال الإسلاميين.
وقد مثل هذا التحول نهاية مرحلة امتدت منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين استندت الحركات الإسلامية الحركية إلى أيديولوجيا كبرى تسعى لتغيير المجتمع وإقامة نموذج الدولة الإسلامية، وعاشت الأجيال الإسلامية السابقة بمختلف تنوعاتها قبل عام 2013 داخل إطار فكري وتربوي تشكل أساسًا حول فقه المحنة والاستضعاف.
وخلال تلك المرحلة، انشغلت المناهج الدعوية للحركة الإسلامية بالسيرة والعبادات والفقه، بينما غاب عنها تطوير تصور متكامل للدولة الحديثة أو أدوات لإدارة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ولذا لم ينتج الإسلاميون المصريون في أغلبهم قبل 2013، تنظيرًا جادًا في قضايا الحكم والعلاقات الدولية ومؤسسات الحكم، بخلاف مدارس فكرية أخرى كانت أكثر انخراطًا في دراسة المجتمع والسياسة.
وقد ظهر هذا الخلل بوضوح في مصر بعد الثورة، إذ ازدحمت المكتبات الإسلامية بكتب السحر والجن والحسد، بينما ندرت المؤلفات التي تعالج قضايا الاقتصاد والطبقات الاجتماعية والتحولات السياسية، في حين كانت التيارات اليسارية تُقدم رؤى عملية ومقاربات اجتماعية.
ومع وصول الإسلاميين إلى الحكم بعد 2011، تكشفت الفجوات المعرفية بوضوح، فبدا العجز عن التعامل مع مؤسسات الدولة وبخاصة فهم وإدراك طبيعة العلاقات المدنية–العسكرية، ما كشف محدودية الخبرة السياسية وضعف فقه الدولة لدى التيار الإسلامي الحركي.
ثم جاء الانقلاب العسكري في 2013 ليطيح بالبنى التنظيمية والدعوية، وينهي فعليًا مرحلة الإسلام السياسي التقليدي، تاركًا الجيل الجديد دون مرجعيات فكرية مؤسسية أو مسارات تربوية كما كان لدى الأجيال السابقة.
وفي هذا الفراغ، توجه عدد كبير من الشباب إلى الفضاء الرقمي كمصدر رئيس للمعرفة والتكوين، ما أدى إلى إعادة التفكير في مفاهيم الدولة والهوية والعدالة والتغيير، وظهور نمط تدين انتقائي يمزج بين التراث الإسلامي وأدبيات التنمية الذاتية والفلسفة والعلوم الاجتماعية. ومع تراجع المرجعية الهرمية القديمة، انتقلت بوصلة التأثير نحو المرجعية الشبكية، ليبرز باحثون مستقلون ومؤثرون رقميون في تشكيل وعي بديل عن القيادات التقليدية.
وقد انخرط هذا الجيل في برامج تعليمية ودورات شرعية وسياسية عبر الإنترنت، وشارك في مجموعات قراءة ومنصات نقاش مغلقة، مستفيدًا من فضاء رقمي مفتوح أتاح له بناء وعيه خارج الأطر التقليدية.
ومع توسع المنصات الرقمية، ظهر جيل جديد من الدعاة والمفكرين الذين اتخذوا من الإنترنت منبرًا بديلًا لكسر احتكار الخطاب الديني الكلاسيكي، ومنهم أحمد السيد وغيرُه، ممن قدموا طرحًا أقرب لأسئلة الشباب وتجاربهم، وبعيدًا عن لغة التنظيمات وأولوياتها.
وبالتالي في هذا السياق الجديد، اتجه الجيل الذي تشكل وعيه بعد 2013 إلى فهم أعمق لبنية الدولة ونظريات الحكم والعلاقات الدولية، وتوسعت اهتماماته لتشمل العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي غابت عن أذهان الأجيال السابقة.
في الواقع، لم يعد الخطاب السائد بين هؤلاء الشباب وعظيًا أو فقهيا تقليديًا، بل صار أكثر انفتاحًا على المدارس الفكرية المختلفة، وأكثر بحثًا عن أدوات واقعية لفهم المجتمع وإدارته، في محاولة واعية لتجاوز حدود التجربة السابقة وصياغة وعي جديد يتلاءم مع تعقيدات الواقع ومتطلبات التغيير.
من الجدير بالملاحظة أن وعي الجيل الإسلامي بعد عام 2013 تشكل في سياق مليء بالأسئلة والخيبات التي أعقبت سقوط المشروع الإسلامي السياسي التقليدي، ما جعله أكثر استعدادًا للمراجعة والنقد وعدم قبول الخطاب القديم. وقد دخل هذا الجيل في مرحلة يمكن وصفها بـ“ما بعد الأيديولوجيا”، مبتعدًا عن الانتماءات التنظيمية ومتجهًا نحو فضاء معرفي مفتوح يقوم على البحث الحر والتفاعل الرقمي.
كما اتسم هذا الجيل بقدرته الأكبر على التحليل مدفوعًا بالدروس القاسية التي أفرزتها التجربة السياسية للإسلاميين، فبدل الاندفاع خلف الشعارات والولاءات التنظيمية، بات أكثر ميلًا إلى المقاربة الواقعية التي تراعي توازنات القوى وتعقيد المشهد العام.
ومع اتساع حضور الفضاء الرقمي بعد 2013، بدأ عدد من الشباب الإسلامي في إنشاء منصات وأكاديميات فكرية مستقلة، ومدونات ودورات تحليلية تناقش قضايا الدولة والتحول السياسي، جامعِين بين الهم الديني والدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة. وقد عكس هذا التوجه رغبة متنامية في تجاوز فقه المحنة والاستضعاف، والسعي نحو بناء فهم أعمق لمتطلبات الإصلاح والتغيير.
وبالتالي، تحول مركز إنتاج المعرفة الإسلامية من المؤسسات التقليدية إلى الفضاء الشبكي، فلم تعد المرجعية محصورة في هياكل تنظيمية أو قيادات بعينهم، بل بات التشكل الفكري يجري أفقيًا عبر التفاعل والبحث الحر. وظهرت تيارات جديدة لا مركزية، تستمد شرعيتها من التأثير الرقمي بدل الأطر الهرمية القديمة.
كذلك أظهر الجيل الجديد استعدادًا أكبر للتفاعل النقدي مع قضايا فكرية واجتماعية واسعة، من النسوية والعلمانية والإلحاد إلى النقاشات داخل التيار الإسلامي نفسه، وغدا طرح الأسئلة ومراجعة المسلمات جزءًا من الممارسة اليومية.
أما على الصعيد السياسي، فقد ولد سقوط التجربة الإسلامية في الحكم حالة من الحذر لدى الشباب تجاه العمل السياسي المباشر، ولذا اتجه كثير منهم إلى التمكين الفردي عبر النجاح المهني والتعليمي بدل الانخراط في مشاريع صدامية أو تنظيمية، ومع ذلك، لم تغب السياسة عن وعي هذا الجيل، بل تحولت إلى اهتمام نقدي يتجنب المغامرة ويقرأ الواقع بعيون أكثر حذرًا وواقعية.
وجدير بالذكر أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا ملحوظًا في مسار العديد من الشباب الإسلامي المصري، حيث اختار كثير منهم تغيير مسارهم الأكاديمي والمهني من تخصصات العلوم الطبية والهندسية نحو مجالات العلوم السياسية والاجتماعية.
وإلى جانب التحول الفكري، برزت لدى هذا الجيل رغبة واضحة في توثيق التجربة ومراجعتها، إذ شرع شباب كثيرون في سرد شهاداتهم عما جرى خلال العقد الماضي من قمع، ونفي، وسجن، وتفكك تنظيمي، وتحولات داخل الحقل الإسلامي نفسه.
لم تعد التجربة حكرًا على القيادات أو الروايات الرسمية، بل باتت تُروى من أسفل، عبر تدوينات ومقاطع مصورة، ومنصات بودكاست، تحاول تحليل الأخطاء وتقديم دروس عملية للجيل اللاحق.
كذلك شكل المنفى والشتات نقطة تحول مركزية في إعادة صياغة وعي الجيل الإسلامي المصري الجديد، فمع اتساع دائرة القمع، اضطر كثير من الشباب إلى مغادرة البلاد نحو تركيا وقطر وأوروبا، ليجدوا أنفسهم في فضاءات اجتماعية وثقافية وسياسية مغايرة تمامًا لما عرفوه داخل مصر، وهناك، بدأت عملية مراجعة عميقة للتجربة السابقة، وإعادة تفكيك مفاهيم الدين والسياسة والمجتمع من منظور أكثر واقعية وانفتاحًا.
ومع مرور الوقت، لم يعد المنفى مجرد ملاذٍ من القمع، بل تحول إلى فضاءٍ للتفكير وإعادة التكوين، حيث التقت الخبرات المصرية مع مؤثرات فكرية ودينية من شعوب ومجتمعات متعددة، وبرز جيل من “المنفيين الرقميين” الذين أنشأوا عبر الإنترنت شبكات فكرية ودعوية جديدة تجاوزت حدود التنظيمات التقليدية.
وقد ساهم هذا التفاعل في تطوير خطاب إسلامي أكثر مرونة وانفتاحًا، يقوم على تعدد المرجعيات والتجريب والنقد الذاتي، ويمزج بين الحس الديني العميق والتفاعل الواعي مع قيم الحداثة والحرية والمواطنة.
وهكذا، يجد الجيل الإسلامي الجديد نفسه في طور تشكل مختلف، يبني رؤيته خارج الأسوار التنظيمية التقليدية، ويتميز بمرونة فكرية ونزعة فردانية واضحة، مع انفتاح واسع على العلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، إنه جيل يعطي الأولوية للقراءة والتحليل على الانفعال والمواقف المسبقة، وينظر إلى تراث الحركة الإسلامية كتجربة تستحق المراجعة والتفكيك لا التكرار والاستعادة.
رماد الهزيمة: إعادة التكوين بعد السقوط
بعد سقوط المشروع الإسلامي السياسي عام 2013، وجد جيلٌ واسع من الشباب الإسلامي نفسه أمام ضرورة إعادة التكوين، ومع انتقال جزء منهم إلى المنفى، وانفتاح آخرين عبر الفضاء الرقمي على عوالم معرفية متعددة، بدأت عملية إعادة بناء الوعي على أسس أكثر فردانية ونقدًا واستقلالًا عن الأطر الأيديولوجية الصلبة.
وعند مقارنة هذا الجيل بجيل ما قبل ثورة 2011، يتضح التحول بجلاء، فجيل ما قبل ثورة يناير كان يتحرك داخل بنى تنظيمية واضحة، يحمل مشروعًا سياسيًا ووعودًا تغييرية كبرى، ويستند إلى خطاب جماعي يميل إلى الصرامة.
أما الجيل الذي تبلور بعد عام 2013، فقد اتجه إلى التحرر من تلك البنى، وانصرف عن العمل السياسي المباشر، مركزًا على التدين الفردي وبناء الذات الروحية والفكرية، مع حضور قوي في الفضاء الرقمي والتعبير الشخصي.
ولم يكن ذلك مجرد انسحاب أو انكفاء، بل شكل تحولًا جذريًا نحو رؤية أكثر واقعية وعقلانية، فقد بدأت الهوية الإسلامية المصرية تُعاد صياغتها بعيدًا عن منطق الجماعة والالتزام التنظيمي، لتتشكل بنبرة أكثر مرونة وتحليلًا دون التخلي عن سؤال الإصلاح والرسالة.
ولا شك أن الوعي السياسي لدى الجيل الإسلامي الجديد بات أكثر اتساعًا مقارنة بالأجيال السابقة، فقد انفتح هذا الجيل على مصادر متعددة للمعرفة السياسية، من المنصات الأكاديمية إلى برامج التدريب المتخصصة والبودكاست والمحتوى التحليلي عبر الإنترنت.
لم يعد هؤلاء الشباب اليوم ينظرون إلى المشهد بعين الجيل القديم، فقد تغيرت زوايا الرؤية، وصارت التجربة وحدة الواقع وكثافة الأسئلة تصوغ إدراكًا مختلفًا. وفي الواقع، يثير هذا الجيل الإسلامي الجديد قلق النظام، ليس لأنه قد ينخرط في مواجهة مباشرة أو تنظيمات سرية، بل لأنه يتشكل خارج أدوات الضبط التقليدية، وبخطاب هادئ يصعب تأطيره أو استهدافه.
فقد لاحظت الدولة بروز منصات شبابية رقمية قادرة على التأثير في الوعي العام دون رفع شعارات صدامية، الأمر الذي دفع مؤسساتها إلى عقد مؤتمرات وندوات للتحذير من “المنصات غير الرسمية” و”الدعوات المموهة عبر الفضاء الإلكتروني”.
هذا القلق يعكس إدراكًا رسميًا بأن الخطر الحقيقي لا يكمن في التنظيمات الكلاسيكية التي جرى تفكيكها، بل في وعي جديد يتشكل بصمت ويتحرك أفقيًا، ويتغذى من المعرفة الرقمية وفضاءات النقاش الحر، بعيدًا عن القبضة الأمنية وخطابات الدولة الموجهة.
وبالتالي، يمكن النظر إلى الجيل الإسلامي الجديد لا بوصفه جيل هزيمة، بل جيلًا انتقاليًا يفتح الطريق نحو طور جديد في تاريخ التدين المصري، طور يتجاوز الصدام ويبحث عن أدوات أكثر نضجًا للتأثير والإصلاح.
وهذه التجربة تفتح الباب أمام تساؤل أوسع حول مستقبل التدين في مصر: هل يمكن أن يولد مشروع إسلامي جديد أكثر مرونة وتوازنًا؟ تشير المؤشرات الراهنة إلى إمكانية تبلور خطاب إسلامي متجدد يوازن بين النقد والانفتاح الاجتماعي، ويتجاوز الصدام ويركز على إنتاج معرفة تستجيب لتحولات العصر
ومع تراكم الخبرات واتساع دائرة الانفتاح على التجارب المحيطة، يتبلور حاليًا ما يمكن تسميته بـ“الإسلام المصري الجديد”، إسلام لا يتقيد بقوالب أيديولوجية أو هياكل تنظيمية، ولا يُختزل في الشعارات، بل يتجسد في رؤية أكثر هدوءًا ومرونة واتزانًا. هو مسعى لإعادة تعريف الدين والهوية في ضوء ما تركته تجارب الانكسار من وعي، وما أتاحه الانفتاح على التجارب الأخرى من إمكانات جديدة للفهم والممارسة.