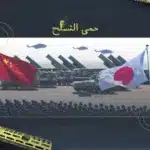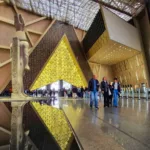جاء في تقرير لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية أن “ميغان هول اضطرت لبيع أثاثها لتوفير المال اللازم لدفع الإيجار لإحدى العائلات في غزة”، ويعرض التقرير تراجعًا كارثيًا في حجم التبرعات العالمية الموجّهة للقطاع، مستفتحًا بذكر الناشطة الأسترالية التي تدير منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة صندوقًا للمساعدات الإنسانية يغطي احتياجات 95 أسرة، والتي تقول إنها جمعت أكثر من 200 ألف دولار منذ فبراير/ شباط 2024، وكانت ترسل قرابة 5000 دولار أسبوعيًا لأهالي القطاع خلال الحرب، لكنها بالكاد تمكنت من جمع 2000 دولار فقط خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2025 كله.
يرى النشطاء العاملون في جمع التبرعات لغزة أنّ هذا الانخفاض الكارثي، وفقًا للتقرير، يعود إلى اعتقاد شائع بأن معاناة الغزّيين قد انتهت بعد التوصل إلى الهدنة، إضافة إلى عوامل أخرى مثل الضغوط المالية التي تثقل كاهل الناس في مختلف الدول، ففي الولايات المتحدة، توقّفت رواتب عدد كبير من موظفي القطاع العام بسبب الإغلاق الحكومي، وفي بريطانيا ودول أخرى يعيش الناس تحت وطأة أزمات غلاء المعيشة، وفوق ذلك، أسهمت خوارزميات “ميتا” المنحازة ضد المحتوى الفلسطيني في تقليص وصول حملات التبرع وظهورها على منصاتها.
لكن لا يمكن التعامل مع هذا التراجع كما لو كان انخفاضًا طبيعيًا يلي حربًا طويلة، بل يجب النظر إليه كمؤشر خطير على تبدّل في الموقف العالمي، لأنه يستند أولًا إلى “قناعة واسعة بأن سكان غزة لم يعودوا بحاجة للمساعدة”، وهذه القناعة تحديدًا تحتاج إلى كثير من التفكيك والتوضيح، ليس فقط لأنها غير صحيحة، بل لأن استمرارها يهدّد حياة مئات الآلاف ممن لم يتجاوزوا آثار الحرب بعد، بل ما زالوا يعيشون في ذروة مأساتها الإنسانية، وما المشاهد المروّعة الأخيرة لانجراف خيام النازحين تحت الأمطار الغزيرة إلا مثال صغير على حجم الكارثة المستمرة.
مشاهد مأساوية لأطفال من غزة يواصلون تعبئة جالونات المياه، رغم المطر الشديد والثياب الخفيفة التي يرتدونها. pic.twitter.com/q49mFuQaqT
— نون بوست (@NoonPost) November 25, 2025
هناك أعداد كبيرة جدًا من الأسر الغزّية التي ستتضرر تضررًا بالغًا وغير مسبوق نتيجة هذا الانخفاض، فالغالبية الساحقة من العائلات فقدت مصادر رزقها؛ إمّا بسبب التدمير شبه الكامل للبنية الاقتصادية، أو بسبب فقدان المعيل الأساسي، ما دفع النساء والأطفال وكبار السن والمرضى إلى تحمّل أعباء العمل والسعي لتأمين ما تبقّى من احتياجات العائلة.
وخلال الحرب شاهدنا نماذج مؤلمة لنساء وأطفال عملوا في ظروف مرهقة ومهام شاقة، ووقفوا ساعات طويلة في طوابير التكايا والمساعدات، وخاطروا بحياتهم بالذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات الأمريكية المعروفة بـ”مصائد الموت” بحثًا عن لقمة العيش، وقد استشهد بعضهم بالفعل في سبيل ذلك.
وما لم تلتقطه الكاميرات أشدّ بؤسًا وعوزًا ممّا ظهر للعلن، ومع هذا الانخفاض الحاد في التبرعات سيجد هؤلاء أنفسهم أمام معاناة حقيقية، بل وكارثية، تُفاقم ما تبقّى من آثار الحرب وتدفع عشرات الآلاف إلى حافة الجوع والعجز.
لماذا لا يمكن اعتبار هذا التراجع طبيعيًا؟
يمكنك أن تتفهّم تراجع نسب التبرعات بعد حرب طويلة استنزفت المتبرعين حول العالم، علمًا بأن بعض هذه الدول تعاني أصلًا من ظروف اقتصادية صعبة، وربما يمكن أيضًا تفهّم أن انتهاء الحرب رسميًا قد ترك انطباعًا لدى البعض بأن مرحلة الطوارئ قد انتهت، لكن غير الطبيعي أن تنخفض التبرعات بنسب كبيرة وخطيرة في الشهر الأول فقط بعد الحرب مباشرة، وهي المرحلة التي تكون فيها المجتمعات المتضررة بأمسّ الحاجة للدعم من أجل التعافي وتعويض الأساسيات والاحتياجات البالغة الأهمية، والتي لا يمكن للمؤسسات الأممية والدولية والمحلية تغطيتها لا كمًا ولا نوعًا.
عادةً، في كل الأزمات الإنسانية حول العالم، تكون فترة ما بعد انتهاء الحرب هي فترة الذروة في حجم المساعدات؛ فهناك إعادة الإعمار، والإسكان، والعلاج، والغذاء، والرعاية النفسية، والدعم الاجتماعي، وتعويض المفقودات الأساسية. لكن ما يحدث في غزة يسير بعكس المنطق المعتاد، وهو ما يشير إلى وجود عوامل أخرى أقوى وأكثر تأثيرًا من مجرد الإرهاق المالي للمتبرعين.
خلال الحرب وبعدها، عملت البروباغندا الإسرائيلية بشكل حثيث على تعزيز الرواية التي تقول إن “غزة تعيش في رفاهية بعد الحرب”، وإن الأسواق قد امتلأت، ورفوف المتاجر تراصّت بالأغذية والمسلّيات، وعاد الناس يقفون طوابير أمام المطاعم، فالمجاعة انتهت، وهذه السردية روّجتها “إسرائيل” بشكل مكثّف عبر وسائل الإعلام، والمنصات السياسية، وآلاف الحسابات التي تعمل بشكل منظّم، حتى أنها جاءت على لسان أبرز القادة والمسؤولين الإسرائيليين.
مشاهد مأساوية لأطفال من غزة يواصلون تعبئة جالونات المياه، رغم المطر الشديد والثياب الخفيفة التي يرتدونها. pic.twitter.com/q49mFuQaqT
— نون بوست (@NoonPost) November 25, 2025
الأخطر أن هذه الرواية دُعمت بكمّ هائل من الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها مواطنون عاديون أو نشطاء داخل غزة لمولات أو محلات بضائع محدودة جدًا، بشكل مقصود أو عن جهل ربما، وأعطت انطباعًا مضللًا للعالم بأن الحياة عادت إلى طبيعتها، بينما لا تمثل هذه المشاهد سوى جزء ضئيل جدًا من الواقع، فمعظم البضائع الموجودة تجارية ومستوردة بكميات صغيرة، لا يستطيع 95% من سكان القطاع شراءها، ولا تمثل بأي شكل حالة عامة، والأطعمة التي يسمح الاحتلال بدخولها هي من الكربوهيدرات والنشويات التي سرعان ما تشبع البطون وتملأ الأجساد دون عناصر غذائية حقيقية يحتاجها المجوّعون كالبروتينات.
في المقابل، يتم تجاهل صور مئات الآلاف الذين يقفون لساعات طويلة في طوابير أمام التكايا، وطوابير المياه، وطوابير المخابز، والعيادات الميدانية، كما أن التغطية الصحفية ونشر الصور والمقاطع لهذه المشاهد تراجع زخمه بشكل كبير، في حين يتم تجاهل حقيقة أن الناس يعيشون في كتل سكانية هي الأعلى كثافة في العالم غرب الخط الأصفر، في ظروف صعبة، بدون بنية تحتية، وبدون كهرباء مستقرة، وبدون مياه نظيفة، وبدون فرص عمل.
هذا الوضع الخطير يحمّل كل صاحب مبادرة، وكل متبرع، وكل متطوع، وكل مؤسسة خيرية، مسؤولية عظيمة أمام الله أولًا ثم أمام ضمائرهم ثم أمام القانون، فالمساعدات التي تصل إلى غزة باتت أقل من أي وقت مضى، مما يعني أن كل دينار وكل دولار يصبح ذا أهمية مضاعفة بالنسبة للمحتاجين، وهذا يتطلب أن يتقي القائمون على توزيع التبرعات الله في تلك الأموال، وأن يلتزموا أعلى درجات الشفافية والأمانة، وأن لا تتحوّل هذه الأعمال الإنسانية إلى وسيلة للتكسب أو للاستثمار الشخصي كما حدث – للأسف – في بعض الحالات.
إن من المؤسف أن تفقد بعض المؤسسات ثقة المتبرعين بسبب ممارسات غير مسؤولة، في وقت باتت فيه الثقة شرطًا أساسيًا لاستمرار تدفق المساعدات، والتقارير الأخيرة يجب أن تكون جرس إنذار للجميع بأن المرحلة القادمة تتطلب نزاهة مطلقة وإدارة مهنية صارمة لهذه الأموال.
ما لم يتم مواجهة هذا الوضع إعلاميًا فإن مشكلة حقيقية تعصف بالمنكوبين، لذلك فإن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الصحفيين والنشطاء والمؤثرين في غزة وخارجها في الاستمرار في بث مشاهد المعاناة الحقيقية، لا بهدف إثارة الشفقة، بل لجعل الصورة كاملة وواضحة أمام الرأي العام العالمي.
فالناس خارج غزة لا يرون سوى ما يُبث لهم، وغياب الصورة الحقيقية يعطي للرواية الإسرائيلية المساحة للهيمنة على الموقف ، ومن الضروري أن توضح الحملات الإعلامية أن توقف المدافع لا يعني توقف الكارثة، وأن الاحتلال ما زال يمنع دخول أصناف كثيرة من الطعام الصحي، ومستلزمات الإيواء، ومعدات الدفاع المدني، والأجهزة الطبية، ومواد البناء، وأدوات التعافي الأساسية، وإن استمرار تسليط الضوء على الواقع الميداني ضرورة إنسانية وسياسية، ليس فقط لإنقاذ حياة الناس، بل لحماية الوعي العالمي من التضليل.
يعزّ على أهل غزة الذين عاشوا يومًا في أفضل البيوت، وفي دفء الأمن الاجتماعي، وكانوا يأكلون من خيرهم، ويحيَون حياة كريمة، أن تتخلى عنهم الأمة في زمن المعاناة كما تخلت – أو عجزت – عنهم في زمن الحرب، لكن ما زال هناك متسع للأمل وفرصة لاستدراك ما يحدث، وهذه دعوة مفتوحة لأن تستعيد الأمة دورها في إغاثة أهلها في غزة وتعويض التراجع العالمي، وأن تردّ الدين لأهل غزة الذين كانوا دائمًا رمزًا للصمود والتضحية، وهذه الدعوة تبدأ أولًا من الشعب الفلسطيني في الداخل والضفة والخارج، ثم إلى الشعوب العربية والإسلامية والأحرار في كل مكان.