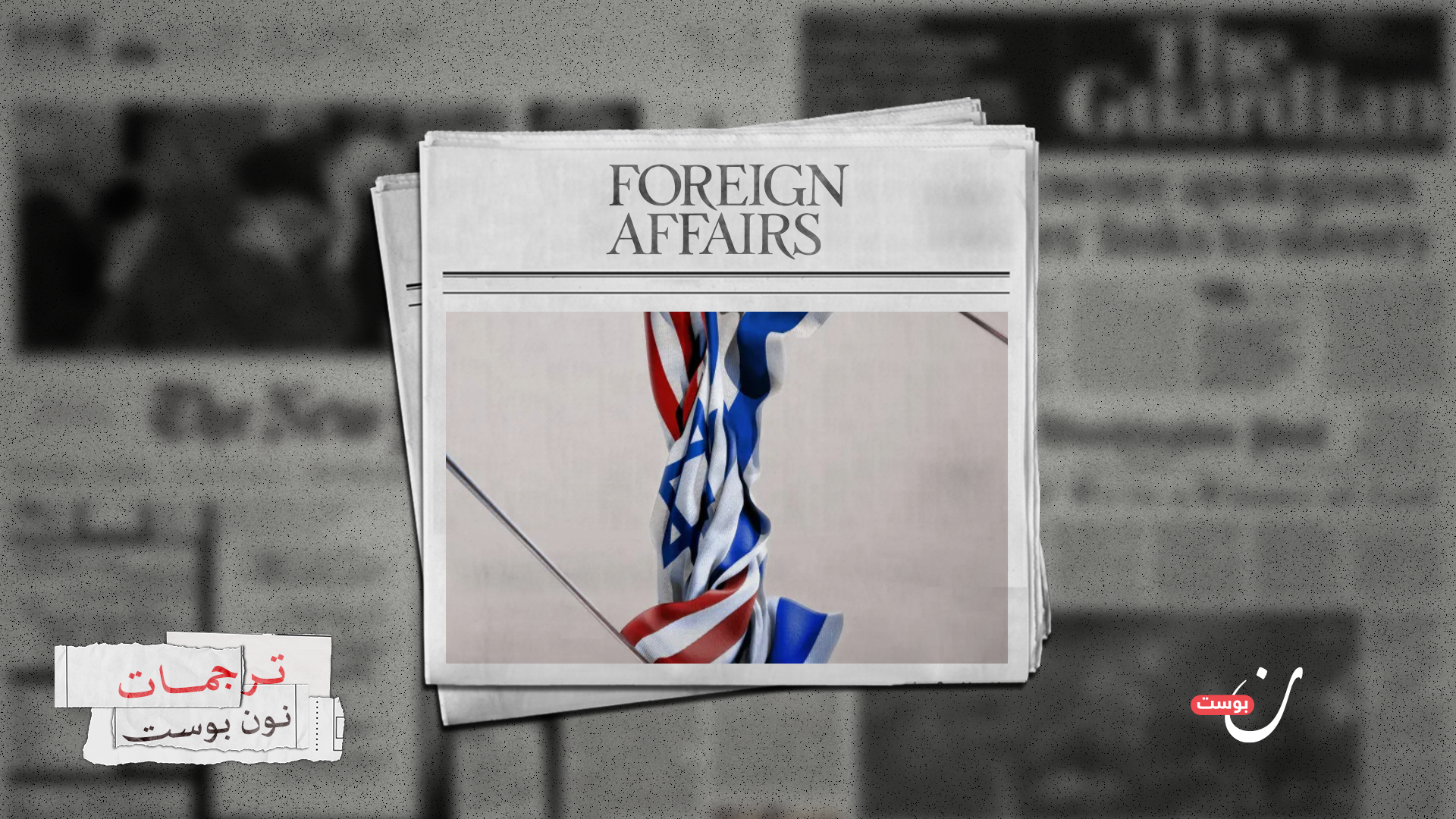ترجمة وتحرير: نون بوست
ظلّ الارتباط بين الولايات المتحدة وإسرائيل وثيقًا على نحوٍ استثنائي طوال ثلاثة عقود؛ فقد واصلت واشنطن اصطفافها التام إلى جانب إسرائيل خلال المرحلة الزاخرة لعملية السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية في تسعينيات القرن الماضي؛ ثم خلال الانتفاضة الثانية، وهي انتفاضة فلسطينية استمرت خمس سنوات واندلعت سنة 2000؛ ولاحقًا، على امتداد العقدين التاليين، عبر سلسلة متعاقبة من النزاعات في غزّة ولبنان. واستمر هذا التماسك حتى بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على إسرائيل، والحرب التي تلته في غزّة، حيث قدّمت إدارتان رئاسيتان أمريكيتان دعمًا دبلوماسيًا وعسكريًا شبه غير مشروط لإسرائيل.
غير أن حرب غزّة كشفت، في الوقت نفسه، وبوضوح لا لبس فيه، أن الإبقاء على هذا النمط من العلاقة الثنائية ينطوي على كُلف باهظة. فباستثناء حالات محدودة، لعل أبرزها وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول 2025، فشلت واشنطن، رغم محاولاتها، في التأثير في كيفية إدارة إسرائيل للحرب. وهذا الإخفاق لا يُعدّ عارضًا استثنائيًا، بل هو متجذر في طبيعة العلاقة الأمريكية-الإسرائيلية نفسها. فمع أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة توصف علاقتهما بـ«الخاصة»، فإن ما يجمع الولايات المتحدة وإسرائيل هو «علاقة استثنائية»: إذ تحظى إسرائيل بمعاملة لا يتمتع بها أي حليف أو شريك آخر. فعندما تشتري دول أخرى أسلحة أمريكية، تخضع عمليات البيع لمنظومة واسعة من القوانين الأمريكية؛ أما إسرائيل، فلم تُلزَم عمليًا بالامتثال لها. كما يحرص شركاء آخرون على تجنّب إظهار تفضيلات علنية لأي حزب سياسي أمريكي، في حين يفعل القادة الإسرائيليون ذلك من دون أن يترتب عليهم أي ثمن. ولا تدافع واشنطن عادة عن سياسات دول أخرى تتناقض مع توجهاتها، ولا تعرقل انتقادات معتدلة لها داخل المنظمات الدولية، غير أن هذا السلوك يُعدّ القاعدة عندما يتصل الأمر بإسرائيل.
أدّى هذا الاستثناء إلى الإضرار بمصالح البلدين معًا، فضلًا عن إلحاق أذى بالغ بالفلسطينيين. فبدلًا من أن يضمن بقاء إسرائيل، وهو الهدف المعلن لهذه السياسة، أتاح الدعم الأمريكي غير المشروط إطلاق أسوأ نزعات القيادات الإسرائيلية. وكانت المحصّلة تصاعدًا متواصلًا في الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، وسقوط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين في غزّة، إلى جانب تفشّي المجاعة في بعض مناطقها. كما مكّن هذا الدعم إسرائيل من تنفيذ عمليات عسكرية طائشة في أنحاء الشرق الأوسط، وفاقم في الوقت نفسه أخطارها الوجودية الذاتية. وداخل الولايات المتحدة، أدّت حرب غزّة إلى تآكل حاد في التأييد الشعبي لإسرائيل، إذ بلغت المواقف السلبية تجاهها مستويات غير مسبوقة عبر مختلف أطياف الانتماء السياسي.
ولا يمكن لهذه العلاقة أن تستمر إلى ما لا نهاية بصيغتها الراهنة؛ فهي بحاجة إلى نموذج جديد، أكثر انسجامًا مع الكيفية التي تدير بها واشنطن علاقاتها مع الدول الأخرى، بما في ذلك أقرب حلفائها المرتبطين معها بمعاهدات. وينبغي أن يقوم هذا النموذج على توقعات وحدود واضحة، ومساءلة حقيقية بشأن الالتزام بالقانونين الأمريكي والدولي، وربط الدعم بشروط عندما تتعارض السياسات الإسرائيلية مع المصالح الأمريكية، إلى جانب الامتناع عن التدخل في الشؤون السياسية الداخلية. وباختصار، علاقة ثنائية أكثر طبيعية بكثير.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن هذا التصحيح المتأخر هو ضرورة إستراتيجية وسياسية وأخلاقية في آن واحد. من منع إسرائيل من ضمّ الضفة الغربية إلى صياغة إستراتيجية مشتركة للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، فإن إقامة علاقة طبيعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ستؤدي إلى نتائج أكثر إيجابية واستقرارًا، مقارنة بالعلاقة الاستثنائية التي غالبًا ما تغذي السلوك الإسرائيلي المتهور وتستنزف نفوذ واشنطن العالمي. وإذا أخّرت الولايات المتحدة هذا التحوّل، فقد ينجم عن ذلك الإضرار بمكانتها الدولية، وابتعاد إسرائيل شبه التام عن الرأي العام الأمريكي وبقية دول العالم، وانهيار المجتمع الفلسطيني في غزّة ولاحقًا في الضفة الغربية. ومن ثم، فإن تغيير المسار قبل فوات الأوان يصبّ في مصلحة الجميع: الأمريكيين، والإسرائيليين، والفلسطينيين.
لا هامش للاختلاف
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل ترتبطان بعلاقة مميّزة منذ تأسيس إسرائيل، فإن هذه العلاقة لم تكن دائمًا على صورتها الاستثنائية الراهنة. فحتى عهد الرئيس بيل كلينتون؛ لم يكن الدعم الأمريكي بمنزلة شيك على بياض. إذ لم يتردد الرؤساء الأمريكيون في المجاهرة بخلافاتهم مع الحكومة الإسرائيلية، أو في فرض عواقب بهدف التأثير في سلوكها. وكثيرًا ما أيّدت الإدارات الأمريكية أو امتنعت عن التصويت على قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي تنتقد السياسات الإسرائيلية، ولا سيما ما يتعلق ببناء المستوطنات. وخلال حرب السويس سنة 1956، وحرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، والحروب الإسرائيلية في لبنان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وكذلك أثناء الانتفاضة الأولى في أواخر الثمانينيات وبدايات التسعينيات، لوّح الرؤساء الأمريكيون بفرض عقوبات أو بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.
غير أن انتهاء الحرب الباردة والانتصار الأمريكي الحاسم في حرب الخليج الأولى بديا وكأنهما يفتحان نافذة مواتية للتوصل إلى تسوية شاملة في الشرق الأوسط. وفي سياق السعي إلى هذا الهدف، قدّم كلينتون وفريقه دعمًا خطابيًا وماديًا شبه غير مشروط لإسرائيل، انطلاقًا من قناعة مؤداها أن إسرائيل قوية تحظى بدعم أمريكي غير محدود ستكون أكثر استعدادًا للمخاطرة من أجل السلام. وتجنّبوا إظهار أي خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وحتى الاعتراضات الروتينية الأمريكية على بناء المستوطنات جرى تخفيفها، واختفت كلمات مثل “الاحتلال” من القاموس الرسمي الأمريكي. وأحيانًا قُدّم دعم عسكري إضافي كحافز لتنازلات إسرائيلية، لكنه لم يُستخدم أبدًا كوسيلة ضغط عبر حجب الدعم، كما تجنّبوا أي إجراءات قسرية بغض النظر عن سلوك إسرائيل.
واستند هذا النهج الأمريكي على أربع فرضيات رئيسية. الأولى: أن المصالح الأمريكية والإسرائيلية متطابقة إلى حدّ بعيد، إن لم تكن متماثلة، بما في ذلك الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى سلام تفاوضي بين إسرائيل والفلسطينيين وجيران آخرين. الثانية، أن إسرائيل أدرى بمصالحها وبطبيعة التهديدات التي تواجهها من دول معادية تماثلها قوة. الثالثة، أن معالجة الخلافات بين الحليفين بعيدًا عن العلن أفضل، لأن إظهار «هامش للاختلاف» علنًا من شأنه أن يشجّع أعداء إسرائيل. أما الفرضية الرابعة، فمفادها أنه عند لحظة الاختبار، ستأخذ إسرائيل المخاوف الأمريكية الجوهرية في الحسبان حفاظًا على علاقة تُعدّ محورية لبقائها على المدى الطويل.
أما العلاقة التي تشكّلت على هذا الأساس فكانت فريدة بحق في معاييرها وتوقعاتها وطريقة إدارتها. وقد استمرت، مدفوعة جزئيًا بنفوذ لوبي سياسي قوي مؤيد لإسرائيل داخل الولايات المتحدة، من دون تغيير يُذكر. ولا تزال واشنطن تُظهر قدرًا كبيرًا من التبجيل، ليس فقط لتقديرات القادة الإسرائيليين، بل كذلك لاعتباراتهم السياسية الداخلية. فهي تقدّم مساعدات عسكرية ضخمة من دون شروط: إذ نصّت مذكرة تفاهم وُقّعت سنة 2016 على تقديم 3.8 مليارات دولار سنويًا، أي أكثر من عشرة ملايين دولار يوميًا من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وغالبًا ما يضيف الكونغرس مبالغ إضافية. ولا يُنتظَر من الولايات المتحدة مجرد الامتناع عن توجيه انتقادات علنية لإسرائيل، بل دعم مواقفها في المحافل الدولية، ولا سيما عبر استخدام حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن التي تعارضها إسرائيل، سواء انسجمت تلك القرارات مع السياسة الأمريكية أم لا. كما نادرًا ما تُخضع إسرائيل لبعض القوانين والسياسات الأمريكية، ولا سيما القيود التشريعية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، التي تُطبَّق على جميع متلقي المساعدات الأمريكية الآخرين.
وأفضى هذا الدعم غير المشروط، على نحو لا مفرّ منه، إلى نشوء ما يُعرف بـ«الخطر الأخلاقي» لدى الطرفين. فإسرائيل لا تجد دافعًا لمراعاة الهواجس والمصالح الأمريكية، إذ إن تجاهلها لا يترتب عليه ثمن يُذكر. وعلى العكس؛ يشجّعها ذلك على انتهاج مواقف قصوى تتعارض في كثير من الأحيان مع المصالح الأمريكية، وأحيانًا حتى مع مصالحها الذاتية. صحيح أن إسرائيل وجّهت ضربات قاسية إلى خصوم تتشاركهم مع الولايات المتحدة، وأن الضمان العملي للدعم الأمريكي قد يسهم في ردع أعدائها عن مهاجمتها. إلا أن تفوق القوة الإسرائيلية الساحق على جميع منافسيها يجعل من هذا الدعم حافزًا معكوسًا يدفعها إلى تصرفات متهورة وغير ضرورية، مطمئنة إلى أن المساندة الأمريكية ستبقى قائمة أيًّا كانت نتائج مغامراتها. كما أن هذا الدعم المستمر يورّط الولايات المتحدة في أفعال إسرائيل، ويعرّض قواتها أحيانًا لعمليات انتقامية مباشرة. وفي المقابل، تبدي إسرائيل امتعاضًا من تدقيق متزايد تمارسه بعض فئات الرأي العام الأمريكي بسبب المساعدات السخية التي تتلقاها.
وليست القيادات الإسرائيلية بمنأى عن الخطأ في تقديراتها، بما في ذلك ما يتعلق بتطورات محيطها الإقليمي. وهذا حال القادة في كل مكان، غير أن تجربة إسرائيل التاريخية دفعت بعض صانعي القرار فيها إلى التركيز المفرط على اعتبارات البقاء الآني، بما أفضى إلى سوء تقدير أو تجاهل الديناميات الاستراتيجية الأوسع. ومن المفارقات المأساوية أن أكبر إخفاقين استخباريين في تاريخ إسرائيل، الفشل في منع الهجوم المفاجئ الذي أشعل حرب سنة 1973 العربية-الإسرائيلية، ثم الهجوم الذي وقع بعد خمسين عامًا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، لم يكونا ناجمين عن نقص في المعلومات التكتيكية، بل عن تقديرات إستراتيجية مفرطة في التفاؤل دفعت القادة الإسرائيليين إلى تجاهل إشارات التحذير. ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تهمل تقييمات إسرائيل، لكنها في الوقت ذاته لا يجوز لها أن تستبدل بها تقييماتها الخاصة على نحو أعمى.
وعندما يتولى القيادة في كل من إسرائيل والولايات المتحدة قادة نزيهون وملتزمون بتحقيق السلام، يمكن الحدّ من أوجه الخلل في هذه العلاقة. فقد أدرك إسحاق رابين، الذي شغل ولايته الثانية كرئيس لوزراء إسرائيل من 1992 حتى اغتياله في 1995، أن تحديه لواشنطن قد لا يلحق الضرر بالشراكة على الفور، لكنه كان يقظًا تجاه الأضرار المحتملة على المدى الطويل. وكان واعيًا بأن المخاوف الأمريكية صادقة ومتجذرة في هدف مشترك هو السلام، رغم الخلافات حول تفاصيله. وربما كان من الممكن تبرير العلاقة الاستثنائية في تلك الظروف الاستثنائية. وعلى الرغم من نقائص رابين مثل توسع المستوطنات بشكل كبير خلال فترته إلا أنه كان شريكًا أمريكيًا متجاوبًا. ورغم أنه لم يعترف علنًا بهدف إقامة دولة فلسطينية، فإن توقيعه اتفاقيات أوسلو مع ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، عام 1993 شكّل خطوة حقيقية في هذا الاتجاه، وحظيت بدعم أكثر من 60 بالمئة من الرأي العام الإسرائيلي.
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فينظر إلى العلاقة الاستثنائية على أنها فرصة للاستغلال، لا شبكة أمان يُلجأ إليها عند الضرورة القصوى. فهو يتعامل مع تعهّد «عدم وجود هامش للاختلاف» بين الولايات المتحدة وإسرائيل بوصفه التزامًا أحادي الجانب، ويستثمر الخلافات العلنية لصالحه، كما فعل حين انتقد إدارة بايدن بسبب حجبها بعض الأسلحة، أو عندما خاطب الكونغرس سنة 2015 لمهاجمة اتفاق نووي محتمل مع إيران. والأهم من ذلك أن معارضته لحل الدولتين تحظى بدعم واسع من جمهور إسرائيلي شهد ميلاً حادًا نحو اليمين خلال العقود الأخيرة. فقد أظهر استطلاع أجراه مركز “بيو” في يونيو/ حزيران 2025 أن 21 في المئة فقط من الإسرائيليين يعتقدون بإمكانية تعايش إسرائيل سلميًا مع دولة فلسطينية. ويعكس انضمام حزبين من أقصى اليمين إلى ائتلاف نتنياهو، يقودهما متطرفون يعلنون صراحة تبنّيهم للعنصرية والعنف — وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير — هذا التحول العميق في المزاج المجتمعي. وخلاصة القول إن الولايات المتحدة باتت اليوم تتعامل مع حكومة إسرائيلية لا تتبنى القيم الديمقراطية، ولا تُبدي اهتمامًا بحل عادل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وغالبًا ما لا تبادل واشنطن التزامها بالحفاظ على متانة العلاقة الثنائية.
المعاملة الاستثنائية
كشفت تداعيات هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بجلاء لا لبس فيه، العيوب البنيوية العميقة التي تنخر العلاقة الأمريكية–الإسرائيلية الاستثنائية. فقد وجد الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه أنفسهم، كما كان متوقَّعًا، عاجزين إلى حدّ كبير عن التأثير في سلوك حكومة بنيامين نتنياهو، سواء خلال حرب غزّة أو في سياساتها الإقليمية الأوسع. ولم تبادر الولايات المتحدة، لا رسميًا ولا حتى ضمنيًا، إلى بلورة تفاهم مع إسرائيل يضبط طبيعة المساعدات المقدمة، أو يحدّد شروطها، أو يربطها بأهداف عسكرية واضحة. وبينما عبّر دعم الإدارة للرد العسكري الإسرائيلي عن تضامنٍ مفهوم مع شريك مصدوم ومحاصر، فإن غياب هذا الإطار جعل الدعم يظهر، في نظر نتنياهو، وكأنه تفويض مفتوح أو شيك على بياض.
وأرست الاتصالات الأمريكية مع المسؤولين الإسرائيليين في الأيام الأولى للحرب نمطًا متكررًا قوامه ضغط محسوب بعناية، يعقبه تراجع عملي في لحظة الحسم. فمنذ الضربات الأولى على غزّة، كان واضحًا أن جيش الاحتلال لا يمنح أولوية جادّة لتقليل الخسائر بين المدنيين الفلسطينيين. وقد سجّلت إدارة بايدن، مرارًا وبلهجة حازمة ولكن خلف الأبواب المغلقة، اعتراضاتها على أنماط القصف الإسرائيلية خلال الأسابيع الأولى. غير أنّ أي أثر محتمل لهذه الاحتجاجات تلاشى بفعل الخطاب العلني للمسؤولين الأمريكيين، الذين اكتفوا بالتعبير عن الأسف لسقوط ضحايا مدنيين، متجنبين الإدانة الصريحة أو تحميل إسرائيل مسؤولية مباشرة.
وترددت الإدارة في حجب شحنات الأسلحة في تلك المرحلة الحساسة، كما أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد سلسلة من قرارات مجلس الأمن الداعية إلى وقف إطلاق النار — بدعوى عدم تضمّنها إشارة إلى دور حماس — قوبل دوليًا بوصفه غطاءً سياسيًا للتكتيكات الإسرائيلية. وحتى مع تصاعد الانتقادات في الداخل الأمريكي، بدا أن نتنياهو استنتج أنه يستطيع تجاهل تبرّم الإدارة، التي فضّلت صون حرية الحركة الإسرائيلية على حساب الحدّ من الأضرار اللاحقة بالمدنيين.
وكان وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، الذي أسفر عن الإفراج عن 105 أسرى إسرائيليين في غزّة، محطة مهمّة، إلا أنّ أكثر من عام مضى بعده دون التوصّل إلى هدنة جديدة. وخلال هذه الفترة، اشتدت الرسائل الأمريكية إلى القادة الإسرائيليين صراحةً وقوةً في اللهجة بشأن الأساليب العسكرية المتّبعة. غير أنه، ورغم المطالبة المتكررة بأن تبذل إسرائيل «المزيد» لحماية المدنيين، نادرًا ما لوّحت الإدارة بإمكانية تعرّض دعمها للخطر. ولم يُستخدم الدعم العسكري في أي مرحلة أداة ضغط حقيقية لتعديل السلوك الإسرائيلي. بل جرى، في الواقع، تعليق تطبيق قوانين ليهي — التي تحظر تقديم مساعدات أمريكية لوحدات عسكرية متورطة بصورة موثوقة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان — على الحالة الإسرائيلية، رغم أن هذه القوانين لا تنص على استثناءات من هذا النوع. ولم يقدم بايدن على تعليق تسليم بعض الأسلحة إلا في مايو/ أيار 2024، ردًا على شروع إسرائيل في عمليتها العسكرية في رفح، رغم التحذيرات الأمريكية المتكررة من المضي قدمًا قبل إجلاء المدنيين. وحتى حين عدل الجيش الإسرائيلي خطته لاحقًا، ظل تأثير الضغط الأمريكي محدودًا ومتأخرًا في المشهد العام للحرب.

وفي ملف المساعدات الإنسانية، برز نمط أكثر فاعلية نسبيًا، وإن ظل بعيدًا عن الكفاية. فقد فرضت إسرائيل في البداية حصارًا كاملًا على غزّة، متحدية الموقف الأمريكي. ورغم أن إدارة بايدن نجحت في دفع حكومة نتنياهو إلى التراجع، فإن القيود المفروضة أبقت تدفق المساعدات عند مستويات لا تلبي إلا جزءًا هزيلًا من الاحتياجات الأساسية. ومع ذلك، يكاد يكون مؤكّدًا أن غزّة لم تكن لتتلقى أي مساعدات تُذكر لولا الضغوط الأمريكية المتواصلة. وفي هذا الملف تحديدًا، استخدمت الإدارة أدوات النفوذ أحيانًا. ففي مناسبتين سنة 2024— مكالمة هاتفية في أبريل/ نيسان بين بايدن ونتنياهو، ورسالة رسمية في سبتمبر/ أيلول من وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين إلى نظرائهما الإسرائيليين — لوّحت واشنطن بتقليص الدعم العسكري إذا لم تُتَّخذ خطوات ملموسة لتحسين إيصال المساعدات. وفي المرتين، امتثلت إسرائيل إلى حدّ كبير، وإن كان امتثالًا مؤقتًا وهشًا.
غير أن الضغط الأمريكي افتقر إلى الاستمرارية؛ فقد عزفت الإدارة عن استخدام أدوات قانونية إضافية متاحة لها، مثل تفعيل المادة 620I من قانون المساعدات الخارجية، التي تحظر تقديم مساعدات عسكرية لأي دولة تعرقل المساعدات الإنسانية الأمريكية. وكان بإمكان واشنطن، بموجب هذا النص، إما إعلان مخالفة إسرائيل ثم تعليق تطبيق الحظر كتأنيب علني، أو السماح بدخوله حيز التنفيذ ووقف تسليم الأسلحة. وكان من شأن أي من الخيارين أن يشكّل حافزًا قويًا لتغيير السلوك الإسرائيلي. وبالتوازي، وللالتفاف جزئيًا على هذا الاستحقاق، أصدرت إدارة بايدن في فبراير/ شباط 2024 مذكرة أمن قومي شددت المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان للدول المتلقية للمساعدات العسكرية. غير أن تقرير الامتثال الصادر في مايو/ أيار خلص إلى أن التعهدات الإسرائيلية «موثوقة ويمكن الاعتماد عليها»، وهي خلاصة لم تقنع إلا قلة من المراقبين المطلعين على وقائع الحرب.
وسجلت إدارة بايدن نجاحًا أوضح في احتواء مخاطر توسّع الحرب إقليميًا. فرغم انخراط إيران ولبنان وسوريا واليمن بدرجات مختلفة، لم ينزلق الصراع إلى حرب متعددة الجبهات طويلة الأمد. وتمكنت الإدارة من حشد تحالف دفاعي دولي حيّد إلى حدّ بعيد الهجمات الإيرانية على إسرائيل في أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول 2024، مانعًا تصعيدًا أخطر. كما وضعت قيودًا على رد الفعل الإسرائيلي عبر تأكيدها أن واشنطن لن تشارك في عمليات هجومية، ما أتاح فسحة زمنية للدبلوماسية. ومع ذلك، بقيت قدرة بايدن على كبح العمليات الإسرائيلية محدودة، ولا سيما تلك التي كانت قابلة للتحول إلى صراع إقليمي. وكانت الضربات الإسرائيلية محدودة الجدوى في دمشق الشرارة التي أطلقت، دون مسوّغ فعلي، أولى الضربات الإيرانية المباشرة. وفي معظم المراحل، احتفظت إسرائيل بحرية شبه مطلقة في التحرك، وربما شجعتها الحماية العسكرية الأمريكية الفعالة على المضي في مغامرات أكثر خطورة لاحقًا.
ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تذبذبت مقاربته تجاه إسرائيل بين الاستثناء المطلق، والضغط المحدود، ونهج أكثر تبادلية في الظاهر. فقد انطلقت الإدارة الجديدة بدايةً بخطوات بدت واعدة، وأسهمت في الضغط على نتنياهو للقبول بمقترح وقف إطلاق النار الذي صاغته إدارة بايدن في يناير/ كانون الثاني 2025. غير أنها سرعان ما أمضت شهورًا سلّمت خلالها زمام السياسة الأمريكية فعليًا لإسرائيل. فبعد بدء الهدنة، لم يبذل فريق ترامب أي جهد يُذكر لدفع نتنياهو نحو مفاوضات تمديدها. وعندما أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي وقف إطلاق النار من طرف واحد في مارس/آذار عبر موجة غارات جوية، سارع ترامب إلى تأييد الهجمات. وبدل الضغط لتوسيع تدفق المساعدات، التزمت الإدارة الصمت إزاء فرض إسرائيل حصارًا شاملًا كارثيًا على غزّة لأكثر من شهرين، انتهى بمجاعة في أجزاء من القطاع. وعندما رُفع الحصار في مايو/ أيار إثر اعتراضات متأخرة، شاركت إدارة ترامب في إنشاء آلية بديلة لتوزيع المساعدات على حساب النظام الأممي القائم — آلية أقرّ نتنياهو نفسه بفشلها في مقابلة مع «فوكس نيوز» في سبتمبر/ أيلول — وأجبرت الفلسطينيين الجائعين على السير لمسافات طويلة نحو أربعة مراكز فقط، حيث قُتل أكثر من ألف شخص أثناء محاولاتهم الحصول على الغذاء.
أما إقليميًا، فقد شجّعت اليد الطليقة التي منحتها إدارة ترامب لإسرائيل نزعاتها المغامِرة. فقوبلت عملياتها في لبنان وسوريا خلال الربيع والصيف باعتراضات باهتة من البيت الأبيض. وعندما بادرت إسرائيل إلى شنّ حرب على إيران في يونيو/ حزيران، تبرأ ترامب منها مبدئيًا، قبل أن يعود ويمدح أداءها حين بدا أن الضربات حققت نجاحًا. ولم تمضِ سوى فترة وجيزة حتى أصدر أوامره بشنّ ضربات أمريكية مباشرة على منشآت نووية إيرانية، الغاية التي طالما سعى نتنياهو إلى تحقيقها.
لم يأخذ ترامب بزمام الأمور ويدفع نحو وقف إطلاق نار جديد حتى أواخر سبتمبر/ أيلول، وبعد مقتل ما يقارب 20 ألف فلسطيني آخرين منذ انهيار وقف إطلاق النار في يناير/ كانون الثاني 2025، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة. وفي مثال واضح على المخاطر الأخلاقية لهذه العلاقة الاستثنائية، كان الدافع وراء التحوّل الأميركي هو محاولة إسرائيل المتهورة لاغتيال قادة من حماس في قطر ذلك الشهر، وهي شريك للولايات المتحدة وتستضيف أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط. وعجز الولايات المتحدة عن حماية شريك من بلد يتلقى مليارات الدولارات من الدعم الأميركي هدد بتقويض مصداقية الولايات المتحدة.
ردًا على ذلك، أطلقت إدارة ترامب، إلى جانب دول عربية وإسلامية رئيسية، حملة ضغط مكثفة على إسرائيل وحماس لإنهاء القتال. وقد ربط فريق الرئيس الاجتماع المتوقع في المكتب البيضاوي بقبول نتنياهو لـ”خطة السلام” التي طرحها ترامب. لم يترك ترامب أي مجال للهروب؛ فقد عقد مؤتمرًا صحفيًا مع نتنياهو بعد أن أجبره فعليًا على الاتصال برئيس وزراء قطر للاعتذار والموافقة على توقيع مقترح وقف إطلاق النار على الهواء مباشرةً. وقال ترامب لمراسل إسرائيلي: “على نتنياهو أن يقبل بذلك. ليس لديه خيار آخر”.
دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول وما زال ساريًا، وقد جلب خطوات مهمة نحو السلام رغم الانتهاكات المتكررة من كلا الطرفين. لكن الوصول إلى هذه المرحلة تطلّب الخروج عن قواعد العلاقة الاستثنائية؛ إذ لم يكتفِ ترامب بتوبيخ الحكومة الإسرائيلية علنًا بسبب الهجوم في قطر، بل هدّد أيضًا بإحراج نتنياهو إذا لم يقبل الخطة الأميركية. مع ذلك، قد يكون من السابق لأوانه تفسير هذه الحادثة كعلامة على عودة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إلى طبيعتها؛ حيث يبقى هناك خطر كبير من عدم اتخاذ الخطوات المقبلة الأكثر تعقيدًا والضرورية لإنهاء الحرب إذا فقد ترامب الاهتمام وعاد، كما هي العادة الأميركية، إلى دعم نتنياهو.
نتائج غير استثنائية
لقد كان دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ضارًا بجميع الأطراف، ويظهر هذا بشكل أوضح في المجتمع الفلسطيني في غزة الذي دمره عامان من الحرب؛ حيث كان ما لا يقل عن 90 بالمائة من السكان نازحين داخليًا عند دخول وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول حيز التنفيذ، وفقًا للجنة الإنقاذ الدولية. وأعلن خبراء الأمم المتحدة أن أكثر من 600 ألف فلسطيني، بينهم 132 ألف طفل، يواجهون ظروف مجاعة أو سوء تغذية. كما أن 78 بالمائة من مباني غزة قد تضررت أو دُمرت. وعلى الرغم من تحييد أي خطر لهجوم مماثل لهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول من قبل حماس في المستقبل المنظور، فإن الهزيمة الدائمة للتنظيم، تتطلب حلًا سياسيًا يتمكن فيه الفلسطينيون – من دون حماس – من حكم أنفسهم في دولة خاصة بهم. لكن الحكومة الإسرائيلية حماس غير مهتمتين بتقديم هذا الحل.
إن عدم وضوح حقيقة معاناة إسرائيل – الحالية أو المستقبلية – من هذ العلاقة الاستثنائية لا يعني عدم صحتها، فإضعاف إسرائيل لقدرات حماس وحزب الله، إلى جانب الضربات القاسية التي وجهتها إسرائيل والولايات المتحدة لبرامج إيران النووية والصاروخية الباليستية، يعزز أمن إسرائيل على المدى القصير، لكن هذه الإنجازات يجب أن تُوازن مع التكاليف التي تكبدتها في العملية.
إن عزلة إسرائيل الدولية نتيجة الحرب في غزة تمثل خطرًا واضحًا وحاضرًا على البلاد؛ فقد قال قادة هولندا وإسبانيا وسويسرا علنًا إنهم سيعتقلون نتنياهو إذا وطأت قدماه أراضيهم. أما ألمانيا والمملكة المتحدة، اللتان سلحتا إسرائيل لعقود فقد قيدتا مبيعات الأسلحة، كما أن تغير المواقف في الولايات المتحدة مقلق بشكل خاص لإسرائيل. فوفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز وجامعة سيينا في سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن أكثر من نصف الأميركيين – وسبعة من كل عشرة تحت سن الثلاثين – يعارضون “تقديم دعم اقتصادي وعسكري إضافي لإسرائيل”. ويعتقد اثنان من كل خمسة أميركيين، وثلثا من هم تحت سن الثلاثين، أن إسرائيل كانت تقتل المدنيين الفلسطينيين عمدًا. كما أن الأمريكيين تحت سن الخامسة والأربعين أكثر أكثر عرضة للتعاطف مع الفلسطينيين بمقدار الضعف مقارنة بتعاطفهم مع إسرائيل. وعلى الرغم من أن هذه التغيرات في الرأي العام لم تُترجم بعد إلى تغييرات في السياسة، إلا أن إسرائيل لا يمكنها أن تتوقع استمرار هذا الانفصال إلى أجل غير مسمى.

قد تكون النجاحات العسكرية التي حققتها إسرائيل ضد خصومها الإقليميين مؤقتة، فاهتمام إيران بتطوير سلاح نووي ربما ازداد مع تراجع قدرتها على الردع التقليدي وشعورها بالأمن. وإذا ما نجحت إيران في نهاية المطاف ببناء قنبلة نووية بدائية – أو حتى عادت إلى عتبة أن تصبح قوة نووية، ولكن هذه المرة من دون أي نظام مراقبة – فلن يكون من الممكن اعتبار حرب يونيو/ حزيران نجاحًا. وبالمثل، فإن غياب حكم فلسطيني فعّال وموثوق في غزة، قد تجد إسرائيل نفسها مضطرة للاختيار بين احتلال مكلف ودولة فاشلة على حدودها. أما تراجع حزب الله في لبنان فقد خدم إسرائيل حتى الآن، لكن من المبكر استبعاد نتيجة أقل ملاءمة بكثير.
حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلًا، فإن التفوق العسكري الإقليمي لإسرائيل يحجب أخطارًا أخرى فمواصلة نتنياهو السعي لإصلاح قضائي داخلي يهدد الديمقراطية الإسرائيلية؛ حيث قد يقلّص عمليًا رقابة المحاكم على حكومته. كما أن التغيرات الديموغرافية في إسرائيل، خصوصًا النمو النسبي لسكان الحريديم (اليهود المتشددين)، تقلل معدلات المشاركة في الاقتصاد والقوات المسلحة. والالتزام بالتوسع غير المقيّد للمستوطنات في الضفة الغربية عبر الطيف السياسي الإسرائيلي، إلى جانب غياب المساءلة عن عنف المستوطنين، قد يشعل انتفاضة جديدة ويجعل قيام دولة فلسطينية أمرًا مستحيلًا عمليًا. كما أن الحرب في غزة ولّدت رياحًا معاكسة قوية ضد المزيد من التطبيع مع الدول العربية والإسلامية في الشرق الأوسط وخارجه. وفي كل هذه الحالات، فإن الدعم الأميركي غير المشروط منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول مكّن نتنياهو من اتباع سياسات تتجاهل أو تفاقم المشاكل القائمة، وهذه التطورات تهدد مستقبل إسرائيل الآمنة واليهودية والديمقراطية – وهو الهدف المعلن للسياسة الأميركية وأمل معظم الإسرائيليين.
الحفاظ على العلاقة الاستثنائية فرض تكاليف كبيرة على الولايات المتحدة أيضًا. فالمسألة لا تقتصر على أن السياسة الأميركية تقوّض أهدافها تجاه إسرائيل فحسب، بل إن العلاقة بصيغتها الحالية أضرّت أيضًا بمصالح أميركية لا علاقة لها بالشرق الأوسط. فقد تدهورت مكانة واشنطن الدولية خلال العامين الماضيين، وهو تطور استغله خصوم الولايات المتحدة بحماس – الصين لتعزيز مكانتها كفاعل دولي “مسؤول”، وروسيا للتغطية على جرائمها في أوكرانيا. كما أن الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل ترتبت عليه فرص بديلة ضائعة؛ فكل مجموعة من حاملات الطائرات الأميركية تُنشر لحماية إسرائيل من تبعات أفعال مكّنتها الولايات المتحدة تسبب قصورًا في المجموعات المتاحة للمهام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وعلى الرغم من أن هذه ليست المحركات الأساسية لهذه الاتجاهات، فإن العلاقة الاستثنائية مع إسرائيل والتواطؤ الأميركي في حرب إسرائيل على غزة قد زادا من الاستقطاب وأجّجا معاداة السامية والإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة.
العودة إلى الوضع الطبيعي
إن استمرار التبعية الأميركية لتفضيلات الحكومة الإسرائيلية، وتقديم الدعم السياسي والعسكري غير المشروط، وتجنب الخلافات العلنية، سيواصل تمكين أسوأ نزعات القادة الإسرائيليين، مما يعرّض أمن إسرائيل واستقرارها للخطر، ويزيد معاناة الفلسطينيين، ويقوّض المصالح العالمية للولايات المتحدة. لذلك، فإن حماية المصالح الإسرائيلية والفلسطينية والأمريكية يعتمد على التخلي عن هذه العلاقة الاستثنائية. يجب على واشنطن أن تجعل سياساتها تجاه إسرائيل طبيعية أكثر، لتتماشى مع القوانين والقواعد والتوقعات التي تحكم العلاقات الخارجية الأميركية في كل مكان آخر. ففي علاقة أكثر طبيعية، سيكون لدى الولايات المتحدة المرونة لتعديل سياساتها لتحقيق توازن أكثر ملاءمة بين الهدف المتمثل في حماية إسرائيل وبين خطر دعمها. وكلما كان الدعم الأميركي لإسرائيل مشابهًا لدعمها لحلفاء آخرين، سيكون من الأسهل على صانعي السياسات الدفاع عن العلاقة أمام الرأي العام الأميركي.
ليست جميع العلاقات الخارجية الطبيعية للولايات المتحدة متساوية؛ فالولايات المتحدة وإسرائيل تتمتعان بمرونة واسعة لتقرير مدى قرب علاقتهما. وبالتالي، فإن تطبيع العلاقة قد يروق لكل من مؤيدي العلاقات القوية ومعارضيها بشدة – وهي حقيقة قد تساعد في دفع هذا النموذج لكنها قد تعرقل أيضًا تقدمه. فقد يصوّر أشد المدافعين عن إسرائيل في الولايات المتحدة إنهاء المعاملة الاستثنائية على أنه تخلي أميركي عن إسرائيل ومكافأة لمرتكبي هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول. في المقابل، قد يرى أشد منتقديها أن علاقة أكثر “طبيعية” لا تزال سخية أكثر من اللازم تجاه بلد ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ، بما في ذلك بأفعال يصنفها العديد من الخبراء القانونيين إبادةً جماعية.
ولكن إذا صحّ الافتراض القائل إن العلاقة بصيغتها الحالية غير قابلة للاستمرار، فإن أكثر ما يمكن أن يفعله أي مسؤول هو إدارة هذه المرحلة الانتقالية بحذر وتروٍ. أما البديل، وهو انقطاع العلاقات بسبب استمرار تراجع الدعم الشعبي الأميركي لإسرائيل أو بسبب قيام إسرائيل بفعل متسرع مثل ضم الضفة الغربية، فمن المرجح أن يؤدي إلى نتائج متطرفة. واتخاذ خطوات متعمّدة نحو التطبيع من شأنه أن يمكّن الولايات المتحدة من وضع شروط تضيّق نطاق التسوية، مثل مطالبة إسرائيل بنقل مزيد من مسؤوليات حكم الضفة الغربية إلى الفلسطينيين وملاحقة المستوطنين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف، كشرط للمضي قدمًا في علاقة ثنائية طبيعية لا تزال “خاصة”. هذا هو جوهر التطبيع، وهو وضع الحكومة الأميركية في موقع يمكّنها من ممارسة نفوذها بشكل أكثر فعالية.
يجب على الولايات المتحدة على الأقل أن تغيّر جذريًا طريقة إدارتها للعلاقة، والشرط الأول هو التوصل إلى تفاهم بشأن الأهداف المشتركة والمختلفة، وما الذي يستعد كل بلد لفعله لدعم مصالح الآخر، وما هي الأفعال التي قد تعرّض هذا الدعم للخطر – لتحديد كل من التوقعات والحدود. يجب مثلًا على الولايات المتحدة أن تؤكد دعمها القوي لتقرير المصير اليهودي، لكنها يجب أن ترسم خطًا واضحًا تشدد به على أن حق الإسرائيليين في تقرير المصير لا يمكن أن يمنع الفلسطينيين من ممارسة الحق نفسه. وبالمثل، يجب أن تحافظ الولايات المتحدة على التزامها الراسخ بأمن إسرائيل، لكنها يجب أن تؤكد أن هذا الالتزام لا يمتد إلى تمكين إسرائيل من السيطرة الدائمة على الضفة الغربية أو غزة.
ينبغي على الولايات المتحدة بعد ذلك أن تطبّق القوانين والأنظمة والمعايير الأميركية والدولية على إسرائيل بالطريقة نفسها التي تطبّقها على الدول الأخرى، ويشمل ذلك قوانين “ليهي” المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقانون المساعدات الخارجية، وقانون النزاعات المسلحة الذي يفرض على الأطراف المتحاربة التمييز بين المقاتلين والمدنيين في جميع العمليات العسكرية. فعلى سبيل المثال، يجب أن تُحاسَب وحدة في الجيش الإسرائيلي تسيء معاملة الفلسطينيين بشكل مناسب من قبل النظام القضائي الإسرائيلي؛ وحتى يُنفَّذ هذا العقاب، لا ينبغي أن تتلقى الوحدة أي مساعدة أميركية. هذه هي الممارسة المعتادة في تعامل الولايات المتحدة مع الدول الأخرى، بما فيها تلك التي لديها معها معاهدات دفاع مشترك. لكن الإفلات من العقاب يشجع على المزيد من الانتهاكات، حتى بين الحلفاء.
يجب أن تصبح المشروطية أيضًا سمة في العلاقة الأميركية الإسرائيلية، فربط المساعدات أو السياسات بمدى توافق دولة أخرى مع أهداف الولايات المتحدة ليس فعالًا دائمًا، لكنه قد ينجح. ولا ينبغي أن يكون الضغط على الشريك الخيار الأول للمسؤولين الأميركيين، لكنه يجب أن يبقى خيارًا إذا فشلت الأساليب الأخرى. فحتى أقرب الحلفاء لا يتأثرون دائمًا بنداءات الصداقة أو الدعم السابق. وعندما يحدث ذلك، فإن ربط أشكال مختلفة من المساعدات الأميركية يمكن أن يفرض، أو يهدد بفرض، تكلفة ملموسة على من يتصرف ضد المصالح الأميركية، مما يزيد احتمال تغيير مساره، أو على الأقل يبعد واشنطن عن سلوكه إذا لم يفعل.
تملك الولايات المتحدة عدة طرق لفرض شروط على إسرائيل، فانتهاء مذكرة التفاهم الأميركية الإسرائيلية بشأن المساعدات الأمنية لعام 2016 بحلول عام 2028، على سبيل المثال، سيتيح وقتًا مناسبًا لإعادة تقييم مساهمة أموال دافعي الضرائب الأميركيين لدولة غنية تنافس الآن شركات الأسلحة الأمريكية في المبيعات الخارجية. يمكن لإدارة ترامب أن تستخلص، على الأقل، التزامات سياسية مقابل اتفاق لاحق، كما يمكن لواشنطن أن تربط مواقفها التصويتية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأفعال إسرائيلية محددة، أو يمكن للولايات المتحدة، كما فعلت في الماضي، أن تحجب المساعدات عن إسرائيل بما يتناسب مع حجم الاختلاف في السياسات – مثل تقليص المساعدات بمقدار ما تنفقه إسرائيل على المستوطنات.
وأخيرًا، يجب على واشنطن أن تصر على أن يمتنع الطرفان عن التدخل في سياسات بعضهما الانتخابية والحزبية. فقد انغمس نتنياهو مرارًا في السياسة الداخلية الأميركية لدفع أجندته – على سبيل المثال، حين كاد أن يعلن تأييده للمرشح الجمهوري ميت رومني للرئاسة عام 2012، وحين ألقى خطابًا أمام جلسة مشتركة للكونغرس عام 2015 بدعوة من أعضاء جمهوريين، ليهاجم الاتفاق النووي مع إيران. أما الإدارات الأميركية فقد تدخلت في السياسة الإسرائيلية أيضًا، ولكن بوتيرة أقل؛ وأبرز مثال كان محاولة إدارة كلينتون دعم خصم نتنياهو في رئاسة الوزراء، شمعون بيريز، في انتخابات 1996 عبر دعوته إلى البيت الأبيض قبل وقت قصير من توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع.
لا تكمن المشكلة في تعبير حكومة ما عن آرائها بشأن أفعال أخرى أو أن تلتقي بسياسيين معارضين، بل في أن تفعل ذلك بنية تقوية حزب معين. لا يمكن لأي إدارة أميركية أن تتسامح مع هذا النوع من التدخل العلني الذي قامت به إسرائيل من أي شريك آخر. مثل هذا الفعل يتعارض مع روح التعاون التي ينبغي أن تسود بين الحلفاء، وقد أضرّ بكلا البلدين في الحالة الأميركية الإسرائيلية. وتفضيل نتنياهو العلني للجمهوريين لم يمكّنه فقط من تقويض سياسات يدعمها غالبية الأميركيين، بل ساهم أيضًا في تراجع دعم إسرائيل بين الديمقراطيين. ولا يمكن لعلاقة دبلوماسية أكثر طبيعية أن تستمر مع بلد يتصرّف كطرف سياسي متحيز.
تحويل الكلام إلى فعل
لن ينقطع تطبيع العلاقة الأميركية الإسرائيلية، ولا ينبغي أن يقطع، فالتعاون قيّم بين البلدين في مجالات الاستخبارات والتكنولوجيا والتجارة، ولن يعفي السياسيين الفلسطينيين من مسؤوليتهم في إصلاح السلطة الفلسطينية أو يعفي حماس من مسؤوليتها عن هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الذي أشعل الحرب في غزة. لكنه سيمهّد الطريق لنتائج سياسية أفضل.
فعلى سبيل المثال، ستكون الولايات المتحدة في موقع أقوى لمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية، وهي خطوة تتعارض مع المصالح الأميركية وحقوق الفلسطينيين. وستحتاج مناقشة استباقية إلى توضيح تعريف الولايات المتحدة للضم وتحديد كيفية رد واشنطن إذا مضت إسرائيل قدمًا. إن تفاهمًا مشتركًا بأن واشنطن ستنظر بجدية في خيارات سياسية أقوى – مثل التوبيخ العلني أو خصم مبالغ من حساب المساعدات العسكرية لإسرائيل – قد يساعد في ردع الضم. وفي الوقت نفسه، فإن حجب المساعدات العسكرية عن وحدات الجيش الإسرائيلي التي تساعد في بناء مستوطنات الضفة الغربية سيُظهر التزامًا أميركيًا بتطبيق القانون الدولي، الذي يحظر على الدولة نقل سكانها المدنيين إلى أراضٍ تحتلها. وبشكل عام، ستواجه إسرائيل تكاليف أكبر في ضم الضفة الغربية إذا كانت علاقتها بالولايات المتحدة أكثر طبيعية، مما يقلل احتمال اتخاذها تلك الخطوة.
كما أن العلاقة الطبيعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد تسمح بجهد مشترك أكثر استدامة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. قد يكون من الممكن استئناف المفاوضات النووية مع إيران إذا تمكنت واشنطن من ضمان موافقة إسرائيل على الامتناع عن أنواع معينة من العمل العسكري عبر التعهد بالانضمام إلى إسرائيل في الرد عسكريًا إذا تجاوزت إيران عتبة متفقًا عليها. يمكن أن تلعب المشروطية دورًا بنّاءً في هذه السياسة: فقد تعلّق واشنطن مبيعات الأسلحة في حال شنّت إسرائيل ضربة من دون موافقة أميركية، أو قد تتعهد بتقديم مساعدات إضافية في مجال الدفاع الصاروخي لإسرائيل إذا أعادت إيران بناء برنامجها النووي أو الصاروخي الباليستي. وقد يكون من الأسهل حتى بناء دعم من الحزبين لإجراءات قوية ضد إيران إذا امتنعت إسرائيل عن التدخل في النقاشات السياسية الأميركية حول الموضوع.
قوّضت عقود من الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بدلًا من أن تعززه، وكان الفلسطينيون هم الضحايا الأساسيين لهذه الإخفاقات، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل دفعا ثمنًا أيضًا. وحتى يُعالج جوهر المشكلة في العلاقة الثنائية، فإن هذا الثمن لن يتوقف عن التزايد، وستحتاج الولايات المتحدة وإسرائيل إلى التكيف إذا أرادتا لعلاقتهما البقاء، عبر الانتقال من تعاون استثنائي لكنه مدمّر للذات إلى علاقة أكثر طبيعية يمكن أن تشكّل أساسًا لتحالف.
وطالما أن ترامب في المكتب البيضاوي ونتنياهو وائتلافه المتطرف يقودون العلاقة، فمن المشكوك فيه أن تلتزم واشنطن بالكامل بنهج جديد متماسك ومؤسسي. ولكن ليس من المبكر البدء في تقييم الأخطاء التي حدثت ومناقشة كيفية إصلاحها، فإذا ضاعت الفرصة التالية لإعادة ضبط العلاقة الأميركية الإسرائيلية المتزايدة هشاشة، فسيكون ذلك على حساب الأميركيين والإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
المصدر: فورين أفيرز