لا توجد ظاهرة أكثر التصاقًا بالسياسة من الكذب. وليس في ذلك مبالغة، فالسياسة، كما يصفها علماء الاجتماع السياسي، فضاء رمادي لا يسمح دائمًا بقول الحقيقة كاملة، ولا تمنح القادة رفاهية الصراحة المطلقة مع شعوبهم أو خصومهم، لكن الإشكال الحقيقي ليس في وجود الكذب، بل في وظيفته وحدوده المشروعة وتأثيره في تشكيل السياسات.
عند هذه النقطة يتدخّل جون ميرشايمر، أحد أبرز منظّري العلاقات الدولية وأستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، ليقدّم كتابه المثير للجدل “لماذا يكذب القادة: حقيقة الكذب في السياسة الدولية”، الذي يحمل جرأة عنوانه وعمق فرضياته، ما استدعى ترجمته إلى العربية حديثًا، ليعيد فتح نقاش طالما تجنّبه الباحثون حول دور الكذب في صناعة القرار.
ويأتي هذا الكتاب امتدادًا لمسار فكري عُرف به ميرشايمر منذ أن هزّ الأوساط الأكاديمية والسياسية عام 2006، بكتابه المشترك مع ستيفن والت “اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية” الذي تُرجم إلى لغات عديدة، بينها العربية، ورسّخ مكانة ميرشايمر في العالم العربي بوصفه صوتًا نقديًا يقتحم المسكوت عنه، ويحلّل السياسة الخارجية بعيون لا تخشى الاصطدام بالمقدّسات السياسية.
وفي “لماذا يكذب القادة” يتابع الكاتب هذا النهج، لكن عبر مقاربة أكثر حساسية، فهو لا يكتفي بوصف الكذب السياسي، بل يسعى إلى تشريحه، وتصنيف أنماطه، والكشف عن دوافعه، وتقييم آثاره داخليًا وخارجيًا، ويؤسس من خلال ذلك لنقاش نادر لا يتجرأ كثيرون على خوضه في أدبيات السياسة الدولية.
ماهية الكذب السياسي ومنهجيته
قبل تحليل الكذب السياسي والخوض في تفاصيله أو ممارساته،، يصر ميرشايمر على البدء بالسؤال الأكثر مراوغة في الفلسفة والسياسة: ما الحقيقة؟ فهو يرى أنها ليست مفهومًا مطلقًا، بل مرتبطة بما يملكه الإنسان من معلومات، وما يخضع له عقله من تحيزات نفسية وإدراكية.
لذلك، لا يتحدث عن “الحقيقة” بذاتها، بل يفضّل استخدام مصطلح “قول الحقيقة” باعتباره جهدًا شاقًا يبذله الفرد لتجاوز الانحيازات والمصالح الخاصة، وتقديم الوقائع كما يراها المرء بأكبر قدر من النزاهة والاتزان.
وعلى هذا الأساس، يصبح الكذب، في السياسة -كما في الحياة- فعلاً إراديًا واعيًا، يهدف صانع القرار من خلاله إلى تضليل الآخر وإقناعه بأن ما يسمعه حقيقة، رغم علم القائل أنه ليس كذلك.

ولكي تتضح الصورة، يمضي ميرشايمر إلى تفكيك الخلط الشائع بين 3 مفاهيم أساسية تتفرع عنها سائر أشكال التضليل في السياسة: الكذب (إطلاق بيان يعلم صاحبه أنه خاطئ بهدف أن يُصدَّق على أنه صحيح)، والإخفاء (الامتناع المتعمّد عن ذكر حقيقة جوهرية كان من شأنها أن تغيّر مسار الفهم أو الحكم)، والتدوير أو التلاعب (تقديم حقائق صحيحة لكن بطريقة انتقائية أو مُحرّفة نسبيًا تخدم المتحدث وتوجّه المتلقي في اتجاه معين).
وهذان الشكلان الأخيران من الخداع أكثر شيوعًا من الكذب الصريح، سواء لدى الدول أو السياسيين أو حتى الأفراد، لأنهما ممارسات أقل خطورة وتكلفة وأسهل تبريرًا وتحمّلاً في الحياة العامة، ويتيحان للقادة والسياسيين تضليل الجمهور دون التورط في كذبة قد يكلّفهم انكشافها تدهور صورتهم العامة والشخصية.
وعند الانتقال من التعريفات إلى التصنيف، يقدّم ميرشايمر خريطة واسعة لأشكال الكذب السياسي في العلاقات الدولية، تتضمن 7 أنماط رئيسية تشكّل البنية الكاملة للخداع الاستراتيجي، وهي: الكذب بين الدول، والتخويف أو فوبيا التهديد، والتغطية الاستراتيجية، وصناعة الأساطير القومية، والأكاذيب الليبرالية، والإمبريالية الاجتماعية، والتغطيات الدنيئة.
ورغم هذا الاتساع في الأشكال والممارسات، وتلك الصورة الشائعة عن عالم السياسة بوصفه مليئًا بالأكاذيب، يصدم ميرشايمر القارئ باستنتاجه بأن القادة -خلاف ما يُعتقد- لا يكذبون على بعضهم بعضًا كثيرًا، ويشير إلى أن الكذب بين الدول يظل محدودًا نسبيًا، لأنها تمتلك أجهزة استخبارات قادرة في معظم الأحيان على كشف التضليل.
يُضاف إلى ذلك أن التكلفة المرتفعة لانكشاف الكذب على المستوى الدولي يجعل الدول حذرة، إذ لا يمكن للدول أن تعمل في نظام دولي يفتقر بالكامل إلى الحد الأدنى من الموثوقية حتى بين الخصوم، لذلك يميل قادة الدول إلى الابتعاد عن الأكاذيب المباشرة لصالح المواربة والصياغات الرمادية التي تُبقي الباب مفتوحًا للتفاهم دون المجازفة بكلفة الكذب الصريح.
ويختلف الأمر جذريًا عندما يتعلق بالكذب على الجمهور الداخلي، فبينما يتردد القادة في ممارسة الكذب ضد دول أخرى، فإنهم يستخدمونه بوفرة مع شعوبهم، السبب وراء ذلك أن الشعوب يسهل منحها روايات مُحكمة عبر الإعلام والأجهزة السياسية، وتفتقر إلى أدوات التحقيق التي تملكها الدول فيما بينها.
كيف تُستخدم الأكاذيب سياسيًا؟
في عالم لا توجد فيه سلطة عليا تضمن السلام، تجد الدول – بوصفها وحدات فاعلة في نظام دولي فوضوي – نفسها مضطرة إلى للتحرك وفق منطق البقاء، فيستخدم قادتها الأكاذيب كأدوات لحماية مصالحها، وتحصين أمنها، وتعظيم قوتها، وانتزاع تفوق استراتيجي أو حرمان خصومها من ميزة محتملة.
وقد تلجأ الدول إلى المبالغة في قوتها أو إخفاء قدراتها أو اختلاق صورة زائفة عن نواياها لردع خصومها أو لجذب حلفائها. ومن الأمثلة على ذلك، تلاعب بعض الدول بمعلوماتها النووية، ففي أعقاب أزمة الصواريخ الكوبية، قال آرثر سلفستر، مساعد وزير الدفاع الأمريكي في عهد الرئيس جون كينيدي “إن حق الدولة في أن تكذب عند مواجهة كارثة نووية أمر أساسي”.
ومن الأمثلة التي يوردها الكاتب للتأكيد على أن الكذب بين الدول ليس استثناءً، بل جزء من اللعبة السياسية: ادعاءات أدولف هتلر بينما كان يحضّر لأكبر حرب عرفتها أوروبا، وتضليل “إسرائيل” للولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، و”فضيحة لافون” عام 1954 التي حاولت من خلالها “إسرائيل” تخريب إفساد علاقات مصر مع أمريكا وبريطانيا.
هنا يتبلور الفرق الحاسم بين الكذب الاستراتيجي والكذب الأناني. فالأول يندرج تحت شعار “لصالح الدولة”، ويُمارَس لأن القائد يرى في تضليل الجمهور أو إخفاء معلومة ما وسيلة لمنع حرب أكبر، أو لحماية موقف تفاوضي، أو لضمان أمن الأمة.
أمَّا الكذب الأناني فهو ذاك الذي يخفيه القادة لحماية أنفسهم أو حلفائهم أو تجنب فضيحة شخصية أو لتحقيق مكاسب خاصة، وهو ما يسميه ميرشايمر “التغطيات الدنيئة”، ويعتبره أسوأ أشكال الكذب، لأنه يخدم الفرد لا الدولة، ويقوض الثقة العامة، ويفسد الأخلاق السياسية، ويقوّض شرعية السلطة.
دوافع الكذب السياسي
من بين دوافع الكذب الاستراتيجي، يتصدر “إثارة الخوف” أو “الترويع” قائمة الأدوات الأكثر فعالية وخطورة في آن واحد، لأنه لا يخدم فقط قرارًا آنيًا، بل يعيد صياغة الوعي الجمعي ويغير بنية الثقافة السياسية ذاتها، ويحوّل الاعتراضات السياسية إلى واجب وطني.
وتعد تلك الممارسة الأكثر قدرة على تعبئة الجماهير، ويستخدمها القادة لتبرير سياسات كانت ستجد معارضة لو عُرضت بصراحة في الظروف الطبيعية، لذلك يكثر استخدامه عند شن لحرب، أو دعم سياسات خارجية مكلفة، أو شرعنة عقوبات أو حصار، أو تمرير اتفاقات أمنية حساسة.
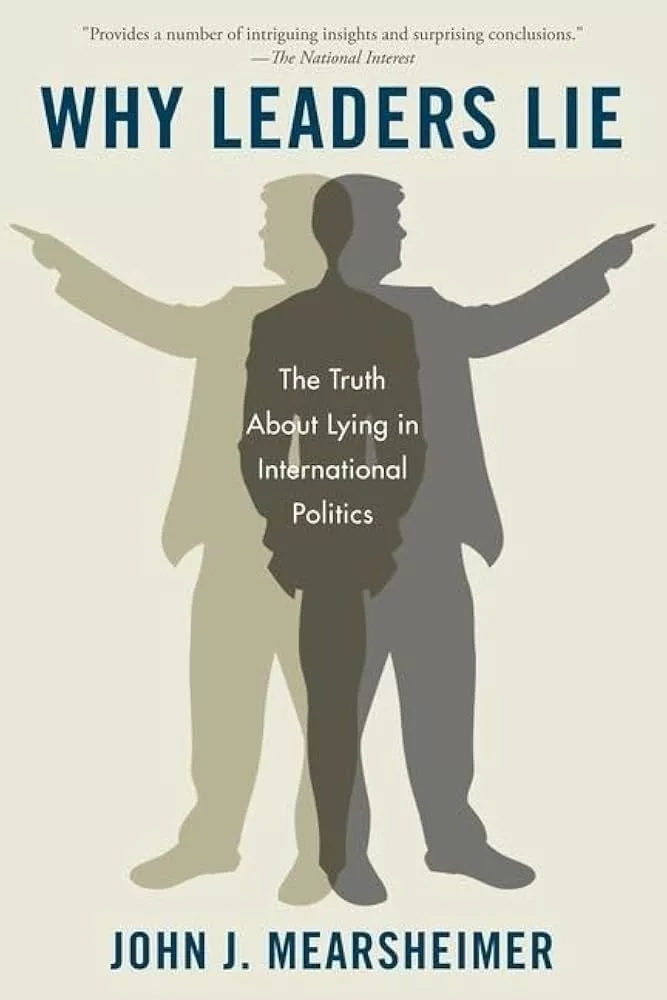
ويزخر التاريخ الحديث بأمثلة تكشف نمطًا مكرر: قيادة سياسية تسعى لإقناع شعبها بخطر عاجل أو وشيك، فتلجأ إلى إعادة صياغة الوقائع لتبدو أكثر إلحاحًا وتهديدًا مما هي عليه. وهكذا يحصل القادة، عبر صناعة شعور جماعي بالخطر، على تفويض شعبي يسهّل تمرير سياسات قاسية -من تدخلات عسكرية إلى تقييد للحريات- تحت ذريعة الضرورة الوطنية.
هنا، تُستدعي صفحات مظلمة من الذاكرة السياسية التي شكلت ملامح “صناعة الخوف”، ففي نهاية الأربعينيات، عمل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق دين آتشيسون في إدارة هاري ترومان على تضخيم الخطر السوفياتي في بداية الحرب الباردة، فاستخدم أساليب نشر الذعر، في محاولة لدفع الناس العاديين والنخب السياسية معًا إلى تبني موقف أكثر تشددًا.
وفي مطلع الأربعينيات، فعل الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت الشيء نفسه حينما عمل على اختراع مجموعة من الأكاذيب ضد ألمانيا، في واقعة الفرقاطة “غرير” أواخر صيف 1941، بهدف إثارة الرأي العام المعادي للحرب العالمية الثانية، وتغييره لمصلحة الانخراط فيها.
وبعد عقدين، أعاد الرئيس ليندون جونسون تشغيل الآلية ذاتها، حين استند إلى رواية مشكوك فيها حول هجوم في خليج تونكين عام 1964، ليمنح نفسه التفويض السياسي والعسكري لتوسيع الحرب في فيتنام.
وبعد نحو 4 عقود، تكرّر المشهد بأكثر صوره حدة عندما نسجت إدارة جورج دبليو بوش سردية تربط بين نظام صدام حسين وتنظيم القاعدة، وأرفقتها بادعاءات حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، واستخدمت هذه الروايات – رغم ضعفها – كقاعدة صلبة للدفع نحو واحدة من أكثر المغامرات الأمريكية كلفة في الشرق الأوسط.
ولا يقتصر الدافع على الحرب فحسب، فهناك “التغطيات الاستراتيجية” التي تهدف إلى إخفاء فشل سياسات معينة أو تجاوزات إدارية أو التستر على قرارات مثيرة للجدل لوقت يُسمح فيه لصناع القرار بتصويب المسار أو تجنب هزة داخلية قد تؤثر على الجبهة الخارجية أو تفادي الانقسامات التي قد تقوّض قدرة الدولة على مواجهة خصومها.
وتأتي “صناعة الأساطير القومية” كآلية بعيدة عن الصدام المباشر، لتكون المادة الرمزية التي تُبنى عليها الهوية الوطنية، حيث تعمل النخب السياسية مع المثقفين، وأحيانًا مع المؤسسة الدينية، على صياغة سرديات تاريخية متخيّلة تُنسب إليها البطولة أو المظلومية أو التفوق الحضاري.
هذه الأساطير المنمّقة التي تتغذى على الخيال أكثر من الواقع ليست حصرية لدولة أو منطقة بعينها، بل تتجلى في معظم الدول المعاصرة، بما في ذلك تلك التي نشأت في ظروف عسيرة أو غير شرعية. وكلما تصاعدت النظرة الخارجية السلبية لتاريخ هذه الدول، تعمّق التمسك بالمبادئ القومية حتى وإن كانت مبنية على أسس مشكوك فيها أو شرعيات مزيفة.
وليس ثمة مثالاً صارخًا على ذلك أوضح من “إسرائيل”. فمنذ بدايتها، روجت الحركة الصهيونية لكذبة مفادها أن فلسطين أرض فارغة. وفي عام 1948، لم يكن من الممكن إقامة دولة “إسرائيل” دون تهجير الفلسطينيين، لكن الرواية التي روّجتها لاحقًا أنكرت التطهير العرقي، واَّدعت أن الفلسطينيين غادروا بيوتهم استجابة لأوامر عربية.
ويصل ميرشايمر إلى نتيجة غير متوقَّعة مفادها أن الديمقراطيات قد تكون أكثر ميلاً من الأنظمة السلطوية إلى الكذب الاستراتيجي، ويفسر هذا التناقض الظاهري بمنطق الحاجة، فالقادة المنتخبون يعتمدون على تأييد شعبي لبقاء سياساتهم أو لخوض مغامرات خارجية أو لتمرير خطط كبرى، لذلك لا يتورعون عن استخدام أساليب الإقناع حتى لو اجتازت حدود الحقيقة، ويلجأون إلى تزييف التهديدات أو تقديم “قصص أخلاقية” تبرر التدخل أو خلق صورة عدائية للخصم أو استخدام الإعلام لتصفية الروايات البديلة.
وينفتح ميرشايمر كذلك على فئة من الخداع أطلق عليها “الإمبريالية الاجتماعية”، حيث يستخدم القادة الأكاذيب والنبرة الثورية لخدمة مصالح اقتصادية وسياسية ضيقة، وغير مرتبطة مباشرة بما يسمى “المصلحة الوطنية”، بل توجه هذه الممارسة الرأي العام لصالح صفقات أو تحالفات تخدم مصالح داخلية فئوية.
لماذا نصدّقهم؟
بجانب دوافع القادة، يتوقف ميرشايمر عند مفارقة هامة لا تتعلق بالقادة وحدهم، بل بالجمهور نفسه، ذلك الذي يمتلك القدرة على رفض الكذب، ومع ذلك ينساق إليه.
هنا ينتقل التحليل من علم السياسة إلى علم النفس، ومن منطق الدولة إلى منطق الجماعة، ليبحث في الأسئلة الأكثر حساسية: لماذا يصدق الناس الأكاذيب السياسية؟ ولماذا ينجح بعضها ويبوء بعضها الآخر بالفشل؟ ولماذا تصمد سرديات في حين تنهار أخرى؟
للإجابة على هذه الأسئلة، يلتفت المؤلف إلى خصائص الجمهور البشري وطبيعة المعرفة الجماعية، ويؤكد أن الأكاذيب لا تعمل إلا إذا وُجدت بيئة قابلة لتصديقها، فالجمهور ليس ضحية ساذجة بقدر ما هو شريك – ولو دون قصد – في عملية إنتاج الوهم.
ولأن البشر يميلون بطبيعتهم إلى تصديق الروايات التي تبدو منسجمة مع قناعاتهم وتصوراتهم المسبقة، وما يلائم سياقًا عاطفيًا يتقاسمون جذوره، فإن الأكاذيب السياسية غالبًا ما تقدَّم في قالب منطقي ومقنع يتناغم مع قناعات قائمة أصلاً، أو مع مخاوف كامنة تنتظر من يُفجّرها.
ويستعيد الباحثون في هذا السياق نظرية “الوعي الزائف” التي تشير إلى قدرة النخب على تشكيل الإدراك الجمعي بطرق تجعل الجماهير تتبنى معتقدات أو قيمًا أو مواقف تتعارض مع مصالحها الحقيقية، وتؤيد النظام الذي يستغلها، وتخدم مصالح من يملكون السلطة.
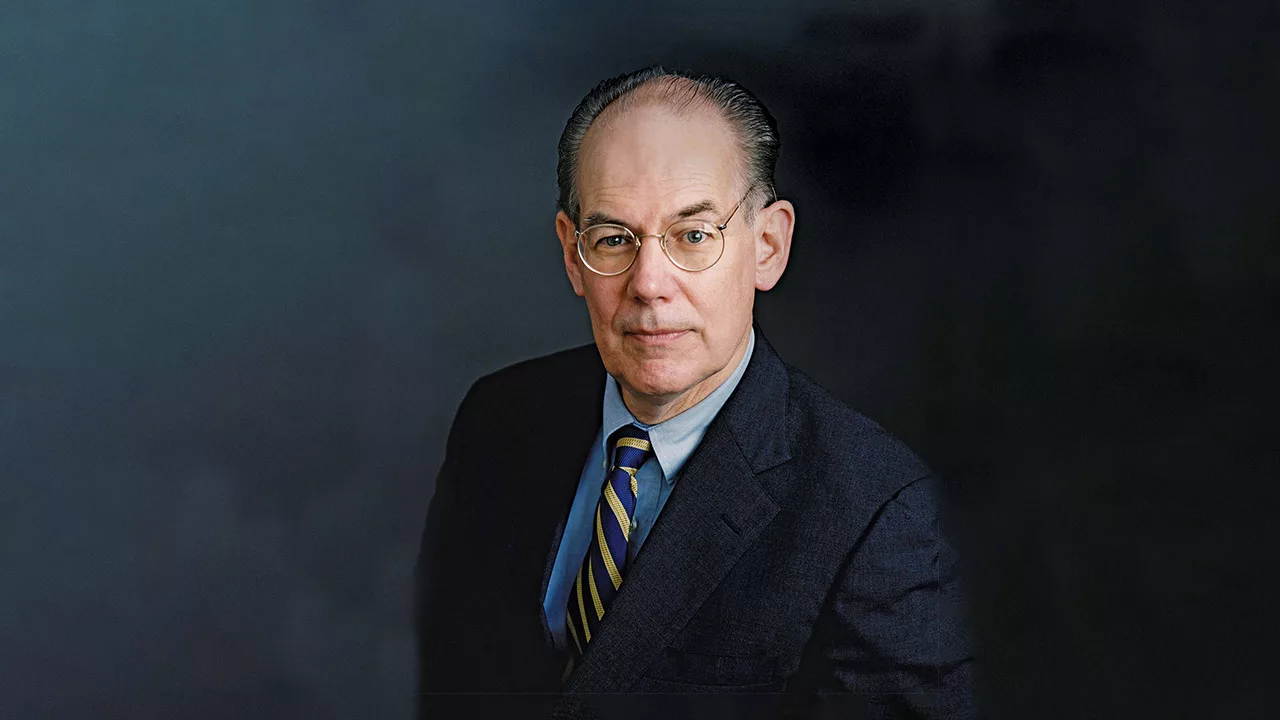
وتؤدي العواطف دورًا بالغ الأهمية هنا، فالكذب الذي يطابق الخيوط العاطفية – مثل المخاوف والذكريات الجمعية والانتماءات القومية – يكون ذا قابلية أكبر للاعتناق من قِبل الجماهير، لأن الإيمان برواية ما يخفف من قلق عدم اليقين، ويمنح معنى لأحداث تشبه الفوضى.
الخوف، مثلاً، يمكن أن يعطل التفكير النقدي، ويحوّل الأكاذيب إلى حقائق راسخة في الوجدان. وقد أثبتت دراسات علم النفس السياسي أن المشاعر تعد أدلة معرفية بحد ذاتها، وأن الناس يستخدمونها لاتخاذ قرارات تبدو عقلانية لكنها مبنية على استجابات وجدانية.
ولا يقل دور الثقة أهمية عن دور العاطفة، فهي الإطار الذي يجعل الجمهور مستعدًا لتقبّل السرديات الرسمية. وحين تُقدَّم الأكاذيب عبر مؤسسات تتمتع بشرعية سياسية أو رمزية، تصبح جزءًا من النظام المعرفي للمجتمع. ولهذا تتحول الجماهير – دون أن تدري – من متلق للكذب إلى منتج له، فقبولها به يمنحه حياة أطول، ويجعل مقاومته أكثر صعوبة.
علاوة على ذلك، فإن الوسائل الإعلامية الحديثة – من صحافة تقليدية إلى منصات رقمية – تسهّل تدوير السرديات وتكثيفها حتى تصبح “حقيقة شعوب”. وهنا يتحول الإعلام ليس فقط ناقلاً بل مصنّعًا للحقيقة.
هذا التلاقي بين القدرة على سرد الرواية والاستعداد لتلقّيها يخلق علاقة تبادلية معقدة: القادة يكذبون لأن الجمهور قابل للتصديق، والجمهور يصدِّق لأن القادة يملكون من الأدوات ما يكفي لصناعة الإقناع. وفي هذه المسافة بين الطرفين تُصنع “الحقيقة السياسية” التي ليست بالضرورة حقيقة، بل ما اتفقت السلطة والجماعة على قبوله بوصفه كذلك.
الارتدادات السلبية للأكاذيب السياسية
على الرغم من المنافع التكتيكية التي قد يجنيها القادة من الكذب، فإن هذا لا يخفي آثاره المدمرة، فالكذبة قد تحقق مكاسب استراتيجية آنية لكنها تكلف ثمنًا طويل المدى، وقد يؤدي نجاحها في تبرير سياسة خارجية إلى ارتقاء مؤقت في نفوذ الدولة أو تأمين فائدة استراتيجية أو منع حرب أو ربح أخرى أو كسب وقت ثمين، لكن فشلها في أداء وظائفها الاستراتيجية يسمم البيئة السياسية، ويزرع الشك، ويعطّل عملية اتخاذ القرار.
وتمتد الآثار السلبية الملموسة للكذب من الساحة الدولية إلى الداخل، فعندما تكتشف الشعوب أنها خُدعت، تنهار ثقتها في الحكومة، وتتراجع شرعية المؤسسات السياسية، وتنشأ ثقافة شك ضخمة، وتتزايد الشعبوية، ويُعاد تعريف الوطنية باعتبارها “تفويضًا للكذب”.
ومع الوقت تتحول الأكاذيب الصغيرة إلى منظومة تضليل شاملة تفقد الشعوب القدرة على التمييز بين الحقيقة والدعاية. وفي حالات عديدة، قد ينجم عن تكرار الأكاذيب انفجار سياسي داخلي يطيح بالقادة ذاتهم.
ويقدم التاريخ الحديث عبرات متعددة، فبعد حرب فيتنام وفضيحة ووترغيت تآكلت ثقة الأمريكيين في قيادتهم، ومع غزو العراق وتبعاته تضاءل كثير من رصيد ثقة واشنطن في عيون شركائها.

وفي العالم العربي، حيث تراكمت سرديات حكومية ملوثة بالتحيز والإخفاء لعقود، وتحول الكذب إلى “أسلوب حياة” سياسي، انعكس هذا التراكم في فجوة ثقة عامة هائلة جعلت أي خطاب رسمي محل شك، بل فتح بابًا لشتى روايات المؤامرة والتطرف، وأفقد النظام السياسي نفسه صلاحيته.
وهذا لا يعني أن الكذب – وإن ظل نادرًا نسبيًا بين الدول – بلا تكلفة دولية، بل محفوف بالمخاطر، وقد تكون نتائجه كارثية، فمجرد انكشاف كذبة واحدة يترك ندبة طويلة في الذاكرة الدبلوماسية، ويقوّض فرص التعاون لعقود، وقد يؤدي إلى انهيار التحالفات، وسباق تسلح، وفقدان المصداقية الدولية، وضعف القدرة على الردع، كما يعقّد القدرة على التفاوض، ويمنح الخصم ذريعة لتشكيل رواية مقابلة تضعف الموقف الدولي للدولة المضللة.
في الوقت نفسه، تبقى الدول مضطرة إلى أن تحافظ على هامش متاح من الغموض والالتباس، وخاصة في الملفات الأمنية، لكن إذا كان الكذب ضرورة سياسية، فكيف يمكن للدول أن توازن بين الضرورة والأخلاق، بين الأمن والصدق، بين المصلحة العامة وحق الشعوب في المعرفة؟
هذا السؤال ليس نظريًا، بل سؤال وجودي يهم كل دولة، وكل مجتمع، وكل نظام سياسي، وخاصة في لحظة عالمية تتشكل فيها الحقائق على يد الخوارزميات، لا على يد البشر.
















