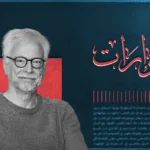لم تنعكس تغيّرات عام 2025 في سوريا على شكل قرارات سياسية فحسب، بل ظهرت بوضوح في ما تبدّل من أنظمة كانت تتحكّم بحياة الناس اليومية، عامٌ شهدت فيه البلاد تحوّلات عميقة ومتباينة، فمع سقوط نظام الأسد، طوى السوريون عقودًا ثقيلة من المعاناة عاشوها تحت قبضة أمنية خانقة، وفسادٍ ممنهج، وتدهورٍ خدمي، وفقرٍ وغلاءٍ خنقا تفاصيل الحياة، إضافة إلى أربعة عشر عاماً من الثورة قُتل واعتُقل وجُرح وهُجّر خلالها الملايين.
ومع انهيار منظومة الأسد، بدأت الصورة تتبدّل، فرفعت قيود رافقت السوريين لعقود وعادت الحياة إلى مدنٍ أنهكها القصف والقمع، وإلى أحياءٍ غادرها شبابها طويلاً خشية الاعتقال، وإلى منازل أُجبر سكانها على مغادرتها.
ليجد سكان المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته أنفسهم أمام واقعٍ مختلف، لا يخلو من التحديات، لكنه أكثر قابلية للحياة، حيث لا حواجز فيه تقطع الطرق، ولا أجهزة أمنية تدير التفاصيل اليومية، ولا “بطاقة ذكية” تتحكّم بحصولهم على الخبز والغاز والمحروقات
حين عاد الحلم ممكناً
“أكثر ما تغيّر هو شعوري بعودة حلمٍ ظننت طويلاً أنه مات قبل أن يولد”، بهذه الكلمات يتحدث علي عثمان (27 عاماً) لـ “نون بوست” عن كيف شكّل عام 2025 نقطة تحوّل في حياته اليومية.
علي شاب من ريف دمشق، وهو المعيل الوحيد لعائلته، ولديه أخت صغيرة، يقول لـ”نون بوست”: “كان عام 2025 نقطة تحوّل جذرية في حياتي اليومية. أبرز ما تغيّر هو شعوري بأن حلمي عاد ينبض من جديد. فالحلم والشغف اللذان كانا في السنوات السابقة مجرد فكرة شبه مستحيلة داخل سوريا، أصبحا في عام 2025 قابلين للتحقق. إذ كانت أحلامنا خلال سنوات الثورة محصورة ضمن حدود صعبة لا تسمح بتحقيقها إلا خارج البلاد، وهذا ما جعلني أفكر دوماً في السفر، رغم ملامة الجميع، بدافع أخلاقي ورغبة صادقة في رعاية أهلي والوقوف إلى جانبهم”.
قبل عام 2025، كانت حياة علي اليومية محكومة بظروف قاسية في معضمية الشام، المنطقة التي عايش فيها مع عائلته الحصار والدمار والنزوح. يقول: “عدنا إلى المعضمية بعد أن دُمّر منزلنا. هذه الظروف جعلت حلمي الإعلامي يبدو كأنه دُفن لسنوات، ولا يمكن تحقيقه داخل سوريا، في بلد يحكمه القمع”.
لكن ما بين الأحلام والخيالات، كان للواقع وجهٌ آخر تماماً، إذ يعمل علي حتى اليوم في ثلاث مهن متزامنة لتأمين مصروف العائلة: صباحاً في ورشة نجارة مع أقاربه، وظهراً في محل بسوق الحريقة لبيع مستلزمات صناعة الأحذية والحقائب، ومساءً في إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق الصوتي مع شركة تسويق رقمي. ويقول إن كل ذلك لم يكن بدافع الإكراه، بل إحساساً بالمسؤولية ورغبة في تخفيف العبء عن والده.
ورغم ضغط العمل، درس علي ثلاثة اختصاصات جامعية في الوقت ذاته، بدافع شغفه بتعلّم مجالات متعددة تصبّ في حلمه الإعلامي. ويوضح أن أي محاولة سابقة للتواصل مع جهات إعلامية خارجية كانت تشكّل خطراً حقيقياً عليه وعلى عائلته.
ويتابع: “لكن في عام 2025 تغيّر كل شيء، وأصبحت قادراً على السعي بجرأة نحو حلمي، وبات الوصول إليه أكثر واقعية. فمنذ الأيام القليلة جداً التي أعقبت سقوط النظام، بدأت بمراسلة القنوات التي طالما حلمت بأن أرسل لها ولو رسالة إلكترونية واحدة فقط، واضعاً كل شغفي وطاقتي لتطوير نفسي والعمل في المجال الإعلامي الذي طالما رغبت فيه”.
حال علي يتشابه مع حال كثير من الشباب الذين لم يستطيعوا مغادرة سوريا، وظلّوا لسنوات تحت وطأة نظامٍ ضيق عليهم سُبل الحياة، وحاصر أحلامهم بالخوف والرقابة وانعدام الفرص.
ليجدوا أنفسهم عالقين بين واقع اقتصادي خانق، وخوفٍ دائم من الاعتقال أو الملاحقة، ما دفعهم إلى دفن طموحاتهم في أعماقهم إلى أجل غير معلوم، بانتظار لحظة تسمح لهم باستعادة حقهم في الحلم والعمل والحياة.
أما خديجة بريمو، أم لثلاثة شبّان من أهالي اللاذقية، تحدثت لـ”نون بوست” عن حلم الكثير من الأمهات، الذي كان مستحيلاً تحقيقه لولا سقوط النظام، وهو رؤية أبنائهن الذين غادروا سوريا بطرق غير شرعية هرباً من الخدمة العسكرية وخوفاً من الاعتقال.
تقول: “منذ 12 عاماً غادر ابني الكبير إلى تركيا بطريقة غير شرعية، ثم إلى اليونان، وكان ذلك برغبةٍ مني ومن والده، إذ كنا نخشى دائماً اعتقاله تعسفياً على أحد الحواجز بسبب عدم التحاقه بالخدمة العسكرية. وبعد أربع سنوات، لحق به الابن الآخر”.
وتتابع: “كنت على دراية كاملة بأنني قد لا أستطيع رؤيتهم مجدداً سوى عبر شاشة الهاتف، لكن الآن أصبح بإمكانهم العودة إلى سوريا متى شاءوا، وأظن أن هذا الأمر هو أفضل ما حدث لكثير من السوريين الذين لديهم أحبة خارج البلاد”.
البطاقة الذكية
شكّلت البطاقة الذكية أحد أبرز أدوات التحكم بالحياة اليومية للسوريين لسنوات، إذ لم تقتصر على تنظيم توزيع المواد الأساسية، بل تحوّلت إلى عبء إضافي على العائلات، ولا سيما الكبيرة منها.
تقول سارة محمد (26 عاماً) من بانياس إن عائلتها كانت تحصل على أسطوانة غاز واحدة كل 45 يوماً أو 65 يوماً فقط، وهو ما لم يكن كافياً لتغطية احتياجاتهم اليومية، في وقت كان فيه شراء الغاز من السوق السوداء مكلفاً للغاية. ورغم أن أسعار الخبز والغاز ارتفعت لاحقاً، فإن توفرها الدائم بعد إلغاء البطاقة الذكية شكّل فارقاً ملموساً في حياة الناس.
وتضيف سارة أن البطاقة لم تكن مجرد وسيلة تنظيم، بل تحوّلت إلى أداة ضغط على الأهالي، إذ كانت بعض أسطوانات الغاز الموزّعة عبرها تعاني من نقص في الوزن نتيجة الغش، ولا تكفي سوى عشرة أيام. كما أن فقدان رسالة الاستلام كان يعني خسارة الدور بالكامل، والاضطرار إلى انتظار دورة التوزيع التالية، ما فاقم معاناة المواطنين وزاد شعورهم بالعجز أمام نظام لا يراعي احتياجاتهم الأساسية.
أما علي فيقول إن البطاقة الذكية كانت أداة لخلق الأزمات وفرض معاناة يومية على الشعب السوري، ولم يقتصر تأثيرها على الخبز والغاز، بل شمل المحروقات وعدة جوانب أخرى من الحياة. ويشير إلى أنها استُغلت لتوليد تجارة سوداء، عبر تواطؤ بين القائمين على الأفران وبعض التجار، حيث كان الخبز يُباع بأسعار مضاعفة، وتتشكّل طوابير وازدحامات طويلة ترهق المواطنين.
ومع إلغاء البطاقة الذكية، تبدّل المشهد اليومي للسوريين، إذ بات الخبز والغاز والمحروقات متوفرة من دون قيود أو انتظار.

أمّا خديجة، فلم يُشكّل إلغاء البطاقة الذكية فارقاً كبيراً في حياتها، إذ تقول إن عائلتها كانت تمتلك بطاقة ذكية، لكنهم مع ذلك كانوا يشترون الخبز والغاز وغيرها من المواد بالسعر الحر، بحجة أن لديهم منزلاً وسيارة، كما قيل لهم، وتضيف أن المواد باتت متوفرة اليوم، لكن ارتفاع الأسعار جعل هذا التوفر بلا أثر حقيقي على مستوى المعيشة.
تحسّن معيشي محدود
إلى جانب التحوّلات التي طرأت خلال عام 2025، لا يزال الأثر المعيشي للتغيير محدوداً بالنسبة لشرائح واسعة من السوريين. تقول سارة لـ “نون بوست”، إن حياتها اليومية تغيّرت من حيث القدرة على التعبير عن الرأي وانتقاد أداء الجهات الرسمية والتحدث عن أي شيء من دون خوف، بعد سنوات من الكبت والملاحقة.
في المقابل، تؤكد سارة أن التحسّن الاقتصادي لم يواكب هذه التحوّلات، مشيرة إلى أن التغييرات المعيشية ما تزال محدودة الأثر، ورغم وجود بعض التحسّن، إلا أنه لم ينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين اليومية حتى الآن، وتتابع: من أبرز التغييرات التي لمستها أيضاً، باتت إمكانية عودة الأقارب والأصدقاء الذين كانوا خارج البلاد في أي وقت، من دون قيود أمنية.
أما علي فيقول شعرنا بتحولات ساهمت بتحسين المعيشة، ولو بشكل طفيف مثل انخفاض الأسعار نسبياً، وتوافر السلع التي كانت نادرة في السوق السورية، وانخفاض أجور المواصلات.
وعلى سبيل المثال يقول علي: “كانت أجور السرفيس سابقاً تتراوح بين 4–5 آلاف ليرة لكل خط، بينما كنت مضطراً في تلك الفترة لدفع 15–20 ألف ليرة ذهاباً وإياباً اليوم أصبح الحصول على وسائل النقل أسهل وأكثر توافراً، ما خفّض من تكاليفي اليومية بشكل ملموس”.
ويتابع: “كانت التنقلات اليومية في سوريا عموماً وبين مختلف مدن دمشق وريفها تجربة مرهقة للغاية، تكاد تكون مرضاً نفسياً، حيث كنت أضطر يومياً للوقوف في الشارع أكثر ما يقارب الساعة، بانتظار وسيلة نقل عامة. وفي كثير من الأحيان، ينتهي بنا الأمر إلى ركوب سيارة أجرة بطريقة “المشاركة” مع ثلاثة أو أربعة ركاب لتغطية الأجرة. هذا الواقع انعكس سلباً على نفسيتي، وعلى قدرتي على إنجاز عملي وتنظيم يومي”.
ويضيف: “أما خلال 2025 أصبح الحصول على وسائل النقل سهلاً ومتاحاً، وأثر إيجاباً على حياتي اليومية وحياة كل المواطنين، من طلاب وعمال وأصحاب مهن، بعد سنوات من الركض وراء المواصلات في صعوبات مستمرة”.
وأدى انخفاض أسعار المشتقات النفطية، إلى تحسن حركة النقل، وتوفر عدد أكبر من المركبات، وانخفاض في سعر تعرفة الركاب بمعظم الخطوط في دمشق وريفها.
ويرى علي أن مستوى الخدمات في دمشق قد تحسن بشكل ملحوظ جداً، خصوصاً من حيث النظافة العامة للطرقات، والعناية بإشارات المرور وغيرها من المرافق العامة. أما في مدن ريف دمشق، فقد شهد التحسن بعض الشيء، لكنه لا يزال أقل وضوحاً من العاصمة، مع توقع امتداد هذا التحسن تدريجياً إلى المناطق الريفية.
ويضيف أن: “التحوّل الأهم الذي لم يحدث بعد هو الرفع الجدي والحقيقي لأجور العاملين في القطاع الحكومي، فرواتب الموظفين ما زالت متدنية جداً، وحتى بعد الزيادات الأخيرة، إذ لا تتجاوز في أفضل حالاتها نحو 150 دولاراً، وهو مبلغ لا يكفي لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة”.

“ويشكّل الموظفون الحكوميون شريحة واسعة من المجتمع السوري، وتحسين دخلهم سينعكس مباشرة على الاقتصاد ككل. فحين يمتلك المواطن القدرة على الشراء سواء الملابس أو طعام، أو احتياجات أساسية، فإن المال يبدأ بالدوران، ينتقل من المستهلك إلى التاجر، ومن التاجر إلى العامل، ثم يعود مرة أخرى إلى السوق. بهذا الشكل تتحرك عجلة الإنتاج، ويُخلق طلب حقيقي ينعش مختلف القطاعات. وببساطة، لا يمكن للاقتصاد أن ينهض دون تمكين المواطن مالياً، ورفع الأجور هو الخطوة الأساسية لإطلاق هذا المسار”، بحسب ما قاله علي لـ “نون بوست”
وتابع: “ما زالت هناك تحديات مستمرة حتى الآن. فهناك مشكلات في البنية التحتية.كذلك يشكل موضوع المياه تحدياً قائماً، مع تفاوت في توزيعها وخصوصاً في الصيف، باختصار، قلة الحد الأدنى للأجور، ومشكلات الكهرباء، وندرة المياه تمثل أبرز العقبات التي ما زلنا نواجهها رغم التحولات الأخيرة، وهي تحديات تحتاج إلى حلول استراتيجية لتحسين مستوى المعيشة للمواطن السوري”.
وعلى صعيد الكهرباء، تشير سارة إلى تحسّنٍ نسبي في ساعات التغذية ببانياس خلال عام 2025، مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت تقنيناً قاسياً. فبعد أن كانت الكهرباء لا تأتي سوى لنصف ساعة متقطعة كل عشر ساعات، بات التيار يُزوَّد حالياً بنحو أربع ساعات متواصلة مقابل ساعتين قطع، وهو تحسّن ملموس، رغم أنه لا يزال دون المستوى المطلوب.
أمّا على صعيد الخدمات، فتوضح أن معظم المواد باتت متوفرة في الأسواق، غير أن المشكلة الأساسية لم تعد في التوفّر، بل في الأسعار التي لا تزال مرتفعة مقارنة بدخل المواطنين. ويُعدّ الغلاء المعيشي التحدي الأبرز اليوم، إذ تؤكد سارة أن التحسّن الذي طرأ على حياة الناس ما زال محدود الأثر، ولم ينعكس بشكل واضح على المستوى المعيشي، في ظل استمرار اعتماد كثير من العائلات على التحويلات المالية من أبنائها في الخارج لتأمين احتياجاتها الأساسية، وسط آمال بأن تشهد السنة المقبلة زيادات على الرواتب.

وتقول خديجة بريمو، إن وضع الكهرباء في اللاذقية لم يشهد تحسّناً جذرياً، فحالياً تصل لنحو أربع ساعات ونصف خلال 24 ساعة فقط.
بالإضافة إلى أزمة السكن، فتفاقمت بشكل كبير في اللاذقية خلال عام 2025، إذ ارتفعت إيجارات البيوت إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل عودة أعداد كبيرة من المهجّرين إلى اللاذقية بعد التحرير، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب وارتفاع الأسعار.
واقع أمني مختلف
يُجمع معظم من تواصلت معهم “نون بوست” على أن التحسّن الأمني يُعد أحد أبرز التحولات التي شهدتها البلاد بعد سقوط نظام الأسد، فاختفاء الحواجز العسكرية والمربعات الأمنية التي كانت منتشرة بكثافة في مختلف المناطق أحدث تغييراً جذرياً في الحياة اليومية للسوريين. فخلال سنوات الثورة السورية، لم يكن التنقل بين مدينة وأخرى رحلة داخلية عادية، بل مساراً شاقاً يمرّ عبر عشرات نقاط التفتيش، التي تحوّلت إلى مصدر ابتزاز ودخل للضباط والمسؤولين السابقين، وفرضت على السوريين واقعاً يومياً من الخوف والإذلال.
بالإضافة إلى أن إلغاء الحواجز الأمنية لم يلغي التحديات الأخرى، ولا سيما الارتفاع الملحوظ في حوادث السرقة، في ظل انتشار أمني لا يزال غير كافٍ للحد منها، وما تزال تُسجل جرائم متفرقة في عدد من المناطق السورية، تتنوع دوافعها.
وتصدّرت سوريا قائمة الدول العربية في معدلات الجريمة، بمعدل 68.1، وفق بيانات مؤشر قياس الجريمة في قاعدة بيانات “Numbeo“.
تروي سارة لـ”نون بوست” جانباً من تلك المعاناة، مشيرةً إلى أن شقيقيها كانا يدرسان في الجامعة، أحدهما في طرطوس والآخر في اللاذقية، وكانا يُنزَلان من حافلات النقل عند معظم الحواجز، حيث تُصادَر هوياتهما للتفتيش، ويتعرّضان للإهانات والكلمات البذيئة، ولا سيما لكونهما من مواليد عين ترما.
وتضيف أن هذه الممارسات دفعت العائلة إلى تجنّب السفر قدر الإمكان، فتقول: “وصلنا إلى مرحلة لم نعد نطيق فيها السفر إلى أي مكان خارج بانياس”، وتتابع: “لكن الخوف والتوتر اللذين كانا يرافقان أي احتكاك مع عناصر الأمن في عهد النظام تراجعا اليوم بشكل ملحوظ، ولم يعد الحديث مع عنصر أمن يحمل الرهبة ذاتها المرتبطة سابقاً بالاعتقال أو التعسف، بل تغير إلى حد كبير بما كان عليه سابقاً”.
أمّا علي عثمان، فلم تشفع له ورقة “الوحيد” التي تعني إعفاءه من الخدمة العسكرية، أثناء مروره على الحواجز، إذ كان عناصر الحواجز يأمرون بإنزاله وتفتيشه وإجراء “التفييش” على هويته، ولا سيما لكونه من أبناء المعضمية، بحسب قوله. وقد جعل إلغاء الحواجز تنقّله اليوم أكثر سهولة، شأنه شأن معظم شباب سوريا.
ومع اختفاء الحواجز الأمنية اليوم، يرى كثير من السوريين أن حرية التنقّل شكّلت أحد أكثر التغييرات تأثيراً على حياتهم اليومية، بعد سنوات طويلة من القيود والخوف. فالتغيير لم يقتصر على شعور الفرد بالأمان الشخصي فحسب، بل انعكس أيضاً على الحالة النفسية للأسر بأكملها.
فالنظام السابق لم يكن بحاجة إلى سبب واضح لاعتقال شخص، كان وجود حاجز طيّار أو عسكري كافياً لإثارة الخوف والتوتر المستمر. وبعد سقوط النظام وإزالة الحواجز، لم يشعر السوريون فقط بالأمان، بل بشيء أعمق كما يقول من التقتهم “نون بوست” إحساس بالحرية والطمأنينة النفسية التي حُرمت منها العائلات لسنوات طويلة.
وتقول سارة، رغم الصعوبات القائمة، فإن شعوراً عاماً بالأمان ساد بعد سقوط النظام، معبّرة عن أملها في أن يستمر هذا الاستقرار. لكنها تلفت في المقابل إلى أن أحد التحوّلات التي لم تكتمل بعد يتمثّل في بقاء أجزاء من سوريا خارج سيطرة الدولة، ولا سيما المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وتتوقع سارة أنه في حال استمر المسار الحالي، وترافقت المرحلة المقبلة مع دعم حقيقي وإطلاق مشاريع إعادة إعمار، فإن ذلك سيسهم في توفير فرص عمل واسعة وتحسين الواقع المعيشي. وتختم بالقول إن أفراد عائلتها، ككثير من السوريين، أجمعوا على أن عام 2025 كان عام الحرية والفرح، رغم ما حمله من تحديات وصعوبات.
من جهته، يقول علي إن عام 2025 كان بالنسبة له “عام المستحيلات التي تحققت”، فبعد سنوات شعر خلالها أن الأحلام لا مكان لها في هذه البلاد، جاء هذا العام ليؤكد له أن ما ظنّه مستحيلاً لم يكن إلا مؤجلاً، وأن الطريق، مهما طال، لا يُغلق في وجه من يصرّ ويصبر.
ورغم هذه التحوّلات، لا يزال السوريون يواجهون تحديات كبيرة، إذ يعاني قسم واسع منهم من الفقر، وارتفاع الأسعار، وانخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة.
ووفقاً لبيانات “مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة” الصادر في حزيران الماضي، فإن الحد الأدنى للأجور في سوريا، والمحدد بـ750 ألف ليرة سورية، لا يغطي أكثر من يومين ونصف من احتياجات أسرة من خمسة أفراد، مقابل متوسط تكاليف معيشة تجاوز 14.4 مليون ليرة سورية، فيما وصل الحد الأدنى إلى نحو تسعة ملايين و100 ألف ليرة سورية.