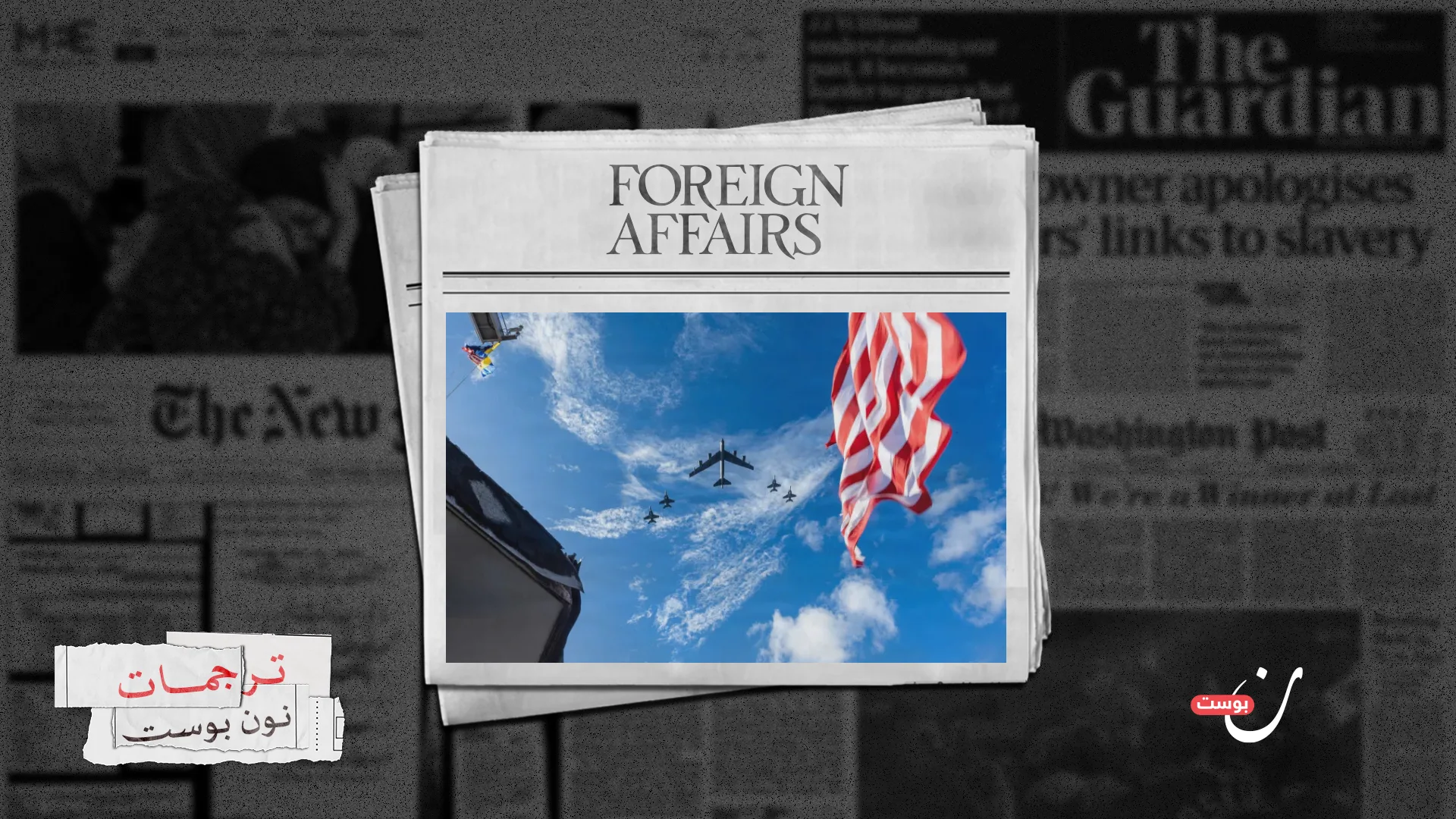ترجمة وتحرير: نون بوست
عندما أعرب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري عن أسفه لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتصرّف “بأسلوب يعود إلى القرن التاسع عشر” عقب غزو شبه جزيرة القرم عام 2014، لم يكن على الأرجح يتوقع أن تعكس عبارته بدقة السياسة الخارجية الأمريكية الحالية.
عقد المحللون العديد من المقارنات بين أحداث تاريخية والتدخل الأمريكي في فنزويلا الأسبوع الماضي، ويزخر القرن العشرون في الواقع بالعديد من الخيارات. لكن الحقبة الأكثر صدىً هي تلك التي بدأت فيها التدخلات الأمريكية الدورية والثقيلة في أمريكا اللاتينية. وتبدأ هذه القصة عام 1898.
بعد أن هزمت الولايات المتحدة إسبانيا في حرب عام 1898 (المعروفة أيضًا بالحرب الإسبانية الأمريكية)، استولت على المستعمرات الإسبانية السابقة في غوام والفلبين وبورتوريكو، وأقامت نظام حماية على كوبا. وبشكل منفصل، ضمّت هاواي وكانت تستكشف إمكانية إنشاء قناة تشق نيكاراغوا (اختارت بنما لاحقًا)، كما حاولت شراء أراضٍ من الدنمارك في منطقة الكاريبي. وعلى مدى نصف قرن بعد عام 1898، لم تكن الشمس تغيب عن الإمبراطورية الأمريكية.
كانت الولايات المتحدة تتمتع بالفعل بخبرة واسعة في التوسّع والاستغلال والاستعمار، لكن عام 1898 شكّل نقطة تحوّل. ففي غضون أشهر قليلة، أطاحت الولايات المتحدة بإمبراطورية أوروبية، واستولت على أكثر من سبعة آلاف جزيرة تبعد أكثر من سبعة آلاف ميل عن ساحل كاليفورنيا، وأصبحت على الفور قوةً في المحيط الهادئ. ومنذ ذلك الحين، لم ينخفض عدد القوات الأمريكية عن مئة ألف جندي. وكما قال وودرو ويلسون قبل عقد من توليه الرئاسة الأمريكية: “لم تغيّرنا أيّ حرب كما غيّرتنا الحرب مع إسبانيا… لقد شهدنا ثورة جديدة”.
عادت حقبة عام 1898 إلى الأذهان، فأوجه الشبه الظاهرة كثيرة. حماسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية والسياسات الحمائية، واهتمامه باستعادة قناة بنما، والتوتر مع كندا، وتركيزه على أمريكا اللاتينية، وسعيه وراء أراضٍ دنماركية، كلها أمور تعيد إلى الأذهان بدايات القرن العشرين. وليس من المستغرب أن يكون أحد قدوات ترامب هو الرئيس ويليام ماكينلي، الذي تولّى منصبه بين عامي 1897 و1901. وربما يحظى خليفته ثيودور روزفلت، الذي واصل سياسات ماكينلي ووسع نطاقها، هو الآخر بإعجاب ترامب، إذ كان أول رئيس أمريكي ينال جائزة نوبل للسلام. وقد فتح ماكينلي وروزفلت معًا الباب أمام دخول الولايات المتحدة في “القرن الأمريكي”، وهي فترة الهيمنة الأمريكية عالميا.
مع ذلك، تتجاوز أوجه التشابه التاريخية مجرد السياسات أو الإجراءات. فإدارة ترامب لا تستخدم فقط دليلًا قديمًا، بل إنها – وبشكل أكثر أهمية – تُعيد إحياء طرق قديمة في تصوّر القوة والأمن. لقد أعادت إحياء رؤية للعالم تُركّز على الثروة والجغرافيا والحضارة، وهي مقاييس لتقدّم الدول عمرها قرون. وتشبه الأهداف المادية والثقافية لإدارة ترامب إلى حد كبير تفكير تلك الحقبة من السياسة الخارجية الأمريكية. لكن في سبيل الارتقاء بهذه الرؤية وتنفيذها، ينبغي لترامب ومستشاريه أن يستوعبوا أعظم درس من عام 1898: كلما تدخّلت الولايات المتحدة في الخارج، بدا كلّ تحدٍّ جديد تواجهه أمرا حيويا يجب حلّه، وأصبح من الأصعب على واشنطن أن تُخرج نفسها من تعقيدات تلك التدخلات.
قوة العالم القديم
كان الاقتصاد القوي محورًا أساسيًا في تصور ماكينلي للقوة والأمن. أراد ماكينلي حماية الأمريكيين من حالة عدم اليقين والخوف والمعاناة الاقتصادية. وكان لديه إدراك متطور للقوة الأمريكية، قائم على الازدهار الداخلي والاعتماد على الذات والتصنيع. لم يكن قلقا كثيرًا بشأن هجوم عسكري مباشر على الأراضي الأمريكية (باستثناء حرب عام 1898 مع خطر قصف إسباني للسواحل الأمريكية). لكنه كان يخشى من أن يتسبب الكساد في حالة من الذعر والفوضى. ولهذا السبب، عند توليه الرئاسة، كان اهتمام ماكينلي بالشؤون الخارجية أقل بكثير من الشأن المحلي.
كما كان للتوسع دور في هذه المعادلة. فقد قال ماكينلي أمام حشد في مينيابوليس عام 1899، عندما شبّه مكاسبه في المحيط الهادئ بصفقة شراء لويزيانا عام 1803 واحتفى بالأراضي الجديدة التي أضيفت إلى الولايات المتحدة: “إن توسيع أراضينا أضاف بشكل هائل إلى قوتنا وازدهارنا”. أضاف ضمّ الفلبين دولة بحجم ولاية أريزونا إلى ممتلكات الولايات المتحدة. وفي نظر ماكينلي، منح ذلك الولايات المتحدة هيبة واحترامًا. وقال ذات مرة لأحد مستشاريه: “من أفضل ما قمنا به هو إصرارنا على الاستحواذ على الفلبين… وهكذا في غضون أشهر قليلة أصبحنا قوة عالمية”.
أما روزفلت فقد ذهب بهذا التوجه خطوة أبعد. ففي نظره، لم تكن القوة والأمن مجرد امتلاك أراضٍ، بل بل مفهوما استراتيجيا أوسع للجغرافيا. مكّن احتلال ماكينلي لكوبا والسيطرة على بورتوريكو خلفه روزفلت من التعامل مع أمريكا اللاتينية باعتبارها ضمن نطاق النفوذ الأمريكي، الأمر الذي ألهمه “التفسير الإضافي لمبدأ مونرو”، الذي استند بشكل صريح إلى سياسة ماكينلي بتحويل كوبا إلى محمية. ولم يكن هذا التفسير الإضافي مجرد إضافة، بل كان تناقضًا. فمبدأ مونرو كان يهدف إلى منع القوى الأوروبية من إنشاء مستعمرات جديدة في نصف الكرة الغربي. وقد وضع هذا المبدأ الولايات المتحدة في مواجهة أوروبا دفاعًا عن السيادة. أما تفسير روزفلت فقد أكّد أن الولايات المتحدة ملزمة بالتدخل لحماية دول نصف الكرة الغربي من عدم الاستقرار والفوضى الداخلية، أي حمايتها من نفسها. وهكذا وضع الولايات المتحدة في مواجهة نصف الكرة الغربي، في انتهاك للسيادة.
كان مفهوم الحضارة هو الركيزة الأخيرة وربما الأهم في تصوّر القوة والأمن لدى كل من ماكينلي وروزفلت. فقد كانت النخب في تسعينيات القرن التاسع عشر تنظر إلى الحضارة باعتبارها مقياسًا لإنجاز المجتمعات، وقد صنّفت الشعوب في تسلسل هرمي للتقدّم يبدأ بما يُسمّى بالهمجيين والبرابرة في أدنى المراتب، وصولاً إلى المجتمعات شبه المتحضّرة ثم المتحضّرة في أعلاها. وقد ارتبطت الحضارة في نظر النخب الأمريكية آنذاك بسمات عديدة، منها سيادة القانون والنظام والحكم الذاتي والابتكار والأخلاق والازدهار والمسيحية والحداثة ومحو الأمية والتعليم. وقد تأثرت هذه المعايير بشدة بالتحيّزات العرقية والاجتماعية والثقافية السائدة، ومهّدت لمصطلحات حديثة مثل “الشمال والجنوب العالمي”، و”الاقتصادات الناشئة”، و”العالم الأول والثالث”، التي تصنّف المجتمعات بدورها ضمن تسلسل هرمي للتقدم بمعايير غامضة.
كانت الحضارة نقطة التقاء بين الثقافة والأمن، فالتآكل الداخلي للحضارة كان ينذر بالفوضى والاضطراب والبؤس. وقد دفع ذلك العديد من النخب إلى الدعوة لمنع دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة. ففي أواخر القرن التاسع عشر على سبيل المثال، قدّم الكونغرس عشرات القرارات لاستبعاد ومعاقبة الفوضويين، إذ اعتبرهم المسؤولون تهديدًا للأمن القومي، كما وثّق المؤرخ ألكسندر نونان بدقة. كان ذلك صحيحًا، إذ اغتال أحد الفوضويين ماكينلي عام 1901، بعد ستة أشهر فقط من بدء ولايته الرئاسية الثانية.
وبالمثل، استخدم آخرون منطق الحضارة لمعارضة الإمبريالية الأمريكية. فعلى سبيل المثال، حث وزير خارجية ماكينلي، ويليام داي، الرئيس على عدم ضمّ الفلبين عام 1898 لأنه كان يخشى أن يؤدي إدماج شعوب أجنبية في الكيان السياسي الأمريكي إلى تهديد حضارة البلاد. وكتب داي إلى الرئيس أثناء مفاوضاته على التسوية النهائية مع إسبانيا: “كما قلت لك دائمًا، إن ضمّ هذا الأرخبيل الكبير الذي يضم ثمانية أو تسعة ملايين إنسان جاهل تمامًا، وكثير منهم منحطّون، مع قدرة على استيعاب خمسين مليون نسمة، يبدو مهمة جسيمة للغاية لبلد يفتخر ببناء حكمه على رضا المحكومين”.
كان ماكينلي وروزفلت يعتقدان أن الشؤون الدولية ستكون أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر سلمية إذا ما تشابهت دول أخرى مع الولايات المتحدة من حيث المعايير الحضارية. وقد أطلقتُ على هذه الفكرة اسم “نظرية السلام الحضاري”، التي تحوّلت لاحقاً إلى “نظرية السلام الديمقراطي” التي سادت في القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، والتي تفترض أن الديمقراطيات لا تخوض الحروب ضد بعضها البعض.
وبالنسبة لروزفلت، دعمت هذه النظرية أيضًا ما وصفه المؤرخ تشارلي لادرمان بـ”التفسير الإضافي الثاني” لمبدأ مونرو، الذي وضع مجموعة من المبادئ للتدخل في مواجهة “جرائم ضد الحضارة”، بما في ذلك الفظائع التي ترتكبها الحكومات بحق شعوبها. فقد كان روزفلت يعتقد أن لدى الولايات المتحدة واجبًا حضاريًا لمعاقبة السلوك السيء ومنع الانتهاكات الفادحة في أي مكان من العالم.
لقد شكّلت هذه الركائز سياسة الأمن خلال إدارتَي ماكينلي وروزفلت، وأفضت إلى حقبة لم تقتصر على بناء الإمبراطورية، بل شملت أيضًا التدخل في شؤون دول أخرى للحفاظ على الأراضي والنفوذ وحقوق التجارة، فضلاً عن الترويج لما كان يُعتبر آنذاك تقدّمًا حضاريًا.
قوة عالمية جديدة
ينظر قادة الولايات المتحدة اليوم إلى القوة والأمن بطريقة مشابهة لماكينلي وروزفلت. يلعب الاقتصاد على سبيل المثال دورًا رئيسيًا في سياسة ترامب للأمن القومي. ويهدف تركيز إدارته على “إعادة التصنيع” والحمائية والاعتماد على الذات، إلى استعادة العصر الذهبي الأمريكي للصناعة في أواخر القرن التاسع عشر، حين شهد الاقتصاد الأمريكي تحوّلا صناعيّا.
وكما كتبتُ سابقًا مع دون غريفز في مجلة فورين أفيرز، فإن رؤية ترامب للأمن الاقتصادي تعطي الأولوية أيضًا لمنطق انتهازي قصير النظر يُطبّق على السياسات المتعلقة بالتكنولوجيا، والتحالفات، والتنمية، وحتى الهدايا من الحكومات الأجنبية. ولهذا السبب، عندما يتعلق الأمر بفنزويلا، ستستهدف الإدارة الأمريكية بشكل متزايد موارد البلاد الطبيعية، ولا سيما احتياطاتها الكبيرة من النفط والمعادن.
كما أن للأراضي – أي الأقاليم – أهمية بالغة لدى إدارة ترامب. فلو كانت موارد الطاقة وسلاسل التوريد والمصالح الاقتصادية هي أولويتها الوحيدة، لكان التفاوض على اتفاقيات تجارية، وبناء وتأجير الموانئ، وتأمين حقوق التعدين هو لغة المرحلة، وليس الضمّ. لكن ترامب ألمح حتى الآن إلى إمكانية الاستحواذ على أراضٍ في بنما وكندا وغزة وغرينلاند.
وبعد اختطاف مادورو في جنح الليل الأسبوع الماضي، وعد ترامب بإدارة فنزويلا قائلاً: “سوف نديرها إلى أن يحين الوقت لانتقال مناسب للسلطة.” ويبدو أن شكلًا من أشكال نظام الحماية ليس مجرد احتمال، بل نية معلنة. وفي أعقاب العملية الدراماتيكية في فنزويلا، أعاد مساعدو ترامب التلويح بتهديدات تتعلق بالاستيلاء على غرينلاند.
ما يجعل الماضي حاضرًا بقوة في سياسة ترامب تجاه فنزويلا هو الدور المحوري الذي تلعبه مفاهيم الحضارة في تصرفات الرئيس. فاختطاف مادورو ينسجم مع منطق تفسير روزفلت لمبدأ مونرو، أي استقرار نصف الكرة الغربي، ومع “التفسير الإضافي الثاني” غير الرسمي، أي معاقبة الجرائم ضد الحضارة.
لا شك أن مادورو يُعدّ وصمة عار في تاريخ فنزويلا، وقد دعا العديد من المشرّعين الأمريكيين البارزين إلى تغيير النظام قبل وقت طويل من تنفيذ ترامب عمليته المفاجئة. حققت إزاحة مادورو التزامين من التزامات روزفلت. كما أن ترامب يعتقد أن الفنزويليين غير قادرين على حكم أنفسهم، على الأقل في الوقت الراهن. وقد قال في الثالث من يناير/ كانون الثاني: “لا نمانع في قول ذلك، لكننا سنضمن أن يُدار البلد بشكل صحيح”. ويعكس هذا التشكيك في قدرة فنزويلا على حكم نفسها القلق الحضاري الذي أبداه ماكينلي بشأن الفلبينيين قبل ضمّ الأرخبيل. أصرّ ماكينلي على أن الولايات المتحدة وحدها يمكن أن تعلّمهم كيفية إدارة بلدهم.
كما تظهر أفكار الحضارة بوضوح في سياسات ترامب الأمنية الأخرى. توسّع نطاق المداهمات التي تقوم بها وكالة الهجرة والجمارك، والتركيز الكبير على الحدود الأمريكية، وإلغاء التأشيرات على نطاق واسع، كلها إشارات واضحة إلى رغبة في تجانس المجتمع الأمريكي.
وفي استراتيجية الأمن القومي لعام 2025، حذّرت إدارة ترامب من “محو الحضارة” في أوروبا وتآكل “الهوية الغربية”. هذا بالضبط ما يبدو أن الإدارة تخشى حدوثه داخل الولايات المتحدة نفسها. ومن هنا جاءت سيطرتها المركزية غير المعتادة على معارض مؤسسة سميثسونيان، وهجماتها على مختلف مستويات النظام التعليمي الأمريكي. وكما كان ويليام داي قلقًا من أن يصبح الفلبينيون في نهاية المطاف ناخبين أمريكيين، يرى العديد من قادة الحزب الجمهوري اليوم أن التنوّع يشكّل تهديدًا للأمن القومي. وجاء في استراتيجية 2025: “لقد انتهى عصر الهجرة الجماعية”.
المزيد من التدخل.. المزيد من المشاكل
هناك جملة قالها ترامب خلال حفل تنصيبه عام 2025 تلفت الانتباه بشكل خاص: “ستعتبر الولايات المتحدة نفسها مرة أخرى دولة نامية – دولة تزيد ثروتها، وتوسع أراضيها، وتبني مدنها، وترتقي بسقف توقعاتها، وترفع رايتها إلى آفاق جديدة وجميلة”. لا توجد جملة أخرى تجسد بشكل أدق الصلة العميقة بمفهوم القوة والأمن الذي تميزت به نهاية القرن التاسع عشر. من الصعب تخيل أن يقول أي رئيس أمريكي معاصر هذه الكلمات، لكنها كانت ستناسب تمامًا خطاب تنصيب ماكينلي في ولايته الثانية.
لكن حقبة ماكينلي تحمل إشارات تحذيرية، تتمحور حول ما أسميته “فخ المتدخل”. سيكون من الحكمة أن تضع إدارة ترامب نفسها مكان إدارة ماكينلي في خريف عام 1898 وهي ترسم مسارها في فنزويلا. في ذلك الوقت، كان ماكينلي قد أطاح بنظام قمعي عبر هزيمة الحكام الاستعماريين الإسبان في الفلبين. لم يكن يثق بالسكان المحليين واعتقد أن الولايات المتحدة تستطيع إدارة بلدهم بشكل أفضل. وقد منحت هزيمة الإسبان والسيطرة على مانيلا ماكينلي إحساسًا بالملكية تجاه الأرخبيل، ما جعله يبالغ في تقدير أهمية الأحداث في الشرق الأقصى بالنسبة للمصالح الجوهرية الأمريكية.
قرر ماكينلي بناءً على ذلك أن الانسحاب الأمريكي من الفلبين سيؤدي إلى حرب بين القوى العظمى، فاختار تجنب مثل هذه الحرب عبر ضم الأرخبيل بأكمله، وهو مبرر مثير للاهتمام بالنظر إلى مثل هذه الحروب الكبرى لم تثِر قلق ماكينلي من قبل.
بعد الضم، أصبح لتدخل الولايات المتحدة في آسيا مبرر ذاتي: كان على واشنطن الاستمرار في التدخل لأنه مهم لمصالحه، لكن تلك المصالح كانت قائمة في الأصل على “الخطيئة الأصلية” المتمثلة في ضمّ الفلبين. بعبارة أخرى، دفع هذا التدخل ماكينلي – والرؤساء الأمريكيين اللاحقين – إلى التشبث بموقفهم. ولم تنل الفلبين استقلالها إلا في عام 1946.
يجب على ترامب الآن أن يقرر ما الذي سيفعله لاحقًا. كما فعل الفلبينيون في بداية التدخل الأمريكي عام 1898، رحب كثير من الفنزويليين بالإطاحة بزعيم مستبد. لكن الفرحة بالتغيير لا تعني الترحيب بسيطرة الولايات المتحدة على البلاد. كان إميليو أغينالدو، الذي يعد أبرز زعيم فلبيني عام 1898، مبتهجًا بانتصار ماكينلي على الإسبان. لكن للأسف، لم يكن للفلبينيين أي رأي فيما تلا ذلك.
أشعل قرار ماكينلي بضم الفلبين تمردًا على بُعد آلاف الأميال، مما أدى إلى أطول حرب خارجية خاضتها الولايات المتحدة حتى الحرب العالمية الثانية. صحيح أن القوات الأمريكية انتصرت، لكن بثمن مادي وأخلاقي باهظ. مات مئات الآلاف من الفلبينيين في الحرب الفلبينية الأمريكية، معظمهم بسبب المرض والجوع، بما في ذلك في معسكرات اعتقال أمريكية. قُتل عدد مماثل من المدنيين تقريبًا بسبب القنابل الذرية الأمريكية التي أُلقيت على هيروشيما وناغازاكي.
قد تبدو فكرة “إدارة فنزويلا” من وزارة الدفاع أو وزارة الخارجية أو البيت الأبيض منطقية للبعض، أو على الأقل لشخص واحد في الإدارة. لكن التدخل السافر في الخارج يهدد بجر هذه الإدارة، وكذلك الإدارات المستقبلية، إلى الاعتقاد بأن الأحداث في فنزويلا وما حولها أكثر ارتباطًا بالمصالح الأمريكية مما هي عليه في الواقع.
مع محاولة إدارة ترامب الإشراف على فنزويلا، ستبدأ أحداث لم تكن تعني الولايات المتحدة سابقًا تبدو أحداثًا محورية. وإذا أدى التدخل الأمريكي في فنزويلا إلى إثارة شكل من أشكال التمرد أو المعارضة الصاخبة، سيتدخل الرئيس بطرق قد تسبب اضطرابات ومآسٍ.
ذكر عالم السياسة كاليب بوميروي مؤخرًا في مجلة “فورين أفيرز” أن الدول غالبًا ما تشعر بأنها أقل أمانًا كلما ازدادت قوتها. عندما ضمت الولايات المتحدة الفلبين، أدت القوة المتزايدة إلى شعور أكبر بالضعف. وقد اعترف روزفلت لويليام هوارد تافت عام 1907 قائلا: “تشكل الفلبين نقطة ضعفنا”.
إذا تولى ترامب إدارة فنزويلا، فلن يجد أن السيطرة عليها مستحيلة، لكنه سيجد هو والإدارات اللاحقة صعوبة بالغة في التخلي عن تلك السيطرة.
المصدر: فورين أفيرز