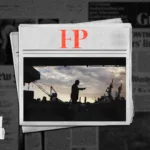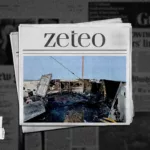ترجمة وتحرير: نون بوست
في 30 مايو/ أيار 1945، وبينما كانت القوات الفرنسية تقصف دمشق في الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، سرت شائعة في الحي الكردي في المدينة على سفوح جبل قاسيون بأن الحكومة السورية قد انهارت وأن الرئيس شكري القوتلي فرّ من العاصمة.
اغتنم الشباب الدمشقيون الأكراد الفرصة، فحملوا السلاح للدفاع عن النفس ظاهريًا حتى أن بعضهم رفع العلم الكردي ثلاثي الألوان، وهو رمز ابتكرته جمعية نهضة كردستان التي اتخذت من إسطنبول مقرًا لها عام 1920.
استلهم الأكراد في سوريا ذلك من مملكة كردستان التي لم تدم طويلًا (1921-1925) في السليمانية في العراق حاليًا، ورأى الأكراد في سوريا في ذلك فرصة لمزيد من الحرية. لكن السلطات السورية سارعت إلى الرد.
هرع وزير الخارجية جميل مردم بك إلى الحي الكردي متحدّيًا القصف الفرنسي لإلقاء خطاب مرتجل مخاطبًا الأكراد بوصفهم “أبناء صلاح الدين الأيوبي الأماجد”، مستحضرًا إرث السلطان الكردي الذي عاش في القرن الثاني عشر والذي حارب ضد الصليبيين ودُفن بالقرب من الجامع الأموي الكبير في دمشق. وأخمدت كلماته الاضطرابات مؤقتًا، لكن النزعة الانفصالية الكردية عادت إلى السطح في مراحل مختلفة خلال الفترة المتبقية من القرن العشرين.
بالانتقال سريعًا إلى اندلاع الثورة السورية ضد بشار الأسد في عام 2011، عندما أخذ الشباب الأكراد زمام المبادرة مرة أخرى ورفعوا علمهم في المناطق الكردية شرق نهر الفرات، آملين أن يتمكنوا أخيرًا من إحياء حلم أجدادهم في حال سقوط الأسد.
في هذه المرحلة، كان عدد الأكراد السوريين يبلغ حوالي 2.5 مليون نسمة، أي 10 بالمئة من إجمالي عدد سكان سوريا و5 بالمئة من إجمالي عدد الأكراد في العالم. ولكن في هذه المرة، لم يرسل الأسد وزير خارجيته لتهدئة مخاوفهم والتحدث إليهم، بل قام بجمعهم وألقى بهم في السجون، مما دفع الأكراد إلى حمل السلاح.
وفي نهاية المطاف، شكلوا الميليشيا التي نمت الآن لتصبح جيشًا مكتمل الأركان تُعرف باسم قوات سوريا الديمقراطية. وبدعم من الولايات المتحدة، أنشأ الأكراد السوريون منطقة حكم ذاتي خاصة بهم أطلقوا عليها اسم “روج آفا” أو كردستان سوريا.
بعد خمسة أشهر من الإطاحة بالأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، بات من الواضح أن خليفته، الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، لن يتقبل أي حديث عن الحكم الذاتي الكردي أو الدولة الكردية، لكن من الواضح أيضًا أنه لا يريد محاربة الأكراد، إذ يرى في ذلك معركة شاقة ستضر بشرعيته الثورية الناشئة وتؤلب الغرب ضده.
وبدلًا من قتالهم، اختار الشرع نهجًا سياسيًا حيث توصل إلى اتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس 2025، ينص على دمج قوات الأخير مع قوات الجيش السوري الجديد، كما يَعِد الاتفاق أيضًا بإعادة آبار النفط الخاضعة حاليًا لسيطرة الأكراد إلى سلطة الحكومة السورية في دمشق، مع ضمان إنفاق عائدات الدولة بسخاء على الأراضي الكردية. ومن غير المرجح أن يحل هذا الاتفاق “القضية الكردية” في سوريا، التي هيمنت لأكثر من قرن على العلاقات بين العرب السوريين والأقلية الكردية في البلاد.
شغل العديد من الأكراد مناصب في السلطة في سوريا قبل استقلال البلاد في عام 1946 وبعده، وقد وصل بعضهم إلى مناصب سياسية رفيعة وأصبحوا أثرياء. لكن مع انحسار الحقبة العثمانية وبداية العصر الحديث، برزت تساؤلات حول مكانة الأقلية الكردية في سوريا.
بالنسبة للبعض، كانت الإجابة تكمن في العروبة والنضال القومي الذي ميّز القرن العشرين، وفي كون الأكراد السوريين مواطنين كاملي المواطنة داخل الجمهورية السورية. وبالنسبة لآخرين، كان الجواب يكمن في القومية الكردية والسعي لإقامة دولة خاصة بهم، كانت هذه الثنائية موجودة لدى بعض أبرز العائلات الكردية حتى يومنا هذا.
يعد عبد الرحمن باشا اليوسف أبرز الشخصيات الكردية في أوائل القرن العشرين، وهو أرستقراطي عثماني وأمير الحج إلى مكة المكرمة منذ تسعينيات القرن التاسع عشر. وكان من بين أقوى الرجال في عهد السلطان عبد الحميد، وهو ينحدر من عائلة كردية تعود أصولها من ديار بكر في تركيا الحالية، على الرغم من أنه لم يتولَّ قط منصبًا رسميًا في البلاط في إسطنبول. وكان أيضًا من بين أغنى أغنياء سوريا حيث امتلك كامل شاطئ بحيرة طبريا في فلسطين، وثلاث قرى في الغوطة، والحزام الزراعي حول دمشق، وخمس قرى في ريف إدلب، و25 قرية في مرتفعات الجولان، وانتُخب نائبًا عن دمشق في أول برلمان في سوريا ما بعد العثمانية، وهو أول برلمان في البلاد، والمعروف باسم المؤتمر الوطني السوري.
لكن العائلة الكردية الأبرز في السياسة السورية كانت عشيرة البرازي التي هاجرت إلى مدينة حماة وسط البلاد في مطلع القرن الثامن عشر قادمة من عين عرب في شمال سوريا وأورفا في جنوب شرق تركيا. وقد شارك أحد أفراد العشيرة، وهو أصلان آغا البرازي، في التمرد المسلح ضد الفرنسيين في عشرينيات القرن العشرين، كما شغل نجيب آغا البرازي، منصب نائب عن حماة في البرلمان السوري في ثلاثينيات القرن العشرين.
لكن الشخص الذي كان له الدور الأكثر مركزيّة في اضطرابات حقبة الحرب الباردة من هذه العائلة الكبيرة والبارزة كان حسني البرازي، الذي تحوّل من محرّض إلى رئيس وزراء، وأنهى حياته في المنفى.
وتعد سيرته الذاتية مثالًا جيدًا على العلاقة المعقدة بين القومية السورية والقومية الكردية. كان البرازي من بين المؤسسين الأوائل للجمعية العربية الفتاة السرية المناهضة للعثمانيين، التي تأسست في باريس عام 1911، وكان وزيراً للداخلية في عهد الانتداب الفرنسي، ثم اعتُقل لصلته بالثوار السوريين الذين قاموا بانتفاضة عسكرية ضد الفرنسيين من جبل الدروز. تولى بعد ذلك منصب رئيس الوزراء في الفترة من أبريل/ نيسان 1942 إلى يناير/ كانون الثاني 1943، كما أسس صحيفة “الناس” في دمشق، التي اكتسبت شهرة واسعة خلال الحرب الباردة لكونها معادية بشدة للسوفييت ومؤيدة للولايات المتحدة.
وكتب البرازي افتتاحيتها على الصفحة الأولى منتقدًا الاشتراكية والماركسية والاتحاد السوفييتي والرئيس المصري جمال عبد الناصر، لكن كلماته كانت أكثر من اللازم بالنسبة للمخابرات السورية. ففي عام 1957، أمر رئيس المخابرات العسكرية الموالي لعبد الناصر، العقيد عبد الحميد السراج، بإغلاق جريدة “الناس” واعتقال البرازي بتهمة “الخيانة العظمى”، وصادف أن رئيس الوزراء السابق كان في تركيا عندما حدث ذلك، وقضى ما تبقى من سنوات عمره بين إسطنبول وبيروت حيث توفي عام 1975 دون أن يعود إلى سوريا.
يُعد البرازي مثالاً على التوتر بين القومية العربية والقومية الكردية. فخلال سنوات نشاطه السياسي في سوريا، لم يشر أبدًا إلى جذوره الكردية، بل كان يصور نفسه دائمًا على أنه قومي سوري وعربي، ولكن يبدو أن هذه الهوية لم تصمد في المنفى، لأنه عندما جلس مع الأستاذ يوسف إبيش من الجامعة الأمريكية في بيروت في أواخر الستينيات، وسجل مذكراته على شريط، أظهر تعاطفًا واضحًا مع الحركة القومية الكردية ومع عشيرة البارزاني التي كانت تقود آنذاك ثوارها ضد نظام حزب البعث في العراق.
يمكننا أن نرى نفس هذه الازدواجية بين العروبة والقومية الكردية أيضًا في حياة ابن عم البرازي، محسن البرازي (1904-1949)، وهو عقل قانوني لامع حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة ليون. عُيّن محسن البرازي، أستاذ القانون في جامعة دمشق، مديرًا لمكتب الرئيس قوتلي عام 1943، كما عمل أيضًا كاتبًا لخطاباته ومستشاراً له، وفي نهاية المطاف، أميناً عاماً للرئاسة السورية.
وكان أحد الشخصيات الرئيسية في الحكومة خلال أربعينيات القرن العشرين حيث شغل منصب وزير التربية والتعليم عام 1941، ثم وزيرًا للداخلية والخارجية والصحة. وقد كان البرازي موضع ثقة عند الرئيس، وفي عام 1946، مارس ضغوطًا لصالح زميل كردي آخر يدعى حسني الزعيم، وهو ضابط عسكري مسرح كان يكافح من أجل الانضمام إلى الجيش السوري المشكل حديثًا، وكان الزعيم كرديًا دمشقيًا خدم في الجيش الفرنسي في بلاد الشام خلال فترة الانتداب، لكنه اعتُقل وفُصل من الخدمة بعد اتهامه بالاختلاس خلال الحرب العالمية الثانية، وقد أقنع البرازي قوتلي بإعادة الزعيم إلى الخدمة النظامية، وجعله قائداً للشرطة العسكرية ثم رئيسًا لأركان الجيش السوري خلال حرب فلسطين عام 1948.
وبهذه الصفة، شن الزعيم انقلابه على الرئيس قوتلي في 29 مارس/ أذار 1949، وساعد محسن البرازي الزعيم في صياغة دستور جديد، وفي المقابل، عُيّن رئيسًا للوزراء في يونيو/ حزيران 1949، ليتم إعدامه رميًا بالرصاص مع الزعيم نفسه بعد أشهر قليلة من الانقلاب الثاني في سوريا في 14 أغسطس/ آب 1949.
هذا تقريبًا كل ما ذكرته كتب التاريخ السوري عنه، باستثناء فقرة مثيرة للاهتمام ومنسية في مذكرات منير الريس، ناشر صحيفة بردى اليومية في دمشق عام 1977. كان الريس قوميًا عربيًا متشددًا ومؤيدًا مستقبليًا لعبد الناصر، ويزعم في مذكراته أن محسن البرازي كان سكرتير الجمعية الكردية السرية “خويبون” التي تأسست في بحمدون بلبنان عام 1927، والتي يعود إليها الفضل في تنفيذ تمرد أرارات عام 1930 في شرق تركيا، ويزعم الريس أن “سوريّة” البرازي وتقربه من القوتلي كانت مجرد غطاء لنواياه الحقيقية، والتي تضمنت “التنازل عن نصف سوريا وثلاثة أرباع العراق من أجل إنشاء كردستان الكبرى”.
ويضيف الريس أن البرازي هو من ألّف جميع أدبيات خويبون، وكان بمثابة “الفيلسوف السري” للحركة القومية الكردية في سوريا. وقد كتب الصحفي المتشدد إلى القوتلي شاكيًا البرازي ثم قام بزيارة شخصية، متسائلًا كيف يمكن لقوميّ عربي مثله أن يثق بانفصالي كردي مثل البرازي.
وقال للرئيس إن هذا الرجل “كان يشرف على الهجرة الكردية الممنهجة من تركيا إلى سوريا لجعل سكان منطقة الجزيرة أكرادًا بالكامل. هناك يقع أكثر من نصف ثروتنا الزراعية، سيدي الرئيس”. وأضاف متنبئًا: “إذا أصبحت الجزيرة كردية فلن يكون هناك بلد اسمه سوريا”. تجاهل القوتلي مخاوفه قائلاً: “لا تقلق؛ ستبقى الجزيرة سورية إلى الأبد”، فرد الريس ساخرًا: “تمامًا كما ستبقى فلسطين عربية إلى الأبد، أليس كذلك؟” ثم اختتم اللقاء قائلًا: “ستستيقظون يومًا ما لتجدوا أن الجزيرة والشمال السوري بأكمله أصبح جزءًا من كردستان”.
اكتفى قوتلي بهز كتفيه، فلم يكن يعرف الكثير عن القومية الكردية. والواقع أن أول حزب سياسي كردي في سوريا تأسس في عهده، وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري الذي أسسه عبد الحميد درويش وعثمان صبري عام 1957. كان هدفهم تعزيز الحقوق الثقافية الكردية والحفاظ عليها، وليس الحكم الذاتي، لكنهم مع ذلك تعرضوا للقمع الشديد من قبل عبد الناصر خلال الوحدة السورية المصرية التي لم تدم طويلًا، عندما أصبحت البلدان الجمهورية العربية المتحدة، من 1958 إلى 1961. لم يكن العداء موجهًا للأكراد بالأخص: لم يكن عبد الناصر يتسامح مع أي حزب سياسي، مهما كان برنامجه، وعندما انسحبت سوريا من الاتحاد عام 1961، شنّ عبد الناصر حملة نارية ضد قادتها الجدد، متهمًا إياهم بأنهم أعداء العروبة وعملاء لإسرائيل.
وقد دفع ذلك، من بين أمور أخرى، الرئيس السوري الجديد إلى إضافة كلمة “العربية” إلى اسم البلاد (الذي كان في السابق “الجمهورية السورية”)، ثم إجراء إحصاء سكاني مثير للجدل في منطقة الجزيرة في 23 أغسطس/ آب 1962. كان هدفه المعلن هو التعامل مع مئات الآلاف من الأكراد الذين دخلوا سوريا بطريقة غير شرعية من تركيا، بينما كان الهدف غير المعلن هو التأكيد على هوية سوريا العربية وزيادة عدد سكانها العرب.
وبين ليلة وضحاها، تم تجريد 120 ألف كردي من هويتهم السورية (20 بالمئة من إجمالي السكان الأكراد في سوريا). وتم تسجيل بعضهم كـ”أجانب”، بينما تم تسجيل البعض الآخر كـ”غير مسجلين”، وبالنسبة للمسؤولين السوريين، لم يعد لهؤلاء الأكراد وجود، ولم يعد بإمكانهم شراء أو بيع الممتلكات، ولا الحصول على شهادات ميلاد أو وفاة. وبعد مرور ستة عقود من الزمن، لم يتم حل هذه المشكلة. كما أن مسألة الدولة الكردية لم تُحل أيضًا.
اتخذت القضية الكردية أبعادًا جديدة في عهد الرئيس حافظ الأسد في سبعينيات القرن الماضي. فقد استضاف الأسد سياسيين أكرادًا عراقيين عارضوا نظام البعث في بغداد، ومنهم جلال طالباني، الكردي اليساري الذي أسس الاتحاد الوطني الكردستاني في دمشق عام 1975 بدعم سوري. كما رحب الأسد بمسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يمثل العائلات الكردية التقليدية مالكة الأراضي. في عام 1980، قدم الأسد ضيافته لعبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، الذي كان يشن تمردًا ضد تركيا. كان وجود أوجلان في سوريا خطوة استراتيجية للضغط على تركيا بشأن حقوق المياه في نهر الفرات. وبقي في سوريا حتى عام 1998، عندما أجبرت التوترات المتصاعدة مع أنقرة الأسد على طرده، وخلال إقامته، أنشأ أوجلان معسكرات عسكرية بالقرب من دمشق وفي وادي البقاع اللبناني، الذي كان تحت السيطرة السورية آنذاك.
كان القوميون العرب في حيرة من هذا التحالف بين نظام متجذر ظاهريًا في القومية العربية وقادة أكراد يسعون إلى الحكم الذاتي. بالنسبة للأسد، كان الأكراد أداة لزعزعة خصومه: الرئيسان صدام حسين في العراق وسليمان ديميريل في تركيا، ولم يكن يهمه كثيرًا أمر إقامة دولة كردية طالما سيحدث ذلك في شمال العراق أو جنوب شرق تركيا – وليس في شمال سوريا أو شمال غرب إيران، رغم أن هاتين المنطقتين أيضاً كانتا أيضاً من المناطق التي تصورها الأكراد كجزء من كردستان الكبرى – وفي نهاية المطاف، ستؤدي مكاسب الأسد إلى نتائج عكسية مذهلة، نظرًا لأن هؤلاء الأكراد الهاربين أنفسهم ألهموا أكراد سوريا للتعبير عن مطالبهم الخاصة، والتي بدأت بالحقوق الثقافية وتطورت إلى دعوات للحكم الذاتي، ثم في نهاية المطاف، إلى إقامة دولة كردية.
مع تغلغل السياسة الكردية في الخطاب السوري، حرص الأسد على عدم انضمام أي سوري إلى جيش أوجلان في تركيا أو إلى حزبي طالباني وبارزاني في العراق، ومن فعلوا ذلك تم اعتقالهم بتهمة الترويج لأجندات عرقية، وهو أمر محظور في سوريا البعثية. لموازنة ذلك، استعان الأسد بأكراد بارزين في المؤسسة الدينية، مثل محمد سعيد رمضان البوطي، عميد كلية الشريعة الإسلامية في جامعة دمشق، والمفتي الأكبر الشيخ أحمد كفتارو. وقد دعم كلاهما نظامه خلال حملته الدموية على جماعة الإخوان المسلمين في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، والتي بلغت ذروتها في مذبحة حماة عام 1982، حتى أن البوطي أمّ الصلاة في جنازة الأسد في عام 2000، وقد قُتل في عام 2013 خلال الصراع السوري.
لم يستطع الأسد تحقيق التوازن بين هذه القوى المتعارضة إلى الأبد، فقد ألهم إنشاء إقليم كردستان العراق شبه المستقل بعد حرب الخليج عام 1991، بقيادة طالباني وبارزاني، الأكراد السوريين للمطالبة بمزيد من الحريات السياسية. وقد عانى الأسد، الذي عارض الحكم الذاتي الكردي في العراق، في تفسير كيف يقود ضيوف دمشق السابقين الآن مشروعًا وصفه الإعلام السوري بأنه “إمبريالي” و”مدعوم من إسرائيل”. وقد شارك الأسد في الحملة على الانفصاليين الأكراد في العراق عام 1963، بصفته قائدًا للقوات الجوية السورية، إلا أنه أصرّ على أن الأكراد السوريين لا علاقة لهم بالحركة الانفصالية، حتى أنه أقام تمثالاً برونزيًا لصلاح الدين الأيوبي في دمشق في الذكرى الـ 800 لوفاته في عام 1993، مؤكدًا على اندماج الأكراد في الهوية السورية.
سيندلع الاحتكاك بين الأكراد والعرب بعد فترة وجيزة من وفاة الأسد، في السنوات الأولى من حكم ابنه وخليفته بشار. ففي 12 آذار/مارس 2004، وخلال مباراة لكرة القدم في مدينة القامشلي الكردية، رفع العرب السوريون صور الرئيس العراقي المخلوع حديثاً صدام حسين. وقد أثار هذا الأمر استياء الجمهور الكردي الذي كان يحتقر الدكتاتور العراقي بسبب المجزرة التي ارتكبها بالأسلحة الكيماوية في حلبجة في آذار/مارس 1988، في خضم حملة الأنفال التي وقعت في شباط/فبراير – أيلول/سبتمبر 1988، والتي راح ضحيتها ما يقدر بـ 50 ألف إلى 100 ألف كردي عراقي. استشاط أكراد سوريا غضباً وعطّلوا المباراة وحطموا تمثالاً لحافظ الأسد واقتحموا الفرع المحلي لحزب البعث. كان هذا أول عمل تحدٍ كبير ضد نظام بشار الأسد ومهد الطريق أمام مشاركة الأكراد في انتفاضة سوريا عام 2011.
يعكس النضال الكردي في سوريا – من لحظات التحدي العابرة في ظل الحكم الفرنسي إلى صعود القومية الكردية – قرنًا من التحالفات المتغيرة والقمع والصمود. وعلى الرغم من أن الأكراد اغتنموا مرارًا وتكرارًا فرصًا لتأكيد هويتهم، إلا أن الضغوط الخارجية وديناميكيات القوة الإقليمية أحبطت باستمرار تطلعاتهم لإقامة دولة. قد يقدم الاتفاق الأخير بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية تسوية هشة، لكن التاريخ يشير إلى أن الطموحات الكردية لا يمكن إخمادها بسهولة بمجرد إيقاظها. وسواء كان ذلك من خلال الحكم الذاتي أو الاندماج أو المقاومة المستمرة، يبقى الأكراد قوة لا يمكن محوها في المشهد السوري الممزق، ولا يزال مصيرهم متشابكًا مع نزوات القوى الكبرى وإرث ماضيهم الذي لم يتم حله.
المصدر: نيولاينز