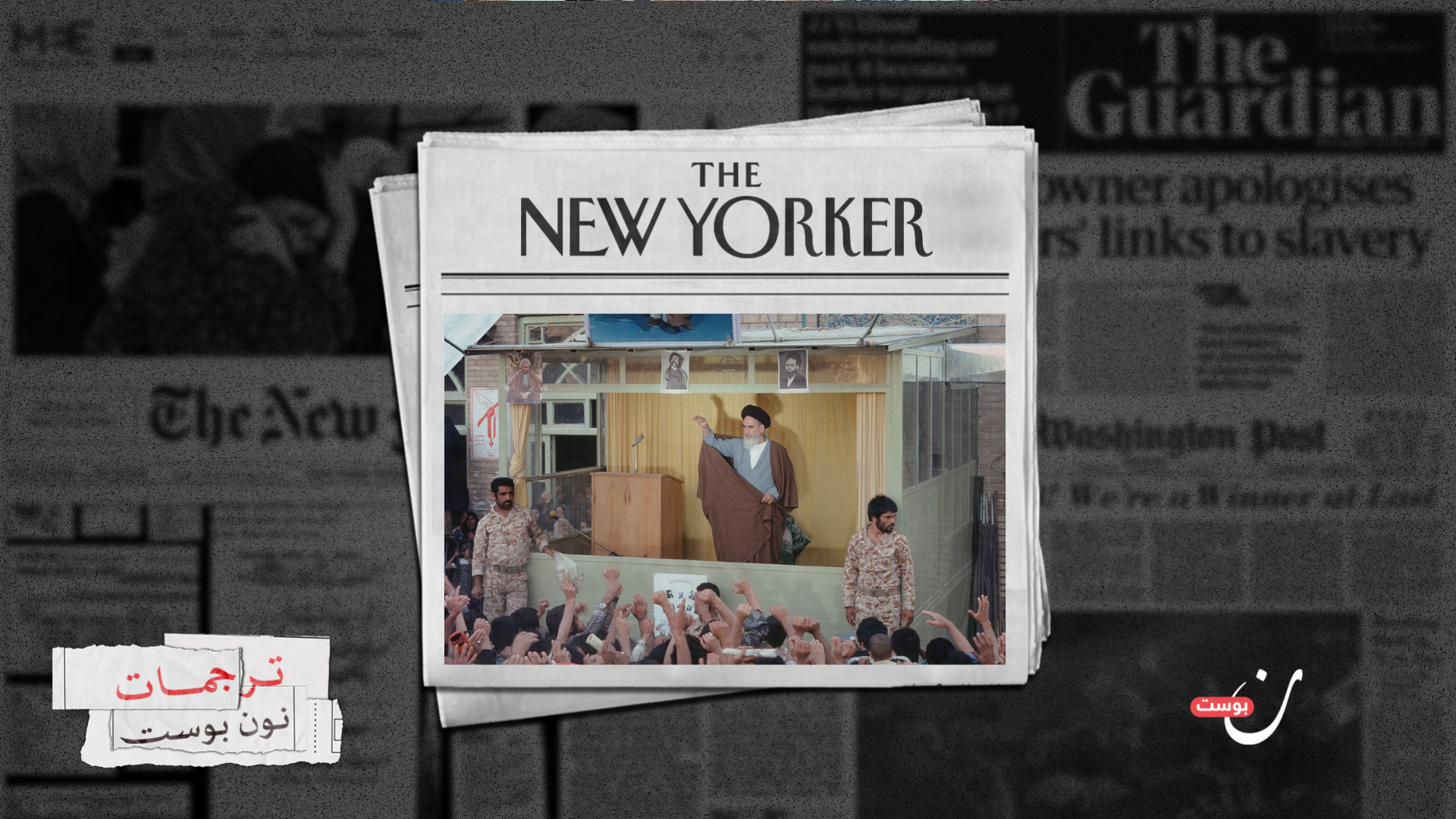ترجمة وتحرير: نون بوست
من الغريب أن نتصور أنه كان هناك فترة كانت فيه إيران أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ففي سنة 1953، دعمت وكالة الاستخبارات المركزية انقلابًا أطاح بمحمد مصدق، رئيس الوزراء الشعبي، وأعاد السلطة إلى الملك محمد رضا بهلوي، الشاه. وعلى مدى ربع قرن بعد ذلك، تابعت واشنطن برضا كيف حافظ الشاه على الاستقرار بينما كان اتحاد شركات تهيمن عليه الولايات المتحدة يبيع نفط إيران.
كان هناك الكثير من النفط، ما جعل الشاه أحد أغنى رجال العالم. وفي عيد ميلاده الثامن والأربعين سنة 1967، نظم لنفسه حفل تتويج فخم. وأمام عرش ذهبي، وضع على رأسه تاجًا مرصعًا بـ 3,380 ماسة. أما زوجته الثالثة، الإمبراطورة فرح، فقد سارت في موكب ترتدي عباءة من تصميم “كريستيان ديور” مزينة بالجواهر ومبطنة بفرو المنك، استلزم حملها ثمانية مساعدين. وبعد الحفل، لوّح الزوجان الملكيان بجمود للجماهير من عربة مذهبة تجرها الخيول، صُنعت في فيينا على يد أحد آخر صنّاع العربات التقليديين في أوروبا. وقد أسقطت الطائرات 17,532 وردة، واحدة عن كل يوم مجيد من حياة الشاه المجيدة.
كانت عروض إيران الجوية المزهرة تلمّح إلى مستفيد آخر من عائدات النفط: الجيش. ففي سنة 1972، منح الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الشاه تفويضًا مطلقًا لشراء أي أسلحة يرغب بها، باستثناء القنابل النووية. وقد جمع الشاه خامس أكبر قوة عسكرية في العالم، حيث احتوت ترسانته على الطائرات النفاثة الأسرع من الصوت والقنابل الموجهة بالليزر والمروحيات الحربية، ويُقال إنه كان يسترخي بقراءة كتالوجات الأسلحة.
وكان من الإنصاف الإقرار بأن ليس كل الإيرانيين شاركوا الشاه رضاه المترَف، فقد سعى الليبراليون الحصول على حقوقهم، وسعى الشيوعيون إلى الثورة، بينما أراد رجال الدين استعادة نفوذهم. وكان هناك آية الله واحد على وجه الخصوص، روح الله الخميني، لم يكف عن مضايقة الشاه وانتقاده. ففي سنة 1967، أدان مراسم التتويج، وفي سنة 1971، عندما نظّم الشاه احتفالًا أكثر بذخًا بمناسبة مرور 2500 سنة على الملكية في إيران، أعلن الخميني أن حضور ذلك “المهرجان المشين” يُعد “مشاركة في قتل الشعب الإيراني المضطهد”.
غير أن هذه الانتقادات كانت مزعجة أكثر منها مقلقة. فالخميني، الذي كان قد بلغ من العمر عتيًّا آنذاك، كان يهاجم الشاه من منفاه في النجف بالعراق، بعد أن مُنع من دخول إيران منذ سنة 1964. أما جهاز الاستخبارات الإيراني “السافاك”، المعروف باستخدامه للتعذيب، فقد نجح إلى حد كبير في تطهير البلاد من أبرز المعارضين. وبحلول سبعينيات القرن العشرين، كان قادة المعارضة إما في السجون أو في المنفى، دون أن يظهر من يخلفهم بوضوح.
بل إن قبضة الشاه كانت، على ما يبدو، تزداد إحكامًا. ففي سنة 1975، ألغى الحزبين السياسيين المسموح بهما في إيران، وأسس حزبًا واحدًا بدلًا منه، كان على كل بالغ الانضمام إليه. وكانت صورة الشاه تملأ المباني العامة وكثيرًا من المنازل، حتى أن النكتة السائدة حينها كانت: “لا يمكنك أن تلقي حجرًا دون أن تصيب صورته”، مع التحذير طبعًا أنك ستتعرض للاعتقال إن فعلت.
وفي احتفال ليلة رأس السنة في طهران سنة 1977، ألقى الرئيس الأمريكي جيمي كارتر نخبًا قال فيه: “لا يوجد زعيم دولة أشعر تجاهه بعلاقات أكثر ودية”. وأضاف أن إيران، في منطقة مليئة بالاضطرابات، تُعد “جزيرة من الاستقرار”.
وكما هو متوقع، استشاط الخميني غضبًا من زيارة كارتر. فردّت صحيفة إطلاعات، وهي الصحيفة المسائية الرئيسية في إيران، بمقال افتتاحي اتهامي أعدّته الحكومة على الأرجح بأمر من الشاه. واتهم المقال الخميني بأنه في آنٍ واحد عميل للشيوعيين والرجعيين، وزُعم أنه يرتبط بعلاقات مع الهند وربما بالإمبريالية البريطانية. كما لمّحت الصحيفة إلى أنه ربما كان روحًا حساسة كتب شعرًا غزليًا في شبابه. (وربما كان كذلك، إذ أصيب أتباعه بالدهشة بعد وفاته حين نُشرت مجموعة من قصائده الصوفية بعنوان “خمر المحبة”. ومن أبياتها: “حررني من هذه الآلام التي لا تُعد، من قلب ممزق وصدر مثقوب مثل الكباب.”)
وهاجم الشاه من موقع يبدو فيه في أوج قوته، ففي الشهر الذي نُشر فيه المقال الافتتاحي، تفاخر قائلاً: “قوتي، سواء بحكم القانون أو بسبب الرابطة الروحية الخاصة التي تربطني بشعبي، في أعلى درجاتها”. لكن القمة كانت أيضًا حافة الهاوية. فبعد نشر المقال في 7 يناير/ كانون الثاني 1978، خرج طلاب الحوزات الدينية في قم في مظاهرات واسعة احتجاجًا على الإساءة إلى الخميني. وأطلقت الشرطة النار، مما أسفر عن مقتل بعضهم. ولم يبدو الأمر حينها كبيرًا، ومع ذلك استمرت الاضطرابات وتصاعدت، وفي غضون ثلاثة عشر شهرًا، انهار نظام الشاه بالكامل، وقامت دولة إسلامية بقيادة الخميني على أنقاضه.
في كتابه الجديد “ملك الملوك” (الصادر عن دار دبلداي)، يناقش الصحفي سكوت أندرسون افتتاحية صحيفة “إطلاعات” في فصل بعنوان “تأثير الفراشة”. وكما يُروى عن رفّة جناح فراشة تتسبب بإعصار، فقد شقّت هذه الافتتاحية السماء وأطلقت فيضًا ثوريًا غيّر وجه الشرق الأوسط. ويتساءل أندرسون: لو أن الأحداث سارت بشكل مختلف قليلًا، هل كان من الممكن ألا تحدث الثورة الإيرانية أبدًا؟
لطالما أثارت الأسباب الصغيرة ذات النتائج الكبرى فضول المفكرين؛ فقد قدّم عالم الرياضيات في القرن السابع عشر بليز باسكال مثال أنف كليوباترا. فلو كان أنفها مختلفًا في الحجم، ربما لما أحبها القائد الروماني مارك أنطوني، ولما وقف إلى جانبها، ولما خسر معركة أكتيوم، وهو ما أدى – من دون قصد – إلى تحوّل روما من جمهورية إلى إمبراطورية. (ومن المثير للاهتمام أن باسكال، في سيناريو “كليوباترا غير الجذابة”، اعتبر أنفها صغيرًا جدًا، مما يوحي بأنه كان يُولِي أهمية خاصة للأنوف). إذا تغيرت ملامح كليوباترا، فإن ذلك يعني تغيير ملامح التاريخ.
وتستحوذ سيناريوهات “ماذا لو” على الخيال، خاصة عندما تُتركز سلطة هائلة في يد شخص واحد. ففي أوائل القرن التاسع عشر، لم يكن هناك من يملك هذه السلطة مثل نابليون بونابرت. وبعد هزيمته، كتب ابنه بالتبني، لويس نابليون جوفروي، كتابًا يتخيّل فيه عالمًا لم تفشل فيه حملة نابليون على روسيا. ووفق تصوره، كان نابليون سيستولي على آسيا وأفريقيا والأمريكيتين، موحّدًا العالم تحت حكم قائد واحد. ويشير المؤرخ ريتشارد ج. إيفانز إلى أن كتاب جوفروي كان “أول عمل متكامل يمكن التعرف عليه كنوع من التاريخ البديل التأملي”. وقد أطلق ذلك شغفًا طويل الأمد بالافتراضات التاريخية: ماذا لو لم يُولد أدولف هتلر؟ ماذا لو لم يُغتل جون كينيدي؟ أو كما تساءلت ذات مرة إحدى حلقات “ساترداي نايت لايف”: ماذا لو امتلك نابليون قاذفة بي-52؟
تستمد مثل هذه التجارب الفكرية متعتها من الفكرة القائلة إن بعض الأفراد قادرون على تغيير مسار التاريخ بشكل جذري. أما الفكرة الأقل إمتاعًا فهي أنهم لا يستطيعون ذلك، وأن الأحداث الكبرى تنبع من أسباب كبرى. وقد تشكل علم التاريخ الحديث جزئيًا حول هذا السؤال المتعلق بنابليون. فمن جهة، كان نابليون تجسيدًا لعملية تحديث تتجاوز بوضوح حدود الفرد الواحد. ومن جهة أخرى، بدا أن مصير هذه العملية معلق بشخص نابليون نفسه، الرجل المتقلب الذي نجا من محاولات اغتيال عدة كادت أن تضع حدًا لحياته ومسيرته.
وسعى هيغل إلى التوفيق بين هذين النقيضين؛ فقد اقترح أن التاريخ يتقدّم وفق منطق كلي عظيم، لكن “الأفراد التاريخيين العظام” يجسّدون هذا المنطق ويعملون كوكلاء للقدر. وفي سنة 1806، بينما كان هيغل يقيم في مدينة فيينا ويضع اللمسات الأخيرة على عمله الفلسفي الكبير ظاهريات الروح، وصل نابليون إلى المدينة مع قواته. وكتب هيغل بانفعال: “رأيت الإمبراطور- روح العالم هذه”، مضيفًا أنه كان “شعورًا رائعًا أن ترى فردًا كهذا، متركزًا في نقطة واحدة، يمتطي جوادًا، ويمتدّ تأثيره ليشمل العالم بأسره ويتحكّم فيه”. وفي اليوم التالي، دمّر نابليون الجيش البروسي، منهيًا بذلك أي أمل في استعادة الإمبراطورية الرومانية المقدسة. ورغم أن قوات نابليون نهبت منزل هيغل وأحرقت منازل جيرانه، لم يستطع هيغل سوى أن يُعجب بروح التاريخ… وجوادها.

في روايته الحرب والسلام (1869)، رفض ليو تولستوي نظرية “الرجل العظيم” في تفسير حروب نابليون. ففي خاتمة الرواية، جادل بأن إسناد الفعل التاريخي لشخصيات مثل نابليون يشبه النظر إلى قطيع من الأبقار والاستنتاج بأن البقرة التي في المقدمة هي القائدة. لقد رأى تولستوي أن القوى الاجتماعية، وليس الرجال على ظهور الخيل، هي التي تحدد مصير الأمم. ويعود الكاتب المحافظ نيل فيرغسون بقراره أن يصبح مؤرخًا إلى قراءته لتلك الخاتمة، حيث قال: “أتذكر أنني فكرت: لا يمكن أن يكون هذا صحيحًا. لا بد أن يكون هناك دور للفعل الفردي، لنابليون، ولهتلر.”
فيرغسون، الذي نشر مجموعة من الدراسات التاريخية الاحتمالية (المعروفة بـ “التاريخ البديل”)، يُعد حالة شاذة بين الأكاديميين. فربما ميولهم اليسارية تدفعهم، كما فعل تولستوي، إلى التقليل من شأن قدرة الأفراد على تغيير مصائرهم بأنفسهم. (المؤرخ الماركسي إدوارد تومبسون رفض مثل هذه التكهنات بقوله إنها “هراء غير تاريخي”). وعلى أي حال، فإن الاتجاه السائد في الأوساط الأكاديمية هو التقليل من أهمية الاختيار والصدفة كعوامل في صنع التاريخ. فالحروب والثورات، رغم ما تبدو عليه من فوضوية، تحدث لأسباب متجذرة في الاقتصاد والأيديولوجيا والجغرافيا والمناخ. أما أفعال القادة العسكريين، وفق هذا الرأي، فلا تعدو كونها زَبَدًا فوق أمواج التاريخ.
ومع ذلك، حتى بالنسبة لأولئك البارعين في تتبّع الأسباب العميقة وراء الأحداث، تظلّ إيران حالة عصيّة. فكل إحساس بأن التاريخ يسير في اتجاه عام – نحو الحرية أو الحقوق أو الاقتصاد الحر أو العلمنة أو العلم – يتبدّد أمام تحوّل بلد كبير ومزدهر إلى شبه ثيوقراطية متشددة. وقد وجد الفيلسوف ميشيل فوكو في ثورة إيران تناقضًا مثيرًا: فقد وصفها بأنها “ربما أعظم انتفاضة شهدها التاريخ ضد الأنظمة العالمية، وأكثرها جنونًا، وأكثر أشكال التمرد جنونًا وحداثة.”
لكن لماذا إيران؟ في روسيا، سبقت الثورة البلشفية ثورتان أصغر. ووصف ماو تسي تونغ، قبل أن تنتصر ثورته، الصين بأنها حطب جاف ينتظر شرارة. لكن قلة من المراقبين رأوا إيران بتلك الطريقة، فقد كانت العوامل التي قد تفسر ـ بأثر رجعي ـ ذلك الانفجار المفاجئ في البلاد، مثل النمو الاقتصادي السريع تلاه انكماش والتحضر المتسارع والسلطوية والفساد، جميعها أمورًا شائعة نسبيًا. وحتى بوصفها دولة إسلامية استبدادية كبيرة في الشرق الأوسط، تتأثر تبعًا لازدهار وانهيار سوق النفط، لم تكن إيران حالة فريدة. فلماذا حدثت الثورة هناك، ولم تحدث في العراق أو السعودية؟
ويكتب أندرسون: “كلما أمعن المرء النظر فيها، بدت أكثر غموضًا ولا معقوليّة.” ومن أفضل الكتب التي تناولت هذا الموضوع، كتاب “الثورة التي لا تُصدَّق في إيران” (2004) لعالم الاجتماع تشارلز كورزمان، الذي يستعرض تفسيرات عدة لكنه يرفضها جميعًا لصالح ما يُسميه “تفسير مضاد”، مسلطًا الضوء على طابع الثورة الاستثنائي وغير النمطي. أما غاري سيك، الذي تولّى ملف الشأن الإيراني في مجلس الأمن القومي الأمريكي في عهد كارتر، فيرى الأمر من منظور مشابه. إذ قال لأندرسون: “لقد درست هذا الأمر طوال الأربعين سنة الماضية، وما زال لا يبدو منطقيًا تمامًا بالنسبة لي.” فهل من الممكن أن يكون أحد أكثر أحداث القرن العشرين تأثيرًا قد حدث مصادفة؟
ويُشير أندرسون إلى أن أحد الأسباب التي تدعو للاعتقاد بأن الثورة الإيرانية كانت أشبه بالصدفة هو “العدد القليل بشكل لافت من الفاعلين الرئيسيين”: الشاه، روح الله الخميني، وجيمي كارتر. فكل منهم كان يعاني من نقاط ضعف كبيرة، ولم يستشير أي منهم سوى عدد قليل من المستشارين، وكانت أفعالهم في الغالب ارتجالية ومتفردة.
كان كارتر قد خاض حملته الانتخابية متبنّيًا قضية حقوق الإنسان، واصفًا إياها بأنها “روح سياستنا الخارجية”. ونحن نعلم اليوم أنه لم يكن يرغب في ممارسة ضغوط على إيران بشأن حقوق الإنسان، لكن الشاه، في محاولة استباقية للتجاوب، قام بتخفيف القيود السياسية على أي حال. وقد فسّر معارضو الشاه خطابات كارتر على أنها ضمانة لحمايتهم. وكما أوضح مهدي بازركان، أستاذ الهندسة وأحد أبرز دعاة الإصلاح: “انفجر كل الضغط المتراكم”. وخلال الموسم السابق للثورة في سنة 1977، بدأ الليبراليون بتوقيع الرسائل وتنظيم أمسيات شعرية يوجّهون فيها انتقادات صريحة متزايدة للحكومة.
وفي أواخر سنة 1977، وبعد أن بات من الواضح أن كارتر لن يضغط في مسألة حقوق الإنسان، غيّر الشاه مساره وعاود القمع من جديد. ومع ذلك، كان هناك خلل واضح في شرعيته. ومن دون أن يدرك، ربما كان كارتر قد ركل حجرًا صغيرًا تسبّب، بعد أشهر، في انهيار جليدي.

كان بإمكان الشاه أن يعزز موقفه ويحتوي الأزمة، ويشير أندرسون إلى أن أقرب مستشاريه، أسد الله علم، كان يتمتع بفهم عميق لمظالم الشعب والحاجة إلى معالجتها. ولكن علم كان يحتضر بسبب السرطان واستقال من منصبه قبل أن تبدأ الاضطرابات. ونتيجة لذلك، أصبح الشاه يعتمد في نصائحه على زوجته، فرح، التي لم تكن تملك معرفة كافية بالوضع. ففي مايو/ أيار 1978، وبعد اندلاع أولى الاحتجاجات في مدينة قم، بدا أن فرح لم تسمع حتى باسم رجل الدين الذي كان يقود التمرد من العراق. ويُروى أنها سألت بدهشة: “من هو هذا الخميني بحق السماء؟”
كان الحصول على النصيحة مشكلة، لكن الأخذ بها كان مشكلة أكبر. فعلى غير علم معظم الناس، كان الشاه مصابًا بالسرطان (وقد تُوفي سنة 1980). وهذا ربما يفسر سبب ظهوره الدائم بمظهر المرتبك، غير الحاسم بين قمع المعارضة أو السماح لها بالتعبير. وقد جمعت توجيهاته المتخبطة أسوأ ما في الخيارين معًا: إذ غالبًا ما سمح الجنود للمتظاهرين بالمسير، لكنهم أحيانًا كانوا يفتحون النار على الحشود، مما أوجد موجات جديدة من الغضب أججت الاحتجاجات أكثر.
وتم حثُّ المتفرجين على الحزم؛ وكما قال حاكم كاليفورنيا السابق، رونالد ريغان: “أطلق النار على أوّل رجل في المقدّمة، وسيلتزم الباقون الصفّ”. في سردٍ ثريّ لانهيار نظام بهلوي، حمل عنوان “سقوط الجنّة” (2016)، يروي أندرو سكوت كوبر مكالمة هاتفية أجراها رئيس العراق، صدّام حسين، مع الشاه في آب/أغسطس 1978. قال صدّام، وفقًا للرواية: “هذا الملا، الخميني، يثير المتاعب لك، ولي، ولنا جميعًا”. وسأله ما إذا كان مقبولًا قتله، وبقي صدّام على الخط بينما استشار الشاه رئيس الوزراء ومدير السافاك، اللذين أعادا القرار إليه، فأبلغه الشاه أن يتراجع.
أما الشخصية الثالثة المحورية في رواية أندرسون، فكانت الخميني، القائد غير المتوقع. كان عالمًا في الشريعة الإسلامية في أواخر السبعينات من عمره، ولم تطأ قدماه أرض إيران منذ قرابة خمسة عشر عامًا. وكانت مكانته قد بدأت تتلاشى حتى تشرين الأول/ أكتوبر 1977، حين توفي ابنه مصطفى فجأة. يُرجّح أن الأسباب كانت طبيعية، كما يشير أندرسون، لكن الإيرانيين ألقوا باللّوم على السافاك. وأعادت وفاة مصطفى آية الله المنفي إلى الواجهة؛ وقد وصفها الخميني بأنها “تدبير خفي من الله”.
ويمكن النظر إلى الخميني كأداة قدرٍ هيغلية، عملت من خلالها قوى التاريخ، لكنه، إن كان كذلك، لم يكن مدركًا لذلك. امتلك حدسًا حادًّا، لكن فهمه للسياسة كان مشوّهًا بأوهامٍ هوسيّة عن اليهود، والبهائيين، والماسونيين، و”القوى العظمى الشيطانية”. وقد عبّر زميله في المعارضة، الليبرالي مهدي بازرگان، عن دهشته من “غفلته عن المشكلات الواضحة في السياسة والإدارة”. وأشار إلى أن الخميني أطلق حملته ضد الشاه “من دون أي خطة”، وأضاف: “أتساءل إن كان لديه أدنى شعور بأنه كان يُطلق ثورة”.
واصلت التمردات تصاعدها طوال سنة 1978، ما دفع الشاه إلى فرض الأحكام العرفية في اثنتي عشرة مدينة في الثامن من أيلول/سبتمبر. في ذلك اليوم، المعروف حاليًا باسم “الجمعة السوداء”، فتح الجنود النار على مظاهرة حاشدة، فقتلوا ما بين مئتين إلى ثلاثمئة شخص. وربما كان بالإمكان تجنّب ذلك لو سارت الأمور بشكل مختلف، لو كانت سياسة كارتر تجاه إيران أكثر تعقّلًا، أو لو لم يكن الشاه ومستشاره الأبرز يحتضران من السرطان، أو لو لم تجعل وفاة الابن من الخميني رمزًا للمقاومة، أو لو أن صدّام اغتال الخميني في آب/أغسطس. لكن مع حلول الخريف، كانت إيران تنزلق من بين يدي الشاه. قال متأمّلًا: “طوال خمس عشرة سنة، كان كلّ ما ألمسه يتحوّل إلى ذهب، أما الآن، فكلما لمست الذهب، يتحوّل إلى براز”.
وفي السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر، ظهر الشاه منهكًا في خطاب تلفزيوني محيّر، قال فيه: “لا يسعني إلا أن أوافق على ثورتكم”. وأضاف: “في هذه اللحظات من النهوض ضد الهيمنة الأجنبية، والطغيان، والفساد، أقف إلى جانبكم”. كانت محاولة مربكة لاستيعاب الانتفاضة، لكنها فشلت فشلًا ذريعًا. وفي أعقابها، تناول السفير الأمريكي في إيران لأول مرة احتمال سقوط الشاه، في برقية مطوّلة حملت عنوان “التفكير في غير القابل للتفكير”.
ويعتبر كتاب “ملك الملوك” سردًا حيويًّا لدسائس القصر، وبالاعتماد شبه الكامل على مصادر باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مقابلات (منها مع الإمبراطورة فرح التي لا تزال على قيد الحياة)، يعيد أندرسون رسم ملامح الفوضى التي أطاحت بإيران. لكن الثورة، بخلاف الانقلاب، ليست من صنع أفراد فقط، بل تتطلب دعمًا جماهيريًا واسعًا. وبحلول نهايتها، كانت ثورة إيران قد استقطبت مليوني شخص، وهي نسبة من السكان تفوق أيّ ثورة في القرن العشرين حتى ذلك الحين.
كان من الصادم رؤية هذا العدد الكبير من الإيرانيين، من تجار ومهنيين ورجال دين وطلاب وربّات بيوت، ممن اعتادوا الانشغال بشؤونهم الخاصة، يصطدمون بعنف مع الشرطة. ويفسّر الاقتصادي تيمور كوران هذا التحول من خلال مفهوم “تزوير التفضيلات”. فقد علّمت سنوات مراقبة السافاك الإيرانيين كيف يخفون تظلّماتهم، لكن مجرد استفزاز بسيط، افتتاحية صحفية، فجّر مشاعر السخط الكامنة. ومع انكشاف آراء المواطنين لبعضهم البعض، راحوا يعبّرون عنها، فانطلقت سلسلة تفاعلات من البوح الجماعي. في هذا السياق، لعب الخميني دور المحفز؛ فنفيه لم يهمّشه، بل منح صوته منصة نادرة ليتحدث بصراحة.

توضح نظرية “تزوير التفضيلات” كيف يمكن للثورات أن تكون حتمية وغير متوقعة في آن معًا. فهناك ضغوط خفية تتراكم بصمت، إلى أن تنفجر فجأة. ولو لم تكن افتتاحية صحيفة إطلاعات هي الشرارة، لكان احتكاك آخر هو من حرّر تلك الطاقة السياسية المختزنة. وحقيقة أن الثورة كانت غير متوقعة، حتى من قبل الثوار أنفسهم، لا تعني أنها كانت رهينة الصدفة.
ومع ذلك، فإن نموذج كوران للثورة باعتبارها كشفًا يفترض امتلاك الناس تفضيلات ثابتة يرغبون في التعبير عنها. لكن، هل يملكونها فعلًا؟ يشير عالم الاجتماع كورزمان إلى أن الثورات أحداث مزعزعة؛ فالناس لا يعرفون كيف يتصرّفون، فيستقون إشاراتهم من جيرانهم أو يستجيبون لخصومهم. وبما أن الجميع يبنون سلوكهم على سلوك الآخرين، تتبدل الأعراف بسرعة، وتحدث تأثيرات مرتدة معقدة. فالمتمرّدون لا يفاجئون فقط بما يريده الآخرون، بل يفاجئون أيضًا برغباتهم هم أنفسهم.
في كتابه الثورة الأكثر وحدة (2023)، يروي عالم الاجتماع الإيراني علي ميرسِباسي أنه كان واقفًا بتوتر مع صديقه حميد خلال أحد الاحتجاجات، وكانت الحشود تهتف وتقترب. فمجرد التواجد قرب تظاهرة كان كافيًا للزج بالناس في السجن. كتب: “نظرتُ إلى حميد وبقية مجموعتنا، وعيوننا تمسح وجوه بعضنا البعض باحثين عن إجابة: أنهرب أم ننضم إلى الصفوف؟”. وفجأة، صرخ حميد: “أطلقوا سراح جميع السجناء السياسيين!”، وتبع الجميع صوته. كانت تلك أول مظاهرة يشارك فيها ميرسِباسي، الذي يتذكّر أنه بحلول أواخر 1978، “كانت الحشود الثورية قد حصلت على إرادة أو روح واحدة”.
كانت إرادة الجماهير ضرورية لأن الثورة لم تكن تستند إلى تنظيم مركزي. فقد انتشرت روح التمرد أكثر عبر الشعارات والغرافيتي والأغاني، لا عبر أوامر فوقية. كما راجت شائعات جامحة عن البهائيين الذين يسمّمون المياه، وجنود إسرائيليين يدخلون البلاد متنكرين، وأن الشاه يطلق النار على المتظاهرين من مروحيته. حاول الخميني توجيه هذه الديناميكيات السائلة وغير المتوقعة، لكن تعليماته كثيرًا ما كانت تُتجاهل. فقد كان أقل من قائد، وأكثر من رمز، أقرب إلى “تشي غيفارا إسلامي”.
وسعى الخميني إلى استبدال الملكية بدولة دينية يحكمها فقيه إسلامي، لكنه كان يعرف كيف يخفف من حدّة هذا الهدف في المقابلات، إذ أن قلة من الثوار شاركوه تلك الرؤية في البداية (حتى زملائه من كبار آيات الله لم يكونوا جميعًا يريدون حكمًا دينيًا). فقد كانت الشوارع تنتمي بالتساوي إلى الطلاب، والنسويات، والتجار، والليبراليين، وعمّال المصانع، تمامًا كما كانت تنتمي لرجال الدين، وضمّت المعارضة أيضًا هيبيين ويهودًا.
كان غموض الخميني عنصراً محورياً في قوته القيادية. فكثيرون ممن كان من الممكن أن ينفروا من رؤيته المعلنة، قبلوه رغم ذلك كرمز. وربما لم يكن في خيالهم أن رجل دين مسنًّا يمكنه فعلاً أن يستولي على الدولة. مهما يكن، فقد جمعت الثورة خلف الإسلاميين طيفًا واسعًا من الشيوعيين والليبراليين. تتذكّر القاضية شيرين عبادي، الناشطة الحائزة لاحقًا على جائزة نوبل، قائلة: “لم أرَ في ذلك أي تناقض، فأنا امرأة متعلمة ومهنية، في تأييد معارضة تخوض نضالها ضد المظالم الواقعية تحت غطاء الدين”. وتضيف: “مع من كان لي قواسم مشتركة أكبر في النهاية؟ معارضة يقودها رجال دين يتحدثون بلغة مألوفة للإيرانيين العاديين، أم بلاط الشاه المذهب، حيث يتمايل مسؤولوه مع نجمات أمريكيات في حفلات تغرق في الشمبانيا الفرنسية الفاخرة؟”
هل كان يمكن لتلك العناصر المتنافرة أن تبقى موحدة؟ في أواخر 1978، ألقى علي ميرسِباسي خطابًا مؤيدًا لتمديد إضراب جامعي، معترفًا بأن الخميني يعارض ذلك، لكنه تساءل: من وضع الخميني في موقع القيادة؟ نال ميرسِباسي تأييد الجمهور الذي هتف له، لكنه بدأ يشعر بالقلق من أنه “اندفع كثيرًا” وكان “قاسيًا بشكل مفرط” في انتقاده لآية الله. وعندما غادر الفعالية، تعرّض للطعن 21 مرة. وإن كانت هناك صدفة هنا، فهي ليست نزوة قادة، بل تقلّبات الحشود.
بحلول عام 1979، وبينما كانت الحشود تصرخ مطالبةً بموته، كان الشاه يستعد للهرب. قال لخادمه الخاص: “لا تحزم كثيرًا من الأمتعة، فهي لفترة قصيرة فقط”. وعيّن رئيس وزراء جديدًا فوّضه بالسلطة، ثم غادر إلى مصر في 16 كانون الثاني/ يناير 1979.
عاد الخميني من المنفى وأعلن تشكيل حكومة مؤقتة “على أساس الشريعة”، رغم أن رئيسها كان الليبرالي مهدي بازركان. أوضح الخميني: “من خلال الوصاية التي أتمتع بها من المشرّع الإلهي، أعلن بازركان حاكمًا، وبما أنني عيّنته، فيجب طاعته”.

وإن كانت الحكومة التي أعلنها الخميني تستند إلى دعم إلهي، فإن الحكومة الإيرانية القائمة آنذاك كانت لا تزال تمتلك خامس أقوى جيش في العالم. ومع ذلك، كانت عدوى التمرد قد بدأت تنتشر هناك أيضًا. إذ بلغت حالات الفرار من الجيش حدًّا جعل الضباط يترددون في إرسال الجنود لمواجهة الحشود، خشية أن ينضموا إلى المتظاهرين. حارب الجيش لبضعة أيام، ثم انهار فجأة. ملايين الإيرانيين، ودهشتهم هي ذاتها، أسقطوا أقوى نظام في المنطقة دون أن يُطلقوا رصاصة. “هل تعتقد أننا خططنا فعلاً لقيام ثورة؟” تساءل أحد المقربين من الخميني. “لقد فوجئنا بها مثل الجميع”.
كان شعار الثورة “الموت للشاه”، لكنه لم يوضح شيئًا عمّا سيأتي بعدها. الدولة التي أعقبت عهد الشاه بدت مزيجًا من ربطات العنق والعمائم، مع بازركان رئيسًا للوزراء، والخميني يعلو فوق الجميع بلا موقع رسمي محدد. قال بازركان متذمرًا: “كثيرًا ما لا تعرف حتى من الذي يوجّه الحركة”.
استغل الخميني هذا الغموض. وكان، بحسب تعبير بازركان، “يتحرك كجرافة تسحق الصخور والجذور والحجارة في طريقها”. أنشأ منظمة عسكرية جديدة هي “الحرس الثوري الإسلامي”، ولجانًا يسيطر عليها رجال الدين، راحت تجوب الشوارع تنفّذ الاعتقالات، وتصادر الممتلكات، وتُعدم من يُشتبه في عدائهم للثورة. في هذا الجو المحموم، اكتسب الخميني زخمًا لم يتوقعه رفاقه غير المعمّمين، ولم يتمكنوا من مجاراته.
في تشرين الأول/ أكتوبر1979، سمح جيمي كارتر، على مضض، بدخول الشاه المريض إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج. بعد أسبوع، ظهر بازركان في صورة وهو يصافح مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال فعالية حضرها الاثنان في الجزائر. جعلت هذه الأحداث البعض يعتقد بوجود محور إمبريالي يضم الشاه وكارتر وبازركان. اقتحم متشددون السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا رهائن. في البداية، عارض الخميني ذلك، وطلب من وزير الخارجية الإيراني، إبراهيم يزدي، أن “يذهب ويطردهم”. لكن وفي واحدة من المفارقات الحاسمة التي يرويها أندرسون، لم ينقل يزدي الأمر إلى طهران، بل سافر بنفسه إلى هناك، وعندما وصل، كان الخميني قد غيّر رأيه وأعلن دعمه العلني لآسري الرهائن. وإذ لم يعد بازركان قادرًا على السيطرة على الوضع، قدّم استقالته، وسرعان ما بدأت الحشود تردد شعارًا جديدًا: “الموت لبازركان”.
والموت لإيران الليبرالية، فقد نص الدستور الجديد على وضع البلاد تحت القيادة العليا لعالم في الفقه الإسلامي، وحددت المادة 107 أن يكون هذا العالم هو الخميني، وتم طرد النساء من مواقع السلطة، وأُجبرن على ارتداء الحجاب، وأُغلقت الجامعات لسنوات. وفي لقاء مع موظفي الإذاعة الرسمية، شدد الخميني على أنه “لا فرق بين الموسيقى والأفيون”، وطالب بـ”القضاء التام على الموسيقى”، ما دفع معظم الموسيقيين إلى العمل السري.
وبسيطرة راسخة، انقلب الخميني على حلفائه السابقين، وخصوصًا أولئك المنتمين إلى اليسار، فقد أكد أنهم لم يكونوا “يسارًا حقيقيًا”، بل “يسارًا مصطنعًا” صنعته واشنطن “للتخريب وتدميرنا”. وفي موجة إعدامات عام 1988، أقدمت حكومة الخميني على إعدام آلاف السجناء السياسيين، إذ أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن عددهم تراوح “بين 2800 و5000″، وهو ما يبدو أنه يتجاوز بكثير عدد السجناء السياسيين الذين قُتلوا خلال ما يقارب الأربعين عامًا من حكم الشاه. وامتلأت السجون وغرف التعذيب بالشيوعيين، والليبراليين، والنسويات، والمثليين، والبهائيين، والملكيين.
قد يتصور المرء أن مثل هذه القسوة كانت كفيلة بزعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية، لكنها لم تفعل. فمنذ عام 1979، حكمت إيران دون انقطاع على يد رجلين فقط: روح الله الخميني، ومن بعد وفاته عام 1989، تلميذه السابق علي خامنئي. ويُعد خامنئي اليوم من بين أقدم وأطول الزعماء بقاءً في الحكم على مستوى العالم. فقد شغل منصب المرشد الأعلى طوال جميع مراحل تايلور سويفت الفنية، بل طوال حياتها كلها.
وترددت في الآونة الأخيرة بعض الأحاديث بأن الهجمات التي شنتها “إسرائيل” والولايات المتحدة قد تنهي عهد خامنئي المستمر منذ ستة وثلاثين عامًا. قال ابن الشاه، ولي العهد رضا بهلوي، بعطش واضح: “كل ما يتطلبه الأمر الآن هو انتفاضة وطنية لوضع حد لهذا الكابوس”. وهو الأدرى بما يتحدث عنه. لكن طهران سبق أن واجهت الحرب دون أن تنهار. فالحرب التي استمرت ثماني سنوات مع العراق في الثمانينات، والتي أودت بحياة مئات الآلاف، لم تضعف الخميني، بل عززت موقعه. وكما رأينا في غزّة، يصعب إقناع الشعوب بتغيير حكوماتها عبر القصف.
أما الاضطراب الأكبر اليوم، فيبدو أنه في الولايات المتحدة، لا في إيران. فالمعايير هناك تتغير على نحو هستيري، والفوضى تدور حول شخصية واحدة: نابليوننا على عربة الغولف. وتُطرح الأسئلة المعتادة: هل دونالد ترامب حادث عرضي أم نتيجة حتمية؟ أهو متخبط لا يُؤتمن أم تجسيد مُسمَّر لتاريخ لا يُقاوَم؟ قد لا تكون الإجابة مهمة في نهاية المطاف. كما يوضح كتاب أندرسون، فإن الحدث غير المُرجّح قد يكون غير قابل للرجوع. يُقلب المفتاح، فتندفع القاطرة نحو مسار بديل، وتبقى عليه لوقت طويل جدًا.
المصدر: نيويوركر