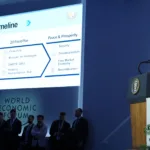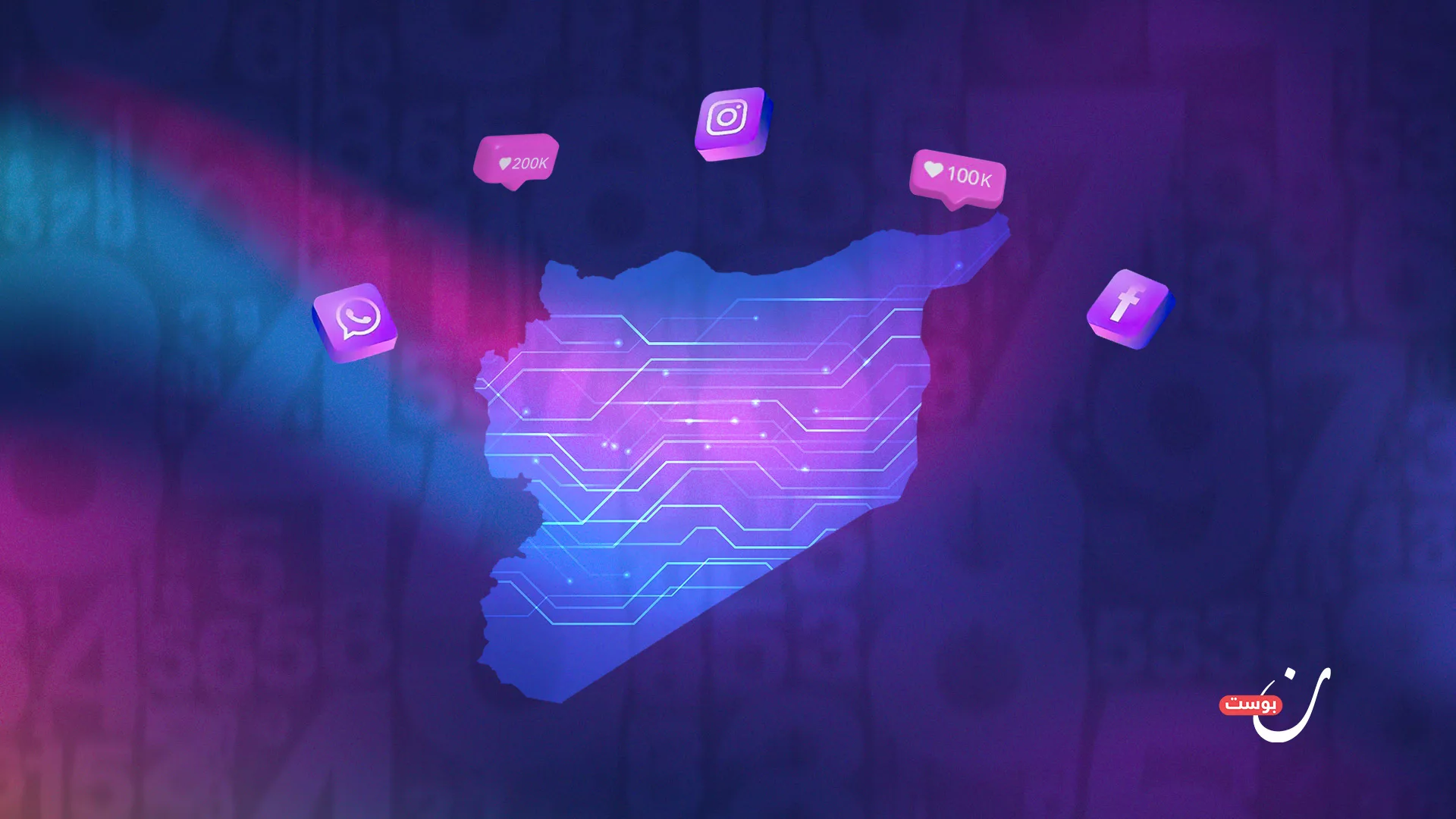أنهت حلب أعمال مؤتمر SCRIPT لِصُنّاع المحتوى تحت شعار «مؤثّرون من أجل سوريا»، برعاية وزارة الإعلام السورية وحضور رسمي لافت. البيانات الرسمية تحدّثت عن مشاركة كبيرة، بينما قدّرت تغطيات أخرى عدد المشاركين بأكثر من 380 من صانعي المحتوى والخبراء العرب والسوريين. الرسالة واضحة: الوجوه الرقمية صارت جزءًا من أدوات الدولة لا هامشًا عليها. لكن القيمة السياسية لا تُقاس بحجم القاعة وعدد الصور، بل بوجود قواعد مُعلنة تحكم هذا الحضور.
يوثّق تقرير رويترز للإعلام الرقمي لعام 2025 هبوطًا مستمرًا في الارتباط بالمصادر التقليدية مقابل صعود الاعتماد على الشبكات الاجتماعية والفيديو القصير، مع تقدّم ملحوظ لما يُسمّى «المؤثّرين/المبدعين الإخباريين». هذه ليست نزوة جيل، بل إعادة توزيع للثقة من العلامة المؤسسية إلى الشخص. تثبّت قراءات مستقلة خلاصاتٍ مشابهة: للمرة الأولى، يحصل قطاع واسع من الجمهور على أخباره مباشرةً من الشبكات أكثر من أي مصدر آخر.
دول عربية: تنظيم التأثير بدل تركه للارتجال
الإمارات انتقلت من تشجيع اقتصاد المؤثّرين إلى تقنينه عبر تصريح المُعلن الذي أطلقه مجلس الإمارات للإعلام صيف 2025. التصريح مطلوب لكل من ينشر محتوى ترويجيًّا على الشبكات، مدفوعًا كان أو غير مدفوع، مع تفاصيل ترخيص واضحة وفئات مشمولة وإعفاءات محدّدة. الهدف المُعلن: رفع الموثوقية وتنظيم المسؤولية القانونية في سوقٍ صار ناضجًا.
السعودية سبقت إلى فرض ترخيص إعلاني للأفراد عبر هيئة تنظيم الإعلام؛ رسمٌ قدره 15 ألف ريال لثلاث سنوات ضمن خدمة «موثوق»، مع ضوابط محتوى واستثناءات منصوص عليها. القراءة هنا واضحة: إطار قانوني يدمج المؤثّرين في السوق بدل ترك العلاقة بين المعلن وصانع المحتوى في المنطقة الرمادية.
اختبرت قطر خلال كأس العالم 2022 نموذج قادة الجماهير بدعوة مشجّعين ومؤثّرين من عشرات الدول مع تيسير السفر والإقامة، مقابل التزامٍ بمدوّنة سلوك ونشاط رقمي داعم. التجربة كشفت قوة «الدبلوماسية الشعبية» عبر صانعي المحتوى، وفتحت في المقابل نقاشًا أخلاقيًا حول الإفصاح والحياد.
الأردن جمع بين تقنين مالي وبيئة قانونية مُشدَّدة: دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المؤثّرين إلى تصويب أوضاعهم الضريبية باعتبار الدخل الرقمي خاضعًا للقانون، بينما انتُقد «قانون الجرائم الإلكترونية» لعام 2023 لتأثيره المقيِّد على الفضاء العام والإعلام الرقمي. تُظهر التجربة أن ضبط السوق لا ينبغي أن يقترن بخنق النقاش.
القاعدة التنظيمية تتشكّل عالميًا
تتبلور في أوروبا معمارية شفافية جديدة تنظّم العلاقة بين السياسة والإعلان الرقمي. لائحة (EU) 2024/900 تفرض وسمًا واضحًا لأي إعلان سياسي، وإشعار شفافية يكشف الراعي الفعلي والجهة الدافعة وفترة النشر والكلفة ومصدر التمويل، مع حفظ البيانات لسبع سنوات وبصيغة قابلة للقراءة الآلية. الفلسفة بسيطة ومباشرة: أن يعرف المواطن «من يقول ماذا، وبأي مال، ولماذا وصل الإعلان إليه».
لا تقف اللائحة عند حدود الوسم؛ فهي تضبط أدوات الوصول أيضًا. تُحظر فئات الاستهداف الحسّاسة (الدين، العِرق، الصحة…)، ويُشترط رضا صريح لأي استهداف مبني على بيانات غير حسّاسة، وتُقيَّد رسائل القُصَّر. بالتوازي، يجري إنشاء مستودع أوروبي موحّد للإعلانات السياسية يُمكّن الباحثين والجمهور من تتبّع الحملات عبر بوابة واحدة وببيانات معيارية.
وفي ظل قانون الخدمات الرقمية (DSA)، بدأت المفوضية الأوروبية اختبار امتثال منصّات كبرى، حيث تلقّت منصة تيك توك رأيًا أوليًا بوجود نواقص في مكتبة إعلاناتها، وهي إشارة واضحة إلى أن “مكتبات الإعلانات” لم تعد ميزة اختيارية. عمليًا، هذا الاتجاه يدفع الحكومات—ومنها سوريا—لاستلهام قواعد الإفصاح والوسم والمستودعات العلنية باكراً، بدل الوقوع تحت مقصلة الثقة لاحقًا.
فرص ومخاطر في السياق السوري
في بيئة مُثقلة بتحدّيات ما بعد الثورة، يقدّم المؤثّرون فرصة واقعية حين يتعلّق الأمر بالرسائل الخِدمية: تبسيط الإجراءات الإدارية، الإرشادات الصحية، التنبيهات الإغاثية، وشرح السياسات بلغةٍ قريبة من الناس. يمكن لشبكات المؤثّرين المحليين ومتوسطي التأثير في المحافظات أن تضاعف الوصول وتُعيد نبضًا فوريًا لصانع القرار عبر الأسئلة والتعليقات.
لكن الوجه الآخر حاضر دائمًا: خطر تديين السياسة بالترند، وتحويل القرار العام إلى رهينة الإيقاع السريع، وإثارة الاستقطاب الهويّاتي في بيئة هشّة، إضافةً إلى تهميش الصحافة إذا تحوّلت “الامتيازات المعلوماتية” إلى حسابات شخصيّة بدل المؤتمرات والأسئلة المفتوحة. كما تبقى القابلية العالية للاختراق الخارجي عامل مخاطرة لا يُستهان به.
الفارق تصنعه قواعد اللعبة: وسمٌ إلزامي لأي محتوى سياسي ممّول يَظهر في صدر المنشور، وسجلّ علني قابل للبحث يبيّن الجهة المموّلة والقيمة والهدف، و”ورقة حقائق” منشورة لكل حملة، وحظر صارم للاستهداف الحسّاس، وتسلسل مؤسسي يضمن أولوية الوثائق للصحافة ثم إحاطات المؤثّرين. ومع بروتوكول تصحيح سريع لأي خطأ، تتحوّل السرعة من خصمٍ للحقيقة إلى حليفٍ لها.
ثم يأتي معيار الحقيقة: لا يُنشر محتوى سياسي مؤثّر بلا ورقة حقائق منشورة تُلخّص النقاط الرئيسية القابلة للتدقيق، مع آلية تصحيح سريعة تُلزِم بتثبيت التصحيح أو تعديل المادة خلال مهلة وجيزة حال تبيّن الخطأ. بهذا، لا يصبح الانتشار أهمّ من الدقّة، بل يرافقها.
في اللغة والأساليب، تُحافِظ الرسائل على شعبيّتها من دون تجاوز الخطوط الحمراء: لا تحريضًا على الكراهية أو العنف، ولا استهدافًا دقيقًا لفئاتٍ حسّاسة (الدين، الطائفة، الأصل العِرقي، الحالة الصحية). الميثاق هنا يواكب روح التشريعات الحديثة في تنظيم الإعلان السياسي، ويُنقلها إلى التطبيق المحلي بوضوح.
أما تضارب المصالح فيُعالج بشفافية مؤسسية: كشف الشراكات التجارية ذات الصلة، وتجنّب الترويج لسياساتٍ تؤثّر مباشرةً في ممولين حاليين أو سابقين. تُنشَر هذه الإفصاحات على صفحة موحّدة ضمن السجل الوطني كي لا يضطر الجمهور للتنقيب في الكواليس.
ولكي لا يبتلع “اقتصاد الانتباه” الصحافة، يُرسّخ الميثاق جدار نارٍ تحريري: أولوية مُعلنة لإتاحة الوثائق للصحفيين لفترة وجيزة قبل إطلاق حملات المؤثّرين، مع تخصيص نسبة ثابتة من أي إنفاق حكومي على المؤثّرين لدعم الإعلام المستقل (شراء مساحات، منح تحقيقية، تدريب). هذا ليس «ترفًا مهنيًا»، بل صيانةٌ لجهاز المناعة الديمقراطي.
أخيرًا، لا يكتمل الميثاق بلا هيئة مستقلة للحوكمة تضمّ صحفيين وقانونيين ومجتمعًا مدنيًا وخبراء إعلان، تراجع عينات الحملات رُبع سنويًا، وتنشر تقارير التزام علنية، وتوصي بعقوباتٍ متدرجة للمخالفين. وتُضاف بروتوكولات سلامة رقمية تحمي المتحدّثين—خصوصًا النساء—من العنف الرقمي الذي يرافق الخطاب السياسي في البيئات الهشّة.
ختاماً:
المؤثّرون ليسوا وزارة إعلام متنقّلة، والصحافة ليست ديكورًا تاريخيًا.
الدولة الرشيدة تعيد توزيع الأدوار: الصحافة تُحاسِب، المؤثّرون يُبسّطون، الحكومة تُفصِح.
ما عدا ذلك—خليطٌ سامّ ينتج دولةً تُدار بخوارزمية الترند وعندها، سنكتشف متأخرين أن الضجيج لا يصنع ثقة، وأنّ مشهد اللايك لا يُطعم خبزًا، ولا يبني مؤسسات.