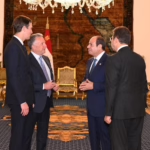يشهد المغرب منذ أسبوعين موجة احتجاجات يقودها جيل جديد من الشباب، يُعرف بـ جيل زد، بدأت بدعواتٍ لتحسين الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم، قبل أن تتطور إلى شعاراتٍ تطالب بمكافحة الفساد وإقالة الحكومة.
هذه الاحتجاجات هي امتداد لمسارٍ طويل من التعبير الشعبي عن الغضب الاجتماعي والسياسي، يمتد منذ الستينيات، مرورًا باحتجاجات 2011 التي كانت نسخة من الربيع العربي بطابعٍ خاص، ثم حراك الريف.
هذا المسار الطويل يكشف عن ثبات جوهر المطالب وتحوّل أشكال التعبير عنها من الغضب الجماهيري إلى الحراك المنظّم والرقمي، في معركةٍ متواصلة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
23 مارس/ آذار 1965.. أنهار الدم في شوارع الدار البيضاء
اندلعت شرارة انتفاضة 23 مارس/ آذار 1965 من مدينة الدار البيضاء، إثر قرارٍ وزاري أحدث صدمةً في صفوف التلاميذ والأسر المغربية. القرار الذي وقّعه وزير التعليم المغربي آنذاك، يوسف بلعباس، في فبراير/ شباط من العام نفسه، قضى بطرد التلاميذ البالغين من العمر 15 سنة من السنة الأولى، والبالغين من العمر 16 سنة من السنة الثانية، و17 سنة من السنة الثالثة إعدادي، من المؤسسات التعليمية. وكانت هذه الخطوة بمثابة إعلان نهاية حلم آلافٍ من الشباب في التعليم الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم، فاشتعلت أولى شرارات الغضب.
ففي 22 مارس/ آذار، خرج مئات التلاميذ من ثانوية محمد الخامس بالدار البيضاء في مسيرةٍ سلمية نحو مقر نيابة التعليم، يطالبون بإلغاء القرار الجائر. لكن قوات الأمن اعترضت طريقهم بالعنف واعتقلت عددًا منهم، لتتحول الحركة الطلابية المحدودة إلى نداءٍ عام للاحتجاج.
وفي اليوم الموالي، 23 مارس/ آذار، تجمّع التلاميذ مجددًا، مدعومين بآبائهم وبالطلبة الجامعيين المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وهي منظمة طلابية نقابية مغربية تمثل الطلبة، فانطلقت مظاهراتٌ حاشدة جابت شوارع المدينة، لتتحول إلى انتفاضةٍ شعبية شاملة.
قبل أن تمتد رقعة الغضب إلى مدنٍ أخرى، ويتحوّل الإضراب التلاميذي إلى إضرابٍ عام شلّ الحياة الاقتصادية، بعد أن انضم إليه العمال والتجار. ومع تصاعد الشعارات المناهضة للقمع وللسياسات الحكومية، واجهت السلطاتُ الاحتجاجاتِ بالعنف، حيث أشرف الجنرال محمد أوفقير على العمليات الأمنية من مروحيةٍ كانت تحلّق فوق سماء المدينة، وأعطى أوامره بإطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين في الأحياء الشعبية بعد ظهر ذلك اليوم، فعمّت الفوضى وسقط عشرات القتلى ومئات الجرحى.
مع حلول المساء، كانت الدار البيضاء قد تحوّلت إلى مدينةٍ تحت الحصار، حيث كانت الدبابات تجوب الشوارع، والجيش ينتشر في النقاط الحساسة في المدينة، فيما استمرّت الاعتقالات بشكلٍ عشوائي وطالت التلاميذ والطلبة والمارة على السواء.
الروايات الرسمية قلّلت من حجم الكارثة، إذ أعلنت وزارة الداخلية أن عدد القتلى لم يتجاوز سبعة، والجرحى 69، لكن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب قدّر الحصيلة بأكثر من ألف قتيل وآلاف الجرحى، دُفن كثيرٌ منهم سرًا في مقابر جماعية، بينما تجاوز عدد المعتقلين ألفي شخص.
انتفاضة يونيو/ حزيران 1981.. احتجاجًا على زيادة الأسعار
في صيف عام 1981، تحولت مدينة الدار البيضاء مجددًا إلى مسرحٍ لاحتجاجاتٍ شعبيةٍ غير مسبوقة، عُرفت لاحقًا باسم “انتفاضة الكوميرا”، وهو وصفٌ ساخر استخدمه وزير الداخلية حينذاك، إدريس البصري، للاستهزاء بالمحتجين.
وقد بدأت شرارة الانتفاضة عندما أعلنت حكومة المعطي بوعبيد، يوم 28 مايو/ أيار 1981، زياداتٍ كبيرةً في أسعار المواد الأساسية كالزيت والسكر والدقيق والحليب… استجابةً لشروط المؤسسات المالية الدولية ضمن ما سُمي حينها بـ”برامج التقويم الهيكلي”. هذا القرار أثار موجةَ غضبٍ عارمة، فأطلقت الكونفدرالية المغربية للشغل دعوةً إلى إضرابٍ عام يوم 20 يونيو/ حزيران 1981، احتجاجًا على ما اعتبرته سياسةَ تجويعٍ وإفقارٍ ممنهجة.
وقد استجاب سكان مدينة الدار البيضاء بقوة، فأُغلقت المتاجر والمصانع، وتوقفت حركة النقل، وخرج الآلاف في مظاهراتٍ سلميةٍ سرعان ما واجهتها قوات الأمن بالعنف.
ومع محاولة السلطة كسر الإضراب بالقوة، انفجرت موجاتُ غضبٍ في الأحياء الشعبية كـ الحيّ المحمدي ودرب السلطان وكريان سنطرال، ليتحوّل الإضراب الاقتصادي إلى انتفاضةٍ اجتماعيةٍ اجتاحت المدينة لساعاتٍ طويلة. ومع حلول المساء، تدخّل الجيش، وفُرضت القواتُ الأمنيةُ حصارًا شاملًا، بينما كانت أصوات الرصاص تملأ الشوارع. وقد تباينت الروايات بخصوص أعداد القتلى بشكلٍ كبير، فبينما أعلنت السلطاتُ سقوطَ 66 قتيلًا و110 من الجرحى، أكدت المعارضة أن العدد تجاوز 600 قتيل، في حين قدّرت بعضُ المنظمات الحقوقية الرقمَ بأكثر من ألف ضحية.
وتحدثت مصادرُ عن دفنٍ جماعيّ للضحايا في مواقع سرّيةٍ قرب ثكنات المطافئ بالحيّ المحمدي، وهو ما سيبقى لعقودٍ طيّ الكتمان، إلى أن فتحت هيئة الإنصاف والمصالحة هذا الملف بعد عام 2004، ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي حاول جبرَ ضررِ ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خلال ما يُعرف في المغرب بـ”سنوات الرصاص”. هذه الانتفاضة أجبرت الحكومة على التراجع عن الزيادات في الأسعار، لكنها تمسّكت بروايتها الرسمية، متهمةً المعارضةَ بتأجيج الشارع والتآمر مع جهاتٍ أجنبية.
هذا الحدث شكّل مقدمةً لاحتجاجاتٍ لاحقةٍ عرفها المغرب عامي 1984 و1990، حين تصاعدت تبِعاتُ التقويم الهيكلي من جديد. وبعد أكثر من ثلاثة عقود، اعترفت الدولة ضمنيًا بفظاعة ما جرى، ففي سبتمبر/ أيلول 2016، دُشّنت مقبرةٌ رسميةٌ لضحايا أحداث يونيو/ حزيران 1981 بالدار البيضاء، بحضور ممثلين حكوميين وحقوقيين وأسر الضحايا، في خطوةٍ سعت إلى إعادة الاعتبار إلى من سقطوا في تلك الأيام الدامية.
احتجاجات 2011.. نسخةٌ من الربيع العربي بطابعٍ خاص
في مطلع عام 2011، ومع تصاعد موجةِ الربيع العربي في تونس ومصر، وامتداد أصداء الشعارات المطالبة بالحرية والكرامة إلى أنحاء المنطقة، ظهرت في المغرب حركةٌ شبابيةٌ جديدة ستُعرف لاحقًا باسم “حركة 20 فبراير“.
كانت الانطلاقة عبر دعواتٍ انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، دعا فيها شبابٌ مستقلون إلى التظاهر يوم 20 فبراير/ شباط 2011. في البداية، لم تكن للحركة قيادةٌ رسمية أو هيكلٌ تنظيميٌّ واضح، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى شبكةٍ واسعةٍ من التنسيقيات المحلية، جمعت نشطاء من توجّهاتٍ فكريةٍ متعددة، من بينهم يساريون وإسلاميون وحقوقيون.
انطلقت الحركة من قناعةٍ بأن الأزمةَ الاجتماعيةَ والسياسيةَ في المغرب مرتبطةٌ ببنيةِ الحكم نفسها، والتي اعتبرتها مكرّسةً للسلطوية والفساد. ففي بيانها التأسيسي يوم 14 فبراير/ شباط 2011، حدّدت الحركةُ مطالبها بوضوح: دستورٌ ديمقراطيٌّ يمثل الإرادة الشعبية، حكومةٌ انتقالية، قضاءٌ مستقلٌّ ونزيه، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومحاكمةُ الفاسدين الذين “نهبوا خيرات الوطن”. كما رفعت شعاراتٍ اجتماعيةً واقتصاديةً تطالب بضمان العيش الكريم، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، وتشغيلِ حاملي الشهاداتِ المعطلين.
بعد أيامٍ من البيان، أعلنت أكثرُ من عشرين هيئةً سياسيةً وحقوقيةً دعمها للحركة، من بينها جماعةُ العدل والإحسان ذات النفوذ الواسع، وأحزابٌ يساريةٌ مستقلة. وفي 20 فبراير/ شباط، خرجت أولى المظاهرات في أغلب المدن المغربية، بمشاركةِ آلافِ المحتجين. كانت المسيراتُ سلميةً، ورفعت شعاراتٍ تطالب بالإصلاح السياسي وإنهاء الفساد والاستبداد.
ورغم بعض التدخلات الأمنية واعتقال عددٍ من النشطاء، استمرّ زخمُ الحركة لأسابيع، لتُصبح عنوانًا لمرحلةٍ سياسيةٍ جديدةٍ في المغرب.
هذا الضغط الشعبي أجبر المؤسسةَ الملكيةَ على التحرّك سريعًا، ففي خطاب 9 مارس/ آذار 2011، أعلن الملك محمد السادس عن إصلاحٍ دستوريٍّ شامل، شمل تعزيزَ صلاحياتِ الحكومة والبرلمان، وتوسيعَ مجالِ الحريات العامة. وقد تفاعلت الحركةُ مع الخطاب بانقسامٍ واضح؛ فبينما رأى بعضُ مكوناتها أن الإصلاح خطوةٌ إيجابيةٌ تستوجب التفاعلَ معها، اعتبر آخرون أنها استجابةٌ شكليةٌ لا تمس جوهر السلطة.
ومع استمرار الخلافات الداخلية حول الموقف من الدستور الجديد، بدأت الحركةُ تعرف تراجعًا تدريجيًا. ورغم أفولها التدريجي، تركت حركةُ 20 فبراير أثرًا بالغًا في الحياة السياسية المغربية. فقد أعادت الشبابَ إلى ساحةِ النقاش العام، كما مهّدت للإصلاح الدستوري لعام 2011، والذي أدّى إلى انتخاباتٍ مبكرةٍ صعد من خلالها حزبُ العدالة والتنمية إلى قيادةِ الحكومة لأول مرة.
حراك الريف 2016–2017: المطالب المحلية تُقاطِعُ الوطنية
في خريف 2016، اندلع حراكُ الريف عقب وفاة الشاب محسن فكري في مدينة الحسيمة، إثر حادثٍ مأساويٍّ هزّ الرأي العام، حين سُحق داخل شاحنةِ نفاياتٍ أثناء محاولته استرجاع بضاعته المصادَرة. غير أن هذا الحادث، كما تشير دراسة الباحث عمر إحرشان، لم يكن سوى الشرارة التي أَطلقت غضبًا مكبوتًا تراكم عبر عقودٍ من التهميش الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في منطقةٍ عُرفت تاريخيًا بصلابتها وخصوصيتها الثقافية. فقد كشف الحادث عن أزمةٍ أعمق تتمثل في إحساسٍ جماعيٍّ بالإقصاء والحرمان من التنمية والاعتراف.
وتؤكد الدراسة أن الريفَ المغربي ظلّ منذ الاستقلال يعيش على هامشِ السياساتِ العمومية، رغم ما يزخر به من مؤهلاتٍ طبيعيةٍ وبشريةٍ، إذ تعاني المنطقةُ من ضعفِ البنيةِ التحتية، وهشاشةِ الخدماتِ الصحيةِ والتعليمية، وتفشي البطالة في صفوفِ الشباب، إلى جانب محدوديةِ الاستثمار وضعفِ الاندماجِ الاقتصادي في النسيجِ الوطني.
هذه الأوضاع، المتراكمةُ تاريخيًا، غذّت شعورًا بالتهميش لدى السكان، الذين يعتبرون أن منطقتهم تؤدي ثمنَ مواقفها التاريخية المقاومة للاستعمار، وما تلاها من انتفاضاتٍ قوبلت بالقمع والإهمال.
في هذا السياق، كان مقتلُ محسن فكري النقطةَ التي أفاضت الكأس، وخرج آلافُ المواطنين في مسيراتٍ سلميةٍ جابت شوارعَ الحسيمةِ والبلداتِ المجاورة، رافعين شعاراتٍ تطالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية والمحاسبة.
تميّز الحراكُ بطابعه المدني والسلمي، ولم تقتصر مطالبه على الحقوقِ الاجتماعية، وإنما تجاوزتها إلى بُعدٍ سياسيٍّ، إذ دعا المحتجّون إلى فتحِ حوارٍ جديٍّ مع ممثلي السكان، ومساءلةِ المسؤولين عن مشاريعِ التنميةِ المتعثّرة. كما تضمّنت لائحةُ المطالب إنشاءَ جامعةٍ ومستشفى جامعيٍّ في الحسيمة، وتحسينَ المرافقِ العمومية، وتوفيرَ فرصِ العمل، والاعترافَ الرسميّ بضحايا المراحل السابقة من القمع.
هذه المطالب، كما يرى إحرشان، لم تكن ثوريةً بقدر ما كانت دعوةً لتفعيلِ الحقوقِ الدستورية، لكن طريقةَ تعاطي الدولةِ معها حوّلتها إلى مواجهةٍ مفتوحة.
حينذاك، تراوحت استجابةُ السلطات بين التجاهلِ والاحتواءِ الأمني. فبعد محاولاتٍ محدودةٍ للتهدئة عبر زياراتٍ وزاريةٍ ووعودٍ تنمويةٍ، اتجهت المقاربةُ الرسمية نحو التشديدِ الأمنيّ والاعتقالاتِ الواسعةِ في صفوفِ النشطاء، مع محاكماتٍ ثقيلةٍ خلقت حالةً من الإحباطِ الشعبي.
ومع ذلك، ظلّت الحركةُ محافظةً على سلميّتها، ما أكسبها شرعيةً أخلاقيةً رغم التضييقِ الإعلاميّ والأمنيّ.
وبالعودةِ إلى الدراسة التي أنجزها إحرشان، فإن أهميةَ حراكِ الريف تكمن في كونه امتدادًا لحركةِ 20 فبراير/ شباط 2011، لكنه أكثرُ تجذّرًا اجتماعيًا وأقلُّ تأطيرًا سياسيًا، فهو يُعبّر عن جيلٍ جديدٍ من الاحتجاجاتِ غير المؤدلجة، التي تُوظّف أدواتِ التواصلِ الرقميّ للتعبير عن مطالبَ واقعيةٍ مرتبطةٍ بالعدالةِ المجاليةِ والكرامة.
كما أن الحراكَ أعاد طرحَ سؤالِ التنميةِ الترابيةِ والعدالةِ الاجتماعية، باعتبارِهما محورًا مركزيًا في علاقةِ الدولةِ بالمجتمع، وكشف محدوديةَ المقاربةِ الأمنيةِ في مواجهةِ الأزماتِ الاجتماعية.
احتجاجات جيل زد 2025.. بين الثابت والمتحوّل
منذ أسبوعين، تتواصل احتجاجاتٌ يقودها جيلٌ جديدٌ من الشباب، يُعرف بـجيل زد، بدأت بدعواتٍ لتحسينِ الخدماتِ الأساسية في مجالي الصحة والتعليم، قبل أن تتطور إلى شعاراتٍ تطالب بمكافحةِ الفسادِ وإقالةِ الحكومة. ولعلّ المتأمّلَ للاحتجاجاتِ الحالية، يجد أنها تحمل مزيجًا من الثوابتِ التي كانت حاضرةً في كلِّ الانتفاضاتِ السابقة، والمتحوّلاتِ التي ميّزت جيلًا تربّى على الإنترنت.
كما تكشف عن تراكمِ الاختلالاتِ واستمرارِها رغم الوعودِ المتكررةِ منذ عقود، ففي الأشهرِ الأخيرة، كانت الشرارةُ من حادثةٍ مأساويةٍ في مستشفى عموميٍّ بمدينة أكادير، تمثّلت في وفاةِ ثماني نساء أثناءَ ولاداتٍ قيصرية، وهو ما أثار غضبًا واسعًا تجاهَ تدهورِ الخدماتِ الصحيةِ، ونقصِ المواردِ، والاكتظاظِ، وقلّةِ الأطرِ الطبيةِ والتجهيزاتِ. رَدُّ السلطاتِ على الاحتجاجاتِ تمثّل في حملةِ اعتقالاتٍ واسعةٍ في البداية، غير أن اندلاعَ أعمالِ العنفِ في بعض المناطق أعقبه قرارٌ بضرورةِ عدمِ التدخلِ في الاحتجاجاتِ السلمية.
وبعد اشتدادِ الضغط، خرجت الحكومةُ بتصريحاتٍ عبّرت فيها عن الاستعدادِ للحوار، وبتفهُّمٍ للمطالبِ الاجتماعية، لكنها أكدت أيضًا ضرورةَ احترامِ النظامِ والحدودِ القانونيةِ للتظاهر. لكن في المقابل، ما لم يظهر في بعضِ الاحتجاجاتِ السابقة كما هو ظاهرٌ الآن، هو شعورٌ عامٌّ بالاستياء من مؤسساتِ الوساطة، خاصةً الأحزابِ والنقاباتِ، التي يُنظَر إليها على أنها عاجزةٌ أو متواطئة.
كما أن شبابَ جيلِ زد لا يريد حلولًا مؤقتةً أو ترقيعاتٍ، بل يريد أن يرى تغييرًا ملموسًا في العدالةِ الاجتماعية، في المساءلة، في المساواة، في التوزيعِ العادلِ للموارد، وفي تحسينِ الحياةِ اليومية، وليس فقط في المشاريعِ الكبيرةِ التي تخطف الأنظار.
هكذا إذًا، يمكن القول إن الثابتَ في تاريخِ الاحتجاجاتِ بالمغرب هو استمرارُ المطالبةِ بالكرامةِ والعدالةِ الاجتماعيةِ، ومحاسبةِ المسؤولين عن الفساد، رغم تغيّر السياقاتِ والأجيال. فمنذ عقودٍ، ظلّ المحتجّون يُعبّرون عن شعورٍ متجذّرٍ باللامساواة وغيابِ العدالةِ في توزيعِ الثروة، مثلما يطالبون بتحسينِ الخدماتِ الاجتماعية، بينما حافظت الدولةُ على نمطٍ شبهِ ثابتٍ في التعامل، يجمع بين محاولاتِ الاستيعابِ والمقاربةِ الأمنية