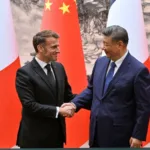تمر الذكرى الخامسة عشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير في لحظة ملتبسة من تاريخ مصر والمنطقة العربية والعالم؛ لحظة يغلب عليها الإنهاك أكثر مما يغلب عليها الحنين، ويثقلها سؤال “ما الذي جرى؟” بقدر ما يثقلها سؤال “ما الذي بقي؟”، فبعد عقد ونصف من الثورة، لا يبدو أننا أمام سردية واحدة، ولا حتى أمام هزيمة مكتملة أو انتصار مؤجل، بل أمام مسار طويل من التفكك، إعادة التشكل، والانكسارات المتراكمة التي طالت السياسة، والمجتمع، والتنظيم، والخيال العام نفسه.
في هذا السياق، تبدو الحاجة ملحّة للعودة إلى الأسئلة الصعبة، لا بوصفها نوستالجيا ثورية، ولا كتمرين في جلد الذات، السياسية تحديدا، بل كمحاولة لفهم ما جرى لمساحات الفعل السياسي والاجتماعي في مصر: الأحزاب، النقابات، الحركات العمالية، الإسلاميون، الإعلام البديل، والأجيال الجديدة.
ومع سياسي وصحافي وأكاديمي مصري مثل حسام الحملاوي، الذي عايش الثورة وما قبلها وما بعدها، وكتب وجادل وناقش من موقع نقدي ومنخرط، نحاول فتح نقاش هادئ حول السياسة كما هي اليوم، لا كما تمنيناها، وحول يناير كما أثّرت في الواقع، لا كما تُستدعى في الذاكرة.
إذا بدأنا من المشهد السياسي داخل مصر، اليوم، في الذكرى الخامسة عشر للثورة، كيف تقيّم حجم وفاعلية وهى شبه مُنعدمة كما نرى ما تبقى من القوى السياسية المختلفة، سواء الأحزاب المدنية مثل تيار الأمل (تحت التأسيس) والكرامة والاشتراكيين، أو التيارات ذات الخلفية الإسلامية؟ وهل كان بإمكانهم خلال السنوات الماضية مقاومة قمع السُلطوية، وهل ما زال يمكن الحديث عن فعل سياسي منظم، أم أننا أمام بقايا أطر بلا تأثير حقيقي؟
يمكن القول إن مختلف التيارات السياسية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، باتت اليوم ضعيفة الحجم والتأثير، إن لم تكن قد انهارت بالفعل، كليا أو جزئيا. ويُعدّ أحد المشاريع الأساسية للثورة المضادة، التي قادها عبد الفتاح السيسي بعد الانقلاب، هو تفكيك المشهد السياسي برمّته. وقد بدأ هذا التفكيك باستهداف المعارضة الإسلامية، سواء جماعة الإخوان المسلمين أو الجهاديين أو السلفيين، ثم امتد لاحقًا إلى القوى المدنية، بما في ذلك حركات مثل شباب 6 أبريل، والأحزاب اليسارية القائمة، سواء تلك المسجّلة رسميًا أو التنظيمات غير الرسمية مثل الاشتراكيين الثوريين. وقد جرى قمع هذه التنظيمات وتفكيك معظمها، وإن لم يكن جميعها، إلى أن يمكن القول إنه مع نهاية عام 2018، وبانتهاء الفترة الأولى من حكم السيسي، كانت أغلب هذه التنظيمات قد انهارت تمامًا.
غير أن النظام دخل منذ عام 2020 وحتى 2022 في أزمة متعددة الأبعاد، تزامنت مع جائحة كوفيد-19، وحرب روسيا وأوكرانيا، وبداية الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلًا عن تراجع أو تذبذب الدعم الخليجي قبل حرب غزة. وقد أسهمت هذه العوامل مجتمعة في خلق حالة من عدم الاستقرار داخل دوائر الحكم، أو على الأقل بثّ قدر من القلق والخوف. وقد عبّر السيسي عن ذلك في أكثر من تصريح، من بينها تصريح شهير حمل نبرة عتاب واضحة، حين أشار إلى أن “بعض الأشقاء العرب” يرون أن مصر غير قادرة، في إشارة ضمنية إلى غياب أو تراجع الدعم العربي/الخليجي. والتاريخ يعلّمنا أن لحظات القلق داخل مراكز القوة، حتى وإن لم تصل إلى صراعات مفتوحة، تفتح دومًا فرصًا محدودة للعمل السياسي، ولو على الهامش، وهي فرص ضعيفة لكنها موجودة.
سبب آخر يُضاف، وهو أن شعبية عبد الفتاح السيسي شهدت تراجعًا حادًا. فمنذ الانقلاب وحتى التعويم الأول للجنيه في أواخر عام 2016 تقريبًا، كان يتمتع بشعبية جارفة. وقد استندت هذه الشعبية، من جهة، إلى حالة من الهلع المجتمعي والبارانويا التي صنعتها الثورة والثورة المضادة، وإلى توق قطاعات واسعة، لا سيما من الطبقة الوسطى، إلى الاستقرار. ومن جهة أخرى، لعب السيسي على أحلام الناس وشعارات من قبيل “مصر قد الدنيا وهتبقى قد الدنيا”، وطلب الصبر لأشهر قليلة، واعدًا بتدفق الأموال وتحسن الأوضاع. وقد صدّق كثيرون هذه الوعود الوردية في بدايات الأمر.
وأيضا لا يمكن فصل مرحلة ما بعد التعويم عن بدايات صعود محاولات مثل “تيار الأمل”، ومحاولات أحمد الطنطاوي، وكذلك محاولات التيار الناصري، رغم التحفظات والنقد الموجه إليها. فقد شهدت تلك المرحلة محاولات متواضعة ومحدودة لفتح المجال السياسي، وهو ما شكّل السياق العام لهذه التحركات.
لكن هل من فعالية حقيقية لذلك؟
في الواقع، لا تزال جميع التنظيمات السياسية، بما فيها الاشتراكيون الذي أنتمي إليهم، اليوم، قد جرى تقليم أظافرها، وتفكيك قواعدها إلى حد كبير.
من هنا، ومع كل هذا الموات السياسي الذي أشرتَ إليه، ورغم بعض المحاولات المحدودة، مثل تجربة “تيار الأمل” بقيادة أحمد طنطاوي، تبدو هذه المبادرات هامشية، وحتى حين تُسبب قدرًا من القلق، سرعان ما تنتصر عليها السلطوية، كما تكشف حالة طنطاوي نفسها. ما تقييمك لهذا الوضع؟ وإلى متى يمكن أن تستمر هذه الحالة السياسية المتردية؟
دعنا نتفق، أن ليس هناك شيء مستمرا للأبد. ففي السنوات القليلة الماضية ظهرت مبادرات تحاول توسيع هامش العمل السياسي، مثل “تيار الأمل” وغيره، إلى جانب حراك ملحوظ داخل النقابات المهنية. ويُعدّ فوز خالد البلشي، وهو معارض من اليسار الجذري، برئاسة نقابة الصحفيين، وكذلك ما جرى في نقابة المهندسين مع طارق النبراوي، إضافة إلى الإضرابات العامة للمحامين خلال العام الماضي، مؤشرات على نبض اجتماعي ما زال حاضرًا، وإن بدا ضعيفًا.
لكن، صحيح، كما ذكرت، فإن معظم محاولات التغيير القائمة اليوم تُجهَض سريعًا ولا يُكتب لها الاستمرار، في ظل نظام شديد القمع لا يتحمل أي مستوى من النقد، ما يجعل قمع أي مبادرة إصلاح أو تغيير نتيجة متوقعة. ورغم أن القمع في عهود سابقة، مثل عهد حسني مبارك، لم يكن بالدرجة نفسها، فإن محاولات التغيير كانت تُحتوى آنذاك أيضًا. ومع ذلك، تظل هذه المبادرات، بما فيها الحراك النقابي، جزءًا من عملية تراكمية طويلة الأمد، تتكوّن من محاولات تفشل أو تنجح جزئيًا، ورغم سوء الوضع الراهن، فإن مجرد ظهورها يُعدّ تطورًا لم يكن مطروحًا على الساحة السياسية قبل عام 2018.
على سيرة النقابات، وبحكم يساريّتك واهتمامك بـ”المسألة العمالية”، كيف ترى وضع النقابات والحركة العمالية في اللحظة الراهنة؟ أين يتموضع هذا المجال اليوم في علاقته بالسلطوية؟ وكيف يمكن فهم موجات الاضطراب المتكررة: هل تغيّر شكلها وأدواتها تحت وطأة السلطوية، أم أن طريقة تعامل الدولة معها هي التي أعادت تعريفها وحدودها؟ وهل ترى أن هذه الاحتجاجات يبنى عليها في المستقبل القريب؟
حول “المسألة العملية” أو وضع الحركة النقابية اليوم، لا بد أولًا من تقديم خلفية مختصرة للقارئ المصري وغيره. منذ عهد عبد الناصر، لم تكن هناك نقابات بالمعنى الحديث. أُسس عام 1957 «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»، الذي جمع كل التنظيمات العمالية في كيان هرمي بيروقراطي خاضع للدولة. تألف هذا البناء من ثلاث طبقات: لجان نقابية مصنعية داخل المنشآت، ثم نقابات عامة للقطاعات، وصولًا إلى مجلس إدارة الاتحاد في قمته، وهو مستوى مغلق تمامًا أمام المستقلين والمعارضين بفعل السيطرة الأمنية.
لم يكن الاتحاد ممثلًا حقيقيًا للعمال، بل أداة لضبطهم سياسيًا، استُخدمت لحشدِهم وتوجيههم، كما في انتخابات عهد مبارك حين نُقلت أعداد كبيرة من العمال بالحافلات لتزوير الانتخابات مقابل وعود مادية محدودة. ومع ذلك، وعلى مستوى القاعدة، كان بعض المستقلين ينجحون أحيانًا في اختراق اللجان النقابية القاعدية رغم استحالة التأثير في المستويات العليا. وخلال موجة الإضرابات بين 2006 و2011، اصطدم العمال مرارًا بالنقابيين التابعين للاتحاد، كما في إضراب غزل كفر الدوار عام 2007 حين احتُجز هؤلاء داخل المصنع لإجبارهم على دعم الاعتصام.
كانت الاحتجاجات العمالية قبل 2011 في معظمها عفوية وغير مؤطرة، تقودها قيادات من قلب المصانع، مع تواصل محدود مع اليسار أو الحقوقيين. هذا المناخ أتاح نشوء النقابات المستقلة، وكانت التجربة الأولى عام 2008 مع نقابة موظفي الضرائب العقارية، ثم لحقتها نقابات أخرى في قطاعات الصحة. ومع ثورة يناير عام 2011، توسع هذا المسار وتأسس «الاتحاد المصري للنقابات المستقلة»، بدعم قوى يسارية مختلفة، لكنه كشف سريعًا عن مشكلات داخلية، أبرزها النزعة الفوقية من قياداته وضعف التنسيق، كما ظهر في فشل الدعوة للإضراب العام، وكانت الدعوة في غاية الأهمية، حينذاك في فبراير 2012.
بعد الانقلاب عام 2013، دخلت الحركة النقابية مرحلة تراجع حاد، مع قمع واسع طال الاتحاد العام والنقابات المستقلة معًا، وانسحاب أو انخراط بعض قوى اليسار في السلطة الجديدة. تعرّضت القيادات العمالية المستقلة للاعتقال أو الفصل أو التقاعد القسري، وصَدرت قوانين عطلت عمليًا عمل النقابات المستقلة، حتى بات فتح حساب بنكي للنقابة فعلًا غير قانوني.
ورغم ذلك، شهدت السنوات الأربع الأخيرة بوادر صحوة محدودة، مستفيدة من أدوات تنظيم جديدة مثل مجموعات واتساب. إلا أن هذه التحركات تواجه صعوبات كبيرة، إذ تقودها غالبًا قيادات شابة تفتقر للخبرة، في ظل غياب الأحزاب أو الشبكات التي كانت تنسق الإضرابات سابقًا. كما أن طبيعة الاحتجاجات اليوم دفاعية أكثر منها هجومية، تتركز على مواجهة إغلاق المصانع أو المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو غير كاف، لا على توسيع الحقوق أو بناء استقلال نقابي. ومع كل ذلك، تظل هذه التحركات مؤشرًا مهمًا على إمكانية إحياء الحركة العمالية مستقبلًا، رغم القيود القاسية المفروضة عليها الآن.
من الفعل العمالي إلى الحقوقي، تاريخيا، أرى، وربما شهد المتابع لهذه الحالة، وهي انتقال جزء من الفعل السياسي إلى المجال الحقوقي، وقاد هذا التحول عدد من الفاعلين اليساريين. اليوم، وفي ظل التضخم الإعلامي وتعدد المنصات، ووجود آلاف المصريين في الخارج خوفا من القمع. هل ترى أن العمل الإعلامي بكافة أفكاره—خصوصا لدى التيارات الإسلامية—أخذ موقعا مشابها، بديلا عن التنظيم السياسي المباشر؟ كيف تقيّم ظاهرة الاكتفاء بالبودكاست والخطاب الإعلامي دون بناء حزبي أو تنظيمي؟ وما السبل الممكنة لاستعادة السياسية الفعلية من هذا الانزلاق؟
فيما يخص المجال الحقوقي في مصر، فهو بدأ فعليًا في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات مع انهيار ما يُعرف بـ”الحركة الشيوعية الثالثة” التي نشأت منذ 1968 وبلغت ذروتها في 1977، ودخلت بعد ذلك مرحلة موت إكلينيكي حتى انهيار الاتحاد السوفيتي. حينها، قرر معظم اليساريين الذين كانوا جزءًا من هذه الحركة التوجه للعمل الحقوقي، باعتباره بديلًا عن العمل الحزبي التقليدي في ظل انهيار البوصلة السياسية التي كانوا يعتمدونها. هؤلاء اليساريون الراديكاليون هم من بدأوا العمل الحقوقي، ومع مرور الوقت تنوعت طبيعة هذا العمل، فظهرت بعض المنظمات التي كانت شبيهة بـ”البوتيكات”، تعمل بمستوى محدود وتركيز على التقارير السنوية بالإنجليزية للحصول على التمويل، بينما ظهرت منظمات أخرى لها دور مركزي في الحراك الاحتجاجي على الأرض، مثل مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب ومركز هشام مبارك والمبادرة المصرية، وكانت تسهم في رفع سقف النقد السياسي في مصر. محامون مثل خالد علي ورفاقه لعبوا دورًا مهمًا في هذا السياق، حيث رفعوا قضايا مهمة تتعلق بالحد الأدنى للأجور وإبطال عقود الخصخصة، وكان نضالهم مرتبطًا أيضًا بالعمل في الشارع وليس فقط في قاعات المحاكم.
فيما يتعلق بالإسلاميين، كانت لديهم حالة مختلفة، فتنظيم الإخوان كان ضخمًا ومنظّمًا ضمن مؤسسات وقطاعات متعددة تشمل مدارس ومشاريع خيرية، ويمكن اعتباره جزءًا من نشاط المجتمع المدني، بينما بعض المحامين الإسلاميين اتجهوا للعمل الحقوقي قبل 2011 وبعدها، وكان منهم من يتمتع بمصداقية عالية ونشاط ملحوظ. بعد الانقلاب والمجازر الشديدة التي شهدتها مصر، اختفى الفضاء العام والحراك على الأرض، وكان من الطبيعي أن تتجه معظم القوى، سواء إسلامية أو علمانية أو غيرهما، إلى الفضاء الرقمي. فقد أصبح الإنترنت، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، المكان الأساسي للنقاش السياسي، فيما أصبح البودكاست والحسابات على فيسبوك وتويتر أدوات مركزية للتواصل والتأثير، نظرًا لتوافر الهواتف المحمولة وانتشار الإنترنت، وهو ما لم يكن متاحًا في أواخر التسعينيات أو قبل 2011.
حالة الإسلاميين أكثر تعقيدًا بسبب التنوع داخل الإخوان أنفسهم، فهناك أطياف مختلفة تتراوح بين من يركز على العمل الدعوي الديني فقط ومن يسعى للعمل التنظيمي والسياسي، مع اعتماد البعض على الأدوات الإعلامية الحديثة كجزء من استراتيجية التنظيم السياسي. وعليه، فإن السؤال عن إمكانية استعادة السياسة من هذا “الانزلاق” يحتاج إلى فهم أن حجم الممتهنين بالسياسة في مصر محدود مقارنة بعدد السكان، وأن سقف بعض هؤلاء يقتصر على متابعة البودكاست، بينما يسعى آخرون إلى الجمع بين العمل الإعلامي والتنظيمي. أيضا، طالما أن الحراك على الأرض مختفٍ ومقموع، لا يمكن لوم الناس على الاتجاه نحو الفضاء الرقمي والعمل الإعلامي، لكن من المتوقع أنه بمجرد انفتاح الفضاء العام في مصر، سواء بسبب الأزمة الاقتصادية أو تحرك المجتمع بشكل مستقل، ستعود الحركة الاجتماعية والسياسية بشكل أقوى، وسيصبح من الممكن تقييم المبادرات المتاحة والعمل على استعادة دور السياسة على الأرض.
لكن، فتح المجال السياسي العام، أظن أنه لن يأتي في أي وقت من الأوقات بإرادة السُلطوية، بل يحتاج إلى تراكمات من الفعل السياسي الجاد المُترابط بين الداخل والخارج. لكن، نأخذ رواية جدلية أُخرى، حيال أن كثيرا ما يُوصف المجتمع المصري اليوم بأنه منهك، مفكك، ويفتقر إلى الأطر والتنظيمات الوسيطة. في رأيك، من يتحمل المسؤولية الأكبر عن هذا الوضع؟ هل هي قيادات التنظيمات السياسية، والمثقفين في كافة مجالاتهم؟ أم القمع السلطوي الممتد؟
في النهاية، كل ما سبق من أسئلة وإجابات صحيح جزئيًا، لكن المسؤول الأول والأكبر عن الوضع في مصر هو القمع السلطوي. مهما اختلفت مع القيادات السياسية أو المثقفين، سواء اليسار أو غيره، فإن الدولة هي المسؤولة الأولى، لأنها التي تمتلك السجون والسلاح والأمن المركزي والدبابات والطائرات والمدافع، وهي التي تتحكم في مفاصل الدولة بالكامل. أما المسؤول الثاني، فهم القيادات السياسية والمثقفون بدرجات متفاوتة، فاليسار المصري، ممثلاً بشخصيات مثل رفعت السعيد، كان له دور في قيادة التنظيمات، ومع ذلك فإن تلك القيادات ارتكبت أخطاء ومواقف خاطئة في أوقات مختلفة. وبالمثل، الإسلاميون، سواء القيادات الراديكالية أو المعتدلة، لعبوا أدوارًا مختلفة، بعضهم تحالف مع النظام في أوقات معينة بينما البعض الآخر احتفظ بموقف مستقل، لكن في المقابل كانت هناك أعمال عنف من بعض الفصائل تجاه المدنيين، مثل الهجمات على أقباط أو محلات، وهو ما ساهم في توحش الدولة في التسعينيات.
القطاع الراديكالي من الإسلاميين كان يعبر عن سخط شديد على عنف الدولة، لكنه كان يوجّه جزءًا من هذا العنف باتجاه أهداف غير مبررة، بينما الإخوان، كجماعة إصلاحية غير ثورية، كان لديها استعداد للتنسيق مع النظام أحيانًا، وخلال 2011-2012 كان بعض قياداتها متحالفة مع المجلس العسكري في محاولة لتصفية الثورة جزئيًا. هذا لا ينفي وجود تباين داخل قواعد الحركة الإسلامية، أو أن بعضهم شارك في أحداث الثورة أو كان على خلاف معها. بالمقابل، معظم قيادات اليسار، تصرفت بشكل متباين بعد الانقلاب، وأحيانًا دعمت ما حدث، مما يعكس مسؤوليتها أيضًا، لكنها لا تعادل حجم المسؤولية الأكبر الذي يتحمله النظام نفسه.
وماذا إن كان هناك أيضًا حدودًا بنيوية داخل المجتمع نفسه حالت دون تطور مطالب أكثر تنظيما واستدامة؟
هناك أيضًا حديث عن حدود بنيوية داخل المجتمع، ولكنني لست مقتنعًا بأن هذه الحدود هي السبب الرئيس في الأزمة. بعض الليبراليين أو اليساريين حاولوا تبرير فشلهم بالقول إن الشعب لا يعرف مصالحه، وأنه سيختار الفاشيين أو الظلاميين في الانتخابات، لكن هذا تعميم غير دقيق. كل شخص يعرف مصالحه الشخصية وكيفية تسيير حياته وأسرته وفق إمكانياته، لكن المشكلة تكمن في غياب القدرة على تحويل هذه المصلحة الفردية إلى مصلحة عامة أو سياسات فعالة على مستوى الدولة. هذه الحدود الاجتماعية أو الاقتصادية لا تلغي المسؤولية الكبرى للدولة ولا المسؤولية الجزئية للقيادات السياسية، لكنها توضح مدى تعقيد الواقع الذي تعمل فيه المعارضة والمجتمع المدني في مصر.
هل يمكن توصيف نظام عبد الفتاح السيسي بوصفه شكلاً من “الديكتاتورية الثورية” التي نجحت في الانقلاب على جميع الفاعلين، وأعادت بناء كيانها المستقل على المستويات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية؟ أم أن هذا الوصف يحمل قدرا من المبالغة النظرية؟
نظام عبد الفتاح السيسي لا يمكن اعتباره “ديكتاتورية ثورية”. الديكتاتورية الثورية، تاريخيًا، ترتبط بنخبة ثورية تمركز السلطة مؤقتًا بين يديها بزعم حماية الثورة وأهدافها، وغالبًا ما تتخذ إجراءات جذرية، بعضها قمعي، في لحظات تراجع أو تهديد. الأمثلة على ذلك كثيرة، من بينها اليعاقبة في الثورة الفرنسية، حيث قامت فئة من الثوار بتركيز السلطات لحماية المسار الثوري في لحظة حرجة، حتى وإن انتهت التجربة في النهاية على نحو مأساوي. هذا النموذج لا ينطبق على نظام السيسي، الذي هو نظام ديكتاتوري خالص وليس امتدادًا لأي مشروع ثوري.
دعني أوضح أكثر، في بداياته، قام نظام السيسي على مقامرة سياسية كبيرة، تمثلت في حشد الشارع لإنهاء المظاهرات، وتعبئة قطاعات من المعارضة الاجتماعية والسياسية للقضاء على المعارضة نفسها. هذا النمط ليس استثناءً، بل يتكرر تاريخيًا في لحظات الثورة المضادة. انقلاب بينوشيه في تشيلي (1973)، على سبيل المثال، لم يكن مجرد تدخل عسكري معزول، بل سبقه حشد وتعبئة من قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى، ساهمت في زعزعة حكم سلفادور أليندي ووفرت الغطاء الشعبي للانقلاب.
دعنا نتذكر، أيضا، أنه عبر تاريخ الثورات في القرنين العشرين والحادي والعشرين، كثيرًا ما نشأت تعبئة مضادة للثورة أفرزت لاحقًا أنظمة ديكتاتورية عسكرية أكثر قمعًا من الأنظمة التي سبقتها. خذ مثلًا الثورة الألمانية عام 1918، التي اندلعت في التوقيت نفسه تقريبًا مع الثورة البلشفية. ما هزم الثورة الألمانية لم يكن فقط ضعفها الداخلي، بل أيضًا صعود ميليشيات “الفرايكور”، وهي حشود يمينية متطرفة قمعت اليسار والحركات الاجتماعية، وكانت النواة التي خرجت منها لاحقًا كوادر الحزب النازي. هنا، لا يعود النظام المنتصر إلى ما كان عليه قبل الثورة، بل يولد نظام جديد أكثر توحشًا، يحاول من وجهة نظره تفادي أخطاء الماضي. من هذا المنطلق، فإن نظام السيسي هو نظام ثورة مضادة، وليس ديكتاتورية ثورية.
لماذا لم يعود نظام مبارك بعد الانقلاب؟ لماذا اختار السيسي صناعة نخب حكم جديدة، وإن كانت رديئة على مستويات عدة مقارنة بنخب سُلطوية مبارك؟
البعض كان يعتقد أن الانقلاب سيعيد إنتاج نظام مبارك، لكن من وجهة نظر السيسي والدائرة التي قادت الانقلاب، فإن نظام مبارك فشل. هذا لأنه سمح بما اعتبروه “مهزلة” 2011. المطلوب كان نظامًا جديدًا، بلا توازنات، بلا حزب حاكم يتفاوض، بلا برلمان يساوم المعارضة، بلا مجتمع مدني، وبلا معارضة سياسية من الأساس. لم يعد الأمر مقتصرًا على الأذرع القمعية التقليدية للدولة، مثل الجيش والشرطة والمخابرات، بل أصبحت هذه الأجهزة هي التي تشرف وتدير باقي مؤسسات الدولة والمجتمع بشكل مباشر.
بكل وضوح، يمكن ملاحظة ذلك إذا نظرت إلى الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وتأملت صور الاجتماعات: ستجد أن الأجهزة السيادية حاضرة في كل تفصيلة، وأن ما يُدار ليس فقط الحكم، بل المجتمع نفسه، عبر منظومة شاملة من السيطرة، لا تترك مجالًا لسياسة أو وساطة أو حتى هامش حركة مستقل.
إذن، يمكننا فهم، وهذا ما كنت أقصده، أن سُلطوية السيسي هي “ديكتاتورية ثورية”، أي انتصرت على المُجتمع، بفعل قمعي ثوري، لا ديكتاتورية ثورية بمعنى أن لديها مشروع تحرّري مثل عسكريات أُخرى، مثلا، ديكتاتورية الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر.
من هنا، وعلى سيرة المُجتمع، يمكن أن ننتقل قليلا إلى جدلية “جيل زد” ودوره السياسي، في ظل صعود المنصات المرئية وثقافة المشاهدات. أخبرنا، كيف تنظر إلى الخطابات التي يطرحها بعض شباب هذا الجيل؟ وهل تعتقد أن حضورهم الإعلامي يعكس وزنًا سياسيًا حقيقيًا، أم أنه تضخيم ناتج عن طبيعة المنصات؟ وكيف تقارن ذلك بأجيال شاركت في ثورة يناير وما تلاها، رغم إخفاقاتها؟ هل تقول لهذا الجيل شيء. ليست نصيحة، بل خطاب مختصر جدًا.
أرى أن هناك قدرًا من المغالطة في طريقة تناول هذا الموضوع، بشكله العام. إذا عدنا إلى 2011 سنجد أن الشباب الذين قادوا الثورة آنذاك هم أنفسهم ما يمكن تسميته اليوم بجيل “زد” في لحظته التاريخية. في كل تجربة تغيير حقيقي، في أي بلد، يكون الشباب هم رأس الحربة دائمًا. لم يحدث في التاريخ أن قامت ثورة يقودها كبار السن؛ من ينزل إلى الشارع، ويواجه قوات الأمن، ويتحمل العنف، ويجري بين الميادين، ويتعرض للغاز والقنابل ويعيد قذفها، هم الشباب بطبيعة الحال، وليس من تجاوزوا الستين أو السبعين من العمر. لذلك، بغض النظر عن المسميات، سيظل الشباب هم في الصدارة في أي انفجار اجتماعي أو سياسي.
أيضا، أرى أن ما يميز الجيل الجديد، اليوم، أو ما يُطلق عليه “جيل زد”، هو امتلاكه مهارات تكنولوجية لم تكن متاحة بنفس الشكل للأجيال السابقة. هؤلاء نشأوا في عالم رقمي، وهم ما يُعرفون بـ”المواطنين الرقميين”، يتعاملون مع التكنولوجيا وتدفق المعلومات بسلاسة عالية. في سنوات 2007 و2008 و2009، كنّا نُنظم ورش عمل للمدونين والنشطاء لتعليم العمال أو المعارضين أو حتى المحامين كيفية استخدام تويتر، أو فتح بريد إلكتروني، أو إنشاء مدونة. أما اليوم، فالطفل منذ سنواته الأولى يحمل الهاتف ويتعامل معه بشكل طبيعي، ولديه حسابات على تيك توك وإنستغرام، ويستخدم واتساب للتواصل اليومي، دون أي تدريب أو وسيط.
طب وماذا عنهم، وعن فضاءاتهم الرقمية، بمنظور نقدي؟
هذا الواقع، في الفضاء المرئي، خلق حالة من السيولة العالية في الحركة والتواصل والتنظيم المحتمل، وهي ميزة حقيقية مقارنة بالماضي، لكنه في الوقت نفسه يحمل مشكلاته وحدوده، فكل تطور تقني يصاحبه شكل من القصور أو التحديات، سواء على مستوى الاستمرارية أو التنظيم أو ترابط وتحويل هذا الحضور الرقمي إلى فعل جماعي منظم على الأرض.
مرة أُخرى، نعود إلى يناير، مع مرور السنوات وتكرار الذكريات، يبدو أن استدعاء ثورة يناير بات خافتًا، وأحيانًا يأتي فقط عبر خطاب السلطة نفسها (حديث السيسي الدائم والنقدي عنها). بعيدًا عن الشعارات والحنين، برأيك، ما الذي تبقى فعلًا من ثورة يناير في الوعي السياسي والاجتماعي المصري؟
حيال استدعاء صورة يناير، والثورة، فلا أستطيع القول إنها باتت خافتة على نحو قاطع. نحن نتحدث عن مجتمع يضم نحو مئة مليون إنسان، ومن الصعب إطلاق حكم عام حول ما إذا كانت هذه الصورة قد تراجعت أو ما زالت حاضرة. في تجربتي الشخصية، وعبر المتابعة على الفضاء الرقمي، ألاحظ أنه في محطات بعينها مرتبطة بالذاكرة الجماعية—مثل 25 يناير، و28 يناير، وأحداث محمد محمود، ورابعة—يظهر اهتمام واضح، خاصة في ظل تراجع شعبية النظام الحالي. بعض الناس يحنّ إلى أيام مبارك، وآخرون يحنّون إلى 2011، وهناك من يستدعي لحظات أخرى من الماضي القريب، بحسب موقعه الاجتماعي وخلفيته السياسية.
هناك أيضًا جيل جديد، هو الجيل الذي كان رضيعًا أو طفلًا صغيرًا وقت الثورة، وربما لم يعشها مباشرة. هذا الجيل يتعرف على يناير عبر يوتيوب وإنستغرام وتيك توك، حيث تبدو له مشاهد الثورة أقرب إلى الخيال العلمي مقارنة بالواقع القائم، اليوم، ما تبقى من يناير في الوعي السياسي والاجتماعي المصري يصعب اختزاله في إجابة واحدة، لأنه يختلف من طبقة إلى أخرى، ومن قطاع اجتماعي إلى آخر، ويتباين بشدة بحسب الخلفيات السياسية والثقافية. لذلك، فإن التعميمات الواسعة حول “وعي المجتمع المصري” غالبًا ما تكون مضللة، أو على الأقل مُجتزأة، لأن هذا المجتمع ليس كتلة واحدة، بل فسيفساء معقدة من المصالح والتجارب والرؤى.
ومع ذلك، يمكن ملاحظة أن أثر يناير لم يختفِ تمامًا، بل يظهر في لحظات معينة، خاصة في اتساع سقف الحديث عن التابوهات الاجتماعية والسياسية. يناير لعبت دورًا مهمًا في كسر محرمات تتعلق بحقوق المرأة، والجندر، والحريات العامة، وفتحت مساحة رمزية للكلام لم تُغلق بالكامل. ظهر ذلك بوضوح عندما فُتحت الميادين لبضع لحظات في أكتوبر عام 2023، حيث عادت الشعارات نفسها: «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، وكأن الذاكرة الجمعية كانت تنتظر مجرد فرصة لتستدعي لغتها القديمة.
حقيقة، أرى أن الناس تحتاج إلى فرصة لاستعادة يناير، لا بوصفها حنينًا أو شعارات، بل كتجربة سياسية واجتماعية مكتملة. صحيح أن الانقلاب هزم ثورة يناير على المستوى السياسي والتنظيمي، لكنه لم يمحُ وجودها من الوعي أو الذاكرة، ولم يُنهِ الأسئلة التي طرحتها، والتي ما زالت كامنة وتنتظر لحظة تاريخية جديدة لتعود إلى السطح.
سؤال آخير إلى أن تجمعنا نقاشات أُخرى، مع سياق أكثر شمولًا في منطقتنا العربية، بعد نحو خمسة عشر عامًا على الثورة، هل يمكن القول إن مصر—وربما المنطقة بأسرها—دخلت زمنًا سياسيًا مختلفًا، وخصوصًا بعد حرب الإبادة على غزة، تحكمه معادلات تفضّل “استقرار” السلطوية القمعية على مغامرة التغيير؟ وكيف يمكن فهم تراجع خطاب الإصلاح والانتقال الديمقراطي في هذا السياق، في ظل كلفة القمع العالية؟ وما نظرتك المستقبل حيال هذا الاستقرار؟
لا أعتقد ذلك. لو كنا بالفعل في هذا الزمن المستقر سلطويًا، لما كان النظام مضطرًا إلى بناء المزيد من السجون، أو توسيع القبضة الأمنية بهذا الشكل، أو السماح بتوحش الشرطة والأمن الوطني في كل تفاصيل الحياة، أو إغلاق أي هامش حتى لو شكلي—في الانتخابات أو المجال العام. سلوكيات نظام عبد الفتاح السيسي هي سلوكيات نظام مذعور، نظام يشعر بأن أي قدر بسيط من التراخي قد يعيد إنتاج ما حدث في 2011. وقد رأينا شذرات من هذا الخوف في أكتوبر 2023، وقبلها في ما سُمّي بـ”هوجة محمد علي” في سبتمبر 2019 و2020، حين خرج الناس لمجرد شعورهم بأن هناك احتمالًا—حتى لو ضعيفًا—لسقوط النظام، أو أن الدولة قد لا تكون قادرة على القمع الكامل. ولو لم يكن القمع عنيفًا وسريعًا في تلك اللحظات، لكانت هذه التحركات انتشرت على نطاق أوسع.
هذا الحديث، نصبح أمام جدلية معقدة ومفرغة أيضًا، بمعنى، أن بناء كل مقومات القمع في يد السُلطوية، واستمرار هذه الحالة لسنوات كثيرة، تُصبح حالة اعتيادية يألفها الناس والمُجتمع، وتألفها أكثر عقلية السُلطوية، فيصبح القمع هو أداة حكم طبيعية غير استثنائية. لكن، النقاش حول هذه النقطة، وخصوصا مع تغيرات المشهد الإقليمي بعد السابع من أكتوبر، وزيادة الهيمنة الإسرائيلية/الأميركية على المنطقة، طويل جدا، نأجله لحوار آخر..
في نهاية حديثنا، أخبرني، أو قل لي أي كلمات عن الثورة، بشكلها المُجرّد، بمناسبة ذكرى ثورة يناير المُجرّدة..
في النهاية، أود أن أقول أن الثورات ليست خيارًا يوميًا أو سلوكًا اعتياديًا للشعوب، بل هي الخيار الأخير. لا يوجد ما يسمى بشعب ثوري بطبيعته أو شعب خامل ومنبطح إلى الأبد. نحن نعيش في عالم يجعل الفرد يشعر دائمًا أنه وحيد، وأن أي تحرك فردي سيجعله يبدو كالمجنون الوحيد في مواجهة منظومة ضخمة من القهر والظلم والتفاوت الطبقي والاستبداد السياسي. لكن من غير الممكن أن يستمر هذا الوضع إلى الأبد. كما يقول كارل ماركس، الأفكار السائدة في أي مجتمع هي أفكار الطبقة السائدة؛ لا أنا ولا أنت نملك الإعلام، ولا نضع مناهج التعليم، ولا نملك المطابع أو أدوات إنتاج الوعي. حتى الإنترنت، رغم أنه وفر هامشًا نسبيًا، يظل خاضعًا لسيطرة شركات كبرى ومنصات يملكها أشخاص مثل بيزوس وماسك وزوكربيرغ. ومع ذلك، يبقى هناك هامش محدود يسمح بالتواصل وتبادل الأفكار، لكنه لا يلغي هيمنة البنيوية القائمة.
في ظل هذا الواقع، من الطبيعي أن يفضل الناس الخيارات الأسهل والأكثر أمانًا، ولا ينكسر هذا المنطق إلا في اللحظات الاستثنائية من تاريخ الشعوب، لحظات الثورات. هذه ليست حالة مصر وحدها، ولا العالم العربي فقط، بل هي قاعدة عامة: لحظات نادرة تُكسر فيها هيمنة الطبقة الحاكمة، وتشعر فيها الناس بقوتها الجمعية، وتنزل إلى الشارع، وتبدأ في الفعل الجماعي لتحسين أوضاعها أو تغيير المجتمع تغييرًا جذريًا. السؤال الدائم هو: ما الذي يقود إلى هذه اللحظات؟ هنا تتعدد النظريات.
إحدى هذه النظريات هي نظرية “تزايد التوقعات”، التي تقول إن الثورات لا تندلع بالضرورة عندما تنهار الأوضاع الاقتصادية تمامًا، بل عندما تتحسن نسبيًا، فتسبق تطلعات الناس وتوقعاتهم معدل التحسن الفعلي، فينشأ التوتر الذي يفجر الغضب. هذه النظرية تفسر بعض الحالات، لكنها لا تفسر كل شيء. في حالة مصر، ما حدث في 2011 لم يكن وليد لحظة واحدة، بل نتيجة تراكم استمر سنوات. في عام 2000، كان من الممكن أن يتجنب النشطاء أنفسهم شخص لمجرد الهتاف ضد مبارك نتيجة للرعب الشديد، وبعدها بأربع سنوات كنا نتحرك في إطار حركة “كفاية”. كنا ننزل الشارع، نواجه، ننتزع هامشًا صغيرًا، ثم نتحرك داخل هذا الهامش ونبني عليه. معارك صغيرة تتراكم فوق بعضها، شبكات تتشكل، معرفة متبادلة بين نشطاء في القاهرة ودمياط والإسكندرية وأسيوط والفيوم، تضامن يتوسع، وأخبار تنتشر عبر الفضائيات مثل الجزيرة، وإضرابات عمالية تمتد من مصنع إلى آخر. هكذا تنتشر الحركة، لا دفعة واحدة، بل عبر تراكم بطيء، وشبكات، وتجارب مشتركة، إلى أن تصل في لحظة ما إلى الانفجار الكبير.