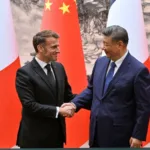لم تكن ثورة الخامس والعشرين من يناير حدثًا عابرًا في التاريخ المصري الحديث، بل شكلت زلزالًا سياسيًا واجتماعيًا أطاح خلال أيام قليلة بمسلمات راسخة حول السيطرة الأمنية وقدرة النظام على ضبط الشارع. وفي الوقت الذي فتحت فيه هذه اللحظة للمصريين أفقًا واسعة للحرية والعدالة، كشفت على نحو صادم للسلطة أن المجتمع قادر على كسر حاجز الخوف، والتنظيم الذاتي، وإرباك منظومة الحكم حتى في ظل أجهزة أمنية قوية.
منذ ذلك الحين، تعاملت الدولة العميقة مع ثورة يناير بوصفها اختبارًا قاسيًا أعاد تشكيل رؤيتها لطبيعة الحكم وحدود المجال العام. وبعد عام 2013 على وجه الخصوص، تحولت يناير إلى مرجعية حاكمة للتفكير الأمني والسياسي، وشرع السيسي في بناء منظومة حكم هدفها الأول والأساسي، كسر منطق “الميدان” قبل أن يتشكل وضمان ألا تتكرر يناير من جديد.
ولذا لم يكتفِ النظام بعد عام 2013 باستعادة أدوات السيطرة التقليدية، بل شرع في إعادة هندسة متكاملة لبنية الدولة والمجتمع، مستخلصًا دروس يناير عبر أربعة مستويات مترابطة: الأمن، والقانون، والإعلام، والمجتمع المدني.
على المستوى الأمني، أعاد النظام هيكلة أجهزته ووسع صلاحياتها، وأنشأ وحدات متخصصة في الرصد والتدخل السريع، مع دمج واسع للتكنولوجيا في منظومات المراقبة، بما سمح بالانتقال من منطق رد الفعل إلى الضبط الاستباقي. وعلى المستوى القانوني، سن حزمة من التشريعات المقيدة للتظاهر والعمل العام، مدعومة بآليات قضائية وأمنية تضمن سرعة الردع وتغليظ العقوبات.
أما في المجال الإعلامي، فقد شدد السيطرة على الإعلام التقليدي وضبط الفضاء الرقمي، وحجم وجرم أي خطاب قادر على التعبئة. وبالتوازي، أعاد هندسة المجتمع المدني من خلال منظومة متكاملة من التراخيص والرقابة تُبقي على الجمعيات المتوافقة مع أهداف النظام، وتقصي أو تحاصر المنظمات الحقوقية والسياسية المستقلة.
إن ما جرى بعد 2013 ليس عودة إلى ما قبل يناير 2011، بل نموذج جديد للحكم يقوم على أمننة المجال العام بالكامل، وتفكيك أدوات التنظيم المجتمعي، ومنع تشكل أي لحظة سياسية جماهيرية غير متحكم بها، إذ لم يسعَ النظام فقط إلى منع تكرار يناير 2011، بل إلى منع المجتمع من تخيلها أصلًا، جاعلًا من يناير دليلًا إرشاديًا حاضرًا في كل سياسات المنع والضبط وإعادة التصميم الشامل للدولة والمجتمع.
15 عامًا على يناير.. حين علت صيحات “الشعب يريد إسقاط النظام” في ميادين مصر إيذانًا بانطلاق الثورة المصرية. pic.twitter.com/QBkdalRf8G
— نون بوست (@NoonPost) January 25, 2026
تفكيك منطق يناير قبل أن يولد: كيف منع النظام تكرار الثورة؟
بعد ثورة يناير 2011، أدرك النظام أن السيطرة على الدولة والمجال العام لا يمكن أن تقوم فقط على القوة الأمنية التقليدية، بل تتطلب منظومة متكاملة للرصد والتدخل السريع، خاصة أن الاحتجاجات الجماهيرية أظهرت قدرة المجتمع على التنظيم الذاتي والتحدي المباشر للسلطة.
استندت استراتيجيات النظام بعد 2013 إلى هذا الدرس، فتم التركيز على مجالات رئيسية تشمل تأسيس مؤسسات أمنية جديدة، وتعديل صلاحيات الأجهزة القائمة، وتطوير وحدات متخصصة لرصد الاحتجاجات والتدخل السريع، مع دمج التكنولوجيا في منظومة الرقابة لمتابعة أي تحرك شعبي محتمل.
إلى جانب ذلك، سعى النظام إلى ضبط المجال العام عبر سن قوانين وإجراءات تحد من الحشد الجماهيري المفاجئ، وتعزز هيمنته على الإعلام، فضلًا عن احتكار أدوات التأثير السياسي، بهدف منع الجماهير أو أي فاعل سياسي من إعادة إنتاج تجربة يناير مرة أخرى. وفيما يلي أبرز الإجراءات والسياسات التي اعتمدها النظام استنادًا إلى دروس يناير:
توسع شركات الأمن الخاصة في ضبط الفضاء العام
أظهرت ثورة 25 يناير أن الاعتماد على الأجهزة الأمنية التقليدية وحدها لا يكفي، إذ لم تكن هذه الأجهزة قادرة على التنبؤ بالتحركات الجماهيرية أو السيطرة على الفضاء العام، ما كشف ثغرات جوهرية في منظومة الأمن التقليدية.
استجابة لذلك، شرع النظام بعد 2013 في تكثيف مراقبة الفضاء العام في المدن الكبرى، لا سيما الجامعات والأسواق والميادين، عبر السماح لشركات الأمن الخاصة بالعمل تحت إشراف وزارة الداخلية، مع منحها مرونة وصلاحيات محددة.
وقد شهدت مصر بعد عام 2013 توسعًا كبيرًا في شركات الأمن الخاصة، فقبل الثورة، كانت الدولة وحدها مسؤولة عن الأمن، لكن الضعف النسبي للشرطة بعد يناير دفع النظام إلى السماح بتسجيل نحو 250 شركة أمنية، مع إخضاع 50 منها للرقابة المباشرة من وزارة الداخلية.
وبرزت أسماء شركات عديدة تُدار بواسطة شخصيات ذوي خلفيات شرطية وعسكرية، وتم توظيف بعضها في التصدي للمظاهرات، ومن أبرز هذه الشركات شركة فالكون، التي توسع دورها ليشمل القضاء على المظاهرات في الجامعات، ضمن استراتيجية الدولة للاعتماد على أذرع أمنية مرنة.
لقد شكلت شركات الأمن الخاصة أحد المكونات المركزية في البنية الجديدة للسيطرة على الفضاء العام، إذ مكنت الدولة من توسيع نطاق المراقبة والضبط، خصوصًا في ساحات حساسة مثل الجامعات، وقد وفرت بالفعل أذرعًا أمنية مرنة في مهام الضبط اليومي والتدخل السريع.
توسع هائل في صلاحيات الأجهزة الأمنية
بعد عام 2013، لم تقتصر إعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسسي لعمل الأجهزة الأمنية على النصوص والتشريعات وحدها، بل ترافقت مع خطاب سياسي صريح وفر غطاءً مباشرًا لاستخدام القوة في الشارع. ففي موازاة توسيع صلاحيات الضباط ميدانيًا، ومنحهم سلطات أوسع في التفتيش والضبط والاعتقال، جرى تقليص فعلي لآليات المساءلة القضائية أثناء فض التظاهرات.
وقد تُرجم هذا التوجه بوضوح في تصريحات علنية للسيسي، أكد فيها أن الضباط الذين يستخدمون الغاز أو الخرطوش خلال التعامل مع الاحتجاجات، حتى لو أسفر ذلك عن إصابات أو وفيات، لن يتعرضوا للمحاسبة.
تجسدت هذه التوسعات قانونيًا في قانون تنظيم التظاهر رقم 107، الذي منح أجهزة الأمن سلطة واسعة لحظر التجمعات وتفريقها بالقوة، حتى لو كانت سلمية، فيما عززت تشريعات لاحقة قدرات الأجهزة على المراقبة والرصد والتدخل والاحتجاز.
وفي يوليو/تموز 2018، أقر البرلمان قانونًا منح ضباط القوات المسلحة حصانة عن الأفعال التي ارتُكبت خلال فترات سابقة، كما قيد إمكانية ملاحقتهم جنائيًا في المستقبل، ووفر لهم مظلة حماية تصل إلى الحصانة أثناء سفرهم إلى الخارج.
وبذلك أصبحت توسعة صلاحيات الأجهزة الأمنية ركيزة أساسية في استراتيجية ما بعد 2013 لمنع تكرار سيناريو يناير، لتتحول هذه الإجراءات إلى منظومة متكاملة تجمع بين التشريع، والممارسة الميدانية، والخطاب السياسي للنظام.
إعادة تشكيل الجيش
منذ استيلائه على السلطة، سعى عبد الفتاح السيسي إلى إحكام السيطرة على القوات المسلحة وإعادة هيكلتها، مستخلصًا درسًا مركزيًا من عام 2011، حين لم يقف الجيش إلى جانب رأس النظام بقدر ما انحاز إلى الحفاظ على النظام العسكري ذاته.
وانطلاقًا من هذا الدرس، سعى السيسي إلى إعادة ضبط موازين القوة داخل المؤسسة العسكرية عبر تدوير القيادات، وتقليص فترات بقاء كبار القادة في المواقع الحساسة، إلى جانب إنشاء هيئة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش، وبالتالي حدت هذه الإجراءات من تشكل مراكز نفوذ وسدت الطريق أمام تكرار سيناريو مبارك.
وبالتوازي، عزز السيسي ارتباط الجيش المباشر ببنية الحكم من خلال توسيع دوره الاقتصادي، وربط مصالح قياداته واستثماراته ببقاء رأس النظام واستقراره. وبهذه السياسات، أُعيد دمج القوات المسلحة بشكل أوثق في منظومة الحكم، بوصفها ضامنًا مباشرًا لبقاء السيسي، لا فاعلًا يمكن أن يكرر ما فعله مع مبارك.

الضبط الاستباقي: تحديث المنظومة الأمنية
أظهرت تجربة ثورة يناير 2011 أن التحركات الجماهيرية قادرة على التوسع بسرعة غير متوقعة، بما يتجاوز قدرة الأجهزة الأمنية التقليدية على الاستجابة الفورية، هذا الإدراك دفع النظام بعد 2013، إلى تبني مقاربة أمنية جديدة تقوم على إنشاء وتطوير وحدات صغيرة ومتخصصة قادرة على التدخل السريع والانتشار المرن في أكثر من موقع خلال وقت قصير.
في هذا الإطار، جرى إنشاء وحدات شرطية خاصة صُممت للعمل بشكل استباقي، تجمع بين الرصد الميداني والتحليل الاستخباراتي لرصد إشارات الحشد قبل وقوعه، وتقدير حجم التجمعات ونقاط الضعف. وقد تجسدت هذه المقاربة عمليًا في نشر وحدات مثل قوات “بلاك كوبرا” وقوات الشرطة الخاصة في ميدان التحرير والمحافظات الرئيسية، مع خطط تدخل معدة مسبقًا لكل سيناريو محتمل.
وفي عام 2014، توسعت هذه الاستراتيجية بإنشاء وحدات قوات التدخل السريع ضمن هيكل الجيش، إلى جانب وحدات الانتشار السريع التابعة للداخلية، بهدف التصدي للاحتجاجات بكفاءة أعلى من يناير.
وتميزت هذه القوات بتدريبات متخصصة للتعامل مع احتجاجات الشارع، واستخدام عربات أخف من المدرعات التقليدية، ما منحها قدرة أكبر على المناورة في الشوارع الضيقة وسرعة أعلى في الاستجابة لأي تحرك مفاجئ.
أسهم هذا التحديث في بناء منظومة أمنية متكاملة تمزج بين الأجهزة التقليدية والوحدات المستحدثة، وتعتمد على الضبط الاستباقي والتدخل السريع لمنع توسع أي احتجاج قبل تحوله إلى حركة جماهيرية واسعة مثل يناير 2011.
غير أن هذا النموذج أفرز مفارقة واضحة في المجال العام، فالحضور الأمني المكثف في الميادين والشوارع لا يعكس رسوخ الاستقرار بقدر ما يشير إلى هشاشته، إذ إن الإفراط في الانتشار الأمني واستعراض القوة اليومية يعكسان قلقًا بنيويًا من تكرار سيناريو يناير، ومحاولة دائمة للسيطرة المسبقة على واقع قابل للاضطراب.
إحكام السيطرة على الإنترنت
بعد ثورة 25 يناير، أدرك النظام أن أساليب الرصد والتحليل التقليدية لم تعد قادرة على مواكبة التحولات التي أحدثها انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح الفضاء الرقمي ساحة مركزية للتنظيم والتعبئة وتداول المعلومات خارج نطاق السيطرة الأمنية المباشرة.
وفي هذا السياق، عززت السلطات بعد عام 2013 قدراتها على مراقبة النشاط الرقمي، عبر استخدام برمجيات وأنظمة متقدمة لرصد المحتوى الذي تنظر إليه باعتباره تحريضيًا أو مهددًا للأمن القومي. وأشار خبراء وتقارير متخصصة إلى أن وزارة الداخلية طورت وحدات وأنظمة مخصصة لمتابعة الشبكات الاجتماعية والمنصات الإعلامية، في إطار التحول نحو الضبط الاستباقي للمجال الرقمي.
دومه اتسأل فى التحقيق عن بوستات أذاعها عن بلاغ روفيده حمدى بشأن التعدى على زوجها محمد عادل فى سجن العاشر، ونشر مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعى كان بيشرح فيه بلاغ روفيده على لسان محمد عادل.
لكن كمان اتسأل عن مقطع نشره لواحد اسمه ناجى الشهابى، بيقولوا انه عضو معين بقرار رئيس… pic.twitter.com/aymWCOk89s
— Khaled Ali (@Khaledali251) January 20, 2026
وبالتوازي مع تطوير أدوات المراقبة، اتجه النظام إلى سياسة أكثر مباشرة لإحكام السيطرة على الفضاء الإلكتروني، تمثلت في حجب المواقع، فمنذ منتصف عام 2017، شن النظام حملة واسعة لحظر مئات المواقع الإلكترونية، شملت منصات إخبارية وصحفية مستقلة ومواقع حقوقية.
ووفقًا لتقارير دولية، بلغ عدد المواقع المحجوبة مئات المواقع، في إطار سياسة هدفت إلى تقليص تداول المعلومات المستقلة والحد من استخدام الفضاء الرقمي كمنصة للتعبئة. وبذلك، أصبح ضبط المجال الرقمي بعد 2013 جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية أوسع لإعادة هندسة المجال العام.
شرعنة القمع بالقانون
أظهرت احتجاجات يناير 2011 أن عشرات الآلاف قادرون على التحرك في القاهرة والمحافظات، وأن حق التظاهر يمكن أن يتحول إلى أداة ضغط فعالة على النظام، وهو ما دفع السلطة إلى استنتاج أن السيطرة الأمنية وحدها غير كافية لضبط الشارع أو منع تكرار المفاجأة.
وانطلاقًا من هذا الإدراك، شرع النظام بعد عام 2013 في بناء إطار قانوني صارم يسبق الفعل الاحتجاجي ويقيده قبل وقوعه، فتم سن حزمة من القوانين المقيدة التي حولت الاحتجاج من حق إلى مخاطرة قانونية عالية الكلفة، وأفرغت المجال العام من أي إمكانية للحشد، حتى في صورته الرمزية.
تجسدت هذه المقاربة بوضوح في قانون تنظيم التظاهر رقم 107، الذي فرض قيودًا مشددة على تنظيم المظاهرات، من بينها اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة من السلطات، وتحديد مسارات وأماكن بعينها للتظاهر، وتجريم أي تجمع دون تصريح، وفرض عقوبات مالية وجنائية على المخالفين.
وبالتوازي مع ذلك، طور النظام منظومة ردع قانونية وقضائية متكاملة، شملت إلى جانب قانون التظاهر قوانين الإرهاب والجرائم الإلكترونية، بحيث لا يقتصر الضبط على المنع القانوني، بل يمتد إلى خلق مناخ عام من الرهبة وعدم اليقين.
وقد تحقق ذلك عبر التوسع في الحبس الاحتياطي وتمديد فترة الحبس الاحتياطي لفترات طويلة تصل إلى سنين، لا سيما في القضايا ذات الطابع السياسي. وفي هذا السياق، تم تأسيس تنسيق أمني قضائي بين الشرطة وأجهزة المخابرات والنيابة العامة، وبهذا لم يعتمد النظام على القوة الأمنية وحدها، بل وظف الإطار القانوني وأنشأ مؤسسات قضائية جديدة لضبط المجتمع المدني وكسر منطق يناير.
إخضاع المجتمع المدني والمجال العام
أظهرت ثورة يناير 2011 أن المجتمع المدني، بما يشمله من جمعيات وروابط ونقابات وفضاءات شبابية، يمكن أن يتحول إلى أداة فعالة للحشد الجماهيري وتحويل السخط الاجتماعي إلى فعل منظم. هذا الإدراك دفع النظام بعد 2013، إلى اعتبار المجتمع المتماسك خطرًا، ولذا تدخل لإعادة ضبطه وتفكيك قدرته على التنظيم.
انطلقت هذه السياسة عبر فرض منظومة قانونية وإدارية صارمة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تقوم على الترخيص المسبق، وتعدد الموافقات الأمنية، والرقابة الدقيقة على مصادر التمويل الداخلي والخارجي، مع حصر النشاط المدني في أطر خدمية ضيقة، ومنع أي انخراط سياسي مباشر أو غير مباشر.
بالتوازي، أُعيدت هندسة مؤسسات المجال العام، بما في ذلك النقابات المهنية، والجامعات، والروابط الطلابية، والأحزاب، لضمان ضبطها وتقليص استقلالها، وحصر أدوارها ضمن مساحات لا تسمح بالحشد أو إنتاج خطاب سياسي مستقل.
لقد شهدت مصر تقلصًا في المساحات المتاحة للمجتمع المدني، وتمت مداهمة ومصادرة العديد من الجمعيات الخيرية الإسلامية والجمعيات المدنية، اختفت الحركات الاجتماعية، وفككت معظم الأحزاب التي خرجت من رحم يناير، وسحقت النقابات، مع غياب محاكم مستقلة أو إشراف برلماني حقيقي، ما أدى إلى هدم كامل للمجتمع المدني.
وفي موازاة سياسات التفكيك والمنع، اتجه النظام إلى تنظيم ورعاية مجموعات شبابية موالية في الداخل والخارج، باعتبارها أداة تعبئة مضادة وذراعًا للدعم السياسي، وجرى دمج قطاعات من الشباب في كيانات تُدار تحت إشراف مباشر من النظام.
وعلى المستوى الاجتماعي الأوسع، رافقت هذه السياسات إدارة مقصودة لحالات الاستقطاب والانقسام داخل المجتمع عبر الإبقاء على خطوط التوتر بين فئات مختلفة (علماني/إسلامي، سلفي/صوفي، إخوان/جيش)، والأسوأ من ذلك إغراق المواطنين في الأزمات المعيشية المتلاحقة والقلق اليومي، وإزاحة الهم العام من المجال السياسي إلى دائرة البقاء الاقتصادي.
أسفرت هذه الاستراتيجيات مجتمعة عن تحويل المجال العام من مساحة للتفاعل والتنظيم إلى مجال مُجزأ ومراقَب ومنزوع القدرة على التعبئة الجماهيرية. ولم يكن ما بعد 2013 مجرد عودة إلى أنماط السيطرة التقليدية، بل إعادة تصميم شاملة للمجتمع المدني والمجال العام، استندت إلى درس مركزي كشفته ثورة يناير، وهو أن المجتمع المنظم خطر، أما المجتمع المنقسم والمستنزف، فقابل للسيطرة والضبط.
إخضاع الوعي العام عبر إعادة هندسة الإعلام
بعد ثورة يناير 2011، أدرك النظام أن التهديد لا يقتصر على الشارع وحده، بل يشمل الدور المحوري للإعلام في التعبئة وكسر احتكار السردية الرسمية. وانطلاقًا من هذا الدرس، تبنت السلطة بعد 2013 استراتيجيات شاملة لإعادة ضبط المجال الإعلامي.
قبل عام 2013، كان المشهد الإعلامي المصري يضم نحو 142 صحيفة، إلا أن سياسات السيطرة بعد 2013 أدت إلى تقلص هذا العدد بشكل كبير، فتم إغلاق حوالي 40% من الصحف، ليصبح العدد الإجمالي 76 صحيفة فقط، وفي المقابل، أُغلقت 19 قناة تلفزيونية.
على المستوى التقليدي، شُددت الرقابة على وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة، فيما أُعيدت هيكلة المؤسسات الإعلامية لضمان انحيازها لخطاب السلطة. كما عمل النظام على تقييد أي استقلالية للإعلام الخاص، عبر صفقات استحواذ لشركات وأفراد محسوبين عليه، ليصبح المشهد الإعلامي بأغلبه تحت نفوذ مباشر أو غير مباشر للنظام.
ويكتسب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دلالة خاصة بوصفه أداة مؤسسية مركزية في ضبط المجال الإعلامي، إذ إن رئيس المجلس يُعين بقرار مباشر من رئيس الجمهورية، بما ينزع عنه أي استقلال فعلي.
بالتوازي، أولى النظام اهتمامًا خاصًا بالإعلام الرقمي، بعدما أثبتت يناير أن الفضاء الإلكتروني كان قلب الثورة النابض، لذلك فرض رقابة قانونية وأمنية مشددة لحظر أو تقييد المنصات الالكترونية التي تنتقد سياسات النظام. كما اعتمد النظام على دعم شخصيات وصناع محتوى على منصات التواصل الاجتماعي لترويج السردية الرسمية والدفاع عن السياسات الحكومية.
إضافة إلى ذلك، لجأ النظام إلى الدراما والسينما والبرامج الإعلامية كأداة مركزية لإعادة تشكيل الوعي العام وترسيخ السردية الرسمية، كما يظهر جليًا في مسلسلات مثل “الاختيار”، التي قدمت صورة أحادية للصراع السياسي والأمني، إذ تُبرز الجيش والأجهزة الأمنية كبطل حامي للوطن، بينما تُصور خصومها باعتبارهم تهديدًا وجوديًا للأمن والاستقرار.
وقد أُعيد تأطير أحداث يناير و30 يونيو بحيث صورت يناير على أنها فوضى ومؤامرة، فيما قدمت 30 يونيو باعتبارها تصحيحًا، مع تشويه رموز يناير ومحو أثر ثورة يناير الرمزي والسياسي من المناهج والفضاء العام. ومن ثم بعد 2013، نسج النظام من التلفزيون إلى منصات التواصل، ومن الدراما والسينما إلى المناهج الدراسية، سردية موحدة، ليصبح الإعلام أداة مركزية لضبط المجال العام ومنع أي خطاب بديل.
نختم بالقول إن النظام بعد 2013 لم يسعَ لمعالجة مسببات ثورة يناير، بل ركز على بناء دولة ضد يناير، وشرع في إعادة تصميم شاملة للدولة والمجتمع. تحولت يناير إلى مرجعية دائمة في كل قانون أمني، وكل إعادة هيكلة، وكل خطاب عن الاستقرار الذي لم يُبنَ على معالجة جذور الأزمة، بل على تفكيك أدوات التنظيم والحشد الجماهيري، واستبدال التوافق الاجتماعي بالسيطرة والتحكم.
ويبقى السؤال المركزي معلقًا: هل يمكن لهذه المنظومة أن تصمد طويلًا دون سياسات حقيقية لمعالجة مطالب المجتمع؟ فالنظام أغلق نافذة يناير، لكنه لم يفتح بعد أي أفق لما بعدها.