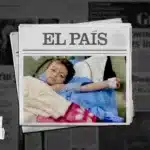يشهد الخطاب العام تحولات جذرية في المفاهيم، حيث تتجاوز المصطلحات التقليدية معانيها لتكتسب أبعادًا جديدة تعكس واقعًا سياسيًا واجتماعيًا متأزمًا، من بينها، برز مصطلح “أبناء المحسوبية” (Nepo Kids)، الذي تحول من مجرد توصيف لظاهرة في عالم الترفيه إلى رمزٍ مريرٍ للفساد السياسي واللامساواة الاقتصادية، إذ يشير المصطلح إلى أبناء الشخصيات السياسية والنافذة الذين ينعمون بنمط حياة مترف يتجسد في التعليم الأجنبي المرموق، والسيارات الفاخرة، والرحلات السياحية الباذخة، من دون أن يقدموا أي تفسير لمصدر هذا الثراء الفاحش.
إن استعارة هذا المصطلح من سياقه الأصلي وتطبيقه على السياق السياسي والاجتماعي يعكس إدراكًا عميقًا لدى الجماهير بأن السلطة السياسية والشهرة قد تداخلا، وأصبح كلاهما مصدرًا لثروات غير مكتسبة أو مبررة، فيما يبدو الغضب المتأجج ليس مجرد رد فعل على الثراء بحد ذاته، بل هو احتجاج على المصدر المزعوم لهذا الثراء: الفساد المالي، وسرقة المال العام، والخيانة الصريحة للثقة العامة.
هذه الظاهرة، التي تبلورت في العصر الرقمي، أصبحت تتجاوز الحدود الجغرافية، وتجسد الأبعاد المتعددة للأزمة المعاصرة التي تتداخل فيها الأزمات الاقتصادية مع غياب الشفافية، لتخلق حالة من السخط الشعبي تجد في ترف أبناء النخب الفاسدة تجسيدًا ماديًا لمظلوميتها. من هنا، نحاول تفكيك هذه الظاهرة من خلال تسليط الضوء على ما حدث في نيبال، واستدعاء سوابق تاريخية مماثلة مثل الثورة الفرنسية وانتفاضات “الخبز” في مصر وتونس والسودان، وصولًا إلى تأطيرها ضمن النظريات المعاصرة للاقتصاد السياسي لفهم أبعادها العميقة.
نيبال: عن تصادم الترف مع الإحباط الشعبي
شهدت نيبال في الأيام الماضية واحدة من أشد الانتفاضات عنفًا في تاريخها الحديث، حيث تحول غضب شعبي مكتوم إلى حراك جماهيري عارم. كانت الشرارة التي أطلقت هذا الحراك موجة من الاحتجاجات الافتراضية على منصات التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى مظاهرات في الشوارع مطالبةً بمساءلة السياسيين وعائلاتهم. بدأت القصة بحملة واسعة النطاق على منصات مثل تيك توك وريديت، استهدفت أبناء الأسر السياسية الثرية والمؤثرة.
تحت هاشتاغات مثل PoliticiansNepobabyNepal#، تم تداول مقاطع فيديو وصور توضح التناقض الصارخ بين نمط حياة “أبناء المحسوبية” الباذخ — الذي يشمل السفر إلى وجهات غريبة، والتعليم في الخارج، واقتناء السيارات الفاخرة — وبين الواقع الاقتصادي القاسي الذي يواجه غالبية الشعب النيبالي.

كان مضمون هذه الحملة يتلخص في سؤال بسيط، لكنه عميق: “أبناء المحسوبية يستعرضون نمط حياتهم على إنستغرام وتيك توك، لكنهم لا يوضحون أبداً من أين تأتي الأموال”، وتزامن هذا الغليان الافتراضي مع قرار حكومي مفاجئ بحظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي الكبرى بحجة عدم امتثالها للوائح الجديدة، فاعتبر المحتجون هذا الحظر محاولة صريحة لإسكات صوت المعارضة وقمع الحملة المتنامية التي تفضح فساد النخب، وبدلاً من أن ينجح الحظر في إخماد الغضب، زاد من تعميق الشكوك حول دوافع الحكومة الحقيقية، مما دفع الحراك من الفضاء الرقمي إلى الشارع الحقيقي.
لم يكن الحظر مجرد شرارة عابرة؛ بل كان تفجيرًا لغضب مكبوت تراكم على مدار سنوات بسبب أزمات اقتصادية عميقة وفساد مؤسسي مستشرٍ، فترف “أبناء المحسوبية” لم يكن سوى تجسيد مادي لهذه المشاكل، ففي الوقت الذي يقل فيه نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن 1,500 دولار أمريكي، يعاني الشباب من بطالة تصل إلى 20.8%، وتعتمد أكثر من 76% من الأسر النيبالية على التحويلات المالية من المهاجرين للبقاء على قيد الحياة. وفي هذا السياق، بدا ترف “أبناء المحسوبية” وكأنه نتيجة مباشرة لجهود المهاجرين الذين يكافحون خارج البلاد لدعم عائلاتهم.
تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف بعد أن استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ما أدى إلى تصعيد جذري في الحراك، حيث قام المحتجون بإضرام النيران في العديد من المباني الحكومية، بما في ذلك البرلمان ومقر إقامة الرئيس، فأثبتت انتفاضة نيبال أن الغضب ليس ضد أشخاص بعينهم، بل ضد منظومة كاملة. إن مشهد “أبناء المحسوبية” وهم يتنعمون بثرواتهم كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، كاشفًا عن هوة سحيقة بين من يملكون ومن لا يملكون.
أصداء تاريخية مشابهة: من باريس إلى القاهرة وتونس
لم تكن انتفاضة نيبال ظاهرة فريدة من نوعها، بل هي حلقة في سلسلة طويلة من الثورات والانتفاضات التي اشتعلت عبر التاريخ عندما أصبح ترف النخب السياسية رمزًا لفسادهم وتهميشهم للغالبية العظمى من الشعب.
تعتبر الثورة الفرنسية عام 1789 مثالًا تاريخيًا بارزًا على أنماط الاحتجاجات المدفوعة بالأسباب الاقتصادية والاجتماعية، إذ لم تكن هذه الثورة مجرد حراك سياسي، بل كانت نتاجًا مباشرًا للتفاوت الطبقي الحاد والظلم الاقتصادي، ففي ظل ديون حكومية هائلة وأزمة غذاء خانقة بسبب شتاء قاسٍ، كان الخبز هو الشرارة المباشرة. ومع ذلك، كان السبب الجذري للثورة هو نظامها الاجتماعي والاقتصادي غير العادل بطبيعته، حيث كان المجتمع الفرنسي مقسماً إلى ثلاث طبقات. احتكرت الطبقتان الأولى والثانية (النبلاء ورجال الدين) الثروة والجاه وامتيازات الإعفاء من الضرائب، بينما تحملت “الطبقة الثالثة” (الفلاحون والعمال والبرجوازية) العبء الأكبر من الضرائب والرسوم، حيث كان أغنى 10% من السكان يمتلكون حوالي 90% من الثروة الوطنية.
على غرار الحالة الفرنسية، كانت انتفاضة الخبز في مصر عام 1977 وتونس عام 1984 نتيجة مباشرة لرفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية، وهو قرار فُرض كجزء من برامج تقشفية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فقد أدى قرار مفاجئ برفع الدعم عن الخبز إلى انتفاضة عفوية وتلقائية من الشعب للتعبير عن سخطه وغضبه. أما في تونس، فقد ارتفعت أسعار الخبز والدقيق بأكثر من 100%، مما أثر بشكل مباشر على الفقراء الذين كانوا ينفقون ما يصل إلى 80% من ميزانيتهم الغذائية على هذه السلع. وفي هذه الانتفاضة، لم يكن “الخبز” مجرد سلعة، بل أصبح رمزًا للمقاومة ضد الفقر والقمع والسياسات النيوليبرالية التي كانت تطبق. لقد خرج المتظاهرون في كلا البلدين إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم، وواجهتهم قوات الأمن بالعنف الشديد، ورغم ذلك اضطرت الحكومتان في النهاية إلى التراجع عن قرار رفع الدعم.
انتفاضات السودان: ثورة من “الأطراف” على المركز
تُعد حالة السودان مثالًا حيًا على أنماط الاحتجاجات المتكررة التي تندلع لأسباب اقتصادية كقاسم مشترك، ففي ثورة 2018، كانت الأسباب المباشرة للاحتجاجات اقتصادية بحتة: نقص حاد في السلع الأساسية وارتفاع أسعارها، خاصة الخبز والوقود. وقد تفاقمت هذه الأزمة بشكل خاص بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011، مما أدى إلى فقدان البلاد 80% من إيراداتها النفطية. لكن السبب الأعمق للحراك كان التهميش المستمر للأقاليم السودانية لصالح المركز، أي العاصمة الخرطوم.
لقد تركزت الثروة، والسلطة، والفرص في العاصمة، بينما عانت الأطراف من إهمال مزمن وتدهور في الخدمات. كما أن سياسات “التمكين” التي تبناها النظام، والتي أسفرت عن تطهير المؤسسات الحكومية من الكفاءات واستبدالها بعناصر موالية للنظام، رسخت ثقافة المحسوبية والزبائنية على حساب الجدارة. إن ترف النخب السياسية التي حصدت ثروات هائلة من هذا النظام الفاسد كان بمثابة إهانة لأبناء الأقاليم الذين لم يجدوا حتى الخبز أو الوقود.
أظهرت الانتفاضة أن تهميش الأطراف لصالح المركز لم يكن مجرد مشكلة اقتصادية، بل كان أيضًا محفزًا للثورة ضد نظام يكرس اللامساواة ويحمي نخبته الفاسدة.
“أبناء المحسوبية” في ميزان الاقتصاد السياسي
لا يمكن فهم ظاهرة “أبناء المحسوبية” كحافز للانتفاضات الشعبية بمعزل عن الأطر النظرية للاقتصاد السياسي. إن هذه الظاهرة ليست مجرد سلوك فردي غير مسؤول، بل هي نتيجة حتمية لسياسات اقتصادية وتصوّرات اجتماعية عميقة الجذور. يُعرّف الاقتصاد النيوليبرالي على أنه نظرية سياسية واقتصادية تدعو إلى إطلاق العنان لرأسمالية السوق الحرة من خلال تقليل التدخل الحكومي إلى الحد الأدنى، وتشجيع الخصخصة، والتحرير، وتقليص الإنفاق العام.
لكن، يرى عالم الاقتصاد ديفيد هارفي أن النيوليبرالية ليست مجرد نظرية اقتصادية، بل هي “مشروع طبقي” متعمد لإعادة توزيع الثروة والدخل من الطبقات الدنيا إلى الطبقات العليا. فيعتقد هارفي أن هذا المشروع نشأ كاستجابة من النخبة الرأسمالية التي شعرت بالتهديد من دولة الرفاهية وحركات العمال القوية بعد الحرب العالمية الثانية. في هذا السياق، يعتبر “أبناء المحسوبية” تجسيدًا ماديًا لهذا المشروع الطبقي، فالثروة التي يتباهون بها ليست مجرد نتيجة للفساد، بل هي نتيجة طبيعية ومقصودة لسياسات تتيح تحويل الأصول العامة إلى ملكية خاصة، وتلغي القوانين التي يمكن أن تعيق تزايد الثروة غير المكتسبة.
فيما تذهب نعومي كلاين في كتابها “عقيدة الصدمة” إلى أن رأسمالية السوق الحرة لا يتم تطبيقها دائمًا بشكل تدريجي، بل غالبًا ما تُفرض بالقوة خلال فترات الأزمات الكبرى، مثل الكوارث الطبيعية، أو الحروب، أو الانهيارات الاقتصادية. تسمي كلاين هذه الاستراتيجية بـ”عقيدة الصدمة”، حيث تستغل النخب السياسية والاقتصادية حالة الفوضى والارتباك التي تلي “الصدمة” لتمرير سياسات اقتصادية غير شعبية مثل الخصخصة الشاملة وتقليص الإنفاق الحكومي. في إطار هذه النظرية، يمكن النظر إلى ظاهرة “أبناء المحسوبية” على أنها الوجه الإنساني لـ”رأسمالية الكوارث”. إن ثرواتهم الفاحشة هي غنائم نظام يزدهر على الكوارث والأزمات. ففي الوقت الذي يواجه فيه عامة الشعب أزمة اقتصادية عميقة، يعمل هذا النظام على استغلال الوضع لزيادة تركيز الثروة في يد القلة.
أما الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي، في كتابه “رأس المال في القرن الحادي والعشرين”، يقدم تحليلاً تاريخيًا عميقًا للامساواة في توزيع الدخل والثروة، إذ يتمحور جوهر أطروحته حول فرضية بسيطة ولكنها قوية: عندما يكون معدل العائد على رأس المال (r) أكبر من معدل النمو الاقتصادي (g) على المدى الطويل، فإن هذا يؤدي حتماً إلى تركيز الثروة في أيدي القلة. يجادل بيكيتي بأن هذه اللامساواة ليست مجرد حادث عرضي، بل هي سمة طبيعية للرأسمالية، ولا يمكن عكسها إلا من خلال تدخلات حكومية كبيرة. تجسد ظاهرة “أبناء المحسوبية” بشكل صارخ نظرية بيكيتي. فثروتهم الموروثة تتزايد بشكل أسرع بكثير من الدخل الناتج عن العمل أو من النمو الاقتصادي للبلاد. إنهم ليسوا مجرد مستفيدين من فساد عابر، بل هم نتاج نظام اقتصادي هيكلي مصمم للسماح للثروة الموروثة بالنمو بشكل أسي، مما يخلق طبقة دائمة من الأثرياء الذين لا يحتاجون إلى العمل.
إن الثروة التي يتباهى بها “أبناء المحسوبية” ليست مجرد نتيجة لسرقة عابرة، بل هي نتاج منظومة كاملة تعمل على حماية النخبة وتفضيلها. وكما أظهرت الثورة الفرنسية، يمكن أن يصبح ترف النبلاء رمزًا لظلم طبقي يمهّد لانفجار ثوري. وكما كشفت انتفاضات الخبز في مصر وتونس والسودان، فإن السياسات الاقتصادية الداخلية والخارجية قد تؤدي إلى إفقار الجماهير وتفجير غضبها.
اليوم، يمثل “أبناء المحسوبية” الوجه الحديث لهذا التناقض، حيث يرفلون في ثروات هائلة في الوقت الذي يغادر فيه شباب بلدانهم بحثًا عن لقمة العيش، أو يقفون في طوابير الخبز والوقود. هذه الظاهرة تؤكد أن الأزمة لا تكمن في انعدام الأخلاق لدى الأفراد بقدر ما تكمن في القواعد التي تحكم النظام بأسره.
فالتزايد المستمر للثروة في أيدي القلة، كما يصفه توماس بيكيتي، سمة طبيعية للرأسمالية غير المنضبطة. أما النيوليبرالية، كما يوضح ديفيد هارفي، فهي مشروع مصمم لتحقيق هذا التركيز للثروة، بينما تقدّم “عقيدة الصدمة” لناعومي كلاين تفسيرًا لآلية فرض هذه السياسات في أوقات الأزمات.
نهاية، وفي مشهد تاريخي مُتكرر، بعيون متباينة، كان جنود الأمن المركزي في معسكرهم في محافظة الجيزة بالقاهرة الكبرى، في فبراير 1986، يعانون من سوء المعاملة وتدني الرواتب، والخوف من تمديد مدة خدمتهم، بينما على الجهة المقابلة، في فندق “الجولي فيل”، يسبح ويلعب ويأكل أولاد النخب السياسية والاقتصادية. هذا المشهد المتبادل بين أعين الأبناء جميعهم، أبناء النخبة وأبناء الشعب، ثوّر الجنود وتمردوا، والتحق بتمردهم بضعة مراكز لقوات الأمن، واندلعت احتجاجات ما عُرفت تاريخيًا في مصر بأحداث الأمن المركزي. في ما بعد، استطاعت سلطوية مبارك السيطرة على تمردهم ومعاقبتهم، لكن الحادثة كانت بمثابة إنذار لانتفاضة أخرى، تجلّت أكبر ملامحها في ثورة يناير عام 2011. والآن، في نيبال، وغدًا، مرة أخرى في مصر، هذا لأن الوعي التاريخي ليس مجرد ترف فكري، بل هو ضرورة وجودية، لأنه يمكّن الجماهير من كشف من يصنع الصدمة ولماذا، ويجعلها قادرة على بناء مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.